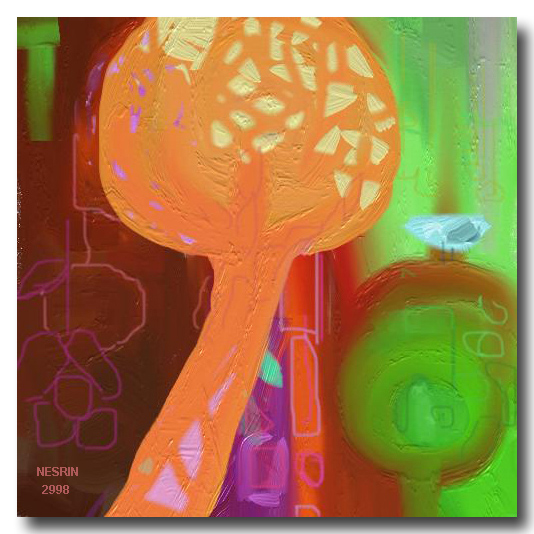|
|
نجيب محفوظ في ابن فطومة
نعيم إيليا


الحوار المتمدن-العدد: 8318 - 2025 / 4 / 20 - 14:01
المحور:
الادب والفن
رواية قصيرة باعتبار عدد الصفحات، طويلة جداً بأحداثها وشخصياتها وأفكارها حتى لتكاد بطولها تفترش أقطار الأرض جميعاً. وإنها لينبثق من بعض أفكارها شعاع لماع ما يزال يحلق ويسمو بأشواق متعطشة إلى الكمال البهي.. بأشواقٍ لن ترتوي حتى يستقر بها التحليق في وكنة من وكنات الوجود ذي المعنى.
كيف استطاع نجيب محفوظ أن يضغط هذه الأحداث والشخصيات والأفكار بعضها إلى بعض داخل عمل أدبي قليل اللفظ، زهيد الدبج ؟!
إنها روعة الإيجاز المبهر وقد سمق إلى القمة بيراع كاتب دانت لسطوة يراعه أفانين الأدب.
ولكن ماذا تستبطن هذه الروعة المبهرة من حقائق إذا تكشفت لعقل استنار بها وانتفع؟
هذا ما سوف تحاول أن تجيب عنه هذه الدراسة، وهي تتعقب آثار بطل الرواية قنديل محمد العنابي المكنى بابن فطومة في كل حلّ منه وترحال، وتتقصى أفكارَه وأفعاله وما سعى إليه من أهداف. كالقطار يعبر نفقاً، وهو في كل محطة من محطات النفق يقف لينزل ركاب، ويصعد ركاب.
للدراسة أيضاً كما للقطار محطات تقف بها، هي على التوالي:
1- ما ينبغي الشروع به قبل الانطلاق في رحلة الدرس.
2- بدء رحلة الدرس بشرح الباعث إلى قيام الرحالة برحلته.
3- عرض مشاهدات صاحب الرحلة، وتتبّع أهم ما جرى له في كل محطة من محطات رحلته.
4- النقد، وينصب على شيئين متداخلين من الحكاية لا يتعداهما: على شخصية الرحالة طباعِها ومسالكها، وعلى ما نثرته الشخصية حولها من أفكار، من آراء.
* * * * *
1- فيما ينبغي الشروع به قبل العرض:
الحكاية منسوجة على منوال أدب الرحلات.. تتبدى لعين المشاهد أول ما تتبدى لوحةً فنية يحيط بها إطار من ماض يسكب ظله على حاضر معيش، وصاحب الرحلة (ابن فطومة) تذكّر كنيته بابن بطوطة (1).
كان الرحالة، فيما غبر من القرون، يخرجون من بلدانهم إلى بلدان أخرى بتكليف من أصحاب الشأن كتكليف كسرى أنو شروان (برزويه) الحكيم بالرحلة إلى الهند في طلب حكمتها، واستنساخ كتبها ولا سيما كتاب كليلة ودمنة الزاخر بالحكم العملية، والإرشادات الخلقية، والنصائح الثرية - على ما روى ابن المقفع - أو بتحريض ذاتي ينبعث من نفس الرحّالة وفكره، ويغريه بالطواف في البلدان على نفقته الخاصة لغاية أو هدف محدد من قبله.
وحكاية ابن فطومة مثال لهذا الضرب من الرحلات.
وقطُّ لم تنقطع الرحلات عبر العصور، وإن تعددت وسائلها، وتبدلت أهدافها، أو انقلبت صورتها ( في حال اعتبار الرحلة شيئاً، فإن للشيء لكلِّ شيء صورةً ومادة، كما بيَّن أرسطو في نقده لمثالية أستاذه افلاطون، وصورة الشيء تتغير أو تنتثر أما مادته فتمكث. ومثال ذلك الإنسان فإن صورته في حال موته تنتثر، أما مادته التي تكوَّن منها فتبقى لا ينالها انتثار. وكذلك صورته وهو عائم فوق أمواج الحياة، فإنها تتغير.. تتنقَّل بين مراحل العمر من الطفولة فالشباب إلى الكهولة فالشيخوخة. لكن الإنسان مع كل هذا التنقل لصورته بين مراحل العمر، يظل هو هو ذلك الإنسان ) فما فتئ الرحالة في عصرنا أيضاً يحملون عصا الترحال على عواتقهم بحثاً وتنقيباً وتحصيلاً وتوثيقاً.
لكنّ رحلات الرحالة في عصرنا ليست تسير كما كانت تسير الرحلات في الأعصر الخوالي مع القوافل التجارية محمولةً على ظهور الجمال والحمير والبغال. إنها اليوم تسير إلى البلدان، إلى الديار، إلى الأماكن المنشود استكشافها، وتحصيل المعرفة عنها، والإخبار عما يجري في ساحتها من أحداث ووقائع بوسائط نقل متطورة: السيارة، الطيارة، السفينة، القطار، الدرّاجة النارية أو الهوائية في الرحلات الفردية لمحبي المخاطرات وهواة المغامرات. ولا يعدم أن يكون الاستكشاف في هذا العصر بالأقمار الصناعية، أو بأجهزة حديثة ذكية متطورة تحتويها المحطة الفضائية المركَّزة في الفضاء خارج السور المحيط بكوكب الأرض.
إن كل شيء يتغير – تغير الأشياء حقيقة مطلقة ثابتة ممتدة في فضاء الزمن بلا قيد بلا حَدّ، لم تلقَ، ولن تلقى، جحداً من أحد ولا حتى من الذين اعتقدوا يوماً بأن الوجود يرين عليه السكون - لكن جوهر الشيء المتغيّر (أصلَه، مادتَه الأولى، هيولاه) كما سبقت الإشارة، يبقى لا يحور فيفنى، إلا حين يعتقد المرء خطأ أن جوهر الأشياء يحور فيفنى.
إن المناسبة (حديث الرحلات) تستدعي تذكر هذه الحقيقة المطلقة وتكرارها
لفهم طبيعة الرحلات وغيرها من الأشياء أيضاً في علاقتها بثنائية المكان والزمان. فما برحت الرحلاتُ - كيفما تكن، وحيثما تكن وجهتها - رحلاتٍ في جوهرها؛ أي انتقالاً لغاية من مكان إلى آخر بوسائط معلومة، بالرغم مما طرأ ويطرأ عليها بمرِّ الحقب من تغير وحَور. وستظل كذلك ما دام على وجه الأرض وعلى وجه غيرها من أجرام الفضاء بشر يرتحلون، أو موجودات تتحرك في أماكنها، أو موجودات تتحرك بالنقلة من مكان إلى آخر.
والسؤال لماذا اختار محفوظ أن يحوط لوحته الفنية - الأدبية (حكايته) بإطار قديم، تصعب الإجابة عنه إجابة قاطعة حاسمة نافذة. فههنا لا يكفي أن يقال في الجواب عن السؤال إن محفوظاً تأثر برحلة ابن بطوطة – مثلاً - فرغب في محاكاتها رغبةَ بعض الكتاب في محاكاة الأعمال التي تستهوي عقولهم، وتأخذ بمجامع قلوبهم: كمحاكاة الفارابي لجمهورية افلاطون، ومحاكاة الجاحظ لحيوان أرسطو، ومحاكاة يوهان فولفجانج فون جوته لسيرة الدكتور فاوستوس، ومحاكاة ابن مسكويه لأخلاق أرسطو في نيكوماخوس، وكذلك محاكاة نجيب محفوظ للتوراة والقرآن بلغته الأدبية، وبنظراته الخاصة، وبتطلعاته الاستشرافية، في روايته أولاد حارتنا (2).
على أن الباحث في هذا الشأن قد يكون له أن يستأنس بحقيقة من حياة محفوظ الأدبية، وهي أنه بدأ حياته الأدبية بكتابة روايات مستلهمة من تاريخ مصر القديم؛ وبحقيقة ثانية من حياته الخاصة تتمثل في الاحتياط لنفسه من التلف، أو من النبذ والكساد، أو من السجن، وذلك بالرمز (3) والتلميح دون الجهر والتصريح. يتجلى هذا الاحتياط في كلّ أعماله التي تتضمن موضوعاتٍ سياسية أو دينية. ولا تستبعد تجربته المؤلمة وذلك حين اختير لبعثة علمية إلى فرنسا إثر تخرجه من الجامعة، لكن اللجنة لم تلبث أن شطبت على اسمه (4) ولا يستبعد أيضاً ولعُه بالسفر، وقد يكون لتقدمه في السن - على ما حدَّث - أثرٌ في اختياره بزعم أن من يتقدم به العمر يميل إلى الماضي فينبش فيه عما انطوى في صفحاته من عبر فيتأملها تأمل الشيخ الحكيم.
لم يكن محفوظ كاتباً ثورياً جريئاً مثل نوال السعداوي، ولا مثل غيرها من كتاب العربية ( ذكوراً وإناثاً ) المتمردين ممن سجنوا وعانوا - وهم كثير - ومنهم شهداء كلمة، وضحايا فكر. كان محفوظ كاتباً شديد الحذر (5) هادئاً، يؤثر السلامة – ولا لوم عليه ولا تعيير، فحياة الإنسان أثمن من كل شيء يملكه؛ لأن كل شيء يملكه الإنسان يمكن تعويضه واستعادته إن فُقد، فأما حياة الإنسان فإنْ عرض لها الفقد، استحال استردادها - ومع ذلك فإن سياسة الرمز الموحي، والغموض المحيل إلى التأويل، والمواربة، والتلويح، والتقية التي انتهجها في سيرته الأدبية، إن كانت أنجته من شراسة السلطة المستبدة (من نبابيت الفتوات) وهيأت له في ظلها أن يعيش بأمان وكرامة من دخل يأتيه من وظائف حكومية، فإنها لم تنجِه من شراسة التطرف الديني المتفاقم كالوباء في كل رجا من أرجاء وطنه؛ بل في كل صقع من الأرض امتدت إليه أذرع التطرف الأخطبوطية.
وفي المقطع التالي المستَلّ من الصفحات الأولى للحكاية، تتكشف ملامح الإطار العام للحكاية، وتتحدد بما يغني عن تتبعها والتثبت منها في مقاطع أخرى منها:
„ وأذعن الشيخ مغاغة الجبيلي للواقع فدعا صاحب القافلة للعشاء معنا. كان في الأربعين، يدعى القاني بن حمديس قوي البنيان والرأي. قال الشيخ مغاغة: أود أن يذهب معك ويرجع معك. فقال الرجل: هذا يتوقف على رغبته. نحن نقيم في كل دار عشرة أيام، فيمضي معنا من يقنع بها، ويتخلف من يروم المزيد. وعلى أي حال توجد قافلة كلَّ عشرة أيام. فقال لي الشيخ مغاغة: عشرة أيام فيها الكفاية.
فقلت: أعتقد ذلك.
أما أمي فركزت على مسألة الأمن، فقال لها الرجل بوضوح: لم تتعرض قافلة لهجوم أبداً. إن أهل البلاد لا يحظون بعشر معشار ما يحظى به الغريب من حماية. وأخذتُ في الاستعداد للرحلة مسترشداً بأستاذي الشيخ مغاغة فملأت حقيبة بالدنانير، وثانية بالملابس، وثالثة باللوازم، ومنها الدفاتر والأقلام والكتب...".
2- الباعث على رحلة ابن فطومة.
فقد تقدّم أن للرحلات، سواء أكانت بتكليف من جهة خارجية، أو كانت بتحريض من الذات، دوافعَ وأغراضاً وبواعث وأهدافاً. فلرحلة ابن بطوطة دافع هو الفضول والاستكشاف، وكذلك كان الاستكشاف دافعاً لرحلة ابن فضلان، ولرحلة فاسكو دا غاما، ولرحلة كريستوف كولومبس، ولرحلات غيرهم فيما خلا من الأزمان ممن يضيق المجال عن ذكرهم لكثرتهم.
ولكن هل كان الاستكشاف – بمعناه الجغرافي، والاجتماعي السوسيولوجي - غرضَ كلّ الرحلات في تاريخ البشر؟ كلا، فللرحلات فضلاً عن ذلك أغراض أخرى: تجارية كرحلة ماركو بولو ورحلات السندباد الخيالية، ودينية تبشيرية كرحلة القديس توما تلميذ المسيح إلى الهند ورحلة جلجامش الأسطورية في طلب المغزى والخلود، والرحلات إلى العالم الآخر في أساطير الشعوب وآدابها مثل معراج زرادشت ومعراج موسى ومعراج اخنوخ ومعراج محمد، وكذلك فيما جاء مشاكلاً لهذا التعريج كرسالة الغفران للمعري والكوميديا الإلهية لدانتي، وأدبية لغوية كتلك التي كان يقوم بها طلاب اللغة والأدب من أقاصي الدنيا إلى معرة النعمان السورية حيث الشاعر أبو العلاء المعري منهل اللغة والأدب والرأي في زمانه، وعلمية كرحلة تشارلز داروين ورحلات ألكسندر فون هومبولدت ورحلات الفضاء، ومعرفية أي لجمع أشتات الحكمة والمعارف العامة من كل لون وفرع، كرحلة برزويه الحكيم الفارسي إلى الهند لاستنساخ حكمتها والتي سبقت الإشارة إليها، وكتلك الرحلات التي قام بها عدد من فلاسفة اليونان وعدد من مؤرخيها إلى مصر وأقاصي الشرق، ومنهم افلاطون وهيرودوتس وفلوتارخوس.
فإن سأل الآن سائلٌ ابنَ فطومة قنديلاً بن محمد العنَّابي (6) على نية تصنيف رحلته بين الرحلات: إلى أيّ من هذه الرحلات تنتمي رحلتك؟
فلن يُتوقع من ابن فطومة أن يتردد في الإجابة عن السؤال بقوله: إنها تنتمي – وإن كانت رحلته في جانب منها رحلة ذهنية روحية - إلى تلك التي هدفها تحصيل المعرفة المكتظة بالفوائد والعبر من البلدان المرتحل إليها، ثم العودة بها إلى الوطن لينتفع بها أبناؤه (7):
„ ونظرتُ إلى أستاذي ملياً وقلت: سأزور المشرق والحيرة والحلبة (8) ولكني لن أتوقف كما توقفتَ بسبب الحرب الأهلية التي قامت في الأمان، سأزور الأمان والغروب ودار الجبل، أيُّ وقت يلزمني لذلك؟ فقال الشيخ مغاغة الجبيلي (9) وهو يلحظ أمي بإشفاق: يلزمك عام على الأقل إن لم يزد. فقلت بتصميم: ليس هذا بالكثير على طالب الحكمة أريد أن أعرف، وأن أرجع إلى وطني المريض بالدواء الشافي „.
فهذا شاهد يمنع اللبس والاشتباه عن تصنيف رحلته بين الرحلات الهادفة إلى طلب الحكمة والمعرفة والعلم. وقد ورد هذا الشاهد في تضاعيف الحكاية مكرراً - اضطره إلى التكرار تكرر مواقف وتساؤلات موجبة لتكراره - أكثر من مرة ولكنْ بصيغ لفظية مختلفة، أو بأشكال من التعبير منوعة:
أ : „ وقلت لنفسي: إن خير ما تفعل يا رحّالة أن ترى وتسمع وتسجل، وأن تتحاشى التجارب، وأن تعاود أحلامك عن دار الجبل، وأن تحمل الدواء الشافي لجراح الوطن…“.
ب : „ فقلت بأسى من أجل ذلك قمت برحلتي يا شيخ حمادة، أردت أن أرى وطني من بعيد، وأن أراه على ضوء بقية الديار، لعلي أستطيع أن أقول له كلمة نافعة “.
ج : „ فقلت مستدركاً: دار الجبل ليست بغايتي الأخيرة ولكني أرجو أن أرجع منها إلى وطني بشيء يفيده „.
د : „ لست من علماء وطني ولا فلاسفته، ولكني محب للمعرفة، ومن أجل ذلك قمت بهذه الرحلة ".
وإذا كان هدف ابن فطومة من الرحلة هو هذا الهدف حقاً، لزم من ذلك أن يكون خلف هذا الهدف باعثٌ حضّه حضاً على السير لبلوغه؛ إذ لا هدف إلا وهو مقرون بباعث ظاهرٍ أو مستتر، قريب أو بعيد.
فما عسى أن يكون هذا الباعث ؟
يروي قنديل العنابي صاحبُ الرحلة، أنه كان أحبّ فتاة من مدينته تدعى حليمة الطنطاوي. فلما عقد عزمه على الزواج منها، واستعد لهذا الزواج من بعد أن خطبها من أبيها الشيخ المؤذّن عدلي الطنطاوي وهمّ به، حدَثَ أن رأى الحاجبُ الثالث للوالي – رمز السلطة الغشوم – حليمة فراقت في عينيه فصمم على أن يضمها إلى حريمه:
„ … ولكن هبط علينا قدرٌ فنسف خطتنا. زحم حياتنا الهادئةَ الحاجبُ الثالث للوالي فاقتحمنا كعاصفة. رأى ذات يوم حليمة فقرّر أن يجعل منها زوجته الرابعة. وذعر الشيخ عدلي الطنطاوي، وقال لأستاذي الشيخ مغاغة: لا قبل لي بالرفض. وفسخ الخطوبة وهو يرتعد، فزُفّت حليمة إلى الحاجب الثالث ما بين يوم وليلة “.
وكان إلى جانب هذا الحدث، أن أمه لم ترفض الزواج من شيخه مغاغة الجبيلي الذي فاجأه بطلب يدها منه للزواج:
„ كان الشيخ أرملاً، وقد أنجب ثلاث بنات تزوّجن وقَرَرْن في بيوتهن. سألتُه ببراءة: ولم تبقى وحيداً؟ .. ألم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عقب وفاة السيدة خديجة؟!
- صدقت، وهذا ما أفكر فيه.
فقلت بحماس: وإنك لرجل ترحّب به كرام الأسر.
فقال بحياء: ولكن مطلبي في أسرتك بالذات.
فدهشت وأحدق بي انزعاج شامل. تساءلت: أسرتي؟!
فأجاب بخشوع: أجل، السّت والدتك.
فقلت بعجلة: ولكن والدتي لا تتزوج.
- لم يا قنديل؟
فحرت قليلاً ثم قلت: إنها أمي.
فقال بهدوء: الزواج شريعة الله سبحانه، ولن يهون عليك أن تتزوج وتترك أمك وحيدة.
وصمتَ قليلاً ثم قال: الله يهدينا إلى سواء السبيل…
وتأملت كيف نزخرف أهواءنا بكلمات التقوى المضيئة، وكيف نداري حياءنا بقبسات الوحي الإلهي".
فهذان حدثان من حياة الفتى الرحالة: حدث انتزاع الحاجب خطيبته منه بما له من سلطة سياسية، وحدث انتزاع أستاذه الشيخ أمّه منه بمكر الزواج الذي يباركه الدين والعرف. ولن يكون هذان الحدثان حدثين منفردين عابرين يمران به فلا يخلفان في نفسه أثراً أو صدى؛ بل سيجتمعان معاً ويتحدان ليكون منهما دافع محرض على القيام بالرحلة بغير قليل من الجموح والتوق.
ولمّا كان الحدثان يسوِّغهما الدين، فلسوف ينشأ في وجدان الفتى الرحالة لوهلة أن للدين أيضاً مساهمةً في امتحانه وابتلائه، أو في صنع مأساته:
„ … زُفَّت حليمة إلى الحاجب الثالث ما بين يوم وليلة. انطويت على نفسي ذاهلاً وأنا أتساءل عن قلب حليمة، عن مشاعرها الدفينة، هل شاركتني ألمي أو أن لألاء الملك أسكرها وبهر عينيها؟ ووجدتني في وحدتي أقول لنفسي: خانني الدين، خانتني أمي، خانتني حليمة، ألا لعنة الله على هذه الدار الزائفة".
ولكنه لن يعتم أن يتراجع عن اتهامه الدين بالخيانة، وعن أنه علة الزيف. سيغلّب رأي أستاذه الشيخ في هذه المشكلة العويصة. وكان أستاذه الشيخ قبل هذا لقّنه أن زيف داره، ليس ناشئاً عن الدين ذاته، وإنما عن هشاشة التزام قومه بالدين، عن ضعف تمسكهم بشرائعه، عن سوء تطبيقهم لمبادئه في حياتهم الخاصة والعامة، عن ابتعادهم عنه حتى بات الدين في عزلة عنهم منطوياً على نفسه في الجوامع:
„ ويوماً، لا أذكر في أي فترة من العمر، سألته: إذا كان الإسلام كما تقول فلماذا تزدحم الطرقات بالفقراء والجهلاء؟ فأجابني بأسى: الإسلام اليوم قابع في الجوامع لا يتعداها إلى الخارج. ويفيض في الحديث فيلهب الأوضاع بنيرانه .. حتى الوالي لا يسلم من شروره. وقلت له: إذن إبليس هو الذي يهيمن علينا لا الوحي ".
وهذا رأيٌ (سيطرة إبليس على دار الإسلام لا الوحي) سيلقى تأييداً له فيما بعد من إمام دار الحلبة حمادة السبكي والد زوجته سامية. الإمام السبكي سوف يشاطر الشيخَ مغاغة الجبيلي رأيه هذا الذي ينزه الدين عن التهمة، ولسوف يوجه أصبع الاتهام إلى الحكام ورجال الدين وعامة المسلمين، وإن اختلف عن الشيخ مغاغة الجبيلي في بعض المسائل والأحكام:
„ وقال الإمام: انظر يا قنديل وطنك دار الإسلام فماذا تجد به؟.. حاكم مستبدٌ يحكم بهواه. فأين الأساس الأخلاقي؟ ورجال دين يطوّعون الدين لخدمته. فأين الأساس الأخلاقي؟ وشعب لا يفكر إلا في لقمته. فأين الأساس الأخلاقي؟ ".
وكذلك زوجته سامية، فإنها ستكون على هذا الرأي. قالت له يوماً بتأنيب:
„ الإسلام يذوي على أيديكم، وأنتم تنظرون ".
فإذا كان عقله رضخ لفكرة أن دينه لا ذنب له فيما آلت إليه حال داره، فإنه مع ذلك سيتوجع من زيف داره، وإذا توجع المرء التمس الدواء. فبات كالمحتم عليه أن يغادر داره وفي وهمه أنه لا يغادرها هرباً ولا هجرة عنها لطلب الرزق أو للإقامة الدائمة في دار أخرى غير زائفة، بل طلباً للعلاجٍ.. لدواءٍ يكون به شفاء داره من الزيف، بنحو ما سعى جلجامش ولكن في طلب الخلود والغاية، أو بنحو ما سوف يسعى إليه عاقل مقيم في كهف افلاطون في اللحظة التي يدرك فيها أن كلّ هذا الذي يراه مرتسماً على جدار الكهف، ما هو إلا صوراً زائفة لحقائق موجودة خارج الكهف:
„ أريد أن أعرف، وأن أرجع إلى وطني المريض بالدواء الشافي".
ولقد حاولت أمه أن تثنيه - وهو الغض الفقير إلى الخبرة والتجربة – عن الرحلة إشفاقاً من مخاطرها وأهوالها، ولكن محاولتها مُنيت بالإخفاق.. باءت بالفشل الذريع أمام عزمه الأكيد، وتصميمه العنيد:
" وهمّت أمي بالكلام، ولكني سبقتها قائلاً بحزم: إنه قرار لا رجعة فيه. واستحوذ عليّ الحلم، وتلاشى الواقع، وتراءت دار الجبل لعين خيالي كنجم معشوق يعتلي عرشه وراء النجوم، فنضجت الرغبة الأبدية في الرحلة على لهيب الألم الدائم…“.
3- عرض حكاية الرحالة:
ولد الرحالة قنديل محمد العنابي، بطل الحكاية، لأب " تاجر غلال مترعاً بالثراء أنجب سبعة تجار مرموقين وعُمّر حتى جاوز الثمانين" من أم فتية جميلة تدعى فطومة الأزهري كانت في السنة السابعة عشرة من عمرها وكان أبوه حين رآها في الثمانين:
" فغزت قلبه وتزوج منها وأقام معها في دار رحيبة اشتراها باسمها محدثاً في أسرته غضباً وشغباً. اعتبر إخوتي الزواج لعبة قذرة غير مشروعة، واستعانوا على أبيهم بشفاعة القاضي وكبير التجار، ولكنه مرق من قبضتهم مروق عاشق مسلوب الإرادة، فاعتدَّ الزواج حقاً لا يقبل المناقشة، وفارق السن وهماً يتعلل به المغرضون…“.
ومات والده ميتة بيضاء:
" قبل أن يطبع صورته في وعيي تاركاً لنا ثروة تضمن حياة رغدة حتى آخر العمر".
أما كنيته (ابن فطومة) فجاءته من إخوته " تبرؤاً " من أخوّته.. تعبيراً منهم عن كرههم لانتسابه إليهم بالقرابة، بالدم. ولأن أمه خافت عليه من أخوته خوف يعقوب على يوسف من أخوته، لم ترسله إلى الكتّاب:
" عهدت بي إلى الشيخ مغاغة، وكان جاراً لأسرتها، ليلقنني العلم في داري. وعنه تلقيت دروساً في القرآن والحديث واللغة والحساب والأدب والفقه والتصوف والرحلات" .
وكان تأثير شيخه فيه، هذا الذي سيصفه كما سيصف دينه، بأنه شيخ عظيم، تأثيراً بليغاً:
„ وراح الشيخ مغاغة الجبيلي ينوّر عقلي وروحي ويبدد الظلام من حولي، ويوجّه أشواقي إلى أنبل ما في الحياة".
هذا الشيخ الجليل هو مصدر ثقافته وعلومه وقيمه الأخلاقية، منه تلقن كل معارفه، وإليه يعزى الفضل في تفتح وعيه على ما في بيئته من خللٍ وفساد تسبَّبا عن ابتعاد داره وغيرها من ديار المسلمين عن روح الإسلام:
„ بعيدة كلُّها عن روح الإسلام الحقيقي " (10).
وكان من تأثيره على عقل الفتى قنديل، أن اعتنق قنديل رأي شيخه في أنّ السبب في تخلف المسلمين عن قافلة الحضارة - إن كان المسلمون متخلفين عنها حقاً. إن الإسلام في اعتقاد جمهور المسلمين نعمة على كل حال. فما دام المسلم مسلماً فهو في نعمة سواء أكانت داره دار حضارة أو لم تكن - هو ابتعادُ المسلمين عن دينهم، لا العكس. فالدين إذاً براء لا يد له في اختلال الأوضاع في ديار المسلمين، وسيظل قنديل الرحالة وفياً لهذا الرأي حتى النهاية بالرغم من تجربة التحول الروحي الخطيرة التي سيخوضها في دار الغروب قبيل انطلاقه نحو دار الجبل.
ومن شيخه سيستمد شغفه بالرحلات. فما فتئ شيخه يحدثه عن مشاهداته في رحلته التي قام بها إلى ديار المشرق والحيرة والحلبة، والتي انقطعت ولم تتجاوز حدود هذه الديار " بسبب قيام حرب أهلية في دار الأمان" (11) حتى أثار أشواقه لدرجة الاشتعال كما يقول.
وكان عشق حليمة استولى على قلبه، فلما صارح أمه التي سألته عن المهنة التي ينوي أن يمتهنها، أنه يفكر بالزواج أولاً (12) لم يسؤها أن يقدم ابنها على الزواج أولاً، لكنها ساءها منه أن يقع اختياره على حليمة التي هي في نظرها "دون المطلوب في كل شيء" ومع ذلك فستذعن لرغبته في النهاية قائلة له بقلب الأم:
„ سعادتك أغلى عندي من أي شيء أو اعتبار. „.
ثم كان ما كان من خطبته لحليمة، وما كان بعد ذلك من زواجها من الحاجب الثالث، وما كان بعد ذلك أيضاً من زواج أمه من شيخه مغاغة الجبيلي. وكل هذا الذي قد كان في حياته، مما قد يصحّ أن يندرج تحت ما يدعى بالمأساة أو المحنة – هي المأساة التي كان أطلق عليها اسم الخيانة - سيضحي العامل الذي سيشحذ عزمه على اتخاذ القرار الذي لا رجعة فيه؛ قرارِ الرحيل إلى الديار التي لا يحكمها الإسلام ليرى على ضوئها وطنه: وهي تباعاً دار المشرق، دار الحيرة، دار الحلبة، دار الأمان، دار الغروب، دار الجبل.
فتكون (الخيانة) على هذا هي السبب المباشر في اتخاذه قرار الرحيل. فصحيح أن الخيانة لم تكن العامل الأول الذي أيقظ وعيه على زيف داره؛ لأن وعيه بفضل أستاذه الشيخ كان مستيقظاً، ولكنها كانت القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل. إن الخيانة – خيانة الدين والخطيبة والأم – هي التي بلا مراء أزعجته عن وطنه.. هي الباعث الأول على اتخاذه قراراً لا رجعة فيه. فأما أحاديثُ أستاذه الشيخ مغاغة الطليّة المشوقة المثيرة عن رحلته فليست الباعثَ له على اتخاذ قراره، كما قد يخيل ذلك للقارئ، بالرغم من أن أستاذه، على ما سلف فيه القول، كان عظيم التأثير في حواسه الداخلية، وفي بنيته الفكرية، حتى ليجد المرء صعوبة في رد قول القائل هنا إنّ ابن فطومة إنما اختار أن يرحل إلى هذه الديار بتوجيه غير مباشر من أستاذه، أو تلبية لنداء ذاك التوق الذي أجّجه في صدره ما كان يرويه له شيخه عن رحلاته. بيد أن هذا القول - ولو صدق - لن يكون له أن ينفي أن الخيانة، خيانةَ الدين تحديداً ( يُلحظ هنا أن قنديلاً يذكر خيانة الدين بالرغم من أنه على رأي أستاذه الشيخ في أن الدين ليس السبب في اختلال أوضاع دار الإسلام، وهذا من المفارقات العجيبة ) هي الباعث الأول على اتخاذه القرار وإنفاذه؛ لأن شيخه من قبله ما بعثه على القيام برحلته إلا خيانة المسلمين لدينهم، وإن لم يأت ذلك صريحاً بلفظه في حديث الفتى عن رحلات شيخه:
„ فحدثني بسخاء حتى عايشت بخيالي ديار المسلمين المترامية، وتبدى لي وطني نجماً في سماء مكتظة بالنجوم. وقال: ولكن الجديد حقاً لن تعثر عليه في ديار الإسلام. وتتساءل عيناي عن السبب فيقول: جميعها متقاربة في الأحوال والمشارب والطقوس، بعيدة كلها عن روح الإسلام الحقيقي…“.
ولا تنتهي الحكاية باتخاذ ابن فطومة قرار الشروع في الرحلة، بل ستبدأ حكايته بتنفيذ قراره حسب الخطة التي اختطَّها لنفسه (من … إلى) غير مبالٍ بالتحذير الذي تلقاه من أحد التجار " ستبدد ثروتك في الترحال، وترجع إلى بلدك فقيراً " والخطة هي السير إلى هدفه على خط - لا يُعلم إن كان مستقيماً أو متعرجاً أو دائرياً ، ما عدا خط السير إلى دار المشرق فمعلوم أنه ينحدر باستقامة نحو الجنوب - يخترق محطات عديدة على التوالي حتى إذا اجتازها جميعاً عاد إلى وطنه. وعلى هذا؛ أي بحسب ما رسم من خطة، ستبدأ حكايته بالسير إلى أولى الديار الواقعة في الجهة الجنوبية من داره، وفيها سينزل رحله مع من أنزل رحله فيها من تجار القافلة.
إنها دار المشرق.
فما دار المشرق؟ وماذا كان من أمره في هذه الدار؟ ما الذي عاينه فيها واختبره؟ بل ما الذي جناه منها لنفسه ولوطنه من قطوف مما منّى نفسه باجتنائها وهو في طريقه إليها؟ ألعلّه عثر فيها على الدواء الذي خرج في طلبه، وهي الدار الوثنية التي يتعوّذ منها كل مسلم وثيق العروة بالإسلام ؟!
الحق أنه لم يعاين في هذه الدار إلا أمرين: هما العري، والفراغ:
„ هالني أمران العري والفراغ. الناس، النساء منهم والرجال على السواء، عرايا تماماً كما ولدتهم أمهاتهم… أما الأمر الغريب الثاني فهو هذا الفراغ الممتد المترامي، كأنما انتقلت من صحراء إلى صحراء. أهذه حقاً عاصمة المشرق؟ أين القصور؟ أين البيوت؟ أين الشوارع؟ أين الحواري؟ لا شيء إلا أرضٌ تعلو جوانبَ منها أعشابٌ ترعاها الماشية، وثمة تجمعات هنا وهناك من خيام تقوم على غير نظام، يتجمع أمامها نساء وفتيات يغزلن أو يحلبن البقر والمعيز، وهن عرايا أيضاً، وجمالهن لا بأس به، ولكن تخفيه القذارة والإهمال والفقر. الحق أني لم أتمادَ في نقد مظاهر البؤس في هذا البلد الوثني الذي قد يكون له من وثنيته عذرٌ، ولكن أي عذر أعتذر به عن أمثال هذه المظاهر في بلدي الإسلامي؟ وقلت لنفسي: انظر وسجل واعترف بالحقيقة المرة “.
ومع أن الرحالة لن يعثر على بغيته في هذا البلد – المقصود ببغيته الدواء - ولن يجد فيه ما " يستحق المشاهدة سوى القصر قصر السيد الحاكم" فإنه - وهو يوازن بين هذا البلد وبلده - لن يستنتج فكرة أنّ دينه الإسلام عظيم وحياةَ المسلمين وثنية: „ وقلت لنفسي متحسراً: ديننا عظيم وحياتنا وثنية“ لأن هذه الفكرة، كان أدركها قبل قيامه برحلته.. أدركها وهو بعد تلميذ يتلقى علومه من أستاذه الشيخ مغاغة، وإنما سيتوصل منها – من الموازنة – إلى الدليل أو البرهان على صحة هذه الفكرة التي كان قبسها من أستاذه الشيخ.
ومع أنه أيضاً لن تنال إعجابه عقيدةُ أهل المشرق الدينية القائمة على عبادة إله القمر، ولن تحظى منه إلا بالنفور طقوسهُم وعاداتهم وتقاليدهم واحتفالاتهم ونظامهم الاجتماعي الذي ذكّره بقبائل العرب قبل الإسلام:
" يا له من نظام ! إنه يذكرني بالقبائل الجاهلية ولكنه مختلف، كما يذكرني بملاك الأرض في وطني، ولكنه مختلف أيضاً " .
فإنه سيتزوج فيهم على سُنَّة أهل البلد في الزواج، وسنتهم في الزواج استئجار فرج.. سيتزوج من فتاة جميلة لها صورة تكاد تحاكي صورة حبيبته السابقة حليمة مما قوى رغبته في استئجار فرجها وجعله يتعلق بها حتى آخر رحلة من رحلاته:
" واشتدت وطأة الملل والحر، فرحت أسلي نفسي بالمشي في السوق. ورغماً عني توقفت مذهولاً أمام خيمة رجل عجوز يعرض التمر في أوعية من الخوص. لمحت فتاة وراءه في عمق الخيمة الفتاةَ الفاتنة حليمة المشرق النحاسية العارية، وهي تزقّ حمامة، منطلقة بقامتها الرشيقة ونضجها الذي لم ينل منه السوء بعد. وقفت محملقاً ناسياً ذاتي، أرى الماثلة أمام عيني، وأتذكر خلالها حليمة بوجهها البدري وعينيها السوداوين وعنقها الطويل… ومضيت أبتعد، وأدركني صوت هرم ينادي: يا غريب!
… فدنوت منه في حياء فسألني: ألم تعجبك ابنتي عروسة؟! … فترددت ملياً ثم قلت: إنها تستحق الإعجاب كله.
- أجبني بصراحة، هل أعجبتك؟ فحنيت رأسي معترفاً فقال: ادخل. ترددت؛ فتناول يدي وجذبني إلى الداخل، ونادى عروسة فجاءت بجسمها العاري وجعلت ترنو إلي، حتى سألها: ما رأيك في هذا الغريب المغرم بك؟ فأجابت بلا حياء ولا تلعثم : إنه مطلوبي يا أبي. ومضى بنا إلى ركن الخيمة وأسدل علينا ستاراً… فسألتها وأنا أشير إلى الخارج: أهو أبوك؟
- نعم.
- أي علاقة بيننا الآن ؟
- عرف أبي أنك تعجبني فدفعك إلي.
- أهذا هو المتبع هنا؟
- طبعاً.
… سألته جاداً : ماذا تقترح لمجنون مثلي؟
- استأجرها لمدة تتجدد حتى تنتهي.
- أطول مدة ممكنة
- استأجرها شهراً بشهر.
- ليكن.
- ولكن الاتفاق ينتهي حال ترغب هي في ذلك. فحنيت رأسي موافقاً فقال: الشهر بثلاثة دنانير . تم الاتفاق ومضيت بعروسة إلى حجرتي بالفندق ..“ .
ولسوف ينجب منها فتخامره الرغبة في الاستقرار في هذا البلد إلى نهاية العمر مستسلماً لدواعي العيش ولذّات الحب متخلياً عن هدفه كما تخلى عنه غيره „ حجزته أسباب الرزق عنه“ كصاحب الفندق (فام):
„ إني مستغرق بالحب ولا شأن لي بالزمن. لا أهمية الآن للرحلة ولا للمهمة ولو بقيت لآخر العمر . وها هي بشائر الأمومة تهل بأفراحها القلبية وأسقامها الجسدية، فأستعيذ بها من تقلبات القلوب وجوامح الأهواء، وأطمح إلى حياة مستقرة، ولو ربطتني في النهاية بالمشرق، وغيرت بشرتي وأحلامي. وقلت ساخراً من نفسي: يبدو أنني خلقت للحب لا للرحلات „.
ولكنه سيرتكب في هذه الدار خطأ لا يغتفر، سيقترف إثماً عظيم الجسامة لن يساهله عليه سيد الدار: „ سينساق إلى تربية ابنه على مبادئ الإسلام" وأهل المشرق يعدون ذلك من الشناعات.. يعتدّونه كفراً عقوبتُه في قوانينهم صارمة فظيعة. غير أنه – لحسن حظه - لن يناله من العقوبات التي يفرضها نظام المشرق على مرتكب مثل هذا الإثم إلا " أخفُّ جزاء" فلكأن سيد الدار حاكمها لان له رحمة منه وعفواً. وحتى امرأته عروسة " لن تسمح له بهذا أبداً " ستكره منه أن يربي ابنه على مبادئ الإسلام وستغضب عليه:
„ قالت لي بجدية: إنك تنشئه على الكفر، وتعده لحياة تعيسة في بلده. فقلت برقة: إني أنقذ روحه كما تمنيتُ أن أنقذ روحك ذات يوم. فقالت بصرامة: لن أسمح لك بهذا أبداً. تبدت صارمة عنيدة، حتى جزعت خوفاً على حبي، وأفضت إلى أبيها بهمومها، ونحن في زيارة له؛ فهاله الأمر وصاح بي: ابعد عن ابننا يا غريب!
وخيّل إليّ أن النبأ تسرب إلى الخارج، رغم تكتمنا له، وأن نظرات الغضب تحرقني في الطريق، وطاردني القلق حتى قلت لنفسي: البناء مهدد بالانهيار ".
وإنه لفي مثواه إذ أتاه ضابط شرطة من لدن سيد الدار ليفرق بينه وبين عروسة وأبنائها منه.. لينتزع زوجه عروسة منه والأبناء، كما انتزع الحاجب الثالث منه خطيبته حليمة، وكما انتزع أستاذه الشيخ منه بالزواج المبارك الحلال والدته الجميلة فطومة الأزهري، ولسوف يأمره بعد احتجازه زمناً يسيراً بالرحيل عن دار المشرق، فيرتحل عنها منكوباً مقهوراً مكلوم الفؤاد محطم الآمال.
ألا ما أبعد الشبه بين أهل المشرق وأهل بلده، وإن اختلفا في العقيدة ومسالك العيش! ويحار المسلم ابن فطومة كيف لداره، وهي تدين بالإسلام (العظيم) أن تكون شبيهة في الانحطاط والإجحاف والفقر والإهمال بدار تدين بالوثنية ؟!
إن أهل المشرق مؤمنون، يؤمنون بإله. ولكن هذا الإله يختلف في طبيعته وصورته وشريعته عن إله المسلمين. إن إلههم القمر. ولسوف يشرح له كاهن المشرق طبيعته وشريعته وكذلك علاقته بهم، بعباده من أهل دار المشرق، في المناقشة التي ثار نقعها بينه وبين هذا الكاهن:
" (إلهنا) لا يتدخل في شئوننا، إنه يقول لنا كلمة واحدة وهي أنه لا شيء يدوم في الحياة، وأنها إلى محاق تسير، بذلك أشار (إلهنا) إلى الطريق في صمت، أن نجعل من حياتنا لعباً ورضاً ".
وأهل المشرق، فضلاً عن ذلك، علاقةُ الرجل منهم بالمرأة لا تتقيد بقيود الزواج التي يتقيد بها أهل داره، وعندهم لا ينتسب الأبناء إلى آبائهم بل إلى أمهاتهم:
„ رجعتُ إلى الفندق فاقد القلب والعقل. تلخصت الحياة كلها في عروسة. والتمست عند فام (صاحب الفندق) مزيداً من الضوء فقال: هذه العلاقة تمارس هنا بلا قيود، ما إن تعجب فتاة بفتى حتى تدعوه على مرأى ومسمع من أهلها، وتنبذه إذا انصرفت عنه نفسها محتفظة بالذرية التي تنسب إليها ".
وينحاز الكاهن إلى إلهه، ولا عجب، فكل مؤمن ينحاز إلى إلهه الذي نشأ على عبادته مذ كان طفلاً، ويستحسن العلاقة الحرة بين الرجل والمرأة وكذلك الإباحة (الحرية الجنسية) ويذم الزواج المقيد بالشرائع، معللاً استحسانه بمنطق لن يقنع الرحالة المسلم قنديلاً:
„ نصف المصائب في البلدان إن لم يكن كلها تجيء من القيود المكبلة للشهوة ، فإذا شبعت أمكن أن تصير الحياة لعباً ولهواً ! ".
ولا يكتفي قنديل بعدم الاقتناع.. يزيد عليه باعتراضه على رأي الكاهن الفظ في عقيدة أهل دار الإسلام:
" في دارنا يأمرنا الله بغير ذلك ".
فيرد عليه الكاهن:
" عرفت أشياء عن داركم ، عندكم الزواج وكثيراً ما يتمخض عن مآس مؤسفة، والناجح منه يستمر بفضل الصبر، كلا يا صاحبي، حياتنا أبسط وأسعد ".
ويمتد النقاش، يطول بينهما حتى إذا سمع الكاهن من الرحالة المسلم قوله:
" الناس عندنا إخوة من أب واحد، وأم واحدة، لا فرق في ذلك بين الحاكم وأقل الخلق شأناً "
انبرى الكاهن، وقد احتدّ قليلاً، لهدم ما ادعاه قنديل:
„… ما قلتَ هو حقاً شعاركم، ولكن هل يوجد لتلك الأخوة المزعومة أثرٌ في المعاملة بين الناس؟ ".
ويمضي الاثنان على هذا الغرار في المفاضلة بين دينيهما. كل منهما يرى دينه أفضل من دين الآخر:
„ فقلتُ بحرارة وقد تلقيت طعنة نجلاء: إنه ليس شعاراً ولكنه دين.
فقال ساخراً: ديننا لا يدَّعي ما لا يُستطاع تطبيقه.
فقلت وقد شدتني الصراحة إلى أعماقها: إنك رجل حكيم، إني أعجب كيف تعبد القمر، وتتصور أنه إله ؟!
فقال بجدية وحدة لأول مرة: إننا نراه ونفهم لغته، هل ترون إلهكم؟
- إنه فوق العقل والحواس.
فقال باسماً: إذن فهو لا شيء.
كدت ألطمه، ولكني كظمت حنقي، واستغفرت ربي، وقلت: إني أسأل الله لك الهداية. فقال باسماً: وإني أسأل إلهي لك الهداية. وصافحته مودعاً، ورجعت إلى الفندق ثائر الأعصاب، موجع القلب، وعاهدت نفسي أن أسمع – في رحلتي – كثيراً وأن أناقش قليلاً أو لا أناقش على الإطلاق. وقلت لنفسي متحسراً: ديننا عظيم وحياتنا وثنية... „.
أما رحلته الثانية، فكانت إلى دار الحيرة مع قافلة تتَّجر، وفي نفسه ألا يخوض لا في نقاش وحسب، بل أيضاً في تجارب من مثل تجربته المريرة (حب عروسة وإنجاب الولد منها) تلك التي خاضها في دار المشرق؛ خوفَ أن تجعله التجارب يذهل هدفه من الرحلة مثلما كادت تذهله عنها إذ هو مقيم في دار المشرق:
„ وقلت لنفسي: إن خير ما تفعل يا رحالة أن ترى وتسمع وتسجل، وأن تتحاشى التجارب وأن تعاود أحلامك عن دار الجبل، وأن تحمل الدواء الشافي لجراح الوطن ".
وسرعان ما ينبثق السؤال ههنا: ماذا كان من أمر الرحالة في هذه الدار ؟ ألعله يكون عثر فيها على الدواء الشافي لجراح وطنه ؟!
إنه السؤال الذي انبثق على الفور في المرة الأولى عند دخول الرحالة دار المشرق، وهو السؤال الذي سوف ينبثق أيضاً وعلى الفور في كل مرة تطأ قدمه فيها داراً جديدة من الديار التي كان أزمع في خطته على زيارتها.
لكنّ الجواب سيخيب على الفور كما انبثق على الفور.. سيخيب كما خاب – ويا للأسف ! - في المرة الأولى.
لن يوفق الرحالة في هذه المرة أيضاً في العثور على الدواء الشافي لوطنه المريض. بيد أن حظه فيها من النوائب والمكاره سيكون وفيراً. لا لأنه ما وفى بعهده ألا يخوض في التجارب وهو في دار الحيرة، بل لأن التجارب أبت إلا أن يخوض فيها. في هذه المدينة ستدهمه تجربة من أدهى التجارب وأقساها، وتفرض عليه غرامة باهظة مميتة لإثم ما ارتكبه.. لتهمة باطلة ستلتهم عشرين عاماً من حياته سدى.
فما كاد الرحالة يضع رحله في حاضرة هذه الدار، حتى دقت أجراس الحرب وطبولها. أعلنت دار الحيرة الحرب على دار المشرق طمعاً بمراعيها الفسيحة الخصيبة وطمعاً بامتلاك كنوز حاكميها لا حباً في تحريرها من الطغيان كما رُوّج لهذه الخدعة بين الناس. هكذا كل الحروب والغزوات، فإن الطمع بامتلاك ثروات الأمم الأخرى هو الذي يوقد نارها.. امتلاك الثروات بالقوة هو الغاية والقصد منها، وليست الغاية منها تحرير الشعب من العبودية والظلم، ولا الغاية منها نشر المبادئ النبيلة والقيم الجميلة في حياة هذا الشعب المقهور لا المحررّ حسبما يُدَّعى ببهتان:
„ استيقظت مبكراً بخلاف ظني، وفي الحال أدركت أن جلبة شديدة تهبُّ من الطريق هي التي انتزعتني من نومي. وفتحت نافذة فرأيت في ضوء البكور جيشاً لجباً، فرساناً ورجالة، يتقدم على دقات طبل نحو باب المدينة … هممت أن أسأل الخادم عن مسيرة الجيش، ولكن الحذر أمسكني. وارتديت ملابسي فوجدت مدخل الفندق مكتظاً بالناس وهم يتحاورون: إنها الحرب كما توقع كثيرون…“.
لكن الحرب وإن كانت شراً مدمراً متفجراً بالأهوال والمحن والآلام، فإنها جالبة للفوائد.. للتجار خاصة. ودار الحيرة سوف تنتصر في حربها على دار المشرق. إنها الأقوى، والأقوى ينتصر دائماً في النهاية. ولأن (عروسة) امرأة الرحالة قنديل مشرقية، فإنها ستقع سبية في يد الجيش المنتصر:
„ وفي ذيل الجيش سارت السبايا من النساء بين ذراعين من الحراس، خفق قلبي خفقة شديدة وتمثلت عروسة لعيني كما رأيتها أول مرة بل كما رأيتها وهي تقود أباها في الحارة التي شهدت مولدي وزاغ بصري بين الوجوه المنكسرة والأجساد العارية. وصدقت لهفتي فاستقرت عيناي على وجه عروسة بجسدها الممشوق ووجهها المليح التعيس تتقدم ذاهلة يائسة ضائعة… “.
وبوقوعها سبية في يد الجيش المنتصر، تكون الحرب أسدت له معروفاً وإحساناً، فهي ستجمع بينه وبين (عروسة) حبيبته وأمِّ أبنائه بعد فراق قهري موجع:
„ وجعلت أطوف بسوق الجواري كل يوم، وحلمي بجمع الشمل يتحدى اليأس… ولما عرضت عروسة اقتحمت المزاد بإصرار… ولم يبق معي في المزايدة إلا شخص سمعت من يهمس بأنه مندوب من الحكيم ديزنج. ورسا المزاد علي بثلاثين ديناراً، فلما دُفعت إلي عرفتني فارتمت بين يدي… وفي الطريق ما ملكت أن سألتها: كيف الأبناء يا عروسة؟ … فقالت ودموعها تسيل إنه الهول، اقتحموا الخيمة، قتلوا أبي بلا سبب، قبضوا عليّ. أين الأولاد؟ لا أدري، قتلوا؟ .. تاهوا؟ .. فقلت مكابراً مخاوفي: لماذا يقتلون الصغار؟ .. كلا.. إنهم في مكان ما.. سنعثر عليهم „.
لكن جمع الشمل لن يكون بادرة من بوادر السعد، ولا بشرى هناء.. سيكون مشؤوماً سيكون جاذباً للنحس المقيت. (ديزنج) حكيم الحيرة هذا الدجال الذي غاب عن الرحالة أن يأخذ حذره منه، سيغريه جمال عروسة على امتلاكها. ولكي يحوزها مالكاً لها، لن يتورع الحكيم الدجال عن أن يلفق لقنديل الرحالة الذي كان كشف له أنه مسلم، تهمة السخرية من دين دار الحيرة التي تستضيفه، والسخرية جريمة عقدية – سياسية إذا وقعت من أحد في هذه الدار قضي عليه بالسجن المؤبد، إن لم يقض عليه بموت زؤام:
„ وذهبنا إلى إدارة الشرطة العامة بالشارع الملكي، فمثلت أمام المدير الذي جلس على أريكة بين بعض معاونيه. نظر إلي نظرة لم أرتح لها وسألني: أنت قنديل محمد العنابي الرحالة؟ فأجبت بالإيجاب، فقال: إنك متهم بالسخرية من دين هذه الدار التي تستضيفك. فقلت بقوة ووضوح: تهمة لا أساس لها من الصحة. فقال ببرود: يوجد شهود. فهتفت: لا يمكن أن يشهد بذلك ذو ضمير. فقال باستياء: لا تطعن الأبرياء، ولتدع ذلك لتقدير القاضي.
وألقى القبض عليّ. وفي صباح اليوم التالي قدمت إلى المحكمة. وأُعلنت التهمة فرفضتها، وجاء شهود خمسة على رأسهم (هام) صاحب الفندق، فأدلوا بشهادة واحدة – كأنها قطعة محفوظات – بعد أن أدوا اليمين. وأصدرت المحكمة حكمها بسجني مدى الحياة، مع مصادرة أموالي وما أملك، وبذلك دخلت عروسة في المصادرة… ضاعت عروسة، تلاشت الرحلة، تبدد حلم دار الجبل، اختفى وجودي نفسه في هذه الدنيا. وكان السجن عند مشارف المدينة في منطقة صحراوية، وهو عبارة عن مكان متسع تحت الأرض، ذي منافذ ضيقة في السقف، وجدرانه من الأحجار الكبيرة، وأرضه رملية، ولكل سجين سروال لا غير وفروة، يكتنفه جوّ خانق ذو رائحة كدرة، نصف مظلم كأنه فجر لا تشرق فيه شمس. نظرت حولي وقلت في ذهول: سأبقى هنا حتى آخر يوم من حياتي. وتطلع إلي الرفاق وسألوني عن جريمتي . سألوني وسألت. أدركت أن ما يجمعنا هي جرائم العقائد والسياسة… ولم يكن أحد منهم قد كفر بالإله، فهذه جريمة عقوبتها ضرب العنق، ولكن نقلت عنهم تساؤلات ناقدة لبعض التصرفات الشاذة التي تمس العدالة أو حرية الإنسان…“.
وأيضاً ما أقرب الشبه بين دار الحيرة وداره ! كأنها دار خالية لا شيء فيها إلا حاكم طاغية مستبد، خالق إله، مالك لكل شيء، وشعبٌ إذا كفر فرد منه بألوهية الطاغية ضُربت عنقه، وإذا صدر عنه نقد " لبعض التصرفات التي تمس العدالة أو حرية الإنسان " نال عقوبة السجن حتى الموت.
وأخذ الرحالة المسلم يقارن بين وطنه ودار الحيرة الوثنية الطغيانية في مسعى منه إلى توكيد حقيقة التشابه بين الدارين:
" وتذكرت أستاذي الشيخ مغاغة الجبيلي فسألته على البعد: أيهما أسوأ يا مولاي، من يدعي الألوهية عن الجهل أم من يطوّع القرآن لخدمة أغراضه الشخصية ؟! „.
وإذا به يتذكر حاجب الوالي في وطنه هذا الذي استطاع أن يسرق منه خطيبته حليمة الطنطاوي سرقة مباحة بقوة النفوذ، فيلتهب في الذهن من التذكر هذا السؤال: ما الفرق بينه وبين حكيم دار الحيرة الدجال ديزنج الذي استطاع كما استطاع الحاجب أن يسرق منه امرأته عروسة بقوة النفوذ وفي وضح النهار.
وسيكون من تداعيات مأساته استغراقه، ومعه أحد أقرانه من السجناء المظلومين، في تأمل عميق بسطت عليه ظلَّها حلكةٌ من كآبة لا تتشرّبها إلا روح عانية:
„ وحامت أفكارنا حول وضع الإنسان في هذا العالم.
- لا يوجد بلد سعيد.
- الشكوى هي لغة الإنسان المشتركة.
- نحن الحائرون بين الواقع القبيح والحلم الذي لا يتحقق.
- لكن ثمة بلدان أفضل.
- هي نفسها لم تعرف الرضا بعد.
- ودار الجبل؟
وثب قلبي في صدري حال استقبال الاسم الساحر. تذكرت بحسرة هدفي الضائع. وسألت: ماذا تعرف عنها؟
- ليس أكثر مما يقال عادة من أنها وطن الكمال.
فسألتُ باهتمام: ألم تقرأ عنها كتاباً أو قابلت من زوارها أحداً؟
- كلا.. ليس إلا ما يقال.
- ومن ذا يحقق الحلم؟
- الإنسان، لا شيء سوى الإنسان „.
وفي قاع سجنه الرهيب:
„ ضاع الزمن فيما ضاع من أسباب الحياة، واختفى التاريخ، وجهلتُ الساعة واليوم والشهر والعام، وتوارت المعالم ، وبات عمري لغزاً، وجعلت أكبر بلا تحديد ولا حساب، ولا مرآة أرى فيها نفسي إلا الرفاق فأتخيل ما صرت إليه من بشاعة وقذارة، فلم ينعم بالسعادة في دنيانا المظلمة إلا الهوام والحشرات. لا شك أن الأجيال والعصور والدهور تتعاقب وأننا نتذوق طعم الفناء بجلاله الأبدي ".
ولكنه بعد عشرين عاماً من غيبوبة بين الحياة والموت، ستمتد إليه يد الرحمة من حيث لم يحتسب، وبعد أن كان أيقن بالهلاك وضياع الآمال والأحلام:
" سيخرج من غيبوبته الأبدية… ثار قائد الجيش على الملك الإله، وقتله وأحلّ نفسه محلّه " . حمل إليه هذا النبأ المحيي حكيم الحيرة ديزنج سارق امرأته عروسة بقوة نفوذه، والذي لفق له التهمة التي أبهظت عمره سنين طويلة بغيبوبة كادت تودي به إلى الهلاك. ديزنج هذا الحكيم (الدجال) ستنتقم الحياة منه شر انتقام.. سيزج به في السجن الذي زج به بأمر من الملك الجديد ليشرب حتى الثمالة من كأس العذاب التي أشربها ضحيته. أما الرحالة، فسيفرج عنه، وسيعتذر إليه مدير السجن الجديد قائلاً له:
„ نحن آسفون لما حلّ بك من ظلم يتنافى مع مبادئ وقوانين دار الحيرة. وقد تقرر أن يرد إليك مالك ومتاعك عدا الجارية التي غادرت البلاد ".
ومكث الرحالة قنديل زمناً في دار الحيرة بعد الإفراج عنه، إلى أن استرجع شيئاً من قواه الذاهبة فبات قادراً على المشي بقدميه، وقادراً على التعامل مع ما يحيط به إذ انصلح بالنقاهة ما كان اختل من توازنه النفسي. فما تمّ له ذلك حتى قرر مواصلة الرحلة بل استجاب لنداء القدر – الرحلة قدره - ماحياً من ذهنه فكرة العودة إلى وطنه تلك التي خطرت في باله في لحظة من لحظات الضعف، أو في لحظة كالطرف هجعت فيها عين القدر:
„ وكرهت العودة إلى الوطن على هذه الحال من الجدب والخيبة. وحدثني قلبي بأنني في وطني معدود من الأموات، لا أحد ينتظرني أو يهمه مرجعي، هذا إذا لم يكن الموت قد أدركهم فاستأصل الجذور وبذر في أصولها الغربة والوحشة. كلا لن أرجع. لن التفت إلى الوراء، بدأت رحالة، وسأظل رحالة، وفي طريق الرحلة أسير. إنه قرار وقدر، خيال وفعل، بداية ونهاية. فإلى دار الحلبة وما بعدها حتى دار الجبل…“ .
فما دار الحلبة؟
لن يطول بالرحالة أن يستكشف أن دار الحلبة ليست كدار المشرق، وأنها ليست كدار الحيرة، وأنها أيضاً ليست كدار الإسلام في العقيدة، ونظام الحكم، ومستوى المعيشة. إنها مختلفة عن هذه الديار في جميع هذه الأحوال والشؤون تمام الاختلاف. دار الحلبة هي دارُ الحرية قبل كل شيء. وحريتها حقيقية أصيلة لا زائفة كالتي خبرها في داره وفي دار المشرق، ودار الحيرة، ولا كتلك التي سيختبرها في دار الأمان. تبين له ذلك من حدث استقبال مدير جمارك الحلبة للقافلة وهي بعد على بوابة سور دار الحلبة:
" وواصلنا السير حتى رأينا السور العظيم تحت ضوء تربيع القمر، وتقدم إلينا مدير الجمرك بسترته الخفيفة المناسبة لجو الصيف المعتدل، وقال بصوت مرح: أهلاً بكم في الحلبة، دار الحرية. وقلت لصاحب القافلة: أول دار ترحب بالقادم بلا نذير. فضحك قائلاً: إنها دار الحرية…“.
فجميع تلك الدور تشترط للحرية حدوداً لا يجوز أن يتعداها المواطن ولا الزائر إلا دار الحلبة. فإنها دار لا حدود للحرية فيها ولا شروط.
وقد يكون غريباً أن يستكشف الرحالة أن دار الحلبة دار حرية غير مشروطة بشروط أو منقوصة، وغريباً أيضاً أن ينبهر بها كل هذا الانبهار:
" ومنذ اللحظة الأولى شملني شعور بأنني في مدينة كبيرة، يذوب فيها الفرد فلا يدري به أحد… تركت قدميَّ تقودانني بحرية في مدينة الحرية، فانبهرت بكل ما وقعت عليه عيناي بين خطوة وأخرى…“.
أفما كان شيخه مغاغة الجبيلي الذي زارها، حدثه عنها ؟!
بلى:
" أما حديثه (حديث شيخه مغاغة) عن الرحلات فمثارٌ للعشق والسرور. وتكشّف في مجرى حديثه عن رحالة قديم… أثار أشواقي لدرجة الاشتعال، ثم قال: قمت بتلك الرحلة وحدي عقب وفاة أبي، فزرت ديار المشرق والحيرة والحلبة…“.
والمعنى أن المرء لا ينبهر عادة كل هذا الانبهار بشيء قد وُصف له أو أحيط به علماً من قبل أن يعاينه بنفسه ويحتك به.
ومهما يكن من شيء فإن دار الحلبة دار حضارة (13) دار ترفرف في سمائها الزرقاء بيارق الحرية، وتنتشر من رفرفتها نفوحُ الديمقراطية والعلمانية والحقوق المصانة. ولا يضيرها أو يقبّحها انتشار متناقضاتٍ فيها: كالفقر والغنى، والجريمة والأمان، والشذوذ والاستقامة، وتصادم الآراء واتفاقها، وتنوع المذاهب وتنابذها، وأيضاً لا يقبحها عجزُها عن تجنب الحروب.
فلا غرابة إذن في أن ينغمس الرحالة في نعيمها ورخائها بعد حين من إقامته فيها ولحين. وإنما الغرابة في أن يتزوج فيها مخلفاً عدداً من الأبناء، كما كان فعل في دار المشرق. وأيضاً أن يوافق زوجته على البقاء فيها مدى العمر، وهو الذي كان عاهد نفسه على ألّا يخوض في التجارب، وعاهدها على أن يقف مما يصادفه في البلدان موقف المتفرج المحايد الذي حسبه أن يرى، ويسمع، ويسجل:
" انغمست في الحلبة ، في الحب ووفرة الرزق والأبوة والصداقة، وكنوز السماء والحدائق التي لا نهاية لحسنها، ما حلمت بشيء أجمل من أن يدوم الحال، وتوالت الأيام حتى صرت أباً لمصطفى وحامد وهشام…“.
فأما زوجته سامية فلن تكون وثنية كعروسة أو من دين آخر، ستكون مسلمة ابنة إمام المسلمين في حاضرة الحلبة، ويدعى حمادة السبكي. ولن تكون ضعيفة مقموعة مستعذبة للذل وذات شخصية رخوة مثل خطيبته السابقة حليمة الطنطاوي، ولا مستسلمة للأقدار مثل أمه فطومة الأزهري؛ بل قوية العقل، كريمة النفس، متعلمة، متفتحة المدارك، طبيبة أطفال. إنها ابنة بيئة متحضرة راقية.. ابنة بيئة قد تكيّف فيها الإسلام حسب قيمها وتقاليدها ومبادئها الغريبة؛ الغريبةِ بالإضافة إلى الرحالة القادم إليها من دار الإسلام:
" وصادفتني تقاليد غريبة تعتبر في وطني بعيدة عن الإسلام، فقد رحبت بي زوجة الإمام (والدة سامية) وكريمتها بالإضافة إلى ابنيه. وتناولنا الغداء على مائدة واحدة، بل قُدّمت إلينا أقداح نبيذ، إنه عالم جديد، وإسلام جديد. وارتبكتُ لوجود المرأة وكريمتها، فمنذ بلغت مشارف الشباب لم تجمعني مائدة طعام مع امرأة لا أستثني من ذلك أمي نفسها. ارتبكت وغلبني الحياء، ولم أمسَّ قدح النبيذ. فقال الإمام باسماً: دعوه لما يريحه. فقلت: أراك تأخذ برأي أبي حنيفة؟ فقال: لا حاجة بنا إلى ذلك؛ فالاجتهاد عندنا لم يتوقف، ونحن نشرب مجاراة للجو والتقاليد ولكننا لا نسكر „.
وستكون لها (لسامية) نظراتها في الإسلام، وهي نظرات أبيها وأهل بيتها، ولعلها أيضاً نظرات السواد الأعظم من مسلمي دار الحلبة:
„ وسألتني سامية عن الحياة في دار الإسلام، وعن دور المرأة فيها، ولما وقفت على واقعها انتقدته بشدة، وراحت تعقد المقارنات بينه وبين المرأة في عهد الرسول، والدور الذي لعبته، حتى قالت: الإسلام يذوي على أيديكم، وأنتم تنظرون ".
وصادفه أيضاً رأي غريب من الإمام السبكي والد سامية. ففي المناسبة التي شرع فيها الإمام يشرح له أحوال الحلبة مجلياً ما غمض عليه من أمورها - وكان الرحالة قنديل، يصغي إليه مبهوراً بما يسمعه منه عن دار الحلبة، مبهوراً برقي الدار – إذا به، بالرحالة، في نهاية حديث الإمام إليه يتمنى: "لو أن أهل الحلبة يطبقون الشريعة الإسلامية" فيرد الإمام:
"لكنكم تطبقونها „. (14)
أي إنكم تطبقونها ومع ذلك فإنها لا ترتقي بكم. إنه رأي غريب لم يألفه الرحالة المسلم، فيأخذ يعارضه برأي مضاد سبق أن تلقّنه من شيخه مغاغة الجبيلي:
" الحق أنها لا تطبق".
وسيصادفه رأي مدهش آخر من حكيم يدعى (مرهم) ولكنْ في اتجاه معاكس. هذا الحكيم الذي زوّده بمعرفة أحداث فاصلة من تاريخ الحلبة كانت سبباً في نهضة دار الحلبة من الحضيض إلى القمة، قمة الحضارة، بالرغم من أنه حكيم عقلاني ملحد وليس مسلماً، سيمتدح أمامه مبدأ الجهاد في الإسلام (15)
ولعله من غيرِ الباعث على الملل، نقلُ الحديث الذي دار بينه وبين حكيم الحلبة، وبلفظ أدق (أحدِ) حكمائها، إذ إنه ليس في هذه الدار حكيم واحد أوحد كما في دار المشرق أو دار الحيرة أو دار الإسلام، ولهذا مغزاه:
„ فذهبت مسرعاً إلى دار الحكيم مرهم فبلغتها متأخراً ساعة عن الميعاد. استقبلني في حجرة أنيقة حوت الكتب والمقاعد والشِّلَت معاً. وجدته طويلاً نحيلاً في الستين من عمره، أبيض الشعر واللحية، يرفل في عباءة زرقاء خفيفة. قبل اعتذاري عن التأخير ورحب بي، ثم سألني: أيهما تفضل، الجلوس على المقاعد أم الشلت؟ فقلت باسماً: الشلتة أحب إلي. فقال ضاحكاً: هكذا العرب، إني أعرفكم، زرت بلادكم، ودرست معارفكم. فقلت بحياء: لست من علماء وطني ولا فلاسفته، ولكني محب للمعرفة، ومن أجل ذلك قمت بهذه الرحلة. فقال بهدوء مشجع: في هذا ما يكفي، وما هدفك من الرحلة؟ فتفكرت ملياً ثم قلت: زيارة دار الجبل.
- لم أعرف أحداً زارها، أو كتب عنها.
- ألم تفكر يوماً في زيارتها؟
فقال باسماً: من آمن بعقله أغناه عن كل شيء.
فقلت مستدركاً: دار الجبل ليست بغايتي الأخيرة، ولكني أرجو أن أرجع منها إلى وطني بشيء يفيده.
- أرجو لك التوفيق.
فقلت كالمعتذر: الحق أني جئت لأسمع لا لأتكلم.
- هل لديك سؤال يشغلك؟
فقلت باهتمام: حياة كل قوم تتكشف عادة عن فكرة أساسية.
فاعتدل في جلسته وقال: لذلك يسألنا محبّو المعرفة من أمثالك كيف صنعتم حياتكم.
- وحياتكم جديرة بإثارة هذا السؤال.
- الجواب بكل بساطة، لقد صنعناها بأنفسنا.
فتابعته في تركيز وصمت، فقال: لا فضل في ذلك لإله، آمن مفكرنا الأول بأن هدف الحياة هو الحرية، ومنه صدر أول دعوة للحرية، وراحت تتسلسل جيلاً بعد جيل.
وابتسم، وصمتُّ حتى تستقر كلماته في مستقرها من نفسي، وقال: بذلك اعتُبر كل تحرر خيراً وكل قيد شراً، أنشأنا نظاماً للحكم حررنا من الاستبداد، وقدّسنا العمل ليحررنا من الفقر، وأبدعنا العلم ليحررنا من الجهل، وهكذا.. وهكذا.. فإنه طريق طويلة بلا نهاية.
حفظت كلَّ كلمة بدرت منه باهتمام بالغ، أما هو فقد واصل حديثه قائلاً: لم يكن طريق الحرية سهلاً، ودفعنا ثمنه عرقاً ودماً، كنا أسرى الخرافة والاستبداد، وتقدم الرواد، وضربت الأعناق، واشتعلت الثورات، ونشبت حروب أهلية، حتى انتصرت الحرية وانتصر العلم (16).
حنيت رأسي مظهراً إعجابي؛ فراح ينقد أنظمة دار المشرق ودار الحيرة، ويسخر منهما، بل سخر أيضاً من نظام دار الأمان التي لم أزرها بعد، وحتى دار الإسلام، لم تسلم من حدة لسانه، والظاهر أنه قرأ تغيراً في صفحة وجهي فسكت، ثم قال بنبرة المعتذر: إنكم لا تألفون الرأي الحر.
فقلت بهدوء: في حدود معينة. فقال متراجعاً: معذرة، ولكن عليك أن تعيد النظر في كل شيء. فقلت مدافعاً: داركم لا تخلو من فقراء ومنحرفين. فقال بحماس: الحرية مسئولية لا يستطيع الاضطلاع بها إلا القادرون، وليس كل من ينتمي إلى الحلبة أهلاً لهذا الانتماء، لا مكان للعجزة بيننا. فتساءلت بحرارة : أليست الرحمة قيمة مثل الحرية ؟!
- هذا ما يردده أهل الديانات المختلفة، وهم الذين يشجعون العجزة على البقاء، أما أنا فلا أجد معنى لكلمات مثل الرحمة أو العدالة، يجب أولاً أن نتفق على من يستحق الرحمة ومن يستحق العدالة.
- إني أخالفك في ذلك حتى النهاية.
- أعرف ذلك.
- لعلك ترحب بالحرب !
- فقال بوضوح: إذا وَعدَت بمزيد من الحرية، ولست أشك مطلقاً في أن انتصارنا على الحيرة والأمان خير ضمانة لسعادة شعبيهما. وبهذه المناسبة إنني على مبدأ الجهاد في الإسلام.
وراح يفسره تفسيراً عدوانياً، فتصديت له لتصحيح نظريته، ولكنه لوّح بيده باستهانة وقال: لديكم مبدأ عظيم، ولكنكم لا تملكون الشجاعة الكافية للاعتراف به. فسألته: إلى أي دين تنتمي أيها الحكيم مرهم؟ فأجاب باسماً: دين إلهه العقل ورسوله الحرية…“ .
وليس من العسير أن تُستشفَّ من موقف هذا الحكيم من العجزة والحرب شخصيةُ مفكر يكره اللين والشفقة ويحبذ القسوة والعنف. فأما مبدأ الجهاد عند المسلمين فهو نشر الإسلام بالسيف، ونشرُ فكرةٍ يراها أصحابها حقاً بالسيف أي بالقتال والحرب، أمرٌ محبوب مرغوب به من قبل هذا الحكيم لا من قبل جميع حكماء الدار. وهذا الذي يفسر سبب تأييده حرب داره على داري الحيرة والأمان لنشر لا الإسلام ولكن العقلانية والحرية والديمقراطية والعلمانية (قيم العصر الحديث) التي هي مجتمعة السبيل إلى كشط الخرافة، وإحراز التقدم الحضاري، وخلق شروط خصبة لنمو بذور السعادة في نفوس المواطنين. بيد أن الرحالة المسلم في تصديه لرأي الحكيم في الجهاد، سيحنف إلى تفسير يبرّئ مبدأ الجهاد الإسلامي مما ألصقه به الحكيمُ من عنف وعدوان؛ تفسيرٍ يتوافق مع ميل الرحالة إلى المسالمة وبغض الحرب. ولكن إن تحرّاه المتحري، فسيستنتج أنه تفسير لا يلتزم بنص القرآن، وأنه لا يحتفل بالسردية التاريخية، وأنه فوق ذلك مرفوض لا يحظى بقبول من عامة المسلمين أكثرِهم.
وكأن الرحالة ههنا قد اجتهد في تفسير مبدأ الجهاد، مع أنه لم يُعرف عنه حتى ذلك الوقت أنه من المجتهدين في الإسلام. فلو كان معروفاً عنه أنه مجتهد اجتهاد حميه الإمام حمادة السبكي، لكان حقاً أن يتساءل المرء باستغراب: فما الذي أثار تعجبه إذاً من إسلام الحيرة المؤسّس على مبدأ الاجتهاد ؟ ما الذي أملى عليه أن يصدر عليه حكماً بأن ظاهره ينقض باطنه:
„ لعلَّ أعجب ما صادفته في رحلتي هو إسلام الحلبة الذي يستعر التناقض بين ظاهره وباطنه. قالت لي (سامية زوجته) : الفرق بين إسلامنا وإسلامكم أنَّ إسلامنا لم يقفل باب الاجتهاد، وإسلام بلا اجتهاد يعني إسلاماً بلا عقل. ذكرني قولها بدروس أستاذي القديم ".
ومن المصادفات النادرة في هذا الجزء من الحكاية، التقاؤه بامرأته الوثنية السابقة عروسة التي ما انقطع شوقه إليها وإن ادعى قبيل زواجه من سامية عكس ذلك:
„ وكنت أسجل بعض الأرقام في دفتر الحسابات بمحل التحف عندما وجدت أمامي عروسة. ليس حلماً ما أرى ولا وهماً. هي عروسة ترفل في وزرة قصيرة، ومطرَف مطرّز باللآلئ مما ترتديه نساء الطبقة المحترمة في فصل الصيف. لم تعد شابة ولا منطلقة عارية، ولكنها ما زالت متوجة بجمال وقور محتشم. كأنها معجزة انبثقت من المستحيل. كانت تقلّب بين يديها عقداً من المرجان، وأنا أتطلع إليها في ذهول. وحانت منها التفاتة إلي فالتصقت عيناها بوجهي وهما يتسعان، ونسيت نفسها كما نسيت نفسي . ناديت مبتهلاً: عروسة! فرددت بذهول: قنديل! وترامقنا حتى قررنا في وقت واحد أن نفيق من ذهولنا، وأن نرجع إلى الواقع. قمت إليها فتصافحنا… وسألتها: كيف حالك؟
- لا بأس، كل شيء طيب.
- مقيمة هنا في الحلبة؟
- منذ تركت الحيرة.
وبعد تردد سألت: وحدك؟
- متزوجة من رجل بوذي. وأنت؟
- متزوج وأب.
- لم أنجب أطفالاً.
- أرجو أن تكوني سعيدة.
- زوجي رجل فاضل وتقي، وقد اعتنقت دينه.
- يئست من العثور عليك.
- - إنها مدينة كبيرة.
- وكيف كانت حياتك قبل الزواج؟
فلوحت بيدها بامتعاض، وقالت: كان عام معاناة وعذاب.
فتمتمت: يا لسوء الحظ.
فقالت باسمة: الختام حسن.. سنقوم برحلة إلى دار الأمان ، ومنها إلى دار الجبل، ثم نسافر إلى الهند.
فقلت بحرارة: لتحلّ بك بركة الله في كل مكان!
ومدت لي يدها فتصافحنا، وتناولت مشتراها، ثم ذهبت بسلام… واعترفتُ لسامية بما كان ، ببساطة ولا مبالاة، ولم أخلُ من شعور بالإثم إزاء ما اضطرم به صدري من اهتمام زائد اهتزّ اهتزازة عنيفة. وتفجرت من جدرانه ينابيع أسى وحنين غمرته دفقات حارة من الماضي حتى أغرقته، ولا أستبعد أن الحب القديم رفع رأسه ليبعث من جديد، ولكن الواقع الجديد كان أثقل وأقوى من أن تعبث به الرياح ".
كان قنديل الرحالة قبل أن يصادف (عروسة) تلك المصادفة الغريبة المفاجئة أعلن أمام حميه الإمام حمادة السبكي الذي كان سأله : „ هل عثرت على عروسة ؟" أنَّ " التعلق بعروسة وهم لا معنى له".
ومما يشدُّ إليه الانتباه هنا أن الرحالة في هذه المرة لم يسأل عروسة عن مصير أبنائه منها، فلعلها كانت لقفت شيئاً من الأنباء عن الأبناء في فترة غيابها عنه! أتراه كان أيقن بهلاكهم؟ أم تراهم خرجوا من قلبه فنسيهم؟
فأما اعتناقها البوذية دين زوجها الجديد في دار الحلبة التي تحمي حقَّ المواطن في أن يخلع عن عنقه طوق دين متوارث، ويعتنق ما شاء من دين، فليس مما يشد إليه الانتباه؛ لأنه حدث في هذه الدار دار الحرية، ولم يحدث في دار المشرق الدار التي لا تبيح لأبنائها اعتناق دين يخالف دين آبائهم.
وعلى الجملة: فقد قرر الرحالة المسلم قنديل العنابي المكوث في الحلبة إلى نهاية العمر. ولن يذهب بقراره إصرارُه – هو إصرار فتر أواره زمناً إذ هو في الحلبة كما فتر أواره إذ هو في دار المشرق، ولكنه لم يخمد - على أن ينجز مهمته؛ أي أن يواصل رحلته التي بدأها حتى يبلغ دار الجبل التي ما انفك الحلم بها متصلاً يملأ خياله:
"قالت لي (سامية) : يجب أن تجعل من الحلبة مقامك الدائم، أتمم رحلتك إذا شئت ولكن لتكن العودة إلى هنا.
فقلت بصراحة أيضاً: قد أرى أن أرجع إلى وطني كما رسمتُ لأنسخ كتابي، ولا بأس من الإقامة هنا.
فقالت بسرور: في هذه الحال سأصحبك إلى وطنك في الذهاب والإياب ".
إن الرحلة قدره، كما نوّه بذلك، فأنى له أن يستسلم للدعة، ويخونَ العهد الذي قطعه على نفسه؟ أنى له أن يتمادى في خذلان هدفه الذي هو – في ظنه وتقديره - جلبُ الدواء الشافي لوطنه المريض؟ القدر كما في عقيدة أمه فطومة يهيمن عليه يسيّر مشيئته فلا مهرب منه:
" على أنني رفضت الاعتراف بالهزيمة، وكنت أقول لنفسي في حياء: آه يا وطني.. آه يا دار الجبل ! „ .
ولأن قنديلاً يخال نفسه مناضلاً حقيقياً يرنو بتوق إلى العدالة والخير، يتطلع بشوق إلى المثال الأعلى (دار الجبل) حالماً بمدينة فاضلة سعيدة بنحو ما حلم بها افلاطون في جمهوريته، والفارابي في مدينته الفاضلة، فليس مما يليق به أن تبرد عزيمته، وتنكسر شوكة إرادته الصلبة، ولو تألّبت عليه كل مغريات الدنيا وتحدياتها:
„ غير أن الرغبة الكامنة في الرحلة استيقظت في روعة ووثبت إلى المقدمة متطلعة إلى الغد بإرادة صلبة لا تلين، وخشيت أن أندفع إلى تنفيذها فأجلب على نفسي الظنون؛ فاتخذت قراراً بتأجيلها عاماً، على أن أمهد لها في أثناء العام بما يهيّئ الأنفس لتقبلها.
وقد كان.
وأذنت لي زوجتي المحبوبة بلا حماس وبلا فتور، ووكلت عني الشيخ الإمام ليحل محلي في التجارة لحين عودتي، وخصّصتُ للرحلة من الدنانير ما يوفر لي حياة كريمة، ووعدت بالعودة إلى دار الحلبة عقب الرحلة، على أن أصطحب زوجتي وأبنائي إلى دار الإسلام، فأنسخ كتاب الرحلة، وألقى الباقين على قيد الحياة من أهلي، ثم نرجع إلى الحلبة. وأشبعت أشواقي من سامية ومصطفى وحامد وهشام، وتركت زوجتي وهي تستقبل في جوفها حياة جديدة ".
وما إن يحط الرحالة رحله في دار الأمان (دار العدالة) بعد مسيرة قد تكون أجهدته قليلاً؛ لأنه كان فارق عهد الشباب " وكالعادة ذكرتني القافلة بالأيام الماضية، ولكني أمسيت كهلاً يتأثر بقدر " حتى يستيقظ السؤال القديم الهاجع زمناً: ترى هل سيجد الرحالة في هذه الدار الدواء الشافي لوطنه المريض؟
ولأن شيخه مغاغة الجبيلي لم يكن دخلها بسبب الحرب الأهلية فيها، فمن المفروغ منه أنه لم يحدثه عنها. ولأنه لم يحدثه عنها، فلا غرو في أن يكون كل ما سيصادفه فيها جديداً مكتشفاً يبهره ويروعه ويثير إعجابه ويبعث فيه بنفس الوقت القلقَ والحيرة وربما الاستنكار أيضاً؛ بل الاشمئزاز.
سيستكشف الرحالة، وهو فيها يجول في ربوعها ويطوف جنباتها ويتفحص معالمها مع مرشده السياحي ( ليس في دار الأمان حكيم واحد للرحالة أن يذهب إليه للاستعلام كما هو الحال في دار المشرق والحيرة ) أنها هي الدار التي لم يزرها أستاذه الشيخ مغاغة الجبيلي – وكان ينوي زيارتها - بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت فيها بين الفقراء (العمال) والأغنياء (ملّاك الأرض، وأصحاب المصانع، والحكام المستبدين، ورجال الدين ):
„ وتذكرت ما أخبرني به أستاذي الشيخ مغاغة الجبيلي من أنه لم يستطع أن يواصل رحلته بسبب نشوب حرب أهلية في دار الأمان… ".
وستروعه هذه الدار بتحضرها وعمرانها، وبنظامها السياسي المشيد على العدل والمساواة وستروعه أيضاً بانتشار الأمان فيها من الفاقة والجريمة المنظمة والبطالة، وبازدهار اقتصادها، وبمتانة شبكة خدماتها الاجتماعية وحسن تنسيقها. فإن مصانعها ومتاجرها ومراكز التعليم والطب فيها:
" لا تقلّ عن أمثالها في الحلبة عظمة ونظاماً وانضباطاً، واستحقت دائماً إعجابي وتقديري، وهزت عقيدتي الراسخة في تفوّق دار الإسلام في الحضارة والإنتاج..“ .
ولسوف يستوثق في هذه الزيارة من أهمية الكفاح والتضحية والثورات الدامية في نهضة الأمم وارتقائها.
ها هو المشرف السياحي يسرد على مسامعه صفحات مجيدة من تاريخ بلاده دوّنها الشعب بدمائه:
"وزرنا قلعة تاريخية جليلة الشأن، حلّيت جدرانها بالنقوش والصور، قال فلوكة (المرشد السياحي): في هذه القلعة دارت آخر معركة انتهت بهزيمة الملك المستبد. ومضى بي إلى بناء ضخم كالمعبد وهو يقول: إليك محكمة التاريخ، هنا حوكم أعداء الشعب، وقضي عليهم بالموت. فسألته عمن يعني بأعداء الشعب، فقال: ملاك الأرض، وأصحاب المصانع، والحكام المستبدون. لقد انتصرت الدولة بعد حرب أهلية طويلة ومريرة ".
فيتذكر الرحالة، وهو يصغي إلى المرشد يسرد تاريخ وطنه الدامي، تاريخَ الحلبة الدامي وطنه الثاني أيضاً كما سرده له الفيلسوف مرهم، وكان ذهب إليه مستعلماً:
„ لم يكن طريق الحرية سهلاً، ودفعنا ثمنه عرقاً ودماً، كنا أسرى الخرافة والاستبداد، وتقدّم الروّاد، وضُربت الأعناق، واشتعلت الثورات، ونشبت حروب أهلية، حتى انتصرت الحرية وانتصر العلم „.
وهو إذ يقف على هذا التشابه بين تاريخي الأمان والحلبة الداميين، سيتذكر كدأبه تاريخ بلاده فيتساءل تساؤل المعترف المقرّ:
„ وهل كان تاريخ الإسلام في دارنا دون ذلك دمويّة وآلاماً ؟".
غير أنه لن يسأل نفسه: لماذا تحقق (بالدموية) لدار الأمان وكذلك لدار الحلبة نصرُهما الحضاري، ولم يتحقق لدار الإسلام مثل نصرهما؟
ومع أن دار الأمان – كما رآها – دارُ حضارة، ولكنّ حضارتها لا ترقى إلى المستوى الذي بلغته حضارة دار الحلبة. دار الحلبة متفوقة تبزُّ دار الأمان بواحدة من أروع قيم الحضارة الحديثة. إنها الحرية: حرية الأفراد، حرية الاقتصاد، حرية السياسة، حرية الفنون والآداب. فلا غرو أن تغريه زوجته سامية بالإقامة الدائمة معها في دار الحلبة، بل إنها لتهيب به بصيغة لا تخلو من الحض الآمر أن يقيم فيها، معتبرة إقامته فيها واجباً عليه أن يؤديه:
" وقد قالت لي: يجب أن تجعل من الحلبة مقامك الدائم، أتمم رحلتك إذا شئت ولكن لتكن العودة إلى هنا… فلن نجد مثل الحلبة في حضارتها ".
ولأن النظام السياسي في دار الأمان قائم على الاستبداد، فسيذكره بنظام الخلافة : " ذكرني بنظام الخلافة في دار الإسلام " والاستبداد مقيت جوهره الظلم وهو يولّد المآسي المروعة.
في دولة الاستبداد تُفرّغ الحرية من معناها الحقيقي، كي تتلاءم مع طبيعة الاستبداد، وتمسي حقاً للمستبد فقط. ولما كانت دار الأمان دولة استبداد، فستوضع الحرية فيها " تحت المراقبة " كل الحرية حتى الحرية الفردية فيها لن يكون لها موطن في حياة المستبَدّ بهم من أبنائها. وما مُلازمة المرشد السياحي له (17) ومشاركته إياه في مسكنه إلا تعبيراً صريحاً ينطق بانعدام الحرية الفردية في دار الأمان، قبل أن يكون تعبيراً عن وجوب اجتناب الإسراف في المال والممتلكات:
" ولاحظت وجود سريرين بها ( في غرفته بالفندق) جنباً إلى جنب فتساءلت بقلق: ما معنى وجود السرير الآخر؟
فأجاب فلوكة (هو اسم المرشد المكلف من دائرة السياحة بمرافقة الرحالة قنديل) بهدوء: إنه لي.
فسألتُه باحتجاج لم أُعنَ بإخفائه: أتنام معي بحجرة واحدة؟
- طبعاً، ما معنى أن نشغل حجرتين إذا كان يكفي أن نشغل حجرة واحدة؟
فقلت باستياء: قد يطيب لي أن أنفرد بحجرة. فقال دون أن يخرج عن هدوئه: ولكن هذا هو النظام المتَّبع في دارنا. فتساءلت متذمّراً: إذن لن أحظى بالحرية هنا إلا في دورة المياه. فقال ببرود: ولا هذه أيضاً.
- أتعني ما تقول حقاً؟
- لا وقت لدينا للهذر.
فقطبت هاتفاً: الأفضل أن ألغي الرحلة.
- لن تجد قافلة قبل مرور عشرة أيام " .
ويلقى الرحالة الكثير من الحرج، وهو بصحبة هذا المرشد. من ذلك تقديم الخمر مع كل وجبة طعام تُتناول في المطاعم. وإذ يراه المرشد كارهاً لها، عازفاً عن شربها، يتساءل بشيء من الإنكار، وبشيء آخر من الاستهانة والسخرية المكتومة:
„ أتصدّق أن إلهك يهمّه أن تشرب خمراً أو لا تشربها؟ ".
وقد أغاظه قول المرشد حتى تغير وجهه.
ولكنَّ " وضعَ الحرية تحت المراقبة " والإحراجَ الذي لقيه في دار الأمان التي تحلّل كلّ ما هو محرم في دار الإسلام، لن يقتلع من نفس الرحالة إعجابه بحضارة دار الأمان، وقد تلمّسها بحواسه.
ويعزو المرشد السياحي نهضة دار الأمان إلى العدل الذي جعلته دار الأمان أسّاً لنظامها دون الحرية، ويأخذ يعلل له تفضيل العدل على الحرية بقوله:
" وجدنا الإنسان لا يطمئن قلبه إلا بالعدل؛ فجعلنا من العدل أساس النظام، ووضعنا الحرية تحت المراقبة".
ولكن الرحالة لن يصدق بقول المرشد السياحي على الفور ( إن العدل أساس نظام داره ) سيشق عليه التصديق، سيظنّه مجرد دعاوة لنظام بلده، غير أن مظاهر الحضارة المادية في دار الأمان التي سيطرت على حواسه بروعتها، سترغمه على أن يقتنع بصدق قول المرشد في عدل داره، ولو على كره:
„ عزّ عليّ التصديق، وقلت ما هو إلا كلام يحفظه عن ظهر قلب، غير أن منظر الشوارع والعمائر راعني، إنها لا تقل في هندستها عن الحلبة نفسها ".
ولم يكن حدس الرحالة في غير محله إذ عزّ عليه التصديق. هل يخطئ من ينتابه الشك في صحة الجمع بين الاستبداد والعدل؟ هل يخطئ من لا يرى الاستبداد عدلاً، وهو يقهر حرية المواطنين، ويسلبهم حقهم في التعبير عن آرائهم؟!
إن دولة الاستبداد، حتى لو عدلت في توزيع الثروة الوطنية على المواطنين وأمنت حياتهم من فاقة، لن تكون عادلة. مساوئ دولة الاستبداد تذهب العدالة. مساوئها تعدل، في نظر الرحالة، مساوئ نظام حكم الخلافة في دار الإسلام. ها هو رئيس الدولة في دار الأمان، إنه شبيه بالخليفة في دار الإسلام يماثله في الظلم والعتو والاستئثار بالسلطة:
" مهيمن على الجيش والأمن والزراعة والصناعة والعلم والفن إذ إن الدولة هي صاحبة كل شيء".
إنه حاكم تصعب إقالته من منصبه إلا في حالات استثنائية نادرة جداً. والمعنى غياب الديمقراطية، وهل عدلٌ بغياب الديمقراطية؟
ويسأل الرحالة المسلم المسكون عقلُه ووجدانه بالدين مرشدَه السياحي :
„- أهذا ما يأمر به دينكم ؟"
فيجيبه المرشد بأن نظامهم لم يأمرهم به دين؛ لأنهم لا يدينون بإله يعتلي سحابة في السماء، أو يجلس على عرش خارج الأكوان بل يدينون بالأرض:
„- نحن نعبد الأرض باعتبارها خالق الإنسان، ومدخر احتياجاته.
- الأرض ؟!
- وهي لم تفعل لنا شيئاً، ولكنها خلقت لنا العقل، وفيه الغنى عن أي شيء آخر… دارنا هي الدار الوحيدة التي لن تصادفك فيها أوهام وخرافات! „.
وإنه ليسوءه – وهو المسلم - أن تعبد دارُ الأمان الأرضَ، كما ساءه من قبل أن تعبد دار المشرق القمر، وتعبدَ دار الحيرة ملوكَها، لكن استياءه من دار الأمان أعظم من استيائه من دار المشرق والحيرة. استياؤه من عبادة دار الأمان الأرضَ وصل به حد التقزز. للمرء أن يلتمس من الوثنية عذراً لهما، ولكن كيف له أن يجد عذراً لدار الأمان وهي على ما هي عليه من بناء حضاري شاهق؟! كلا، لا عذر لدار تعبد الأرض، ملحدة تستهدي بأنوار العقل لا بشرع الله. عبادة الأرض كفر وإثم عظيم لا يغتفر في نظر المسلم، ومدعاة إلى التقزز والنفور:
"استغفرت الله في سري طويلاً. قد يجد الإنسان لوثنية دار المشرق عذراً، ومثلها دار الحيرة، ولكن دار الأمان بحضارتها الباهرة كيف تعبد الأرض؟.. وكيف تبوّئ عرشها رجلاً منها فتنزله منزلة الملك الإله؟ إنها دار عجيبة، أثارت إعجابي لأقصى حد، كما أثارت اشمئزازي لأقصى حد".
وإذا كان استياؤه من عبادة دار الأمان الأرضَ بلغ حد الاشمئزاز، وعلَت درجتُه درجة استيائه من عبادة دار المشرق والحيرة؛ فإن استياءه من حال دار الإسلام، سيسوءه أكثر من ذلك:
"ولكن ساءني أكثر ما آل إليه حال الإسلام في بلادي، فالخليفة لا يقلُّ استبداداً عن حاكم الأمان، وهو يمارس انحرافاته علانية، والدين تهرّأ بالخرافات والأباطيل، أما الأمة فقد افترسها الجهل والفقر والمرض ".
هكذا، فكلما أبصر الرحالة المسلم سيئةً – بنظره – في دارٍ من الديار، راح يقارن فيها بين تلك الدار ودار الإسلام. وهي مقارنة لا مفرّ له منها. لا لأن الرحلة بما هي انتقال من مكان إلى مكان تستدعي بطبيعتها المقارنة بين المكانين؛ بل لأن المقارنة هدف من أهداف رحلته، سبق أن أبانه بلفظ من البلاغة في قوله:
" لأرى وطني على ضوء البلاد الأخرى".
فإن رؤية وطنه على ضوء البلاد الأخرى كناية صريحة عن المقارنة. لكن المؤسف في كل مرة أن النتيجة المستخلصة من المقارنة بين دار الإسلام، وداري الأمان والحلبة، تأبى إلا أن تكون لصالح الدارين لا لصالح دار الإسلام:
" وخطر لي أني أرى الأمور بوضوح أكثر من ذي قبل. أجل إن لدار الحلبة هدفاً، وقد حققته بدقة (هو الحرية أضف إليها الإنجازات الحضارية المادية) وإنّ لدار الأمان كذلك هدفاً وقد حققته بدقة (هو العدالة الاجتماعية أضف إليها الإنجازات الحضارية المادية) أما دار الإسلام فهي تعلن هدفاً، وتحقق آخر باستهتار وبلا حياء وبلا محاسب ".
ويفسر الرحالة المسلم للمرشد تخلف دار الإسلام عن دار الأمان والحيرة بخيانة المسلمين لدينهم، لكن هذا التفسير لن يقنع المرشد. ولسوف يترتب عن عدم اقتناعه بتفسيره، عدمُ اقتناعه بجدوى رحلة الرحالة قنديل جملةً. وحجة المرشد على عدم اقتناعه بالتفسير الذي ساقه الرحالة لتخلف دار الإسلام، أنّ كلّ نظام – والإسلام نظام في اعتقاد قنديل وغالبية المسلمين - إن لم يتضمن في داخله شروط تطبيقه؛ أي إن لم يكن صالحاً للتطبيق، فلن يكون له بقاء. إذن فمن العبث تكلف مشاق رحلة باهظة التكاليف كثيرة الأخطار بحثاً عن دواء. إن النظام الذي لا يتضمن في أصله شروط بقائه حياً، لن يعثر له أحد على دواء في مكان أيّ مكان:
„ ورآني أبتسم فلم يرتح لابتسامتي وقال: أترى الحياة في وطنك أو وطنك الثاني (يريد دار الحلبة التي كان وافق زوجته على الإقامة الدائمة فيها ) خيراً من حياة الأمان؟
فقلت بمرارة: دع وطني الأول فأهله خانوا دينهم.
فقال بخشونة: إذا لم يتضمن النظام الوسيلة لضمان تطبيقه فلا بقاء له.
- إننا لم نفقد الأمل
- إذن لم كانت الرحلة إلى دار الجبل؟
فقلت بفتور: العلم نور.
فقال ساخراً: ما هي إلا رحلة إلى لا شيء ".
ولكن دار الأمان التي يراها المرشد خير دار، ليست آمنة من الحرب. فبعد انتصار الحلبة على الحيرة، سحبت الحلبة اعترافها بحق دار الأمان في عيون المياه، وعيون المياه هذه من قضايا النزاع بين الحلبة والأمان:
„ ولما انتصروا (أهل الحلبة على أهل الحيرة والمشرق) سحبوا اعترافهم بكل خسة ودناءة، واليوم يقال إنهم يجندون جيشاً من البلدين اللتين استولوا عليهما، المشرق والحيرة، وهذا يعني الحرب. واستحوذ عليّ القلق فسألته: وهل تقوم الحرب حقاً؟ فأجاب ببرود: نحن على أتمّ استعداد… ".
وشبت نار الحرب بالفعل بين الحلبة والأمان:
" فشدّ (المرشد) على يدي صامتاً ثم همس في أذني: قامت الحرب بين الحلبة والأمان. اضطربت لدرجة منعتني من الاستمرار في الكلام، حتى البادئ بالحرب لم أسأل عنه، وهيمنت عليّ ذكريات سامية والأبناء، وحتى الوليد المنتظر ".
ومن طريف ما وقع له في دار الأمان، علمُه بما آل إليه مصير عروسة امرأته السابقة:
„ وفي تلك الآونة خطر لي أن أسأل (فلوكة) عن الرحالة البوذي وزوجته عروسة، اللذين زارا الأمان منذ عام فأكد لي أنه يمكن أن يمدني بمعلومات عنهما عندما نذهب إلى المركز السياحي في آخر أيام الإقامة. وأنجز الرجل وعده، وراجع الدفاتر بنفسه، وقال لي: مكث الزوجان في دار الأمان عشرة أيام ثم سافرا في القافلة إلى دار الغروب، غير أن الزوج مات في الطريق ودفن بالصحراء، أما الزوجة فواصلت رحلتها إلى دار الغروب. وهزني الخبر، وتساءلت عن مكان عروسة وحالها، وهل أجدها في دار الغروب، أو تكون رحلت إلى دار الجبل، أو رجعت إلى المشرق؟! „.
وليس هذا كل شيء عن عروسة، فإنه وهو في دار الغروب سيخبره حكيمها بما صار إليه أمرها:
„ وقمت حانياً رأسي في خشوع، وخطر لي خاطر فترددت جافلاً من إعلانه، وإذا به يقول: تريد أن تعرف ماذا فعل الدهر بعروسة! فسألته بدهشة: وُفّقتْ في خوض التجربة؟ فقال باسماً: بفضل ما عانت في حياتها من آلام ".
وبانقضاء مدة الإقامة المسموح بها في دار الأمان، يغادر قنديل الرحالة دار الأمان مع قافلة كانت في طريقها إلى دار الغروب المحطةِ الأخيرة إلى دار الجبل. وقطعت القافلة الطريق إلى دار الغروب في شهر ، ولكن الرحالة في هذه المرة لن يعاني وصحبه من وعثاء السفر ومئونته إلا " عناءً غير ذي عنف ".
فأما دار الغروب، فنسيج وحدها بين الديار. هي دار لا تحدها أسوار، ولا يقوم على حراستها حراس، ولا يُرى في أرجائها كوخ أو بيت أو قصر. إنها جنة من جنان الأرض: شمسها " أجمل شمس عرفتها في حياتي ". نسيمها عليل ورائحته طيبة كشذا العطر. " وأرضها " معشوشبة ، نثرت على أديمها أشجار النخيل والفاكهة، تتخللها عيون مياه وبحيرات". كل فصولها جميلة، وخيراتها مبذولة للجميع بلا جهد بلا اعتراض من أحد، أرض مشاعة لا أحد يملك منها شيئاً. والبشر فيها ليسوا كالبشر فهم لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يرون مع أنهم لم يفتقدوا حواسهم. إنهم كالأرواح. لا شغل لهم إلا " الجلوس فوق الأرض على هيئة هلال، بين يدي شيخ هرم، يتخذ مجلسه تحت شجرة وارفة، وكأنه يعلمهم الغناء وهم يرددون الصوت في حنان بالغ ".
وما غناؤهم بين يديه في حقيقته إلا من قبيل الرياضة الروحية يمارسونها كي تتقوّى بها نفوسهم وتغدو مؤهلة لعبور الطريق الكأداء إلى دار الجبل.. إلى الفردوس، إلى عالم الكمال المطلق.
قوم راتعون في " جنة الغائبين" لا يكترثون بشيء من أشياء الدنيا المادية. بذا يصفهم الرحالة، وهو وصف قد يصدر عنه استفسار حائر: فما دام هؤلاء القوم غائبين لا يكترثون، فما عسى أن تكون حاجة قافلة تجارية من الذهاب إليهم؟ لماذا ذهبت إليهم القافلة التجارية وهم لا يتجرون ؟
ولأن دار الغروب مفارقة لكل الديار في شكلها ومضمونها، فلن يكون للسؤال العتيد: ( ترى هل عثر الرحالة أو هل سيعثر في هذه الدار على الدواء الشافي لوطنه؟ ) مبررٌ لأن يستيقظ من غفوته كما كان يستيقظ من تلقاء ذاته في كل مرة يهدف فيها الرحالة إلى دار من الديار التي كان أزمع على زيارتها.. هذا السؤال بات لا خير في طرحه الآن، وإن ظنّ الرحالة أن في دار الغروب ما قد يكون مفيداً لوطنه؛ لأن دار الغروب ليست حضارة مادية كالحلبة أو الأمان يمكن للرحالة أن يجد فيها الدواء الشافي لوطنه المريض. إنها دار تجربة واختبار لأفراد لا لأمة أو شعب.. لأفرادٍ:
" جميعهم مهاجرون، ومن شتى الأنحاء يجيئون إعراضاً عن الهواء الفاسد، ليُعدّوا أنفسهم للرحلة إلى دار الجبل".
ولمّا كان قنديل العنابي يحلم منذ بدء رحلته، بل قبل أن يبدأ رحلته بالوصول إلى دار الجبل؛ فإنه سيبتهج أيما ابتهاج بتباشير تحقق حلمه.. ستعروه فرحة رداح وقد عثر على ضالته في شخص حكيم الغروب الشيخ الهرم الذي يتبوأ مرتبة نبي عارف يقرأ الغيب، ويكشف بحدسه عما هو محتجب خفي مستور خلف مظاهر الأشياء، ويسبر ببصيرته ما هو كامن في أعماق النفس البشرية " إنك ضالتي يا مولاي" وسينضم إلى حلقة الشيخ مريداً مواظباً يُعدُّ نفسه بالمجاهدة الروحية " بالتركيز الكامل.. بحب العمل وإهمال الثمرة والجزاء" حتى يتأتى له أن " يستخرج من ذاته القوى الكامنة فيها … ويطير بلا أجنحة " ولا بد له من ذلك؛ لأنه إن لم يتأتَّ له أن يستخرج من ذاته الكنوز الكامنة فيها، فيمسي وقد أمكنه أن يطير بلا أجنحة؛ فلن يكون طريقه إلى دار الجبل ممهَّداً، بل إنه إن نقص استعداده وأتيح له أن يدخل دار الجبل، وهو على هذا النقص من الاستعداد، فحينئذ قد يمسخ فيها حيواناً، أو يعامل فيها معاملة الحيوان الأعجم:
„ فطربت للاسم وقلت بحبور: إذن سأجد رفاقاً في رحلتي الأخيرة. فلاحت ابتسامة في عينيه وقال: عليك أن تُعدَّ نفسك مثلهم.
- كم يتطلب ذلك من وقت؟
- كلّ بحسب قدرته، وقد تخور الهمة فينصح بالبقاء في الغروب.
فانقبض صدري وسألته: وإذا أصرَّ على الذهاب؟
- يخشى أن يعامل هناك كالحيوان الأعجم ".
إن دار الجبل حلم وارف وهدف منشود ولكن دونها، دونهما، جهادٌ لا يطيقه إلا الأشداء بالروح. وكيف لا، ودار الجبل هي الكمال، هي: " العدل والحرية والنقاء الشامل" هي الحقيقة الصادقة المبتغاة لحياة سعيدة. وإنما باستخدام العقل، باستخراج القوى الخفية من باطن النفس، يُتوصل إلى الكمال، وتُنال السعادة:
„ هناك في دار الجبل بالعقل والقوى الخفية، يكشفون الحقائق، ويزرعون الأرض، وينشئون المصانع، ويحققون العدل والحرية والنقاء الشامل ".
وأمل المريد أن ينجح في هذا الاختبار العسير، فإن ينجح، يكن " جزاؤه المكوث في دار الجبل". لا مطمح للمريد أبعد من المكوث في دار الجبل. المكوث فيها هو البغية والمنية والهدف الأخير من التدريب والاستعداد. وشأن المريد في هذا كشأن الديّن الذي يتهجد ويتورع ويؤدي الفروض ورناهُ جنةُ الخلد. بيد أن المكوث في دار الجبل، لم يكن هدف الرحالة قنديل. كان هدف قنديل أن يزور دار الجبل ويعود منها إلى وطنه بما ينفعه. وقد أفصح عن هدفه هذا بلفظ صريح واضح أمام فيلسوف الحلبة مرهم:
„ فقلت مستدركاً: دار الجبل ليست بغايتي الأخيرة، ولكني أرجو أن أرجع منها إلى وطني بشيء يفيده ".
وسيفصح عنه فيما بعد أيضاً أمام شيخه العارف، وهو في دار الغروب:
„ فقلت بعجلة: ما هي إلا زيارة أرجع بعدها إلى داري. فقال بيقين: سوف تنسى بها الدنيا وما فيها.
- لكنّ وطني في حاجة إلي.
فسألني متعجباً: وكيف تركته؟ (هو سؤال سأله إياه المرشد السياحي أيضاً، قال له: إذن لم كانت الرحلة إلى دار الجبل؟)
- قمت بالرحلة بأمل أن أرجع إليه بخبرة يكون فيها خلاصه.
فقال الشيخ بامتعاض: إنك من الهاربين، تعللت بالرحلة فراراً من الواجب، لم يهاجر أحد إلى هنا إلا بعد أن أدّى واجبه، ومنهم من خسر زهرة عمره في السجن في سبيل الجهاد لا بسبب امرأة.
فهتفت جزعاً: كنت فرداً حيال طغيان شامل.
- هذا عذر الخائر.
فتوسلت إليه قائلاً: ليكن من أمر الماضي ما يكون، فلا تثبّط همتي ولا تبدد حياتي هباء.
فلاذ بالصمت حتى اعتبرت الصمت رضاً، وتشجعت قائلاً: ستجدني من أهل العزم والإخلاص.
ولما هممت بالذهاب تساءل: ما فائدة الدنانير التي تكتنزها حول وسطك؟
رجعتُ إلى محط القافلة فأودعت الدنانير إحدى الحقائب. وقال لي صاحب القافلة: نحن ذاهبون فجر الغد.
فقلت دون مبالاة: إني باقٍ ".
ويكون في هذه الأثناء من تداعيات حرب دار الأمان والحلبة، أن يجتاح جيش دار الأمان دار الغروب:
„ واستيقظنا غداة اليوم التالي على جلبة وصهيل خيل، ونظرنا فرأينا المشاعل منتشرة فوق الأرض كالنجوم، رأينا جيشاً من فرسان ورجّالة يطوّق دار الغروب دون سابق إنذار. وهرع الجميع إلى موقع الشيخ وجلسوا حوله صامتين. وراحوا يغنون حتى أشرقت الشمس، وعند ذاك قدم قائد يتبعه حراس حتى وقف أمامنا. من النظرة الأولى اكتشفت أنهم جيش دار الأمان، وتساءلت في قلق، ترى هل انتصروا على الحلبة؟ وقال القائد: بالنظر إلى الحرب الدائرة بيننا وبين الحلبة ، وبناء على ما بلغنا من أنّ الحلبة تفكر في احتلال دار الغروب لتطوّق دار الأمان، فقد اقتضت دواعي الأمن أن نحتلَّ أرضكم. ساد الصمت، ولم يعلق أحد من جانبنا بكلمة، فقال القائد: إذا أردتم البقاء فعليكم أن تزرعوا الأرض، وأن تنضموا إلى البشر العاملين، وإلا فسوف نُعِدُّ لكم قافلة تحملكم إلى دار الجبل. ساد الصمت مرة أخرى حتى خرقه الشيخ موجهاً خطابه لنا: اختاروا لأنفسكم ما تحبون. فاستبقت الأصوات هاتفة: دار الجبل.. دار الجبل. فقال الشيخ محذراً: ستلقون عناءً لنقص تدريبكم. فأصروا هاتفين: دار الجبل .. دار الجبل. فقال القائد بحزم: من يُعثَر عليه منكم ها هنا بعد قيام القافلة سيُعتبر أسير حرب ! „.
وهكذا تنتهي حكاية الرحالة قنديل العنابي بالرحيل إلى دار الجبل. لكنّ هذه النهاية بالنسبة إلى الرحالة قنديل هي بداية حياة جديدة. كل نهاية بداية وكل بداية نهاية، هكذا كما في منطق هيغل:
„ وفكرت في ذاتي وفيمن خلّفت وفيما قد يصادفني من أسباب تحول دون عودتي، فكرت في ذلك فخطر لي خاطر، وهو أن أعهد بدفتر رحلتي إلى صاحب القافلة ليسلّمه إلى أمي، أو إلى أمين دار الحكمة، ففيه من المشاهد ما يستحق أن يعرف، بل به لمحات عن دار الجبل نفسها تبدد بعض ما يخيم عليها من ظلمات، وتحرّك الخيال لتصوّر ما لم يعرف منها بعد. ولا بأس بعد ذلك أن أفرد دفتراً خاصاً لدار الجبل، إذا قيض لي زيارتها والرجوع منها إلى الوطن. وقبل الرجل القيام بالمهمة، فنفحته بمائة دينار، وقرأنا الفاتحة. تخففت بعد ذلك من وساوسي، وتأهبت للمغامرة الأخيرة بعزيمة لا تقهر ".
ورب سائل يسأل وهو يقف بإزاء قوله: „ ففيه (في دفتر رحلته) من المشاهد ما يستحق أن يعرف…“ أحق هو أنّ في دفتر رحلته من المشاهد ما يستحق أن يعرف؟ فإن كان حقاً، ففي أي المشاهد منها ما يستحق أن يعرف؟ وما يستحق أن يعرف يعني ما سوف يفيد منه وطنه إذا عرفه.
4 – النقد.
* شخصية الرحالة:
شخصية قنديل محمد العنابي الرحالة، قبل أن تكون نموذجاً للمسلم الفار من إسلامه التقليدي إلى التصوف، هي نموذج متخيّل مطابق لشخصية "المسلم الحزين" وشخصية "المسلم الحائر" مجتمعتين معاً في شخص واحد يتنفس أنسام الحياة في دار الإسلام بمشقة. إنها شخصية مستقلة بذاتها بعيدة عن أن تكون نموذجاً مطابقاً لكل المسلمين – عدا المتصوفة - فليست نموذجاً لشخصية المسلم المتمرد (الملحد - العلماني) ولا لشخصية المسلم العادي – إن جاز التعبير – ولا لشخصية المسلم المتطرف الإرهابي.
فأما المسلم الحزين فحزين مما آلت إليه حال دار الإسلام من التقهقر والتصدع الحضاري والانكسار حتى أمست داراً مريضة زائفة تستحق أن تُصبَّ عليها اللعنات:
"خانني الدين، خانتني أمي، خانتني حليمة، ألا لعنة الله على هذه الدار الزائفة".
وأما المسلم الحائر ، فهو المسلم الذي يشهد نكوص أمته الحضاري، فيمعن في التساؤل بتوجع: لماذا ؟ وكيف...؟ لماذا النكوص؟ وكيف السبيل إلى الرجوع، إلى النهوض، إلى الارتقاء، إلى العمران من بعد أن كبا جواد الأمة، وهفا عالِمها، ونبا صارمها ؟
ولشخصية المسلم الحزين – الحائر التي يجسدها قنديل محمد العنابي، وهو يواجه هذا التحدي الحضاري الثقيل، من السمات ما يميزها وما بها تتفرد وتعرف، أوضحها: الاضطرابُ، والتناقض، والضعف، وقصر النظر، والتهور، والعجز، حتى ليصدق الحكم عليها بأنها شخصية ليس يليق بها أن يطلق عليها اسم قنديل. إن اسم قنديل وقد أُطلق على ابن فطومة اسم على غير مسمى.. إن قنديلاً - وإن كان بطل الحكاية - فإن بطولته خاوية مفرّغة من معانيها الأصلية.
فها هو في دار المشرق وإنه لشديد الاضطراب تتنازعه قوتان: حبُّ امرأة، وهدفٌ قد خرج إليه محتملاً مشاقه مضحياً من أجله بما أنعم عليه من حلاوة العيش، هو البحث عن دواء شافٍ لوطنه المريض، وهو أيضاً الحلم يجمح به إلى دار الجبل، إلى دار الكمال والسعادة المصفاة، إلى الدار التي " تفيض أرضها لبناً وعسلاً“.
ولقد كان التنازع بين هاتين القوتين من العتو في أقصى درجاته. كلّ منهما تجدُّ في جذبه إليها. ولولا خطأ جسيم ارتكبه في هذه الدار بسبب تهوره وغفلته، لكانت الغلبة للقوة الأولى ( حبّ المرأة ) فمكث بسلطة منها وأمرٍ في دار المشرق، وأحجم عن مواصلة السعي إلى هدفه.
وكذلك هو في دار الحلبة، حيث تتنازعه هاتان القوتان أيضاً: حب سامية زوجته وحب الولد والتمتع بالعيش الهانئ الرغيد في دار الحلبة من جهة، وهدفه من جهة ثانية، حتى كادت الأولى تنكّصه عن هدفه، لولا بقية من عزم وتصميم، أبت أن تخمد وتمسي رماداً.
فهل كان شيخه الهرم الحكيم في دار الغروب إلا صادق الحدس والرؤيا، نافذ البصيرة، وهو يسبر أغواره فيستنبط لا اضطرابه وحسب بل أيضاً انحرافه عن هدفه جملةً، حال أن أنظره الرحالة قنديل وجهَه في أول لقاء له به مقدماً نفسه إليه رحالةً يمضي من دار إلى دار، وراء المعرفة ؟
„ فأغمض عينيه دقيقة، ثم فتحهما، وقال: غادرت دارك للمعرفة، ولكنك حدت عن الهدف مرّات، وبددت وقتاً ثميناً في الظلام، وقلبك موزّع بين امرأة خلفتها وراءك (هي سامية) وامرأة تجد في البحث عنها (هي عروسة) „ .
وكذلك إذ هو في طريقه إلى دار الجبل، فإنه لن يحزم أمره، سيتردد – والتردد اضطراب - بين المكوث فيها والعودة منها إلى داره مع أنه سمع من شيخه أنّ من يصل إليها " سوف ينسى بها الدنيا وما فيها " أي لن يعود. والمعهود من المريد أن يوقن بما يسمع من شيخه دون لكن، دون أو... ليس للمريد أن يتردد لحظة واحدة في قبول ما يسمع من شيخه. المريدُ من شيخه كالجندي من قائد الجيش.
وإن الرحالة بذاته ليعبر تعبيراً - وإن بجمجمة - عن تردده في نهاية مطافه بقوله:
„ وفكرت في ذاتي وفيمن خلّفت وفيما قد يصادفني من أسباب تحول دون عودتي، فكرت في ذلك فخطر لي خاطر، وهو أن أعهد بدفتر رحلتي إلى صاحب القافلة ليسلمه إلى أمي أو إلى أمين دار الحكمة…“ .
وهو، وإن كان معتقداً منذ البدء اعتقاداً راسخاً لا تشوبه ذرة من شك ( وإلا فما الذي سيبرر تكبد ما تكبده في سبيل الوصول إلى دار الجبل، أيكون تكبَّدَه في سبيل الوصول إلى وهم، إلى لا شيء؟! ) بأن دار الجبل فيها الدواء الشافي، وإنه أيضاً، وإن كان بلغ من التدريب الروحي والاستعداد على يد شيخه أولى المراتب المرموقة فتفتحت أكمام بصيرته حتى بات قادراً على التخاطر مع شيخه عن بعد:
" واستيقظت ذات يوم قبل الفجر مبكراً عن ميعادي المعتاد، وذهبت من فوري إلى الشيخ فوجدته جالساً تحت ضوء النجوم؛ فاتخذت مجلسي وأنا أقول: ها أنا ذا يا مولاي. فسألني: ماذا جاء بك؟ فقلت بثبات: نداءٌ صدر منك إليّ. فقال راضياً: هذه خطوة أولى للنجاح، وأول الغيث قطر ".
فسيخالجه ارتياب كارتياب الأنبياء حيناً بصدق ما توحيه إليهم به الآلهةُ المحتجبة عن أبصارهم:
„ إنه عالم غريب حافل بالجنون، وستكون معجزة حقاً إذا وجدت الدواء الشافي في دار الجبل ".
وفي موضع آخر (18):
„ وقضيت شطراً من الليل وأنا أدوّن في دفتري تاريخ الرحلة ومشاهدها، وقطعت شطراً آخر مسهداً، أفكر فيما صادفني من أحوال وأفكار، وأتأمل عذابات الإنسان في هذه الحياة، وأتساءل هل حقاً يوجد في دار الجبل الدواء الشافي لكل داء ؟! „.
ومن هذا القبيل أيضاً ما دار بينه وبين المرشد السياحي في دار الأمان، وقد سبق الاستشهاد به على غير هذا المعنى:
„ فقال بخشونة: إذا لم يتضمن النظام الوسيلة لضمان تطبيقه فلا بقاء له.
- إننا لم نفقد الأمل بعد.
- إذن لمَ كانت الرحلة إلى دار الجبل؟
فقلت بفتور: العلم نور ".
فالمرشد السياحي يبطل ادعاءه بوجود أمل في شفاء داره من مرضها بالرحلة، وحجته: إن كان ثمة أمل في الشفاء حقاً؛ فما الذي يسوغ للرحالة المسلم مكابدة الرحلة إلى دار الجبل؟ إن رحلته إليها إنْ هي إلا الدليل على أن النظام (الإسلام) لا يؤمَّل منه شفاء؛ لأنه - في رأي المرشد - لا يتضمن الوسيلة لضمان تطبيقه. ولو فرض أنه يتضمنها، فلماذا عليه في هذه الحالة أن يسعى إلى البحث عنها.. عن الوسيلة في دار أخرى كدار الجبل ولا يسعى إلى البحث عنها في الإسلام ذاته؟
فأما منطق الرحالة قنديل في ردّ حجة المرشد، أو تعليقه عليها، بقوله: (العلم نور) فضعيف. وقد يصح أن يوصف بالمراوغة، والتهرب من الإقرار لخصمه. كما يصح عند التحقيق أن يوصف بالتناقض. فإنه إذا كان هدفه من الرحلة أن يعلم؛ لأن العلم نور يُلتمس لذاته، انتقض هدفه من الرحلة.. هدفُه الذي زعم أنه البحث عن دواء شاف لوطنه المريض.
ولن يصح تفسيرُ قوله " العلم نور " على أن المقصود منه: العلم هو الدواء الشافي لوطنه؛ لأنه إذا صحّ ذلك، فلن يكون لسخرية المرشد السياحي برحلة قنديل أي معنى، أو داع، يسوّغ التسجيل في دفتر رحلته:
" فقال ساخراً: ما هي إلا رحلة إلى لا شيء ".
إذ كيف يسخر مرشد يعتز بأن نظام داره أساسه العلم لا الوهم والخرافة، ممن يسعى في طلب العلم دواء شافياً لوطنه ؟!
فإن قيل بعد هذا في تفسير سخرية المرشد: إنما هي سخرية من اعتقاد الرحالة بأن العلم الشافي موجود في دار الجبل – المرشد لا يعتقد بوجود دار الجبل إلا في الوهم والخيال - فلن يكون هذا التفسير حجة على سلامته من التناقض والضعف؛ لأنه لا يجيب إجابة مقنعة عن السؤال الذي يطرح نفسه ههنا بإلحاح: لماذا يطلب الرحالة المسلم العلمَ في غير دار الإسلام، ولا يطلبه في الإسلام؟ أليس يدعي بأن الإسلام عظيم وأنه إذا طبّق في دار الإسلام، ارتقت دار الإسلام؟
ويظهر تناقضه وتآكلُ جوانب من همته فيما عاهد نفسه عليه:
" إنَّ خير ما تفعل يا رحالة أن ترى وتسمع وتسجل، وأن تعاود أحلامك عن دار الجبل، وأن تحمل الدواء الشافي لجراح الوطن ".
وذلك حين لا يفي بهذا الذي عاهد نفسه عليه.
فهو إذ يعاهد نفسه على ألا يزجّ بها في معمعان التجارب حين زيارته لهذه الدار أو تلك؛ خوفاً من عقابيل التجارب، وخوفاً من أن تثنيه التجارب عن هدفه وتطوح به بعيداً عن أرض أحلامه (دار الجبل) وأيضاً حين يعاهد نفسه بألا يتدخل فيما يجري حوله من أحداث ووقائع، وألا ينفعل بما تتلقفه أذنه من أفكار وآراء تعارض أفكاره وآراءه الخاصة؛ خشية أن ينجرف مع انفعاله إلى أحدور لا تحمد عاقبة النزول فيه، فإنه مع ذلك لن يكون حريصاً على القاعدة الني سنها لنفسه وهي ألا يزجّ بنفسه في التجارب...
ومن أفعل هذه التجارب في نفسه، وأبلغها أثراً في مجرى حياته، اقترانُه بعروسة وفق التقليد الشائع في دار المشرق الوثنية (الاستئجار) ثم زواجه من سامية، وتجربة السجن الرهيبة في دار الحيرة التي كادت تودي به إلى الهلاك، وهي تجربة كان في وسعه أن يتفادى منها، لو أنه كان أعمل عقله فنزل (لديزنج) حكيم دار المشرق عن المرأة التي أحبها (عروسة) ومضى آسفاً أو غير آسف إلى هدفه. كان عليه ههنا أن يوازن بين حب المرأة وهدفه فيدرك أن هدفه أكثر نبلاً من حب امرأة، فلا جناح عليه حينئذ إن ضحى بحبه من أجل هدف عظيم. ولكنه لم يقم بذلك ! خذله عقله، خذلته عاطفته، فأمسى وهو عاجز لا يملك القدرة على الموازنة بينهما واختيار الراجح منهما في الموازنة.
ولعل موقفه من عروسة أن يكون محتملاً لشيء من التناقض أكثر من أن يكون محتملاً للفضول، أو للحنين إلى عشرة طيبة لم يستطع الدهر أن يعفّي آثارها في قلبه! لقد ظل متعلقاً بها – وإن كان تعلقه بها، أغلب الظن، من باب تعلق الذاكرة بتجربة من الماضي عميقة الأثر في حياة صاحبها – على الرغم من أنه كان نفى لحميه الإمام حمادة السبكي في دار الحلبة أن يكون متعلقاً بها بعدُ: „ التعلق بعروسة وهم لا معنى له " حتى إنه لا يملك إلا أن يفكر بها: في دار الحلبة، في دار الأمان، في دار الغروب إذ هو بين يدي شيخه الهرم المتصوف الزاهد الحكيم:
„ وخطر لي خاطر فترددت جافلاً من إعلانه، وإذا به (الشيخ) يقول: تريد أن تعرف ماذا فعل الدهر بعروسة ؟ ".
وأوضح من موقفه من عروسة دلالةً على النقض أنه - وقد كان حدد هدفه من الرحلة: وهو طلب المعرفة والعودة إلى وطنه حاملاً معه الدواء الشافي له – لن يلتزم كل الالتزام بتحقيق هذا الهدف: إما لأنه تخاذلَ – والتخاذلُ ضعف – كما تخاذل شخوص ممن التقى بهم في رحلته أمام مغريات العيش وحاجاته مثل (فام) صاحب الفندق الذي نزله في دار المشرق، وإما لغفلته.
قنديل العنابي لن يعود إلى وطنه الأول وبيده الدواء الشافي، ولن يعود إلى وطنه الثاني أيضاً كما وعد سامية.. كلا، سيحيد عن هدفه – وإن خال حيده إلى أجلٍ، وإن خال استنساخه كتاب رحلته وإرساله إلى أهل داره دواءً، وإن خال رحلته لم تضِع سدى - قنديل سيضرب في المجهول متوهماً أنه إذا استنسخ كتاب رحلته وأرسله إلى أهله، سيكون بهذا أدى واجبه تجاه وطنه، فأراح ضميره:
„ وهو أن أعهد بدفتر رحلتي إلى صاحب القافلة ليسلّمه إلى أمي، أو إلى أمين دار الحكمة، ففيه من المشاهد ما يستحق أن يُعرف، بل به لمحات عن دار الجبل نفسها تبدد بعض ما يخيم عليها من ظلمات، وتحرك الخيال لتصور ما لم يعرف منها بعد. ولا بأس بعد ذلك أن أفرد دفتراً خاصاً لدار الجبل، إذا قُيّض لي زيارتها والرجوع منها إلى الوطن…“
ولأنه كان نشأ على الإسلام وثقف أصوله وألم بفروعه " .. تلقى دروساً في القرآن والحديث واللغة والحساب والأدب والفقه والتصوف والرحلات" منذ صغره على يد شيخه مغاغة الجبيلي، لن يفارقه الإسلام.. لن يخرج الإسلام من وعيه ولا من صدره، سيلازمه في رحلته. قنديل سيظل وفياً له مع أن الإسلام على حد قوله قد خانه.
ففي دار المشرق، على سبيل المثال، سينساق إلى تربية ابنه (رام) على مبادئ الإسلام، غافلاً عن عواقب الانسياق الوخيمة. وأيضاً في هذه الدار سيتمنى أن ينقذ بالإسلام روح امرأته عروسة ذات يوم، كما سيتمنى في دار الحلبة لو أنَّ الإسلام بشريعته يسود الدار „ لو أنكم تطبقون الشريعة“.
وإنه ليستمسك بفرائض الإسلام في حله وترحاله ولا سيما حلاله وحرامه كامتناعه عن شرب الخمر كلما قدم له، وأينما قدم له: في الحلبة في ضيافة الإمام حمادة السبكي، أو في دار الأمان في المطاعم، وهو بصحبة المرشد السياحي فلوكة، أو حين يقدمه له (فام) صاحب الفندق في دار المشرق:
„ وسألني: هل آتيك بخمر البلح؟ فقلت وأنا أقبل على الطعام بنهم: أعوذ بالله ".
وإنه ليحبب دينه إلى من لا يعتنقه، وحيناً قد لا يتورع عن تفسير ما أشكل منه بلفظ جميل مداور كتفسيره لمبدأ الجهاد في الإسلام في زيارته لفيلسوفٍ من فلاسفة دار الحلبة، هو مرهم.
وإنه ليخوض في مناقشات حول دينه مع كاهن المشرق، وحكيم دار الحلبة، والمرشد السياحي في دار الأمان فلوكة، وكذلك مع الإمام حمادة السبكي ممثِّل شخصية المسلم المجتهد المندمج في مجتمع العلمانية والحرية، أو الراضي بالخضوع لسلطة العلمانية والحرية بلفظ أدق، وكذلك مع سامية زوجته التي لا تختلف آراؤها عن آراء أبيها الإمام حمادة السبكي. ولسوف يقرأ الفاتحة إحدى صلوات المسلمين، وهو يهمّ مع جماعة (الغائبين) من حلقة حكيم دار الغروب الهلالية بمغادرة دار الغروب إلى دار الجبل في الوقت الذي كان فيه انقاد للشيخ الذي لا يألف الإسلام؛ وتشرّب فلسفته الروحانية ملء عقله وروحه وجوارحه.
لكن الأعجب من كل هذا أن يتأوّه من الإسلام قبيل قيامه بالرحلة:
„ خانني الدين ...„
وأن يهتف فيما بعد، وقد انهمك في حديث مع المرشد السياحي في دار الأمان:
" دع وطني الأول فأهله خانوا دينهم".
وبين الاثنين " خانني الدين " و " أهله خانوا دينهم " تناقض فادح شديد القبح؛ فهو إذ يثبت الخيانة للدين ينفي الخيانة عن الدين ويثبتها لأهل الدين، حتى إذا سأله سائل: من الخائن حقيقةً، أهو الدين أم الدّيّن؟.. أهو الإسلام أم المسلم؟ أبلم.
فبم عساه يجيب؟
ولن يكون موقفه من المرأة بريئاً من التناقض ومن طغيان نزعته الذكورية التي قوّتها نشأته الدينية. إنه يحب المرأة، لكنه لا يحب منها عريها حتى وهي في دارٍ العريُ فيها هو المعتاد المتبع المحبوب، والتستّر فيها بالرداء عيب فاضح مكروه. وهو في هذا المقام، صريح جريء لا يخفي رغبته إلى امرأته عروسة المشرقية العارية بأن تستر عريها الجميل:
„ قلت لها برجاء: دعيني أستر جمال جسدك ".
ولكن عروسة لن تستجيب لرجائه:
" فقالت بانزعاج لا تجعل مني أضحوكة. فتراجعت مسلماً بكل شيء ".
وما كان ليسلمّ بكل شيء - أغلب الظن - لو أنه كان هو الأعلى في هذه الدار، أو كانت هذه الدار دار حرية كدار الحلبة.
ومع أن الرحالة قنديل يحترم المرأة في صورة زوجته سامية، ويقر بتفوقها، يستكره أن تعمل، وهذا ظاهر في مكاشفته لزوجته:
" فترددت قليلاً ثم قلت: يخيل إلي أن عملي الجديد سيدر علينا رزقاً وفيراً، ألا يدعوك ذلك إلى التفكير في الاستقالة من عملك في المستشفى؟ "
كما أنه في طويّته لا يبالي بغير ملاحتها وجسدها المثير المشبع لغريزته، ولولا أن واقع دار الحلبة يطالبه بالتكيف مع قيم الدار، وإلا خسر سعادته، لجهر بذلك :
„ ...كنتُ مغرماً بالأنثى الكائنة فيها، وملاحتها المشبعة لغريزتي المحرومة. طاردت تلك الملاحة بنهم غير مبالٍ بما عداها، غير أن شخصيتها كانت أصدق وأقوى من أن تذوب في ملاحة الأنثى الناضجة، وجدت نفسي وجهاً لوجه مع ذكاء لمّاع، ورأي مستنير، وطبيبة ممتازة، واقتنعت بتفوقها عليَّ في أمور كثيرة؛ فساءني ذلك. أنا الذي لم أرَ في المرأة إلا متعة للرجل، وخالط ولعي بها حذر وخوف، ولكن الواقع طالبني بالتكيف مع الجديد، وملاقاته في منتصف الطريق، حرصاً عليه، وعلى سعادتي المتاحة ...".
ولا يستغرب المرء هذا التناقض يجترحه قنديل وحسب، بل يستبد به الاستغراب حيال أمر آخر من أموره - وصاحب الشأن قنديل نفسه، لن يملك حياله إلا أن يستغرب أيضاً - أنْ رضيت سامية به زوجاً، وهي الشابة الموصوفة بأحسن ما في الأنثى من صفات جسدية وخلال نفسية ومزايا عقلية.
رجل ابتلعه السجن الرهيب في دار الحيرة، دار الطغيان.. رجل أسكنه السجن في جوفه ذي الدموس عشرين عاماً، ثم مجّه على ضفة الحياة كهلاً ذاوياً:
„ وتأثرت أيضاً بجمالها وشبابها، وضاعف من تأثري طول حرماني وتقدمي في السن"
بمَ استطاع هذا الذاوي المتقدم في السن، أن يملك قلب فتاة من أهل الحجا يضج عمرها بالنضارة، ويصرخ عطفها بالحسن والملاحة ؟!
فأما أن يكون سر رضائها به زوجاً، أنها أحبّت فيه الرحالة الذي يضحي بأجمل ما يملك في سبيل الحقيقة والخير، فليس مقنعاً؛ لأنه مخالف لطبيعة الأنثى. ما من أنثى حرة، بديعة الصورة، جميلة الطبع، عزيزة النفس، تحيا في مجتمع حرٍّ مستقلةً بما تتقاضاه من عملها، ترضى الزواج برجل تفصلها عنه مسافة مديدة من سنيّ العمر لشميلة فيه كالتضحية؛ إلا إذا اختلَّ طبعها، أو انحرف ميلها الجنسي، أو أطمعها فيه ثراء فاحش. ليست الأنثى الحرة المثقفة المستقلة السليمة من الأمراض النفسية والجنسية كالأنثى الأمية الجاهلة الضعيفة المعتمدة على عائل والمصفّدة بأعراف وشرائع مجتمع لا يراعي حق المرأة في رفض الزواج قبل سن البلوغ؛ وحقَّها في رفض الزواج بعد سن البلوغ - إلا في حدود شكلية معينة - ممن لا يروق لها من الأزواج. إن سامية مسلمة متفوقة، ليست ضعيفة ضعف أمه فطومة الأزهري التي زوّجت وهي في السابعة عشرة من أبيه التاجر المترع الثراء وهو في الثمانين، وليست ضعيفة أيضاً ضعف خطيبته حليمة الطنطاوي التي زوّجت من الحاجب الثالث لوالي بلده دون مراعاة لحقها في أن تكون لها الخيرة بين رفض الزواج أو الرضاء به:
„ وقلت لنفسي: إنه لسرّ أن تهبني نفسها بهذا السخاء، وإنني لسعيد الحظ حقاً.
ومداراة لمخاوفي الدفينة قلت لها مرة: إنك يا سامية كنز لا يقدر بثمن.
فقالت لي بصراحة: وفكرة الرحالة الذي يضحي بالأمان في سبيل الحقيقة والخير تفتنني كثيراً يا قنديل ".
إذن فليس رضاؤها بسرّ، إنه معلن مكشوف، إنه بداعي الافتتان منها بالرحالة الذي يضحي في سبيل الحقيقة والخير. ولعل أصل هذا الافتتان، أن يكون تأثّرُ سامية بالحكايات التي فاض ويفيض بها خيال الرواة والدعاة عن حال المرأة في عهد محمد وصحابته، مع أنها حكايات ليس في القرآن، وليس في سيرة نبي الإسلام، ما يؤيدها، ويثبت أنها صادقة يصحّ الاستشهاد بها على أن واقع المرأة في عهد الرسول وصحابته، كان أفضل من واقعها اليوم في دار الإسلام (19) وفي هذا أيضاً ما يستثير التعجب والاستغراب: كيف لامرأة في منزلة رفيعة من رجاحة العقل والفطنة واتساع المعرفة أن تصدِّق بحكايات لا يؤيّد صدقها القرآنُ ولا السيرة ولا التاريخ ؟! بل كيف لها، وهي سامية، أن تسأل رجلاً من دار الإسلام عن حياة المرأة في هذه الدار سؤالَ من يجهل حال المرأة المسلمة في دار الإسلام؟! أوَكانت حقاً جاهلة بحالها ؟ أم هو السرد بلغة تراعي موضوعها المؤطر بإطار التاريخ القديم حيث كان جهل بشر مقيمين بمصرٍ من الأمصار بأحوال بشر مقيمين في مصر آخر أمراً مألوفاً لبعد الشقة بين المصرين وانعدام وسائل الاتصال بين الاثنين؛ اللهم إلا تلك الوسائل التي كان تأثيرها في وعي الناس عصر ذاك محدوداً كالقوافل التجارية ورحلات الرحالة :
„ وسألتني سامية عن الحياة في دار الإسلام، وعن دور المرأة فيها، ولما وقفت على واقعها انتقدته بشدة، وراحت تعقد المقارنات بينه وبين المرأة في عهد الرسول، والدور الذي لعبته، حتى قالت: الإسلام يذوي على أيديكم، وأنتم تنظرون ".
إن هذا، وسوى هذا مما سيأتي، شاهد لا يُدفع على شخصية الرحالة قنديل محمد العنابي، أنها شخصية مضطربة، كليلة الحد، محدودة الأفق، ليست تمتّع بمواهب البطل (الإيجابي) المؤهل لإنجاز المهمات التاريخية - الاجتماعية الصعبة المعقدة المرهقة: من توقد ذهن، وثبات عزيمة، ووضاءة حكمة، وجريان فطنة، ووضوح رؤية، وشجاعة فكر.
ولا بأس من المقارنة بين شخصيتي قنديل و (برزويه) الحكيم، بل لا بد من هذه المقارنة لتصديق ما صدر من حكم على شخصية الرحالة قنديل تصديقاً يبعد عن هذا الحكمِ الشططَ والميل وعدم النزاهة والإنصاف. ولا يوهن هذه المقارنة اختلافُ الدافع إلى الرحلة بينهما، فأن تكون رحلة برزويه بتكليف من جهة خارجية (كسرى أنو شروان) وأن تكون رحلة قنديل بتكليف رغيب من ذاته، أمرٌ ليس من شأنه أن يجعل المقارنة بين الشخصيتين تقبل علامة استفهام.
ينقل ابن المقفع إلى العربية عن الحكيم برزويه:
" فلما عزم كسرى أنو شروان على ما أراد من أمره، وهمَّ بالبعثة في طلب كتاب كليلة ودمنة وانتساخه، قال في نفسه: مَنْ لهذا الأمر العظيم، والأدب النفيس، والخطب الجليل الذي يزَّيَّن به ملوك الهند دون ملوك فارس؟ وقد هممنا ألا ندع – مع بعد السفر، وصعوبة الأمر، ومخاطر الطريق، وكثرة النفقة – طلب هذا الكتاب حتى نصل إلى نسخه، ونقف على إتقانه، ورصانة أبوابه، وعجائبه، ولا بد لنا من أن ننتخب من نريد إرساله في ذلك من هذين الصنفين من الكتاب والأطباء، فإن أهل هذين يجتمع عندهم جوامعُ من بحور الأدب، وكنوز الحكمة، في أناة وتؤدة، وتجربة ونفاد حيلة، وتحفظ وتحرز، وكمال مروءة، ودهاء وفطنة، وحلم وتصنّع، ولطف وسياسة، وكتمان سرّ. فلما فحص الرأي فيما أجمع عليه، اختار في مملكته، وانتخب من علمائه، فلم يجد أحداً على نحو ذلك إلا بَرْزَوَيهِ بن آذَرهِربَد، وكان من رؤساء أطباء فارس ومن أبناء مقاتلتها، فدعاه كسرى وقال له: إنّا قد انتخبناك لموضع حاجتنا، وتفرَّسنا فيك الخير، وأمّلنا فيك أن تكون على ما أردنا من إصابة هذه الحاجة التي نحن مرسلوك فيها؛ لما علمنا عنك من الاجتهاد في العلم والأدب، وحرصِك على طلبهما. ونحن مرسلوك إلى بلاد الهند لِما بلغنا عن كتاب عند ملوكها وعلمائها قد ألّفته العلماء، وهذّبته الحكماء، وأتقنه الفطناء، ليس في خزائن الملوك مثله، يستعين به على عظائمهم ملوك الهند، فتعزم على المسير بسببه فتستفيده برفق وتؤدة وتلطف، وتحمل معك من المال ما أردت، ومن طُرَف بلاد فارس وهداياها ما تعلم أنه يعينك على استخلاصه، مع ما تقدر عليه من الكتب التي يحتاج إليها الملوك، وليكن ذلك في سرٍّ مكتوم " (20).
فإذا قوبلت صورة شخصية برزويه هذه التي رَسمتْها ههنا ريشة الكاتب في كليلة ودمنة، بصورة شخصية قنديل العنابي، فلا ريب حينئذ في أن تخمل المقابلةُ شخصية قنديل العنابي، وتخلع عنها ما زمّلها من صفات ليست لها.
أما حكاية تضحية الرحالة بالأمان في سبيل الحقيقة والخير، فشيء أشبه ما يكون بالخدعة تخدع بها النفسُ صاحبها. إن نفس الرحالة التوّاقة إلى الخلاص توهمه – ولم تنجُ سامية أيضاً من هذا الوهم - أنه يضحي بالأمان لخير دار الإسلام، والحقيقة أنه لم يضحِّ بالأمان لخير دار الإسلام، وإنما ضحى به لخيره هو. هذه هي الحقيقة، وقد ظلّت مطمورة في أعماقه حتى كشف له عنها شيخُه العارف في دار الغروب.
ولم ينكر قنديل هذه الحقيقة حين انكشفت له، وهو بين يدي شيخه في دار الغروب، أقرّ بها دونما اعتراض حال أن تفرّسها الحكيم، ورفع عنها سترها الذي كان غطاها فحجبها عن وعيه كلّ تلك المدة الطويلة:
„ فقال الشيخ بامتعاض: إنك من الهاربين، تعللت بالرحلة فراراً من الواجب، لم يهاجر أحد إلى هنا إلا بعد أن أدى واجبه، ومنهم من خسر زهرة عمره في السجن في سبيل الجهاد لا بسبب امرأة.
فهتفت جزعاً: كنت فرداً حيال طغيان شامل.
- هذا عذر الخائر.
فتوسلت إليه قائلاً: ليكن من أمر الماضي ما يكون، فلا تثبّط همتي ولا تبدد حياتي هباءً. فلاذ بالصمت حتى اعتبرت الصمت رضاً، وتشجعت قائلاً: ستجدني من أهل العزم والإخلاص ".
فهذه هي الحقيقة وقد تعرّت من ثيابها، هذه هي الحقيقة التي لم يدركها، ولم تدركها سامية، وأدركها الحكيم العارف ذو الكشاف المضيء. فإنما برحلته يكون الرحالة موّه هروبه من ساحة النضال ضد الزيف في داره دارِ الإسلام، من غير أن يعي أنه بهذه الرحلة إنما يموه هروبه ويغطيه. كان وعيه بهذه الحقيقة غائباً - ليس يوجد فيما سجله في هذا المقام إشارات إلى أنه كان واعياً بحقيقة هروبه - وظل وعيه غائباً عنها حتى التقى بشيخه العارف في دار الغروب.
ولا يقال في هذا الهروب بالرحلة، سواء أكان عن وعي أو لا وعي، إلا أنه مخجلٌ معيب.. إلا أنه عوار لا يبرره في رأي حكيم الغروب أن صاحبه كان " فرداً حيال طغيان شامل".
أن يهرب قنديل من مواجهة الزيف في وطنه – وهو الذي يزعم أنه يحب وطنه ويتوجع لمصابه، وهو الذي يخُيّل إليه أنه موكَّل بإنقاذه من الزيف – ليطلب الأمان والخير والخلاص لراحة نفسه وسعادتها في مكان آخر، فحركة نفسية كالخطيئة قد تقبل الغفران، لكنها لا تقبل التبرير، كذا في منطق الشيخ.
ولا يصح هنا بحال من الأحوال أن يخطّئ المرءُ الحكيم العارف قائلاً: إنه أخطأ في تفسير رحلة قنديل على أنها هروب من المواجهة.. على أنها لخير نفسه لا لخير وطنه كانت؛ لا لأن الرحالة أقرّ بذلك وبس، بل لأن الرحالة منذ البدء إنما كان يحلم بزيارة دار الجبل. ودار الجبل كما يوحي بذلك كلُّ حديث عنها يرد على لسانه أو لسان غيره، دارُ خلاص النفس.. خلاص نفسِ الفرد لا الوطن، من أعباء الحياة وزيفها وسفسافها.
إنها الحقيقة، ولن يكون لما ادعاه الرحالة في سجله مراراً أن هدفه من رحلته هو جلب الدواء لوطنه الجريح، أو اكتساب العلم والمعرفة، أن يكذب هذه الحقيقة، ولن يهدمها أيضاً تصوير نفسه في سجله بطلاً صادق البطولة يُغمّر في المكاره لأجل وطنه؛ إذ لو كان صادق البطولة حقاً، ما كان أصرّ على إتمام رحلته إلى دار الجبل، وقد كشف له عنها شيخه العارف الرائي أنها دار سينسى بها الدنيا وما فيها.
دار الجبل دار إذا دخلها المريد، فلن يقدر على الخروج منها والعودة إلى وطنه الأول أو الثاني، حسبما أخبر شيخه الرائي بلفظه الهلامي الذي يغلّفه شيء من غموض: " سوف تنسى بها الدنيا وما فيها " فلمّا كان قنديل الرحالة التقط ما أخبر به عنها شيخه بأذن مرهفة، فلماذا أصرّ على دخولها؟ ما معنى أن يصر على دخول دار لا رجعة له منها إلى وطنه، إن كان هدفه حقاً جلب دواء شاف لوطنه المريض؟! هل لهذا الإصرار من الدلالات سوى الدلالة على أن هدفه الحقيقي هو خلاص نفسه، لا خلاص وطنه؟
إلاّ أن يكون الرحالة قنديل، إذ أصرّ على دخول الدار، شكّ في صدق ما أخبره عنها شيخه الجديد، مثلما كان شك (ربما) فيما رواه شيخه مغاغة الجبيلي عن الديار التي زارها؟ ولكن، كيف ذلك؟! كيف له أن يشك في صدق شيخه الجديد، وشيخه الجديد - بشهادة قنديل نفسه - عارف صادق يسبر الحجب.. شيخه حكيم ينقذ الأرواح وهو ضالته وبغيته وعليه اتكاله ؟
فإذا وُضع هنا أن قنديلاً لم يكن شكّ في صدق قول شيخه فيها، فعندئذ لا مفر من تقديم تفسير مقنع لما قاله مخاطباً نفسه، وهو يهم بتسليم دفتر رحلاته لقائد القافلة العائدة إلى وطنه:
„ إذا قيّض لي زيارتها والرجوع منها إلى الوطن“
إن الفعل (قُيّض) في صدرها من جهة المعنى أو الدلالة، لا يمنع من أن تكون العودة إلى وطنه ممكنة بخلاف ما أخبر به شيخه " ستنسى بها الدنيا وما فيها " حيث جعل الشيخ العودة منها إلى وطنه بهذا الخبر مستحيلة.
فكيف التفسير؟ كيف حل عقدة التناقض بين الممكن والمستحيل؟ وكيف الإتيان بتفسير مقنع ينزاح معه الشكّ بصدق شيخه الحكيم؟
إنها معضلة ! وليس من اليسير أن يؤتى لها بتفسير مقنع.
مَن يُتح له أن يدخل دار الجبل فيمكث بها، فلا محالة من أن ينسى بها الدنيا وما فيها؛ فيترتب عن هذا أن قنديلاً سينسى وطنه؛ لأن وطنه شيء أو جزء من الدنيا التي سينساها. ومن ينسَ وطنه، فسيفقد – لا محالة - مشيئة العودة إليه، فأنَّى لمن نسي وطنه وفقد مشيئة العودة إليه أن (تقيض) له العودة إلى وطنه أو تُقَدَّر؟
هذا، ومن جانب آخر فإن المكوث فيها – في عقيدة الشيخ - مكوث في الفردوس في عالم المثل والسعادة المطلقة والكمال البهي، ومن يمكث في الفردوس، فهل له أن يبرح منه إلى وطنه إلا على وجه التخييل؟ وإنه لكذلك أيضاً في الإسلام دينِ الرحالة، فإن الماكث في جنة الخلد، محال أن تقيّض له العودة إلى الدنيا.
فينتج مما سبق، أنّ قنديلاً إذ أضحى مريداً طائعاً قد أخلص قلبه وعقله لشيخه، وانهمك على اكتساب المقدرة على الطيران بلا أجنحة من تعليم شيخه حتى أوشك أن يطير؛ ليس يصحّ أن يشك بما أخبره شيخه بوساطة الفعل قيض.
فإن قال قائل: إنه لم يشكَّ في صدق قول شيخه عن الدار، أو يكذبه، ولكنه تورّط في موحل اللفظ (قيّض) أي خانته الدقة في اختيار اللفظ اللائق بمعناه؛ فللرحالة عندئذ مخرج من ورطته بانتحال وجه من وجوه التأويل، أو بالتماس عذر له مقبول بنحو :
إن قنديلاً لم يعِب فكرة (المكوث) الدائم في دار الجبل كما صورها له أستاذه الشيخ الروحاني مدرب الحائرين لنقص في تدريبه؛ وأيضاً بسبب أن شيخه صاغها في تركيب من اللفظ غامض هلامي على عادة المهوّمين من المتصوفة " سوف تنسى بها الدنيا وما فيها " وسرُّ غموضه أن ما فيه من معنى يحتمل المبالغة.
فالمعنى نسيان الدنيا وما فيها على حقيقته؛ أي بتجرده من المبالغة، هو: (قد، ربما تنسي الدارُ الماكثَ فيها الدنيا وما فيها لروعة جمالها وقوة جاذبيتها ) لكن الشيخ غالى في هذا المعنى.. بالغ في توكيده لغرض هو السيطرة على انتباه المريد والتأثير في شعوره تأثيراً عميقاً.
وبهذا يكون الرحالة غير مذنب إذ لم يفهم أن شيخه أراد المعنى مجرداً عن المبالغة، وإنما الذنب ذنب عبارة الشيخ الغامضة. فلولا أن العبارة اشتبهت عليه والتبست، لكان فهم أن (المكوث) في لغة شيخه أو في عقيدته، يستحيل من بعده أن تكون له أوبة إلى الوطن، فتنحنى إذ ذاك عن استعمال لفظ (قيض) الذي لا يأبى أن يكون على معنى الإمكان.
وقد يقال: إنما هو على معنى التوقع واحتمال حدوث مكروه – مثلاً - يمنع من العودة والرجوع كالهلاك في الطريق من شدة الإعياء، يؤيد هذا ما جاء على هامش الرحلة: „ هل واصل رحلته أو هلك في الطريق؟ هل دخل دار الجبل؟ وهل أقام بها لآخر عمره أو عاد منها إلى وطنه كما نوى؟".
ولكنه قول يفسده أن شيخه عارف يقرأ الغيب " ذهلت حقاً ورمقته بخوف ثم قلت: كيف تأتى لك أن تقرأ الغيب؟ فقال ببساطة: هنا يفعلون ذلك وأكثر" فلو كان شيء كالهلاك في الطريق يحدث له؛ لأخبره بذلك شيخه العارف، فلما لم يخبره بذلك بطل قول القائل إن المعنى على وجه التوقع والاحتمال. صحيح أن الشيخ حذّر مريديه من العناء حين اختاروا الرحيل إلى دار الجبل على البقاء في دار الغروب حتى يستكملوا تدريباتهم الروحية:
„ ساد الصمت مرة أخرى حتى خرقه الشيخ موجهاً خطابه لنا: اختاروا لأنفسكم ما تحبون. فاستبقت الأصوات هاتفة: دار الجبل.. دار الجبل.
فقال الشيخ محذراً: ستلقون عناء لنقص تدريبكم ".
ولكن التحذير لم يتضمن احتمال أن يهلك أحدهم في الطريق، أو يعرض له ما يعوقه عن الوصول إلى دار الجبل. العناء وإن كان شدة، ليس عائقاً يحول دون دار الجبل.
وقد يقال: إن لفظ (قيض) يحمل في داخله معنى من المعاني المتداولة في عالم الغائبين الباطنيين الصوفيين؛ على معنى تتجاذبه قوتان: النجاح والإخفاق في التجربة النورانية التي راح يخوض في غمارها تحت إشراف شيخه الحكيم، فإما أن ينجح وإما أن يخفق، ليس لكل مريد يخوض في التجربة النورانية (التجربة هي خلع ثياب الدنيا والغوص في أعماق النفس لاستخراج ما فيها من كنوز) أن يفوز بمأموله، قد يفشل فينكص على عقبيه. ولكن الرحالة زعم أنه نجح في التجربة، وإن لم يعبر عن هذا النجاح بلفظ صريح حين قال:
„ تخففت بعد ذلك من وساوسي، وتأهبت للمغامرة الأخيرة بعزيمة لا تقهر
„
فمن يتخفف من وساوسه ويتأهب بعزيمة لا تقهر ، فجزاؤه أن تتكلل مغامرته الأخيرة بالنجاح والفوز.
وقد يقال: إن الرحالة كان له من رحلته هدفان: هدف خاص هو زيارة دار الجبل، وهدف عام هو جلب الدواء لوطنه الجريح العليل، غير أن هذا القيل سيصطدم بجدار سميك لن يستطيع اختراقه بناه الرحالة بيده:
„ إنه عالم غريب حافل بالجنون، وستكون معجزة حقاً إذا وجدت الدواء الشافي في دار الجبل ".
وكذلك: „ من أجل ذلك قمت برحلتي يا شيخ حمادة، أردت أن أرى وطني من بعيد، وأن أراه على ضوء بقية الديار، لعلي أستطيع أن أقول له كلمة نافعة ".
وكذلك: „ دار الجبل ليست بغايتي الأخيرة، ولكني أرجو أن أرجع منها إلى وطني بشيء يفيده ".
إذ لو كان له هدف خاص من زيارة دار الجبل، ليس هو جلب الدواء منها لوطنه وحسب، فما معنى قوله : إذا وجدت الدواء الشافي في دار الجبل، ومعنى قوله الثاني ومعنى قوله الثالث ؟
وما هو هذا الهدف الخاص إن وجد؟ هل هو شيء آخر غير أن يمكث في دار الجبل؟ فإن كان هذا هذا، عاد بهدفه إلى " المكوث " في دار الجبل، والمكوث في دار الجبل يحول دون تحقيق هدف العودة إلى داره، على ما قد تبين فلا يزول الإشكال ويبقى قائماً.
فأما أن يكون في مواضع أخر زعم أن الهدف من رحلته حبُّ المعرفة لذاتها من مثل قوله للمرشد السياحي: „ العلم نور " ومن مثل قوله لفيلسوف الحلبة: „ لست من علماء وطني ولا فلاسفته، ولكني محب للمعرفة" فهو جميعاً من متناقضاته.
والآن، إذا أمكن المرءَ أن ينتحل له هذا الوجه من الاعتذار والتفسير، فكيف للمرء إمكانُ أن ينتحل له عذراً أو تفسيراً، وهو يراه قبل لقائه بشيخ دار الغروب، يتخبط في تصوره لدار الجبل، وفي حديثه عنها؟
فها هو يسجل في دفتر رحلاته على لسان امرأته السابقة عروسة المشرقية:
„ فقالت باسمة: الختام حسن… سنقوم برحلة إلى دار الأمان، ومنها إلى دار الجبل، ثم نسافر إلى الهند ".
فإنه يسجّله دون تعليق منه أو اعتراض عليه ظاهر أو خفي؛ مما يرسخ الظن بأنه كان على يقين من تمام صحة ما قالته عروسة؛ أي إنها سيتاح لها أن تغادر دار الجبل من بعد أن تدخلها. وهو يقين لا يسع المرء إزاءه إلا أن يتساءل: ممن استقى قنديل هذا اليقين؟
أتراه استقاه من شيخه مغاغة الجبيلي الذي لقنه المعارف والعلوم وحدثه بسخاء عن رحلاته، وعن دار الجبل؟
فإن كان استقاه منه، فمتى حدث هذا؟ وأين ورد ما يؤكد هذا الحدوث في سجله عن رحلته؟
… سؤال، ولكن لن يعثر المرء له على جواب. ليس في كل ما سجله الرحالة قنديل عن شيخه الأستاذ من حديث عن دار الجبل، ما يوحي بأنها دار مثل غيرها من الدور للداخل إليها أن يخرج منها بعد أن يمكث فيها إلى أجل! لم يرد في كل ما سجله الرحالة أن شيخه مغاغة الجبيلي، قد قال له عنها شيئاً بهذا الصدد غير قوله عنها: إنها سر مغلق:
„ فسألته بشغف:
- وما خطورة دار الجبل؟
فقال متنهداً:
- تسمع عنها الكثير، كأنها معجزة البلاد، وكأنها الكمال الذي ليس بعده كمال.
- لا شكّ أن كثيرين من الرحالة قد كتبوا عنها.
فقال بنبرة لم تخلُ من أسى:
- لم أصادف في حياتي آدمياً ممن زاروها، ولا وجدت كتاباً عنها أو مخطوطاً.
فقلت بضيق:
- إنه أمر عجيب لا يصدق.
فقال بكآبة:
- إنها سرّ مغلق ".
بل إن المرء، حتى لو استقصى كلّ ما سجله الرحالة في دفتر رحلته عن دار الجبل مما تساقط عنها من أفواه الذين خالطهم أو مرّ بهم في رحلته؛ لن يعثر على إشارة واحدة تومّئ إلى أن العودة من دار الجبل ممكنة. وبعض هؤلاء، ينفي وجودها؛ بدعوى منه أن وجودها ليس مما لعقل سليم أن يقرّ به، أو بدعوى منه أن العقل ليس بحاجة إليها حتى لو وجدت.
فهذا (فام) صاحب الفندق في دار المشرق، يحدثه هو الآخر بحديثها، ما إن تعرف إليه، وحديثه خال من الإشارة إلى إمكان العودة منها:
„ سرّني أن أجد فيه (في فام) رحالة قديماً فقلت: دار الجبل هي الهدف الأخير من رحلتي.
- وهي هدف الكثيرين، ولكن أسباب الرزق حجزتني عنها.
فسألته بلهفة: ماذا تعرف عنها يا سيد فام؟
فأجاب باسماً: لا شيء إلا ما توصف به أحياناً كأنما هي معجزة الدهر، ومع ذلك فلم أصادف رجلاً واحداً ممن زاروها.
وقال لي بصوت باطني بأنني سأكون أوّل ابن آدم يتاح له أن يطوف بدار الجبل، ثم يعلن سرّها للعالمين ".
ولقد أخطأ (فام) حين أسرّ له بأنه سيكون أول ابن آدم يتاح له أن يطوف بدار الجبل؛ لأن عروسة – فيما بعد – ستسبق قنديلاً إلى دار الجبل حسبما روى قنديل:
„ وقمت حانياً رأسي في خشوع (لحكيم دار الغروب) وخطر لي خاطر فترددت جافلاً من إعلانه، وإذا به يقول: تريد أن تعرف ماذا فعل الدهر بعروسة !
فذهلت كما ذهلت حين انتزع ماضيَّ من الظلمات، وساءلت نفسي ترى أهكذا يتفاهمون في دار الجبل؟ أما هو فقال: لقد سبقت إلى دار الجبل ".
بل إن قنديلاً نفسه سيخطئ في هذا حين يجهر به أمام زوجته سامية ظاناً أنه سيكون " … أول من يكتب عن دار الجبل " فعروسة التي دخلتها لا بد أن تكون سبقته في الكتابة عنها أو في نقل ما شاهدته فيها للناس شفاهاً.
وهذا ديزنج حكيم الحيرة يتفاخر أمامه بداره - وكلٌّ يتفاخر بداره ما عدا قنديل العنابي المسلم فإنه لا يتفاخر بداره - زاعماً أن دار الجبل إن هي إلا رمز الكمال وقد انطبق على دار الحيرة داره:
„ أليس هذا هو الكمال نفسه ؟
فقلت مدارياً ما في نفسي: هو ما يقال عادة عن دار الجبل.
فهتف بقوة: دار الحيرة هي دار الجبل ".
وهذا الإمام حمادة السبكي والد زوجته سامية، إنه أيضاً إذ يتفاخر أمامه بنظام الحكم السائد في دار الحلبة، يصارحه بأنه يجهلها، لا يعرف عنها شيئاً:
„ إنه نظام فريد، لم يصادفك فيما رأيت ولن يصادفك فيما سترى.
- ولا دار الجبل؟
- لا أعرف شيئاً عن دار الجبل حتى أدخلها في المقارنة ".
وهذا (مرهم) فيلسوف دار الحلبة الذي ذهب إليه الرحالة للاستعلام، يصارحه على سعة معرفته بأنه أيضاً لا يعرف أحداً زارها أو كتب عنها؛ مؤكداً له - وقد لمس من الرحالة يقيناً بوجودها - بأن العقل في غنى عن دار الجبل، حتى لو كان لدار الجبل وجود واقعي:
„ … وما هدفك من الرحلة؟ فتفكرتُ ملياً ثم قلت : زيارة دار الجبل.
- لم أعرف أحداً زارها أو كتب عنها.
- ألم تفكر يوماً بزيارتها؟ فقال باسماً: من آمن بعقله أغناه عن كل شيء ".
وكذلك مرشده السياحي في دار الأمان (فلوكة) فإنه على مذهب فيلسوف الحلبة يرى أن العقل يغني عن دار الجبل:
" فيه الغنى عن أي شيء آخر ".
ويرى فلوكة أن رحلة قنديل إلى دار الجبل رحلة إلى الوهم واللا جدوى مستهتراً عابثاً بأجمل أحلامه:
„ ما هي إلا رحلة إلى لا شيء ".
ولئلا يخفى شيء من معالم شخصية الرحالة، يُشار إلى أنّ أستاذه الشيخ مغاغة الجبيلي، كان حدّثه عن رحلاته إلى ديار المشرق والحيرة والحلبة، ووصفها له وأسهب في وصفها:
„ أما حديثه عن الرحلات فمثار للعشق والسرور. وتكشف في مجرى حديثه عن رحالة قديم. قال: عرفتُ الرحلات في صحبة المرحوم أبي، فطوفنا بالمشرق والمغرب. فأقول بلهفة: حدثني عن مشاهداتك يا سيدنا. فحدَّثني بسخاء… ثم قال: قمتُ بتلك الرحلة وحدي عقب وفاة أبي، فزرت ديار المشرق والحيرة والحلبة، ولولا الظروف المعاندة لزرت الأمان والجبل. ولكن القافلة وقفت عند الحلبة بسبب قيام حرب أهلية في دار الأمان ويحدجني بنظرة غريبة ثم يقول: وهي دار وثنية ".
ومع ذلك فإن قنديلاً سيشد رحاله إلى هذه الديار ! وهو أمر لا غرو أن يُنبض في الذهن تساؤلاً ينطوي على شيء من حيرة تشوبها دهشة خجولة: لماذا يتكلف رحالة شاب عناء زيارة بلاد، قد بات من شيخه على علم بأحوالها، وبما يضطرب في جوائها مما له مثيل في ديار المسلمين ومما لا مثيل له فيها؟ أما كان حرياً به - وقد علم من أستاذه بأحوالها - أن يتجاوزها إلى البلدان التي امتنعت زيارتها على شيخه الأستاذ؛ فيكون بهذا التجاوز الذي يستملحه المنطق السليم، وفَّر على نفسه الجهد والمال، ودرأ عنها الأخطار، وقصّرَ طِوَل الرحلة، ووقى نفسه من الدخول في تجارب تذهله عن هدفه، وتجاربَ لا تؤمن عواقبها؟ أم أن أستاذه الشيخ الذي بالرغم من زعم قنديل أنه قد حدثه عن رحلاته (بسخاء) لم يفلح في أن ينقل له ما شاهده في هذه الديار نقلاً أميناً وافياً يغنيه عن الرحلة إليها؛ كما أغناه وصفُه لديار الإسلام عن الرحلة إليها؟ أو أن قنديلاً الرحالة لم يوقن بما رواه له شيخه عن هذه الديار، فآثر أن يقطع شكَّه فيما رواه شيخه عنها، بيقين منه يستمده من معاينته الشخصية لأحوال هذه البلدان؟ أو أنه قد يكون وثق برواية شيخه، غير أنه وجدها ناقصة لا تفي بمراده؟
أم هي الخفة والاغترار يكون كلاهما في عطاف الشاب المتحمس فيلهيانه عن الإفادة من تجارب الآخرين:
„ فحدثني بسخاء حتى عايشت بخيالي ديار المسلمين المترامية، وتبدى لي وطني نجماً في سماء مكتظة بالنجوم. وقال: ولكن الجديد حقاً لن تعثر عليه في دار الإسلام. وتتساءل عيناي عن السبب فيقول: جميعها متقاربة في الأحوال والمشارب والطقوس، بعيدة كلها عن روح الإسلام الحقيقي، ولكنك تكتشف دياراً جديدة وغريبة في الصحراء الجنوبية. أثار أشواقي لدرجة الاشتعال ثم قال: قمت بتلك الرحلة وحدي عقب وفاة أبي، فزرت ديار المشرق والحيرة والحلبة، ولولا الظروف المعاندة لزرت الأمان والغروب والجبل، ولكن القافلة وقفت عند الحلبة بسبب قيام حرب أهلية في دار الأمان. ويحدجني بنظرة غريبة ثم يقول: وهي ديار وثنية. فهتفت: أعوذ بالله !
- ولكن الغريب لا يلقى فيها أو في الطريق إليها إلا الأمن لحاجتها الملحة إلى التجارة والسياحة. فهتفت مرة أخرى: ولكنها ملعونة.
فقال بهدوء: لا حرج على المشاهد ".
فهذا الذي، إنْ وقف به نظرُ المرء هنيهة، اقتضاه الوقوفُ به ذاك التساؤلَ المشوب بحيرة مدهوشة، واقتضاه أن يكرر مردداً: ما دام شيخه حدثه عن تلك الديار (بسخاء) وما دام علم من شيخه أنها وثنية ملعونة، فلماذا خرج إليها ينشد فيها الدواء لوطنه الكسيح المريض الجريح، وليس له فيها من دواء؟!
ربما كان في دار الحلبة ما ينتفع به وطنه، مما يسوغ زيارتها حتى لو كان حُدّث عنها بحديث سخي طويل. ولكن أي شيء نافع لوطنه يوجد في دار المشرق ودار الحيرة فأغراه بزيارتهما؟ أما كان علم أنهما وثنيتان؟ أما كان علم أن أحوالهما وأحوال وطنه متقاربة؟ إذاً فما الداعي لزيارتهما ؟ إلامَ هدفَ الرحالة من زيارتهما؟ أإلى الهروب؟.. الفضول؟ .. المغامرة؟ .. " العلم نور" أي تنوير عقله بمعرفة أحوالهما عن كثب حتى لو يكن في هذه المعرفة خير لوطنه؟
* وإنما بهذا التساؤل ينتهي القول في شخصية الرحالة، ويبدأ القول فيما اعتبأته هذه الشخصية من أفكار، وما ادخرته من آراء مكتسبة من البيئة، والتراث، والتعليم، والتجربة الخاصة، وكذلك في كيفية ازدرادها هذه الآراء والأفكار وكيفيه تصريفها والعمل بها في سيرتها خارج ذاتها، في المجال العام الذي يقتضي تطبيقها.
ولا مهرب، قبل البدء في ذلك، من التنبيه على حقيقة من أمر الشخصية أنها لا يمكن فصلها عن أفكارها ولا سيما في الأدب؛ لأن الشخصية في الأدب تجسّم فكرة تولد وتتطور في سياق الزمن ومجراه – تبدأ وتنتهي نهاية سعيدة جليلة نافعة، أو تعيسة خاملة فاسدة، أو تتقلب في حضن النهايات: فطَوْراً سعيدة نافعة، وطوراً تعيسة خاملة، وطوراً لا هي في هذه الحال ولا تلك، وطوراً هي في الحالين معاً - في فضاء متخيَّل تتشابك فيه فعاليات الإنسان، وأنماط عيشه، وألوان مقاصده ونزعاته وميوله وأهوائه، وتندمج.
فما شخصية الرحالة قنديل – إن وجب التمثيل - إلا فكرةً ترتدي جسداً حياً وتمتطي مركباً يمخر بها عباب الزمان والمكان إلى مرفأ من مرافئ المعنى.
وإنما يكون الفصل بينهما، بين الشخصية والفكرة، في الدراسة والنقد صناعياً لغايات هي الإبانة والتسهيل واستنباط النتائج المتوخاة بليونة.
فما هي الفكرة العامة وجزيئاتها المتجسدة في شخصية الرحالة؟ وأيّ مدى قطعته في مسار الخير والنفع والحكمة ؟
في الجواب على ما هي ... يقال:
ليس من الحق أن يعتبر الرحالة قنديل، عالماً أو فيلسوفاً. اعترافه بأنه ليس عالماً وفيلسوفاً: " لست من علماء وطني ولا فلاسفته، ولكني محب للمعرفة… " يحول دون اعتباره عالماً فيلسوفاً. فإن عُدَّ كذلك بحمل اعترافه على محمل التواضع؛ أي إنه حين قال عن نفسه إنه ليس فيلسوفاً وعالماً، فإنما قال ذلك ليتجنب أن يوصم بالغرور والخيلاء، فلن يكون سديداً، ببرهان أن سيرته كما رواها ليس فيها ما يحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن صادقاً في اعترافه؛ فالعالم الفيلسوف قد يخطئ غير أنه لا يتورط في كل هذا الذي تورط فيه قنديل وهو يتوقل في المصاعد إلى هدفه. إذن فلقد كان اعترافه بكونه ليس فيلسوفاً وليس عالماً اعترافاً صادقاً لا تمويه فيه..
ولكنه – وإن لم يكن فيلسوفاً أو عالماً - ما أمحل عقلُه، بل نشط كما ينشط حقل خصيب ذي ريّ بأُكله، إذ هو في زيارة فيلسوف الحلبة مرهم.. نشط إلى إنتاج فكرة عامة ضخمة تكاد تحاكي في ضخامتها فكرة هيغل المطلقة في التاريخ، ألقاها على مسمع الفيلسوف ولكن بلفظ أو تركيب لم يبرأ من الإبهام شيئاً:
„ حياة كل قوم تتكشّف عادة عن فكرة أساسية ".
ومرد إبهامه ما في لفظ (الفكرة الأساسية) من فضفضة تنشر في ذهن السامع أكثر من تصور للمعنى المرغوب فيه، وهو إبهام يكاد يداني إبهام لفظ شيخه الروحاني في دار الغروب، إلا أن الفيلسوف مع ذلك قد أدرك المقصود منه في التوّ، فلم يحتج لأن يستفسر عنه. وإنما بنباهته أدرك الفيلسوف أن الرحالة يريد من اللفظ أن يتعرّف الأساس الذي شادت عليه دار الحلبة حضارتها، ما هو؟ فأجابه بلا تلكؤ: الأساس هو الحرية. وراح يتغلغل في طبيعتها التي هي الخير، خير الفرد والدولة والمجتمع. والخير في مذهب الفيلسوف يصنعه الإنسان بالعلم والعلمانية والمساواة والعدل والعمل وبتحطيم قيود الاستبداد ومحو شروره؛ ولا يصنعه إله. ويتغلغل الفيلسوف أيضاً في سيرورتها التاريخية مذ أينعت قيمةً أولى للحياة في عقل أول فرد مفكر من داره، إلى أن أثمرت بنضال أجيال متعاقبة من أهل داره حذوا حذوه، وكان نضال هذه الأجيال المتعاقبة من أهل داره جاداً حاراً لم يفتر، وكان أحياناً مدلهماً شديد العبوس دموياً:
„ … لذلك يسألنا محبّو المعرفة من أمثالك كيف صنعتم حياتكم.
- وحياتكم جديرة بإثارة هذا السؤال.
- الجواب بكل بساطة، لقد صنعناها بأنفسنا.
فتابعته في تركيز وصمت، فقال: لا فضل في ذلك لإله، آمن مفكّرنا الأول بأن هدف الحياة هو الحرية، ومنه صدر أول دعوة للحرية، وراحت تتسلسل جيلاً بعد جيل. وابتسم، وصمت حتى تستقر كلماته في مستقرها من نفسي، وقال: بذلك اعتُبر كل تحرر خيراً وكل قيد شراً، أنشأنا نظاماً للحكم حررنا من الاستبداد، وقدسنا العمل ليحررنا من الفقر، وأبدعنا العلم ليحررنا من الجهل...“.
فإذا كانت الفكرة الأساسية التي شادت عليها دار الحلبة (أرقى الديار) حضارتها، هي الحرية وما يشع منها من أضواء تؤنس العقول والقلوب، وجب بداعي الإحاطة تقصي الفكرة الأساسية في كل الديار التي زارها الرحالة: وهي دار الأمان، ودار الحيرة، ودار المشرق، باستثناء دار الغروب لسبب قد سبق ذكره.
فعلى أي فكرة شادت عليها بقية الدور، كل منها على حدة، حضارتَها؟ أو ما هي، بلفظ قنديل الرحالة، الفكرة الأساسية التي تتكشف عنها حياة القوم في كل دار من هذه الدور؟
فأما دار الأمان، فإن فكرتها الأساسية، هي العدالة الاجتماعية (المساواة بين الطبقات، أو هدم نظام الطبقات) وللفكرة هذه انبثاقاتها من عقلانية وعلم وعمل. وبهذا تكون دار الأمان على اتفاق في العدل والعلم والعمل مع دار الحلبة (منافستها) وعلى اختلاف معها في فكرة الحرية. فالحرية التي هي أساس دار الحلبة طليقةٌ، أما الحرية في دار الأمان فمأسورة.
وفلوكة مرشد الرحالة السياحي في دار الأمان هو الذي سيتولى مهمة تزويد الرحالة بمعلومات وافية عن طبيعة النظام السائد في دار الأمان - وإن لم يكن حكيماً فيلسوفاً مثل مرهم في دار الحلبة – على غرار الكاهن الذي تولاها في دار المشرق، وديزنج الذي تولاها في دار الحيرة:
„… نظامنا لا شبيه له بين النظم، كل فرد يُعَدُّ لعمل ثم يعمل، وكل فرد ينال أجره المناسب، الدار الوحيدة التي لا تعرف الأغنياء والفقراء. هنا العدل الذي لم تستطع دار أخرى أن تحقق جزءاً منه… وقد وجدنا أن الإنسان لا يطمئن قلبه إلا بالعدل؛ فجعلنا من العدل أساس النظام، ووضعنا الحرية تحت المراقبة ".
فأما دار المشرق – وهي أول دار زارها الرحالة - فدار مكونة من أربع مدن ولكل مدينة منها حاكم، وكل حاكم من الأربعة يسكن في قصر داخل مدينته وحيدٍ لا يوجد من القصور في مدينته سواه؛ وكل حاكم مدينة من هذه المدن، حاكمٌ مالك لكل شيء ولكن لا سلطة له على أحد من سكان مدينته بالرغم من أنهم عبيده ويخضعون لمشيئته. تقتصر مهمته على الدفاع عن مدينته فقط وتوفير الأمن لأبنائها:
"دار المشرق عبارة عن عاصمة وأربع مدن، لكل مدينة سيد هو مالكها، يملك المراعي والماشية والرعاة، الناس عبيده، يخضعون لمشيئته نظير الكفاف من الرزق والأمن، فالقصر الذي شاهدت هو قصر سيد العاصمة، هو أكبر السادة وأغناهم ولكن لا هيمنة له على أحد منهم، ولكل سيد قوة مسلحة من المرتزقة يجلبهم عادة من الصحراء ".
إن نظام دار المشرق شبيه بنظام القبيلة، فلا غرو أن تكون فكرتها الأساسية بدائية. وتتجلى هذه الفكرة في عبادة القمر وما ينجم عن هذه العبادة من بساطة عيش، وخلو بال، وتوافق مع نظام الطبيعة، وبُعدٍ عن تعقيدات المدنية ومنجزاتها:
„ أهل المشرق جميعاً يعبدون القمر، في ليلة البدر يتجلى الإله في تمامه فيهرعون إلى الخلاء، ويحيطون بالكاهن للصلاة، ثم يمارسون طقوسه رقصاً وغناء وسكراً وغراماً. فذهلت كثيراً ثم تساءلت: وبذلك يضمنون الخلود في الجنة؟
- لا نعرف خلوداً ولا جنة، وليس لنا إلا ليلة البدر.
فترددت قليلاً ثم سألت: ألا يوجد طب وتعليم؟
فقال باستهانة: أبناء السيد يتعلمون الفروسية، ومعلومات عن الإله القمر، وفي كل قصر طبيب وارد من الحيرة أو الحلبة، أما الناس فيتركون للطبيعة، ومن يصبه مرض يعزل حتى يبرأ أو يموت فتأكله الجوارح.
فنظرت إليه كالمتسائل فاستدرك: إنها سنة القمر وتعاليمه، وهي تتوافق مع الحياة تماماً، لذلك فنحن شعب يغلب عليه المرح والرضا، نحن أسعد الشعوب يا سيد قنديل ".
فأما دار الحيرة التي هي دار أكثر تقدماً وتحضراً من دار المشرق، ففكرتها الأساسية هي الطغيان والاستبداد – وإن ادعى حكيمها أنها العدل - في صورة حاكم فرد (إله) يملك الدار وما فيها وله منها الريع يتقاسمه مع صفوته. ويخضع لمشيئته وقراراته كل عبيده بطاعة عمياء، فإن سوّلت لعبد نفسه أن يتمرد على ألوهيته، نكّل به بأفظع أنواع التنكيل، وأشدها قسوة :
„ وذهبت في الميعاد عصراً إلى بيت الحكيم ديزنج… طلب مني أن أقدم نفسي؛ ففعلت ذاكراً اسمي ومهمتي ووطني. قال: بلادكم عظيمة أيضاً، خبرني عما أعجبك في دارنا. فقلت مدارياً ذاتي، أشياء لا تعد ولا تحصى .. حضارة وجمال.. وقوة ونظام.
فقال: لعلك تسأل عن سرّ ذلك كله؟ لقد دلوك علي باعتباري حكيم هذا البلد، والحق أنني ما أنا إلا تلميذ. مولانا هو الحكيم، وهو الإله، وهو مصدر كل حكمة وخير. إنه يجلس على العرش، ثم ينعزل في جناح صائماً حتى يشع منه النور؛ فيعرف أن الإله قد حلّ فيه، وأنه صار الإله المعبود، عند ذاك يمارس عمله، يرى كل شيء بعين الإله، فنتلقّى منه الحكمة الأبدية في كل شيء، ولا نطالب بعد ذلك إلا بالإيمان والطاعة. تابعته باهتمام، وأنا أستغفر ربي في سري، أما هو فواصل حديثه قائلاً: فهو ينشئ الجيش، ويختار له قواده فيكون جيش النصر، ويعين من أسرته المقدسة الحكام، وينتخب من الصفوة قادة للعمل في الأرض والمصانع، أما بقية الناس فلا قداسة بهم ولا مواهب، يعملون في الأشغال اليدوية، ونوفّر لهم اللقمة، يلي هؤلاء الحيوانات، ويلي الحيوانات النبات والجماد، نظام محكم كامل يضع كل فرد في موضعه محققاً بذلك العدل الأكمل.
وسكت ملياً وهو ينظر إلي ثم قال: لذلك فنحن لنا أكثر من فلسفة، نخاطب الصفوة بما يقوي في نفوسهم القوة والهيمنة والنمو، ونستعين على ذلك بتوفير التعليم لهم والطب، أما الآخرون فنقوّي بهم مواهب الطاعة والانقياد والقناعة، ونهديهم إلى الكنز الروحي المدفون في أعماق كل منهم، والذي يُهيِّئ لهم بالصبر والاجتهاد السلام. بهذه الفلسفة المزدوجة تتحقق السعادة للجميع، كل بحسب استعداده وما أُعدَّ له، فنحن أسعد أهل الأرض طراً .
تفكرت فيما يقال وفيما لا يقال ثم سألته: من يملك الأرض والمصانع؟
- الإله، هو الخالق وهو المالك.
- وعلاقة الصفوة بها؟
- هم ملاّكها بالنيابة، والريع يقسم مناصفة بينهم وبين الإله.
فوثبت خطوة جديدة متسائلاً: كيف تنفق أموال الغلة؟
فضحك لأول مرة وقال: وهل يُسأل إله عمّا يفعل؟ ".
وإذ قد تمّ بهذا استقصاء الفكرة الأساسية في كل دار من الديار التي زارها الرحالة، بات لا مناص من استقصائها في دار الرحالة: ما هي هذه الفكرة؟ أهي الحرية ؟ أهي العدالة الاجتماعية؟ أم هي شيء آخر كالذي في دار المشرق، ودار الحيرة؟
كلا، فلا هي هذه ولا هي تلك. إنها الإسلام. الإسلام هو الفكرة الأساسية التي تتكشف عنها حياة المسلمين في دار الرحالة قنديل – وإن كان الرحالة قنديل فصل بين الاثنين - وتقوم على أساسه حضارتهم، إنه نظام على زعمهم.. إنه دين ودنيا. لكن دار الإسلام، وإن تفردت بفكرتها الأساسية، فإن ثمة وجهاً من وجوه الشبه في هذه الفكرة بينها وبين داري المشرق والحيرة الوثنيتين. فكما أن الفكرة الأساسية في داري المشرق والحيرة تنبع من وجود إله أو من عقل إله، فكذلك الفكرة الأساسية في دار الإسلام، فإنها تنبع أيضاً من عقل إله (الإسلام في عقيدة المسلمين من صنع الله) ولا تنبع من عقل الإنسان وحاجاته المادية كما هو الحال في داري الحلبة والأمان.
غير أن المصدر الإلهي الذي تنبع منه الأفكار الأساسية للدور الثلاثة – في اعتقاد الرحالة – ليس واحداً لا من حيث طبيعته ولا من حيث وجوده بما هو واجب وضرورة. إن إله الإسلام ليس وثناً، وليس صنماً، وليس جرماً، وليس بشراً، وإن وجوده ليس عارضاًً بل واجباً ضرورياً وإلا لم يكن وجود ولم يكن معنى؛ فهو إذن أعظم – في تقدير الرحالة المسلم وتصوره - من إله دار المشرق (القمر) ومن إله دار الحيرة (الحاكم الفرد):
" وقلت لنفسي متحسراً: ديننا عظيم وحياتنا وثنية "
على أن الرحالة المسلم حين يعظّم دينه، يفشل في إثبات عظمته. فبمَ هو عظيم حقاً؟دينه عقيدة، ولكي تكون عقيدة ما عظيمة أعظم من غيرها من العقائد، لا بد لها من أن تأتي بما هو عظيم – لا يقال عن شجرة إنها مثمرة إلا إذا أثمرت، ولا يقال هو كاتب إلا إذا كتب - وكذلك بما لم تأت به كل العقائد من قبلها ومن بعدها من عظائم، وإلا كان وصفها بالعظمة مجرد ادعاء فارغ، أو نفخة كاذبة، أو شعار خادع. وهذا هو الشرط الذي يسّر لكاهن المشرق الطعن في الإسلام في المناقشة التي جرت بينه وبين الرحالة المسلم، دون أن يستطيع الرحالة المسلم تفنيد مطعنه عليه:
„ فقلت وأنا في غاية الاستياء: الناس عندنا إخوة من أب واحد، وأم واحدة، لا فرق في ذلك بين الحاكم وأقلّ الخلق شأناً. فلوح بيده استهانة وقال: لست أول مسلم أحادثه، إني أعرف عنكم أشياء وأشياء، ما قلت هو حقاً شعاركم، ولكن هل يوجد لتلك الأخوة المزعومة أثر في المعاملة بين الناس؟ فقلت بحرارة وقد تلقيت طعنة نجلاء: إنه ليس شعاراً ولكنه دين. فقال ساخراً: ديننا لا يدّعي ما لا يستطاع تطبيقه. فقلت وقد شدّتني الصراحة إلى أعماقها: إنك رجل حكيم، إني أعجب كيف تعبد القمر، وتتصور أنه إله؟ فقال بجدية وحدة لأول مرة: إننا نراه ونفهم لغته، هل ترون إلهكم؟
- إنه فوق العقل والحواس.
فقال باسماً: إذن فهو لا شيء.
كدت ألطمه، ولكني كظمت حنقي واستغفرت ربي، وقلت: إني أسأل لك الهداية. فقال باسماً: وإني أسأل إلهي لك الهداية ".
وليس الإسلام في اعتقاد الرحالة متفوقاً بعظمته على عقيدة أهل المشرق والحيرة فقط، بل هو متفوق أيضاً على نظام دار الأمان، وعلى نظام دار الحلبة أيضاً. فها هو في دار الحلبة والإمام حمادة السبكي يمدّه " بمعلومات عن نظام الحكم في هذه الدار العجيبة " يهتف بأمنيته:
„ لو أنكم تطبقون الشريعة !“
في تناقض غريب عجيب بين ما يعتقده وبين ما يفعله، فهو رغم اعتقاده بعظمة الإسلام، لن يختار دار الإسلام وطناً لإقامته الدائمة، بل سيختار لإقامته دار الحلبة دار الحرية والعلمانية والديمقراطية، ولا يزيل هذا التناقض فصلُه بين الإسلام عقيدةً والمسلمين بشراً أفراداً (21):
" وقد قالت لي (سامية زوجته): يجب أن تجعل من الحلبة مقامك الدائم، أتمم رحلتك إذا شئت ولكن لتكن العودة إلى هنا. فقلت بصراحة أيضاً: قد أرى أن أرجع إلى وطني كما رسمتُ، ولا بأس من الإقامة هنا ".
ويتجلى اختياره في موضع آخر.. إذ هو يستعد لرحلته القادمة إلى دار الغروب ومنها إلى دار الجبل بعد أن أذنت له بها زوجته سامية:
„ ووعدت بالعودة إلى الحلبة عقب الرحلة، على أن أصطحب زوجتي وأبنائي إلى دار الإسلام، فأنسخ كتاب الرحلة، وألقى الباقين على قيد الحياة من أهلي، ثم نرجع إلى الحلبة ".
وعلة هذا التناقض الذي لن يلحظه الرحالة، هو تعلقه العاطفي بعقيدته الدينية. إن تعلقه العاطفي سيهيئ له مخادعة عقله بفصم علاقة الارتباط بين الإسلام والمسلمين. فالإسلام عظيم، أما المسلمون فوثنيون؛ لأنهم ابتعدوا عن "روح الإسلام " وهي عين الفكرة التي لقنه إياها شيخه مغاغة الجبيلي لتبرئة دينه من أن يكون سبباً فيما أصاب دار الإسلام من زيف وظلم وفقر وجهالة:
" ويوماً - لا أذكر في أي فترة من العمر – سألته: إذا كان الإسلام كما تقول فلماذا تزدحم الطرقات بالفقراء والجهلاء؟ فأجابني بأسى: الإسلام قابع في الجوامع لا يتعداها إلى الخارج. ويفيض في الحديث فيلهب الأوضاع بنيرانه.. حتى الوالي لا يسلم من شرره. وقلت له: إذن إبليس هو الذي يهيمن علينا لا الوحي. فقال برضاً: أهنئك على قولك، إنه أكبر من سنك ".
وقد اقتنع الفتى قنديل بفكرة شيخه مغاغة الجبيلي. اقتناعه بفكرة شيخه، هو الذي سيجعله في كل مناسبة يذم دار الإسلام، ويعلن بصوت جهير أسيان: „ ما من سيئة عثرت بها في رحلتي إلا وذكرتني ببلادي الحزينة" بخلاف كاهن المشرق، وحكيم الحيرة، وفيلسوف الحلبة، ومرشد الأمان، فهؤلاء جميعاً ما ونوا عن امتداح ديارهم والاعتزاز بها مباهين بما تحقق لديارهم من خير وسؤدد ورفعة وسعادة – وإن لم يكن بعضهم صادقاً فيما يدعي - بفضل أنظمتهم أو فكرتهم الأساسية.
أما شيخه الإمام حمادة السبكي، فلن تقنعه فكرة الفصل بين الإسلام والمسلمين؛ أي فكرة إلقاء اللوم على المسلمين وتنزيه الإسلام من اللوم. إن الواقع في نظره لا يؤيد هذه الفكرة. الواقع في دار الإسلام يؤيد فكرة أن الإسلام يطبق فيها لكن تطبيقه لا يثمر. وتطبيقه لا يثمر؛ لأنه تطبيقٌ لإسلام قديم قد خلقت ديباجته بفعل الزمن. إذن فلا محيد – في رأي الإمام - عن تجديد الإسلام ليتلاءم مع قيم العصر الجديدة وليكون فاعلاً فيها. ولا يتجدد الإسلام إلا بأداة قد سبق لبعض الاتجاهات الإسلامية فيما مضى، ولبعض الفلاسفة المسلمين أن تأدّت بها، هي الاجتهاد والتأويل. وقد لمّحت سامية إلى هذه الأداة إذ قالت:
" الفرق بين إسلامنا وإسلامكم أن إسلامنا لم يقفل باب الاجتهاد، وإسلام بلا اجتهاد يعني إسلاماً بلا عقل " .
بيد أن قنديلاً سيرى في الاجتهاد نقضاً لمبادئ الإسلام كما رسخت في القرآن وفي سيرة نبيه:
„ فقلت وأنا أكابد خيبة أمل، لو بعث نبينا لأنكر هذا الجانب في إسلامكم „ .
ففي منطقه أن الإسلام إذا كان يحرم الخمرة أو أكل لحم الخنزير – مثلاً - وكذلك زواجَ المسلمة من كافر بنص صريح، وجاء الاجتهاد فحلل الخمرة، وأكل لحم الخنزير وزواج المسلمة من كافر؛ أفلن يكون الاجتهاد بهذا التحليل نقض شرائع أزلية - أبدية شرعها الله للمسلمين في كتابه؟
نعم، قد يكون حسناً أن ينقض المسلم ما وضعه البشر من أحكام ومبادئ وتشريعات؛ لأن ما يضعه البشر عرضة للتغير والتقادم، فأما ما وضعه الله، وهو الحكيم العليم أزلاً وأبداً، فكيف لمسلم مؤمن أن ينقضه؟ إنه إن فعل، فقد أقرّ بأن كلام إلهه، كلام بشر يلهو به الزمن. ومن أقر بذلك فهو ليس مسلماً بعد.
فالاجتهاد إذاً يهدم الإسلام الحقيقي، كما لاحظ قنديل، وينتج ديناً جديداً يختلف كل الاختلاف عن الإسلام الحقيقي، وإن ظل يحمل اسم الإسلام.
لكن الرحالة قنديلاً، وقد أدرك التناقض في موقف الإمام:
" أعجب ما صادفته في رحلتي هو إسلام الحلبة الذي يستعر التناقض بين ظاهره وباطنه ".
لن يكون بمنجى من هذا التناقض، فهو إذ يعارض رأي فيلسوف الحلبة في مبدأ الجهاد زاعماً أن الجهاد في الإسلام لا عنف فيه، يكون اجتهد – من حيث لا يدري - في مبدأ الجهاد وجعله دعوة سلمية.. جعله منافحةً عن الإسلام باللسان لا بالسيف؛ مخالفاً بذلك ما جاء في القرآن عن الجهاد بلفظ صريح أنه قتال: [كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] فإذا كان أراد نوعاً آخر من أنواع الجهاد في الإسلام – والجهاد أنواع في الإسلام - وهو يخفي هذا النوع من الجهاد أي القتال، يكون غالط مغالطة من يتخذ الغش والاحتيال وسيلة إلى إقناع المخالف أو الغافل بصحة رأيه، ورأيه في الحقيقة فاسد ساقط. فإن لم يرد كل ذلك، وإن قال بأن الجهاد ليس فيه قتال لا من باب الاجتهاد والكذب والخداع، وإنما من باب الجهل بحقيقة الجهاد وأنواعه في الإسلام؛ يكن جاهلاً تنطّع بما ليس يعلم.
إن سيرة الرحالة تحفل بالكثير مما يتناقض مع شرائع الإسلام، منها على سبيل المثال اقترانه بعروسة الكافرة باستئجار فرجها. فالاقتران بكافرة يحرمه الإسلام ويعده زنى والزنى – في رأي فقهاء الإسلام - من أكبر الفواحش في الإسلام:
„ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ " .
فإذا كان الرحالة اجتهد في مسألة الاقتران بكافرة، لا على مبدأ (الضرورات تبيح المحظورات) لأنه لم يكن مضطراً إلى الاقتران بها بأي شكل من أشكال الاقتران، فهو إذن على رأي الإمام حمادة السبكي.. موافقٌ لمذهبه في التجديد والإصلاح، ولكنه في الحقيقة ليس على رأيه؛ لأنه يعتبر رأي الإمام في تجديد الإسلام وإصلاحه نقضاً للإسلام.
وهو من جهة المنطق (منطقه الذاتي) محق في ألا يكون على رأي الإمام في تجديد الإسلام؛ لأنه إن أخذ برأيه، هدم تصورَه عن الإسلام أنه "دين عظيم" إذ كيف يكون الإسلام عظيماً وهو محتاج إلى إصلاح؟
ولكن المنطق الخاص به إن كان يؤازره في هذه المسألة، فإنه لا يؤازره في هروبه (كذا بلفظ شيخ الغروب) من دار الإسلام؛ فهروبه من دار الإسلام ليس دليلاً على الخور كما وصفه به الشيخ العارف وحسب، بل أيضاً على أنّ فكرته (الإسلام عظيم) فكرة منقوضة. فلو كان الإسلام عظيماً، فلم كانت رحلته؟
ألم يقل له إمام الحلبة حين استحسن نظام دار الحلبة:
„ كان الأجدر بالمسلمين أن يبشروا به قبل غيرهم ".
فلماذا لم يبشر المسلمون به، بهذا النظام الرائع المبهر، قبل أن يبشر به أهل الحلبة؟ لماذا عجز المسلمون – بلفظ أدق - عن التبشير به، والإسلام العظيم بين أيديهم.. والإسلام (العظيم) ملء عقولهم وجوارحهم؟
أليس عجز المسلمين عن التبشير به، برهاناً على أن المسلمين لا يملكون إسلاماً عظيماً قادراً على إنتاج نظام رائع مدهش كنظام دار الحلبة؛ دار الحرية وإشعاعاتها من ديمقراطية وعلوم وفنون واختراعات وحقوق إنسان وحيوان وبيئة؟
ولكن الرحالة لن يعترف لنفسه بأن الإسلام لا ينتج حضارة، سيظل يعتقد بأن المشكلة ناجمة عن خيانة المسلمين للإسلام. فكان مَثَله كمثل رجل يظهر له معبوده في رؤيا فيعطيه مصباحاً مقدساً ويوهمه بأنه مصباح منير لا يأتيه عطب أو عطل من كل جانب، فيأخذه الرجل منه بخشوع شديد وامتنان زائد، فإذا جاءه الليل وأراد الرجل أن يستضيء به من دهمة الليل، ما أضاء المصباح لعطل فيه. فلما سئل الرجل في ذلك أجاب: ليس العيب في المصباح، العيب في عيني العشواء التي لا تبصر في الليل، وليس الرجل في الحقيقة أعشى وإنما هو مبصِرٌ لم يعشَ.
وليس هذا وحسب، فإنه إذا افتُرض ههنا أن رحلته لم تكن هروباً من مواجهة الزيف.. إذا افترض أنها لم تكن هروباً من محاربة إبليس المهيمن على داره ، وكانت سعياً في طلب العلاج لداره لا لنفسه، وافترض أن طلب العلاج خارج الإسلام لا يتناقض مع فكرة عظمة الإسلام، فإنه لن يكون متاحاً تفسير استعداده لتحقيق حلمه بالرحلة إلى دار الجبل (دار الكمال) بعشق المتصوفة الغائبين، وأحلامهم المخدرة بأفيون الوهم، وهو المسلم الغيور الذي يؤمن إيماناً لا يتقلقل بأن الكمال لله وحده !
„ فابتسمت قائلاً بنبرة ذات مغزى: الكمال لله وحده ".
فما دام الكمال لله وحده، فلماذا يسعى الرحالة المسلم في طلب الكمال؟ أفي نفسه توق إلى أن يصير مثل الله؟ لكن الكمال في الإسلام، ولو رامه بشر، محال؟ إذن فما جدوى السعي والمخاطرة؟
إن فكرة الكمال لم تكن غائبة عن أذهان البشر عبر التاريخ. ولا زالت حية في بعض العقائد كالبوذية، وهي تظهر بوضوح في تعاليم المسيح وفي وصاياه حيث وضع المسيح مبادئ أخلاق، وهو على الجبل يعظ الناس، إذا حققها الإنسان في حياته بلغ درجة الكمال. وهو القائل:
„ فكونوا أنتم كاملين كما أنّ أباكم الذي في السموات هو كامل".
الكمال هو الدرجة القصوى التي يمكن أن يصل إليها المسيحي بالزهد والتبتل والتهدج والعبادة وممارسة الفضائل التي نصت عليها موعظة الجبل. وفي تاريخ سير القديسين من الرهبان الأقباط والسريان أن بعضاً من هؤلاء بلغ درجة الكمال فلقب بالكامل. ولكنّ الإسلام ليس كالمسيحية. الإسلام يخلو من فكرة الكمال. قد يرد في الإسلام كلام عن عصمة الأنبياء، بيد أن العصمة ليست الكمال. وقد يرنو المتصوفة المسلمون إلى الكمال، ولكن المتصوفة في حقيقتهم لا يمتّون إلى الإسلام بنسب قريب، أو يخالفون عنه بتعبير آخر.
فلما كانت فكرة الكمال تقتضي الزهد، وفكرة الزهد أيضاً لا تشتمل عليها عقيدة المسلمين القائمة على ركنين القرآن والحديث، باستثناء عقيدة المتصوفة منهم - وعقيدة هؤلاء في حقيقة الأمر أيضاً لا تنتمي إلى عقيدة المسلمين انتماء صحيحاً كما سبق القول في هذا - ولمّا كان قنديل صار من الزاهدين:
" … ولما هممت بالذهاب تساءل (شيخ الغروب): ما فائدة الدنانير التي تكتنزها حول وسطك؟
رجعت إلى محطّ القافلة فأودعت الدنانير إحدى الحقائب. وقال لي صاحب القافلة: نحن ذاهبون فجر الغد. فقلت دون مبالاة : إني باق ".
فقد حقّ التساؤل: أيكون قنديل الرحالة ترك الإسلام أم عقّه ؟
فإن المسلم الحقيقي لا يسعى إلى أن يكون كاملاً مثل الله، ولا يتخذ سبيلاً إلى الكمال من الزهد بمتاع الدنيا على طريقة المتصوفة والرهبان الذين يستجيبون لما أوصى به المسيح: „ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم „. فإن فعل فقد وافق عقائد المتصوفة والمسيحيين والبوذيين وغيرهم من الملل وصار منهم.
لكن الرحالة لا يلحظ أنه يعق الإسلام ويفارقه بزهده وسعيه نحو الكمال. سيظل في نفسه مؤمناً بأنه مسلم حقيقي حتى آخر محطة من محطات رحلته. ها هو يقرأ الفاتحة قبيل انطلاقه مع القافلة إلى دار الجبل مثل كل مسلم ملتزم بدينه:
"وفكرت في ذاتي وفيمن خلّفت وفيما قد يصادفني من أسباب تحول دون عودتي … فخطر لي خاطر، وهو أن أعهد بدفتر رحلتي إلى صاحب القافلة ليسلمه إلى أمي، أو إلى أمين دار الحكمة… وقبل الرجل القيام بالمهمة، فنفحته بمائة دينار، وقرأنا الفاتحة…“.
وها هو يحلم بالعودة من دار الجبل إلى دار الإسلام مصلحاً:
" وأرجع إلى عزلتي، وأنا أتخيل اليوم الذي أسلط فيه قواي الكامنة على كل معوجّ في وطني، لأُنشئه من جديد مقاماً صالحاً لقوم صالحين ".
وهو إذ يحلم بتقويم كل معوجّ في وطنه بعد عودته إليه، لا يفكر بعواقب إقدامه في وطنه على تقويم ما في وطنه من اعوجاج. وكأن أبناء وطنه ينتظرون عودته بفارغ الصبر ليصلح لهم ما فسد من أحوالهم بأفكار ونظم مستعارة من ديار أخرى يتناقض معظمها مع نظام داره، دار الإسلام.
إنها السذاجة الرومانسية تحلم بتغيير أحوال الوطن وفق مبادئها وتصوراتها الخاصة دون أن تحسب حساباً لما سينوبها من شدائد وويلات، إذا حاولت أن تحدث تغييراً في دارها التي يهيمن عليها الركود ويتحفز فيها التطرف لكل جديد أو بدعة!
قد يكون قنديل شجاعاً شهماً يندفع إلى التضحية بروحه في سبيل تحقيق أهدافه النبيلة في وطنه، فينال المجد، ولكن كيف يطاوعه قلبه على أن يعرّض زوجته سامية وأولاده مصطفى وحامد وهشام والوليد المنتظر للشدائد – وربما للهلاك - باصطحابهم معه إلى دار الإسلام وهي دار لا تفتح ذراعيها للمصلحين حاملي مشاعل التنوير وأدوات التقويم ؟!
„ ووعدت بالعودة إلى الحلبة عقب الرحلة، على أن أصطحب زوجتي وأبنائي إلى دار الإسلام، فأنسخ كتاب الرحلة وألقى الباقين على قيد الحياة من أهلي، ثم نرجع إلى الحلبة ".
ومما هو خليق بالتنويه به في آخر المطاف أنّ امرأة قنديل السابقة (عروسة) " بفضل ما عانت في حياتها من آلام " نالت نعمة الدخول إلى دار الجبل، دار الكمال التي يعتمد أهلها في عيشهم على قوى النفس ولا يستعملون حواسهم وأطرافهم:
" الدار هناك تقوم على هذه القوى، وبها شارفت الكمال… هناك دار الجبل بالعقل والقوى الخفية ، يكشفون الحقائق، ويزرعون الأرض، وينشئون المصانع، ويحققون العدل والحرية والنقاء الشامل ".
وهو أمرٌ يستدعي التساؤل: فإذا كانت عروسة بفضل المعاناة تحقق لها زيارة دار الجبل، فلم تحتج إلى أن تُعدَّ نفسها للدخول إليها على يد الشيخ الروحاني، فلم احتاج قنديل إلى أن يُعدّ نفسه على يدي الشيخ للدخول إلى دار الجبل“ :
„ وعدت إلى مجلسي تحت نخلة وشرعت في التجربة. صارعت التركيز وصارعني. والتحمت في معركة حامية مع صور حياتي الماضية. تغزوني بالحب والوفاء، وأطاردها بمرّ العناء، وتمرّ الأيام مليئة بالعذاب والعزم والأمل. وعند بداية كل درس، قبل الغناء والترديد، يوصينا بحب العمل وإهمال الثمرة والجزاء ويقول:
بذلك توثق المودة بينكم وبين روح الوجود. كما يوصينا بالتركيز قائلاً: إنه مفتّح أبواب الكنوز الخفية ".
لمَ وقد عانى في حياته مثلما عانت عروسة؟ لقد خانه الدين، وخانته حليمة، وخانته أمه، وغنم الحاجب منه حليمة حبه الأول، وغنم ديزنج امرأته عروسة، وضاع أبناؤه من امرأته عروسة أو هلكوا، وفقد شبابه في سجن تحت الأرض في دار الحيرة قضى فيه عشرين عاماً في عذاب وذهول !
انتهى الكتاب وتليه شواهد وإيضاحات من المؤلف
******************
(1) يُقال إنّ ابن بطوطة " تسمّى باسم أمه بطوطة وهي في الأصل فطومة " انظر الويكيبيديا. واسم صاحب القافلة الأولى (القاني بن حمديس ) من الأسماء التي يوحي لفظها بأن صاحبها من أهل المغرب.
(2) تحدث نجيب محفوظ إلى رجاء النقاش عن روايته أولاد حارتنا فقال:
" ربما تكون أولاد حارتنا أكثر رواياتي إثارة للأزمات والجدل، وهذا الأمر لا يتفق مع حسن النية الذي كان وراء كتابتي لهذه الرواية. وأعترف بداية أنني اخترت أسماء الشخصيات موازية لأسماء الأنبياء، وجعلت من المجتمع انعكاساً للكون، وكنت أريد بذلك أن تكون القصة الكونية غطاء للمحلية. وبلغ من حسن نيتي أنني فكرت في كتابة مقدمة للرواية أشرح فيها وجهة نظري، لأنني كنت أحسب أن من يقرأها سوف يقرأها قراءة صحيحة. ولم أقدر أن حسن النية عندي سوف ينتهي بوجود مفاتيح سهلة في أيدي الجماعات المتطرفة للطعن في الرواية وصاحبها. كنت أظن أن الناس ستقرأ الرواية من منطلق هذه الرؤية الشاملة، وهل هذه الشخصيات التي تقدمها الرواية هي شخصيات خيرة أم شريرة؟ وهل تقوم بأدوار ثانوية؟ فإذا كانت تلك الشخصيات خيرة، وتقوم بأدوار البطولة، فإن التفسير الموضوعي يؤكد أن مؤلفها ليس ضد الأنبياء، وليس لديه النية للإساءة إليهم. وللأسف فوجئت بتفسيرات غريبة للرواية، فقد طابقوا بين الأنبياء وأبطال الرواية، لدرجة أن أحدهم قال لي إنني جعلت أحد الأنبياء " بيحشش وماشي حافي" ودخلنا في جدل عقيم وصل حد الإسفاف، ولم أحسب مطلقاً أنني سوف أتعرض لشيء من ذلك عندما كتبت الرواية. المغزى الأساسي لرواية أولاد حارتنا هو أنها حلم كبير بالعدالة وبحث دائم عنها، ومحاولة للإجابة عن سؤال جوهري: هل القوة هي السلاح لتحقيق العدالة أم الحب أم العلم؟ والذي دفعني لكتابة هذه الرواية، وهي أول رواية أكتبها بعد قيام ثورة يوليو، هو تلك الأخبار المتناثرة، والتي ظهرت في تلك الفترة – حوالي عام 1958 – عن الطبقة الجديدة التي حصلت على امتيازات كبيرة بعد الثورة، وتضخمت قوتها.. حتى بدأ المجتمع الإقطاعي الذي كان سائداً في فترة الملكية يعود مرة أخرى، مما ولد في نفسي خيبة أمل قوية، وجعل فكرة العدالة تلح على ذهني بشكل مكثف، وكانت هذه هي الخميرة الأولى للرواية ".
ويروي عن استفادته من الكتاب المقدس فيقول:
„ والحقيقة أنني عندما وضعت لنفسي برنامجاً للتثقيف الذاتي في بداية حياتي، كان جزء كبير من هذا البرنامج يتعلق بدراسة الديانات الكبرى، وتاريخ الحضارة، والفكر الإنساني. لذلك قرأت الكتاب المقدس بإمعان، وكان من مصادري التي اعتمدت عليها في كتابة رواية أولاد حارتنا، كما أنني اقتبست منه قصة أيوب التي تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي قام ببطولته عمر الشريف. وهناك اختلافات كبيرة بين قصة أيوب في الكتاب المقدس وقصة أيوب التي كتبتها أنا، إلا أن المصدر الرئيسي الذي أوحى بكتابة القصة هو ما جاء عنها بالكتاب المقدس" .
وفي تضاعيف الحديث يذكر أسباب الانقطاع عن الكتابة، كما يذكر سببين لجنوح الكاتب إلى استلهام موضوعاته من الماضي:
„… كلما هممت بالشروع في الكتابة يواتيني شعور داخلي بأن الموضوع قديم، وسبق أن عالجته في أعمال سابقة، أو أن المشكلة تافهة ولا تستحق الكتابة عنها.. هذا على الرغم من أن المجتمع الآن ملئ بالمشكلات التي تصلح في أغلبها للمعالجة الفنية، لكني كما قلت أشعر أنها مشكلات قديمة. فعندما قدمت شخصية (محجوب عبد الدايم) في القاهرة الجديدة أصيب الناس بالدهشة، وكانت أشبه بالاكتشاف. أما الآن فيوجد مليون محجوب عبد الدايم، ولم تعد شخصيته تثير الاستغراب أو الدهشة. ولذلك يلاحظ القراء أن كل إنتاجي – تقريباً - خلال الفترة الأخيرة تدور أحداثه في الزمن الماضي، ولا يأخذ صفة المعاصرة، وذلك في أعمال: صباح الورد، قشتمر، أو الفجر الكاذب.
سبب آخر لحالة الانقطاع هذه، وهو سبب عام في مجمله، يتمثل في أن الأديب عندما يتقدم به العمر، ينحصر تفكيره في الزمن والموت وقضايا فلسفية، وتشعر في كتاباته بالشجن والرغبة في العودة إلى الماضي.
(3) أما عن رمزيته فيقول:
" أستطيع أن أقول وأنا مرتاح الضمير إنني قلت كلّ ما أريد قوله في أعمالي الروائية، وعبرت عن كل آرائي خلال فترة حكم عبد الناصر، والرأي الذي لم أستطع التصريح به مجاهرة أوصلته للناس عن طريق الرمز. فمن مزايا الفن الكبرى أن الفنان يمكنه أن ينقد ويعترض ويقول كل ما يريد بشكل غير مباشر، لقد كنت معترضاً على ممارسات جهاز المخابرات، والأساليب التي يتبعها، فكتبت قصة أقرب إلى الفانتازيا أسمها روبابيكيا أسخر فيها من تلك الممارسات، وسمحوا بنشرها.
(4) يروي محفوظ هذا الحدث الموجع لرجاء النقاش بشيء من التفصيل:
"كثيرون سوف يصابون بالدهشة عندما يعرفون أنني كنت من عشاق السفر، وكانت أمنية حياتي وأنا طالب في الجامعة أن أستكمل تعليمي في أوروبا، وفي فرنسا على وجه التحديد… أما أقرب فرصة واتتني للسفر فكانت بعد تخرجي في كلية الآداب والتحاقي بوظيفة في إدارة جامعة القاهرة، فقد أعلنت الجامعة عن حاجتها لمجموعة من خريجي قسم الفلسفة للسفر إلى فرنسا لدراسة اللغة الفرنسية بمدرسة الترومال… ومن فرط ثقتي في الحصول على هذه البعثة جهزت ملابسي وذهبت إلى أستاذ في كلية الآداب حصل على الدكتوراه من فرنسا لأسأله عن أنسب الأماكن للإقامة في باريس، وعن كيفية التعامل مع الفرنسيين، لذلك كانت المفاجأة قاسية عندما لم أجد اسمي بين العشرة المختارين للسفر، وكدت أجن. اكتشفت أن إدارة البعثات اشتبهت في اسمي، وظنّت أني قبطي، وبما أن هناك اثنين من الأقباط في قائمة المختارين للسفر، فقد رفعوا اسمي منها اكتفاء بهما.
(5) اتُّهم نجيب محفوظ بمداهنة السلطة، فقال يدفع عن نفسه هذه التهمة:
"وفي رواية ميرامار تعرضت بصراحة لمشكلة الاتحاد الاشتراكي وصراع الطبقات في المجتمع، وتعرضت كذلك للديكتاتورية، وانتقدتها بشدة. ومع ذلك ظهرت كتابات نقدية تهاجمني وتتهمني بنفاق السلطة في تلك الأيام، وهؤلاء لا يعرفون أنني كنت أكتب الرواية، ثم أضع يدي على قلبي خشية الاعتقال. ثم ماذا يريدون مني بعد كل تلك الانتقادات الصريحة التي وجهتها إلى السلطة وكشفت فيها عن أخطاء خطيرة؟ وهي أمور ما كنت لالتفت إليها لو كان في نيتي نفاق الحكام.
(6) القنديل هو المصباح المنير. فلا تخفى دلالة إطلاقه على الرحالة الذي خرج يسعى في طلب ما ينير عتمة داره. والرحلة سعياً إلى اقتباس ما ينير من العلوم والنظم الاجتماعية، حركة تاريخية شهدتها مصر. بدأت عقب أن استولى محمد علي باشا على كرسي السلطة فيها. وفي رحلة ابن فطومة خيط رفيع يشدها إلى هذه الحركة .
(7) سيتبين للقارئ فيما بعد تخبط ابن فطومة في تحديد هدفه الأول من رحلته.
(8) لا يخطئ المرء إذا عدّ دار المشرق والحيرة رمزاً للعالم الذي يسمى اصطلاحاً بالعالم الثالث، وعدّ دار الحلبة رمزاً للعالم الأول الولايات المتحدة خاصة، وعدَّ دار الأمان رمزاً للعالم الثاني، الاتحاد السوفياتي سابقاً.
(9) مغاغة الجبيلي شيخ ابن فطومة. لقبه الجبيلي منحوت من الجبل، أو مأخوذ من الثلاثي (جَبَلَ) وللجبل عند محفوظ معنى قدسي. أولى الشرائع التي تدعى سماوية نزلت على موسى وهو على الجبل. والثلاثي جبلَ على معنى خلق من الطين، والجابل هو الله. وشخصية الجبلاوي في رواية أولاد حارتنا، تمثل الله الجابل الخالق، وشخصية جبل فيها تمثل شخصية النبي موسى وإن نفى محفوظ أن تكون تمثل شخصية موسى.
(10) روح الإسلام: مصطلح غامض واسع الجلباب. فإن تتبعه الدارس في كتابات محفوظ غير الروائية، في مقابلاته، وفي مقالاته التي كان ينشرها في جريدة الأهرام، فلن يعثر لها على معنى محدد يضبطه بسبب موقفه الملتبس غير الواضح من الدين.
ما هي، روح الإسلام؟
لكلٍّ أن يزعم أنها حقيقة الإسلام، ولكن ما هي حقيقة الإسلام؟ أين توجد؟ أفي القرآن؟ أفي الأحاديث النبوية؟ أفي تاريخ الإسلام وسير شخصياته؟ أفي اجتهادات المجتهدين وآراء أصحاب المذاهب والبدع؟ أم توجد في كل هذه الأجزاء مجتمعة؟ فإن كانت روح الإسلام أي حقيقته مجتمعة في كل هذه الأجزاء من الإسلام، فما هي؟
يجيب محفوظ في إحدى مقالاته المنشورة في جريدة الأهرام عن هذا السؤال الذي لم يوجه إليه، فيقول:
" إن الإسلام دين إنساني شامل، يشع مبادئ خالدة، كالحرية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والتسامح، والحب المكين للعلم والعمل، إلى اتسامه بالاعتدال وتجانبه عن المغالاة، ودعوته المؤثرة إلى دار السلام. مقالة إعادة النظر. الأهرام. 1990. 5. 10“.
فهذه إذن هي حقيقة الإسلام، أو روحه: الإنسانية، حب العلم والعمل، الاعتدال، حقوق الإنسان، الحرية… الخ كما أرادها محفوظ أن تكون. وكأن نجيب محفوظ بتعريفه هذا لحقيقة الإسلام، يطوِّع الإسلام لإخراج فئة من المسلمين منه (المتطرفين) بنفس الأسلوب الذي تطوّع به هذه الفئةُ الإسلامَ لإخراجه هو من الإسلام. لكنه لن يلبث أن ينقض نصف هذا الذي قاله في تعريف روح الإسلام في حديثه إلى رجاء النقاش:
„ وفي اعتقادي أن تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها طبقاً لمفهومهم أمر غير متاح في ظل الظروف الحالية. فالأمم تعيش الآن على أساس مبدأ القوميات، ومن ثم فمن الصعب أن تجعل من مصر دار الإسلام وتطبق الشريعة على وطن يساوي بين جميع أبنائه على اختلاف دياناتهم وألوانهم وأشكالهم. فدار الإسلام الآن غير موجودة، وحل محلها وطن يخطو نحو القرن الحادي والعشرين، وحاول أن يعيش العصر بكل ما فيه من متغيرات. وإذا نظرت إلى الدستور المصري فستجد أن نسبة عالية من مواده على الأقل مستمدة من روح الشريعة الإسلامية، أي أننا نعيش في دولة إسلامية، ولكنها دولة مدنية عصرية. وإذا قالوا إن الدستور لا يأخذ بالحدود التي نص عليها القرآن الكريم، أقول لهم إن سيدنا عمر أوقف العمل بأحكام دينية صريحة في ظرف محدد. وهذا يدل على أن النص أحياناً يكون موقوتاً أي مرتبطاً بظروف معينة، وفي العصر الحديث من الممكن أن نجد بدائل عصرية دون الإساءة للنص الأصلي. ففي أيام الرسول – مثلاً - كان يطبق حد السرقة بقطع يد السارق، وكانت هذه القاعدة مقبولة في ظل الظروف التي كان يعيشها المجتمع الإسلامي الأول. فلا توجد سجون، كما أن لغة القوة هي السائدة، فكان قطع اليد هو الأسلوب المناسب لزجر السارق، الآن توجد بدائل لهذه العقوبة يمكن أن تحقق نفس الهدف مثل السجن والغرامة. وعندما تنظر أيضاً إلى حد آخر من حدود الإسلام وهو الزنى، تجد أنك إذا طبقته كما هو في الشرع ، بوجوب وجود أربعة شهود ثقات، فمن الصعب على هذا الأساس أن تجد زانياً متلبساً بجريمته، وقد يزني شخص في ميدان التحرير، ولا يشهد عليه أربعة ثقات، فلا تنطبق عليه العقوبة. والنص القرآني الذي يقول بجلد الزاني ورجم المحصن الغرض منه هو التخويف وليس العقاب. وعلى ذلك فأنا أميل إلى الرأي القائل بأن البدائل المدنية الحديثة يمكن أن تحل محل الحدود دون أن يطعن ذلك في النص أو ينتقص منه. وخلاصة القول إن الديمقراطية هي الحل للخروج من أزمة التطرف والإرهاب. أنا لست ضد حكم الإسلام ، ولو وافقت أغلبية الشعب على تطبيق الشريعة كما يريد المتطرفون فسوف أقبل، لأنني إذا رفضت في هذه الحالة لا أكون ديمقراطياً. فالديمقراطية نزول على رأي الأغلبية، والدين الإسلامي دين مرن يحتوي على كل المبادئ الحديثة، الحرية والديمقراطية والاشتراكية ويحث على العمل والإنتاج والابتكار. الإسلام دين كامل وهو أيضاً إنساني وعالمي، فهو ليس مثل ديانة "الشنتو" اليابانية التي تقول للياباني : „ جزيرتك أعظم جزيرة، وملكك أعظم ملك، ولا بد أن تعمل لتضع جزيرتك فقط وملكك فقط في المكانة اللائقة" . والإسلام دين إنساني مفتوح للجميع، ويتكلم بكل لغات العالم ".
فإن ادعاء محفوظ هنا أن الإسلام دين كامل، ثم اعتقاده بأن تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها أمر ليس متاحاً، قضية فاسدة في ميزان العقل؛ لأن الشريعة الإسلامية هي جزء مهم من الإسلام جزء مكمل له، فكيف يكون الإسلام كاملاً يستوعب كل هذه القيم وقد أسقط منه جزءاً؛ حين أضحى هذا الجزء غير قابل للتطبيق في عصر من العصور؟!
لا يفاجأ الدارس لأدب محفوظ بمثل هذا التناقض، ففي سيرته الكثير من المتناقضات: فهو إذ يرفع شعار حرية التعبير، سيتولى منصب مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية، وهو إذ يدافع عن حق سلمان رشدي، سيجرده من هذا الحق بعد قليل، وهو إذ يذم سياسة عبد الناصر، سيرثي عبد الناصر رثاء ولا رثاء الخنساء لأخيها صخر، وهو إذ يرفع شعار الديمقراطية، سيطالب للإسلاميين أعداء الديمقراطية الألداء بحق تشكيل أحزاب سياسية، وهو إذ يطالب بحق الإسلاميين في تشكيل أحزاب سياسية، لن يرى للأقباط المسيحيين حقاً في تشكيل أحزاب سياسية… الخ.
أضف إلى ذلك أن مطالبته بالسماح للمتطرفين الدينيين العنصريين بإقامة أحزاب سياسية، باسم الديمقراطية، ليس يدل على فهمه الناقص لحقيقة الديمقراطية وحسب، بل يدل أيضاً على إحساسه بخطر هذه الجماعات المتطرفة على حياته، فيدفعه الخوف منها إلى مداهنتها بالمطالبة لها بحق تشكيل أحزابها وبحقها في تولي السلطة.
(11) لعلها ثورة أكتوبر الشيوعية.
(12) اندفاعه إلى الزواج في داره ودار المشرق ودار الحلبة كأنه تنفيذ لوصايا كثيرة تحض المسلم على الزواج وردت في الأحاديث من مثل: „ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج…“ مما يؤكد التزامه بدينه، ولكن التزامه بدينه لن يعصمه من أن يحلم بمدينة فاضلة يحكمها نظام يهدم أركان دينه الأساسية.
(13) يروى أن الشيخ محمد عبده لما زار باريس انبهر بحضارتها كما انبهر قنديل بطل الحكاية بحضارة دار الحلبة، فأطلق عبارته المشهورة في فضاء المسلمين الواسع: „ ذهبت للغرب فوجدت إسلاماً ولم أجد مسلمين، ولما عدت للشرق وجدت مسلمين ولكن لم أجد إسلاماً " فنسب كل خير وفضيلة إلى دينه، وادعى أنه أسّ متين إذا شيّد قامت عليه حضارة سامقة أين منها حضارات الأمم جميعاً، ولم يسأل نفسه لماذا عجز دينه، وهو إلهي وفيه كل هذا الذي ادعاه له من خير ونفع دنيوي وصلاح، عن أن يبني حضارة للمسلمين ينعمون برخائها، ولم تعجز العلمانية التي نشأت في أحضان المسيحية والبوذية والوثنية والتي ليست إلهية أن تبني حضارة لم يستطع إلا أن ينبهر بها؟ كيف قدر الإنسان على أن يبني حضارة في باريس، ولم يقدر الله على أن يبني حضارة مثلها في دار الإسلام؟!
يرد نجيب محفوظ الذي لا يخفى تأثره مثل العقاد وكثيرين من مفكري جيله بآراء الشيخ محمد عبده: "لم نفقد الأمل بعد " وتتردد هذه العبارة على لسان بطله ابن فطومة، ولكن ماذا ينفع الأمل إذا كانت الأداة المنوط بها بناء الحضارة مفقودة؟هل كان نجيب محفوظ الذي أذن لعرفة في أولاد حارتنا بأن يقتل الجبلاوي، يجهل أن رأي الشيخ محمد عبده بأن الحضارة في داره لا تقوم إلا بالإسلام، رأيٌ ليس سديداً ؟! أيعقل ألا يكون محفوظ أدرك الحقيقة حقيقةَ أنّ الحضارة لا ينهض بها الدين؟ إذ لو كان الدين ينهض بها، فكيف نهض الغرب بحضارته والغرب لا يحكمه الدين؟
وما زال المسلمون يتخبطون في الإجابة عن سؤال الحضارة. لم يستطيعوا إلى اليوم أن يتمثلوا هذه الحقيقة البسيطة وهي أن الدين ليس من شأنه أن يبني حضارة. الحضارة تستلزم العقل.. على قواعد العقل تقوم الحضارة. فأما من يدعي من المسلمين من أمثال محمد عبده – وقد يمالئ نجيب محفوظ محمد عبده في بعض ادعائه - أن الإسلام، دون غيره من الأديان، دين عقل؛ ولأنه كذلك فهو الأداة لبناء الحضارة، وهو الحقيق بأن يحكم ويسود كل مرافق الحياة، فهو واهم. ووهمه ناشئ من تعلقه العاطفي بدينه لا من رجاحة عقله، ولا من ضرورات الواقع. وفي هذا الصدد يخاطب فرح أنطون الشيخَ محمد عبده في المناظرة قائلاً:
„ إن القول بأن الدين دين عقل قول مناقض لكل دين وكل عقل؛ لأن العقل مبني على المحسوسات ولا يعرف نواميس غير نواميسها، والدين بني على الغيب..“.
ويضيف:
„ الدين هو الإيمان بخالق غير منظور وآخرةٍ غير منظورة ووحي ونبوءة ومعجزات وبعث وحشر وثواب وعقاب وكلها غير محسوسة وغير معقولة ولا دليل عليها غير ما جاء في الكتب المقدسة. فمن يريد فهم هذه الأمور بعقله ليقول إن دينه عقليّ ينتهي إلى رفع ذلك كلّه لا محالة ".
والغريب أن بين المسلمين من وعى هذه الحقيقة، غير أنه يأبى إلا أن يحكّم الإسلام في شؤون دنياه، وهو يلحظ – مثل نجيب محفوظ - التناقض بين الإسلام وبين هذه الحقيقة، لكن هذا التناقض مع ذلك لا يؤذي عقله. وإنه لمن المؤسف حقاً، أن يسمع المرء في أيامنا أصواتاً تتعالى من صفوف اليساريين المسلمين، تدعو إلى الجمع بين الشريعة الإسلامية والسياسة، بدلاً من أن تدعو إلى فصل الإسلام عن السياسة، والحل في الفصل. وتتعالى أيضاً من صفوف بعض الليبراليين تدعو إلى الجمع بين الشريعة والديمقراطية، والجمع بينهما كالجمع بين النار والماء.
(14) في هذا الصدد يقول نجيب محفوظ في محاولة فكرية منه غايتها إفهام المتطرفين المسلمين أن حكومة مصر حكومة إسلامية، فلا يجب بالعنف أن يسقطوها:
„ أختلف مع الذين يرون أن الحكومة المصرية علمانية ولا دينية، فلا توجد حكومة تقف ضد الدين باستثناء الحكومة الشيوعية الصريحة، بل هذه الأخيرة تنازلت في فترة لاحقة عن عدائها للدين. من هذا المنطلق أرى أن حكومتنا تنطبق عليها صفة " الحكومة الدينية" لأنها تهتم بتعليم شعائر الإسلام وتقيم المساجد وتعتني بها، وتخصص وزارة كاملة مهمتها الوعظ والإرشاد ونشر الإسلام. فكيف نقول إن هذه الحكومة ليست إسلامية؟ حكومتنا ذات نظام إسلامي متطور ومتحرر ويعي روح الدين، ومن ثم فإن اتهامات المتطرفين لها بالكفر ليس لها سند… وأختلف أيضاً مع فكرة (رجل الدين الحاكم) الذي يأمر فيطاع ولا يرد له أمر. فهي فكرة خطيرة وضد العقل والعصر، بل وضد الدين „.
ولكن محفوظ في رحلة ابن فطومة سيجعل الشيخ مغاغة الجبيلي يؤمن بالعقل وحرية الاختيار، ويثور بالحكام، وسيضع مقولة على لسانه هي: " الإسلام اليوم قابع في الجوامع لا يتعداها إلى الخارج" وهي مقولة موافقة تماماً لمقولة المتطرفين التكفيريين الذي يتهمون الحكومة (الخارج) بأنها علمانية بعيدة عن الإسلام. فلماذا يلوم التكفيريين إذا كان المجددون العقلانيون – ويظهر محفوظ نفسه واحداً منهم - يرون أيضاً أن الإسلام (الحقيقي من وجهة نظرهم) ليس مطبقاً في دار الإسلام؟ ويرون أن من واجب الحكومة أن تطبقه، أو أن توفق بين الإسلام والسياسة، لأن الإسلام دين ودنيا، وأن يكون الإسلام ديناً ودنيا فنعمة - في رأي محفوظ أيضاً - أسبغها الله على المسلمين؟
يقول في نعمة الإسلام بما هو دين ودنيا:
„ ومن نعم الله علينا أن ديننا دين دنيا كما أنه دين آخرة، يدعو إلى تعمير الأرض، ويقدس العلم، ويعد العمل عبادة، فضلاً عن أنه رحمة للعالمين بما أعلن من حقوق للإنسان، وما قرر من مساواة بين أهل الديانات. وما عصرنا إلا عصر العلم والعمل وحقوق الإنسان، فمن الحكمة أن نجعل من الدين منطلق تربيتنا ونهضتنا، وفي ذلك ما يضمن خلق إنسان صالح يملك من مقومات الوجود ما يقتضيه الوجود الإنساني المستنير الشريف ". الأهرام. مقالة الدين في العصر الحديث 9.6. 1988.
(15) يوافق رأي هذا الفيلسوف في الجهاد رأي الفيلسوف نيتشه.
(16) فكرة انتصار العلم هي الفكرة التي انتهت إليها رواية أولاد حارتنا تمثلها شخصية عرفة العالِم قاتل الجبلاوي رمز الدين أو الله، أو قاتل خادم الجبلاوي الذي يمثل الدين، والدين خادم الله. فإذا كان الإسلام في اعتقاد محفوظ يحض على العلم، فإن قتل عرفة للجبلاوي أو خادمه، سيكون قتلاً لإله دينٍ يحض على العلم.
(17) مرافقة المرشد السياحي للرحالة قنديل في دار الأمان، تماثل في صورتها صورة المرشد السياحي لميخائيل نعيمة في زيارته للاتحاد السوفياتي التقطها في كتابه (أبعد من موسكو ومن واشنطن) كما أن فكرة وجود نظام عظيم أبعد من الحضارة المادية القائمة في روسيا الشيوعية وفي الولايات المتحدة كما وردت في كتاب ميخائيل نعيمة، تماثل فكرة نجيب محفوظ في رحلة ابن فطومة الذهنية إلى دار الكمال والسعادة وقد شخصها قنديل العنابي، الذي لم يجد كمالاً في كل الديار التي زارها، حتى دار الحلبة التي هي أفضل هذه الديار، والتي وافق زوجته على اتخاذها وطناً ثانياً له، لم تخلُ من كثير مما ينقص من كمالها. ولا يجمل بالمرء أن يحمل هذا التماثل على محمل التأثر، أو الاقتداء. فلكل من الأديبين فلسفته التصوفية الخاصة به.
(18) يرى محفوظ مع من يرى أن الحضارة المادية مهما ترتقِ بالإنسان، فإنها غير قادرة على اقتلاع جذور البؤس والشقاء والألم والشكوى من قلبه. سعادة الإنسان لا تتحقق بالكامل إلا في عالم المثل، وعالم المثل هو حلم قنديل، هو دار الجبل. وهذه الفكرة هي نواة رحلته إلى دار الجبل:
„ هناك رأي يقول إن السعادة البشرية لم تتحقق من خلال التقدم، وإن الإنسان في هذا العصر ما زال يشعر بالتعاسة رغم التطور الهائل الذي وصل إليه والرفاهية الرهيبة التي يعيش فيها. وفي رأيي أن الإنسان لا يرضى أبداً عن واقعه ولا يقنع بما حققه مهما كان، وسيظل يحلم بواقع أفضل، فهذه هي طبيعته، وفي الفجوة بين الحلم والواقع، سيظل يتألم ويشكو ".
(19) يعارض قاسم أمين في كتابه ،المرأة الجديدة، رأي سامية فيقول:
„ كذلك إذا نظرنا إلى حالتهم العائلية (حالة المسلمين في العصور الأولى) نجد أنها مجردة عن كل نظام حيث كان الرجل يكتفي في عقد زواجه بأن يكون أمام شاهدين ويطلّق زوجته بلا سبب بأوهى الأسباب ويتزوج عدة نساء بدون مراعاة حدود الكتاب. كل ذلك كان واستمر إلى الآن على ما هو مشهور، ولم يفكر أحد من الحكام أو الفقهاء في وضع نظام يمنع ضرر انحلال روابط العائلة. وأقل ما كان يلزمهم لرفع ذلك الخلل أن يقرروا مثلاً أن إيقاع الطلاق وعقود الزواج والرجعة لا بد أن تكون أمام مأمور شرعي حتى لا تبقى هذه الشؤون موضعاً للرّيب ومحلاً للشبهة ومثاراً للنزاع والشقاق. أين هذه الفوضى من النظامات والقوانين التي وضعها الأوروبيون لتأكيد روابط الزوجية وعلاقات الأهلية. بل أين هي من القوانين اليونانية والرومانية التي لم تغفل في جميع أدوارها عن أهمية العائلة وشأنها في الهيئة الاجتماعية؟ فأي شيء من هذا يمكن أن يكون صالحاً لتحسين حالنا اليوم؟ ".
(20) كتاب كليلة ودمنة. تحقيق عبد الوهاب عزام وطه حسين.
(21) في مقالته، الاحترام، المنشورة في جريدة الأهرام 25. 11. 1993، ينزه محفوظ الإسلام ويضع الوزر على أكتاف المسلمين. وهي فكرة قد تلقنها المسلمون من أوائل شيوخهم الذين برزوا في ميدان ما يدعى بالإصلاح الديني – السياسي، في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. والدين عند هؤلاء الشيوخ لا ينفك عن السياسة. من أشهر هؤلاء الشيوخ: الطهطاوي، والأفغاني، ومحمد عبده، والكواكبي... يقول:
" إن بعض الشعوب الإسلامية تحكم بطريقة بعيدة عن روح العصر، وحقوق الإنسان، بها تتعرض للاستهانة والعدوان، والإدارة فيها تتسم بالعجز والفساد بالإضافة إلى تأخرها في مجالات العلم والثقافة. وتلك حال يسأل عنها المسلمون لا الإسلام، فهو دين شورى ويحترم الإنسان، ويقدس الحرية والعدل والعلم والعمل ".
وهو رأي فيه ظلم للمسلمين؛ لأنه يتهمهم بأنهم أغبياء! إنهم أغبياء لأنهم يعلمون أن خيرهم في الإسلام، ومع ذلك فإنهم يبتعدون عن الإسلام. أو هو اتهام لهم بأنهم جهلاء؛ لأنهم لا يعلمون بأن في الإسلام خيرَهم فيبتعدون عنه. وهذا الرأي من محفوظ يردعه الواقع ولا يقره عليه، فإن المسلمين إذا خرجوا من دار الإسلام، إلى ديار العلمانية والديمقراطية أبدعوا وأسهموا في الحضارة مثل أبناء هذه الحضارة إلا الذين سيطر الإسلام على عقولهم فإنهم يحيون في هذه الديار بأجسادهم دون أرواحهم، ومنهم من يصبح خطراً يتهدد العلمانية وغيرها من قيم الحداثة، ومنهم من يتحول إلى إرهابي قاتل أبرياء. فإذا كان المسلمون _ سامية زوجة قنديل في حكاية ابن فطومة مثالاً - وهم في ديار العلمانية والديمقراطية، يبدعون ويسهمون في الإعمار، فلماذا ليس فيهم إبداع ومنهم إسهام في الإعمار، وهم في ديار الإسلام؟
إن ما يحدث في ديار الإسلام في هذه الأيام، يثبت خطأ رأي نجيب محفوظ. فالملحوظ أن كلّ دار، إذا تراخت فيها قبضة الإسلام، تقدمت ونعم أهلها بقسط من السعادة – العربية السعودية، الإمارات، ماليزيا… أمثلة على ذلك - وكل دار منها إذا اشتدت فيها قبضة الإسلام تخلف أهلها، وشقوا وراح كثير منهم يلوب بحثاً عن دار مثل دار الحلبة في حكاية ابن فطومة لا يحكمها الإسلام تؤمن له عيشاً رضياً وكرامة.
#نعيم_إيليا (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ورقةُ الحظّ المهملة
-
هزيمة فنان مهاجر
-
الوجيز من حكاية الزوجة الضائعة
-
دوَّامةُ النّهرِ الكبير 12
-
الأخلاق بين فريدريش إنجلز ولودفيج فويرباخ
-
دوَّامةُ النّهرِ الكبير 11
-
منطقُ الجاحظ في ردِّه على النصارى
-
مُشادّة على مائدة الحوار المتمدن
-
دوَّامةُ النّهرِ الكبير 10
-
الوعي والحياة بين هيغل وماركس
-
مناظرة السيرافي والقُنَّائي
-
دوَّامةُ النَّهرِ الكبير 9
-
البعد الفلسفي لفرضية الانفجار الأعظم
-
محاورة ملحد الكريتي
-
ثالوث الديالكتيك الماركسي
-
الطعن على رأي الأستاذ منير كريم في الديالكتيك والمادية
-
دَوّامةُ النَّهرِ الكبير 8
-
الزمان بعداً رابعاً
-
سُلَّم الوجود
-
مشكلة النسبية
المزيد.....
-
كيف كسر فيلم -سينرز- القواعد وحقق نجاحا باهرا؟ 5 عوامل صنعت
...
-
سيمونيان تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم بين RT ووزارة الإعلام الع
...
-
محمد نبيل بنعبد الله يعزي في وفاة الفنان المغربي الأصيل الرا
...
-
على هامش زيارة السلطان.. RT Arabic توقع مذكرة تفاهم مع وزارة
...
-
كيف تنبّأ فيلم أمريكي بعصر الهوس بالمظهر قبل 25 عامًا؟
-
مهرجان -المواسم الروسية في الدار البيضاء- يجمع بين المواهب م
...
-
شم النسيم: ما هي قصة أقدم -عيد ربيع- يحتفل به المصريون منذ آ
...
-
فنانة أرجنتينية تستذكر ردة فعل البابا الراحل على لوحة بورتري
...
-
لوحات تتحرك.. شاهد كيف بدت هذه الأعمال الفنية التفاعلية في د
...
-
سعيد البقالي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ضيف
...
المزيد.....
-
فرحات افتخار الدين: سياسة الجسد: الديناميكيات الأنثوية في مج
...
/ محمد نجيب السعد
-
أوراق عائلة عراقية
/ عقيل الخضري
-
إعدام عبد الله عاشور
/ عقيل الخضري
-
عشاء حمص الأخير
/ د. خالد زغريت
-
أحلام تانيا
/ ترجمة إحسان الملائكة
-
تحت الركام
/ الشهبي أحمد
-
رواية: -النباتية-. لهان كانغ - الفصل الأول - ت: من اليابانية
...
/ أكد الجبوري
-
نحبّكِ يا نعيمة: (شهادات إنسانيّة وإبداعيّة بأقلام مَنْ عاصر
...
/ د. سناء الشعلان
-
أدركها النسيان
/ سناء شعلان
-
مختارات من الشعر العربي المعاصر كتاب كامل
/ كاظم حسن سعيد
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة