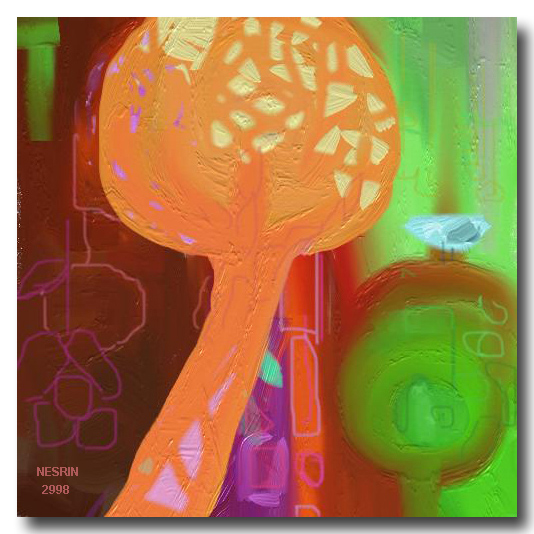|
|
مراجعة كتاب: -التأويل بين التاريخ والفلسفة- لهانز جورج غادامير/ شعوب الجبوري - ت: من الألمانية أكد الجبوري
أكد الجبوري


الحوار المتمدن-العدد: 8264 - 2025 / 2 / 25 - 00:14
المحور:
الادب والفن
سيرة تعريفية موجزة عن الكاتب؛
هانز جورج غادامير (1900 - 2002) () فيلسوف ألماني كان لنظامه في التأويل الفلسفي، المستمد جزئيًا من مفاهيم فيلهلم ديلتاي (1911-1833)، وإدموند هوسرل (1859-1938)()، ومارتن هايدغر(1889 - 1976)()، تأثيرًا كبيرًا على فلسفة القرن العشرين، وعلم الجمال، واللاهوت، والنقد.
غادامير ابنًا لأستاذ في الكيمياء، ودرس العلوم الإنسانية في جامعات بريسلاو، وماربورغ، وفرايبورغ، وميونيخ، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة تحت إشراف هايدغر في فرايبورغ عام 1922(). وألقى محاضرات في علم الجمال والأخلاق في ماربورغ عام 1933، وفي كيل في عامي 1934 و1935()، ومرة أخرى في ماربورغ، حيث عُيِّن أستاذًا استثنائيًا عام 1937(). وفي عام 1939 عُيِّن أستاذًا كاملًا في جامعة لايبزيغ. عمل لاحقًا بالتدريس في جامعات فرانكفورت أم ماين (1947-1949)() وهايدلبيرغ (منذ عام 1949)(). أصبح أستاذًا فخريًا في عام 1968().
يعتبر البعض أن أهم عمل لغادامير ("الحقيقة والمنهج". 1960)() هو البيان الفلسفي الرئيسي في القرن العشرين حول النظرية التأويلية. تشمل أعماله الأخرى كتابات صغيرة، 4 مجلدات (1967-1977؛ التأويل الفلسفي، مقالات مختارة من المجلد 1-3)()؛ الحوار والجدلية (1980)()، الذي يتألف من ثماني مقالات عن أفلاطون؛ والعقل في عصر العلم (1982)().
****
مراجعة الكتاب؛ التأويل بين التاريخ والفلسفة؛
"التأويل بين التاريخ والفلسفة: مختارات من كتابات هانز جورج غادامير (1900 - 2002)()، المجلد الأول، يجمع ثمانية عشر مقالاً لغادامير حول موضوع فلسفة التاريخ. ومن بين هذه المقالات الستة عشر، نُشر مقالان سابقًا باللغة الإنجليزية ("الذاتية والتفاعل بين الذات والذات، الذات والشخص"، غادامير 2000؛ "التأويل على الدرب"، غادامير 2007)(). هذا المجلد عن فلسفة التاريخ هو الأول من ثلاثة أعمال مختارة من تأليف غادامير، وسيتبعه مجلدان عن الأخلاق والجماليات. من خلال توفير هذه المواد المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، يهدف المحررون إلى المساهمة في فهمنا لفلسفة غادامير وتطورها، فضلاً عن توفير سياق جديد لفهم آرائه:
"عندما يتعلق الأمر بفيلسوف كبير مثل غادامير، يمكن تقديم حجة قوية مفادها أن الباحثين بحاجة إلى الحصول على جميع المقالات المتاحة من أجل تقييم المكونات المختلفة لأطروحات الفيلسوف، وقياس تطور فكره عبر الزمن، وفهم جميع تعقيدات آرائه في السياقات المختلفة لتطبيقها. هذا هو هدف هذه الطبعة."()
لاحظ أن هذا المشروع لا يهدف إلى جمع أهم أعمال غادامير حول فلسفة التاريخ. بل إنه يكمل ما هو متاح حاليًا في مواقع أخرى باللغة الإنجليزية. كما يستبعد الخطب القصيرة ومراجعات الكتب، فضلاً عن المقالات التي يرى المحررون أنها لا تضيف أي شيء ذي أهمية فلسفية إلى ما هو متاح بالفعل. إن هذا المشروع جدير بالثناء، ورغم أن غادامير يطور العديد من موضوعات هذا المجلد في الكتب والمقالات المتاحة بالفعل باللغة الإنجليزية، فإنه يشكل مساهمة مهمة في فهمنا للتأويل الفلسفي غادامير، وعلى نطاق أوسع، الطبيعة الشاملة وسياق وتطور الفلسفة الألمانية في القرن العشرين. وبالتالي، ينبغي أن يكون هذا المجلد موضع اهتمام قراء غادامير، والفلسفة القارية بشكل عام، وأي شخص مهتم بالعلاقة بين الفلسفة وتاريخها.
إن التأويل الفلسفي غادامير، الذي ينطوي على رؤية للحياة البشرية باعتبارها تفسيرًا مستمرًا للعالم، يحاول إظهار أن الفكر واللغة يحملان علاقة أساسية بالماضي. بالنسبة لغادامير، فإن ما نستطيع التفكير فيه والأسئلة التي نستطيع طرحها في الحاضر تنشأ على أساس التقاليد التاريخية. ومن المعروف أن غادامير سعى في عمله الضخم "الحقيقة والمنهج"() الذي نُشِر لأول مرة في عام 1960 إلى إعادة تأهيل مفهوم "التحيز" الذي اعتقد أنه تعرض للتشويه بشكل غير عادل نتيجة لرفض عصر التنوير للسلطة الخارجية (غادامير 2004، 268-83)(). ورغم أن غادامير لا يعتقد أنه ينبغي لنا أن نقبل دون نقد الأحكام والأفكار التي انتقلت إلينا من خلال التقاليد، فإنه يؤكد أن الأحكام التي نجدها مسبقة كجزء من تراثنا الثقافي وخبرتنا توفر الأساس الإيجابي لآفاقنا الفكرية في الحاضر. ومن هذا المنظور، تتكشف الفلسفة كحوار مع الماضي، حيث نكشف ونفسر ما هو ضمني في الطريقة التي نفكر بها بالفعل في العالم، وحيث نستوعب ونجدد ما لا يزال يتحدث إلينا من خلال مسافة زمنية.
ومن وجهة نظر التأريخ الفلسفي، فإن موقف غادامير يشق مساراً بين المناهج المستخدمة في دراسة التاريخ الفلسفي والتي ترى نفسها تعمل على فهم الماضي وفقاً لشروطه الخاصة دون الرجوع إلى الاهتمامات الفلسفية الحالية، وتلك المناهج التي تستخرج من تاريخ الفلسفة الحجج والحلول التي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للمشاكل المعاصرة دون مراعاة التكوين التاريخي لهذه المشاكل الفلسفية نفسها. ومن منظور غادامير، فإن كلا النوعين من المناهج يقطعان الصلة الحية بين الماضي الفلسفي والحاضر في قلب أي مشروع فلسفي أصيل. وبالنسبة لغادامير، لا ينبغي أن يكون تاريخ الفلسفة من اختصاص مؤرخي الفلسفة الذين يصفون أنفسهم بذلك فحسب؛ بل إن كل فيلسوف عامل يستجيب للتقاليد الفلسفية، سواء أدرك ذلك أم لا.
تغطي المقالات التي تم جمعها في هذا المجلد الفترة من عام 1964 إلى عام 1994()، وهي الفترة التي أعقبت نشر كتاب الحقيقة والمنهج عام 1960()، وبالتالي تمثل فترة تم فيها الاعتراف به كصوت فلسفي رئيسي سواء في ألمانيا أو على المستوى الدولي. تتطور العديد من المقالات وتشرح موضوعات من كتاب الحقيقة والمنهج، فضلاً عن توفير مساحة لغادامير للتفكير في تطوره الفلسفي. وأبرز ما في هذا الصدد الأخير هو تخصيص مساحة واسعة للأدوار التي لعبها فيلهلم ديلتاي(1833 - 1911)() ومارتن هايدغر(1889 - 1976)() (معلم غادامير في عشرينيات القرن العشرين، والذي ساعد غادامير في استعادة سمعته في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية)() في تطوير التأويل الفلسفي لغادامير. في حين لعبت تاريخية دلتاي وفلسفة الحياة والتأويلات دورًا رئيسيًا في تشكيل "الموقف التأويل"() لشباب غادامير، فقد أعطى تأثير هايدغر شكلًا لوجهات نظر غادامير في اللغة والموضوعية العلمية والدور الذي يلعبه تاريخ الفلسفة في تحديد آفاقنا الفلسفية.
يقسم المجلد إلى أربعة أجزاء. يتضمن
- الجزء الأول ستة أبحاث تغطي الموضوع العام للتاريخ، ويطورون فكرة غادامير المميزة عن الحياة البشرية باعتبارها "متأثرة تاريخيًا”.
- يتميز الجزء الثاني بثلاثة أبحاث حول فلسفة دلتاي التاريخية للحياة، وكيف نظر إليها غادامير كحافز لتأويلاته الفلسفية الخاصة.
- يجمع الجزء الثالث خمسة أبحاث عن أعمال الفلاسفة والمثقفين الأوروبيين بما في ذلك إدموند هوسرل(1859-1938)() وجان بول سارتر (1905-1980)() وبيير بورديو (1930-2002)() ويورغن هابرماس (1929 - )() وجاك دريدا (1930 - 2004)(). إن المادة التي تناولت بورديو وهابرماس ودريدا مفيدة بشكل خاص لأنها تقدم ردود غادامير على معاصريه، حيث يمثل كل منهم، بطريقته الخاصة، تحديات مباشرة لمواقف جادامر الظاهراتية واللغوية والتأويلية. و
- يتضمن الجزء الرابع أربع أبحاث عن هايدغر من منتصف الثمانينيات، تتألف من ذكريات تجارب غادامير كطالب لهايدغر، وتفسير غادامير لما يسمى بـ "التواء/ألتفاف" عند هايدغر باعتباره “عودة" ["التف - حوله"]، وروايته لتفسيرات هايدغر للفلسفة اليونانية القديمة.
في ضوء إحياء الجدل مؤخرًا حول تورط هايدغر في الاشتراكية الوطنية، والذي حفزه نشر الدفاتر السوداء (هايدغر 2014/2016)()، قد يكون من الجدير بالملاحظة أن هذه المقالات لا تقدم سوى القليل من البصيرة في معرفة غادامر أو وجهة نظره بشأن المشاركات السياسية لهايدغر (لقد عمل غادامر نفسه على الحفاظ على مسافة واستقلال فكري عن النظام الاشتراكي الوطني. انظر جان غروندين (1955 -)()؛ (2003، 150-230)(). ربما كانت ملاحظة المحررين مع التوضيح، أو التي تشير إلى مناقشة مستقلة لهذه القضايا ستكون مفيدة.
بالإضافة إلى ملاحظات وقواميس للتعبيرات الألمانية واللاتينية واليونانية التي يستخدمها غادامير. تقدم المقدمة محتويات المجلد وتصف أسلوب غادامر الفلسفي والبلاغي. يقدم المقدمة؛ بمقدمة عامة عن مشروع غادامير الفلسفي، مع التركيز على دور التاريخ في إطاره. بالإضافة إلى معالجة موضوعات غادامير بما في ذلك التفسير والحوار والصوت المتحدث والممارسة الفلسفية، يدرس المقدمة التأثيرات الفلسفية لغادامير والمحاورين مثل أفلاطون(427 -347 ق. م)() وأرسطو (384- 322 ق. م)() ودلتاي (1833-1911)() وهوسرل (1859-1938)() وهايدغر(1889 - 1976)() ودريدا (1930 - 2004)(). وجد القارئ أن وصف المحررين لكيفية ارتباط فلسفة غادامير للتاريخ بفلسفته في اللغة مفيد بشكل خاص.
في مقاربتي لهذا المجلد، اعتمدت منظور مؤرخ الفلسفة المعني بالسؤال المنهجي حول كيفية فهم العلاقة بين الماضي الفلسفي والحاضر. ولهذا السبب، وكذلك من أجل مصلحة المكان، ستركز المراجعة بشكل أكبر على فلسفة التاريخ عند غادامير، وأقل على تفاصيل تفسيرات غادامير للفلاسفة الآخرين الموجودة في هذا المجلد. تم تطوير فلسفة التاريخ هذه بشكل مباشر في الجزء الأول من المجلد. تتضمن هذه المقالات تأملات حول موضوعات بما في ذلك السببية التاريخية، والعلاقة بين التاريخية والحقيقة، والعلاقة بين التاريخ البشري والتاريخ الطبيعي للكون، وما يعنيه محاولة فصل الذات عن كل التاريخ، ومعنى مصطلحي "قديم" و"جديد"، والموت. تقدم هذه المقالات مجتمعة وصفًا شاملاً لفهم غادامير للحياة البشرية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التاريخ.
في المبحث الأول، "هل هناك سببية في التاريخ؟" (1964)()، يزعم غادامير أن التاريخ عبارة عن شبكة من الأحداث التي تحدد حياتنا ولا يمكن اختزالها في "تحليل سببي". لا يمكن للتفسير الطبيعي في شكل سببية فعّالة، ولا التحليل الكانطي للسببية التاريخية باعتبارها عالم الحرية البشرية، أن يلتقط الطريقة التي يحدد بها التاريخ الحياة البشرية والإمكانات:
"إن التحقيق في الأسباب العميقة للمسار التاريخي للأشياء ليس محاولة على الإطلاق لتفسير "سببي"، والذي لن يطلب سوى السبب الفعّال. عندما نميز الروابط التاريخية، فإننا لا نكتشف شبكة من العوامل السببية - الطبيعة والحرية - التي نعزل خيوطها فقط حتى نتمكن من وضع أيدينا عليها للمستقبل - التاريخ لا يكرر نفسه أبدًا. هذا هو بالضبط ما يتألف منه واقع التاريخ: أن يكون ويحددنا، دون أن يكون من الممكن إتقانه من خلال التحليل السببي." ()
إننا منغمسون في التاريخ، ولا نستطيع أبداً أن نحرر أنفسنا منه بحيث نستطيع أن نقدم رواية سببية شاملة للماضي والمستقبل. وبالنسبة لغادامير، تصبح المهمة التأويلية هي فهم حقيقة مفادها أن الماضي يقيد إمكانياتنا في العمل بينما يظل منفتحاً على احتمالات المستقبل.
المبحث الثاني، "التاريخية والحقيقة"، من عام 1991()، يتناول مسألة النسبية التاريخية. وفي مواجهة الرأي القائل بأن ادعاءات الحقيقة الموجودة في التاريخ نسبية لأزمنتها وأماكنها، يزعم غادامير أن هذا الاعتقاد يفترض مفهوم المعرفة الموضوعية باعتبارها المعرفة التي تهدف إلى السيطرة والسيطرة. وفي ظل هذا النظام، فإننا نختزل ادعاءات الحقيقة في موقعها المحدد داخل التاريخ، وبالتالي نقضي على قدرتها على تحقيق شكل من أشكال الحقيقة يتجاوز الظروف المجردة. "إذا قاومنا هذا الافتراض، فلن نتمكن من التعامل مع الفلاسفة السابقين باعتبارهم محاورين محتملين فحسب، بل يمكننا أيضًا أن نفهم كيف أن أفكارهم قادرة على تحقيق تطبيق عالمي فيما يتعلق بفهم الحياة البشرية وإمكانياتها:
"الموضوعية تعني التشييء. إنها تدل على تحيز مقيد في كل مكان في ذلك العالم حيث لا يكون كسر المقاومة وتحقيق السيطرة أمرًا بالغ الأهمية في الواقع، بل يكون الأمر بالأحرى أن نكون معًا ونشارك في الكون التأويلي الذي نعيش فيه مع بعضنا البعض. في هذا الصدد، يمكنني أن أظهر كيف تجعل أفلاطونية، بالإضافة إلى أرسطو، نفسها ذات صلة متكررة بتفسير الغموض المسيحي، وكيف تصل تصريحات الفن في زمن التنوير إلى أعماق حياة الأفراد والشعوب، خارج كل المسافات والاختلافات التاريخية وكذلك خارج القرارات العملية والسياسية." ()
بالنسبة لغادامير، تكمن أهمية التاريخ والمعرفة التاريخية في الطريقة التي قد تستمر بها الأفكار في التحدث إلينا عبر الزمن. فعند تناول الأفكار القديمة، يمكننا بالطبع ترجمتها بتطبيقها على سياقاتنا الخاصة. ومع ذلك، فإن هذا النمط من التطبيق ليس تحريفًا للفكرة الأصلية؛ بل إنه يكشف عن ما كان صحيحًا وبالتالي عالميًا في داخلها.
في المبحث الثالث، "تاريخ الكون وتاريخ الأشياء"، الذي كتبه في عام 1998()، يزعم غادامير أن التاريخ البشري يمثل مجالًا متميزًا عن تقدم الأحداث أو الحقائق الطبيعية. يميز جادامير بين ما يسميه "تاريخ الكون"() و "تاريخ العالم"():
"من الواضح أن تاريخ الكون يتضمن أيضًا السؤال حول متى ظهرت البشرية لأول مرة على هذا الكوكب، الذي نسميه الأرض، وكيف تطور النوع البشري - وربما أيضًا ما إذا كان من المتوقع انقراض هذا النوع ومتى. عندئذٍ سيتم تسجيل البشر مثل الحفريات الرئيسية في فصل من تاريخ الكون. "ولكن هذا الماضي التاريخي، الذي نستيقظ عليه من خلال ما تقدمه لنا الآثار والتقاليد كإشارات، يعني شيئاً آخر. إن "تاريخ العالم" ليس مرحلة في تاريخ الكون، بل هو كل في حد ذاته. وليس من خلال ما يسمى "الحقائق"، والتي يمكن إثباتها من خلال البحث الموضوعي بأساليب العلوم الطبيعية، أن نمتلك معرفة بهذا التاريخ الذي نسميه تاريخ العالم".()
ورغم أن تاريخ العالم البشري يتكشف داخل القوس الزمني للتاريخ الطبيعي للكون، ويمكن تحليل مكوناته كحقائق من منظور التاريخ العالمي، باعتبارها سمات لتاريخ العالم البشري، إلا أنها لا يمكن اختزالها في حقائق طبيعية. وعلى النقيض من البقايا المتحجرة للتاريخ الطبيعي، فإن ما ينتمي إلى تاريخ العالم البشري، بالنسبة لغادامير، هو ما يتم الاحتفاظ به في الذاكرة الحية في شكل آثار وتقاليد. وهذا التاريخ هو ما يوفر أهمية لحياتنا، فضلاً عن ما يمنحنا لمحة عن إمكانياتنا البشرية على وجه التحديد في المستقبل.
في حين أن "تاريخ الكون" هو موضوع العلوم الطبيعية، فإن "تاريخ العالم" هو مجال العلوم الإنسانية. يزعم جادامير أننا لا نعرف الحقائق المتعلقة بالعلوم الإنسانية بشكل مؤكد أو بطريقة موضوعية. بل إن العلوم الإنسانية مثل الفلسفة أو الأنثروبولوجيا أو تاريخ الفن تشارك في الممارسات الثقافية ذاتها التي تدرسها، مما يساعد على فتح إمكانيات إنسانية جديدة من خلال أساليب التأمل الخاصة بها:
"إن العلوم الإنسانية تنتمي إلى أنظمة تتشكل وتعيد تكوين نفسها باستمرار من خلال مشاركتنا الملموسة فيها وبالتالي تساهم في معرفتنا بالإمكانيات البشرية والقواسم المشتركة المعيارية التي تؤثر علينا [...] لا توجد هنا يقينيات مثل الضمانات من النوع النظري و"العلمي" وهنا نحتاج دائمًا إلى النظر في الجانب الآخر - ليس فقط ما يدور في أذهاننا، ولكن أيضًا ما يعتقده الآخرون." ()
إن إحدى نتائج كل هذا، بالنسبة لغادامير، هي أن العلوم الإنسانية لها دور مهم تلعبه في نقل عالمنا المتعدد الثقافات والعولمي إلى المستقبل. ليس فقط أن العلوم الإنسانية لديها القدرة على خلق حوار بين مجموعات متباينة في جميع أنحاء العالم، ولكن غادامير يزعم أن لديها إمكانية أخرى للمساعدة في مقاومة الهيمنة العالمية للتكنولوجيا بقدر ما تتجنب أشكال المعرفة الموضوعية:
"في عالمنا التعددي، يشمل الآخر أيضًا الثقافات الأجنبية والسكان البعيدين عن هذه الأرض. سيتعين علينا أن نتعلم كل هذا أكثر فأكثر في المستقبل. "إن هدفنا الإنساني لا يمكن أن يكون استخدام الحضارة التكنولوجية لقمع كل ما تم تقديمه لنا أو للآخرين والذي شكلنا جميعًا في الأشكال التي اتخذتها حياتنا. فقط عندما نضع قدرات الفهم والقبول المتبادل في الاستخدام في المهام الجديدة التي تجلب العالم وتحافظ عليه في حالة توازن، سنكون قادرين على خلق أشكال جديدة من التنظيم. من بين جميع العلوم، فإن ما يسمى بالعلوم الإنسانية بشكل خاص هي التي تساهم أكثر من غيرها في رعاية هذه القدرات. إنها تجبرنا على مواجهة باستمرار بكل ثرائها للنطاق الكامل لما هو إنساني وإنساني للغاية."()
المبحث الرابع، محاضرة ألقيت في عام 1969 بعنوان "عالم بلا تاريخ؟"()، تدافع عن أهمية فن القراءة والمعرفة التاريخية على وجه التحديد ضد ما وصفه غادامير بأنه "الوجود الدائم لفيضان مستمر من المعلومات"() في العالم الحديث. وإلى جانب وجهة النظر القائلة بأن كل المعرفة ينبغي أن تصاغ على أساس المعرفة الخاصة بالعلوم الطبيعية، يقترح غادامير أن هذا التدفق من المعلومات من وسائل الإعلام يهدد بإنتاج تطابق غير مدروس وآراء مصطنعة. وفي هذا الموقف، يدعو جادامر إلى الاعتراف بأهمية القراءة المرحة والمعرفة التاريخية. وهنا، لا يهتم جادامر بالتاريخ بمعنى الحقائق الموضوعية لما حدث في أي وقت، بل يهتم أكثر بما يتم تناقله في الذاكرة الحية للماضي:
"بدون المعرفة وبدون التفكير في إمكانياتنا الخاصة، لن يكون لنا مستقبل. ومع ذلك، فهذا لا يعني بدون التاريخ. التاريخ لا يعني التهرب من الماضي، بل هو ذاكرة الحياة، كما يسمي شيشرون التأريخ. التاريخ، عالم التاريخ، ليس عالمًا ثانيًا للماضي إلى جانب العالم الطبيعي الذي يحيط بنا. التاريخ هو نظام لا ينضب تمامًا لجميع العوالم الموجودة هناك، والتي هي أقرب إلينا من القمر الصناعي القريب الذي يدور حول الأرض(). "إن التاريخ هو عالم البشر. ودراسة التاريخ تعني إبقاء المجال مفتوحاً أمام كل ما يعنيه أن تكون إنساناً. وبفضل التاريخ لم نعد محصورين في ما نعرفه أو نفكر فيه بأنفسنا. بل يصف التاريخ كل إمكانياتنا. أما عن نوع المستقبل الذي سنحظى به، فسوف يتوقف ذلك على مدى قدرتنا على الحفاظ على تراث التقاليد التاريخية التي ننتمي إليها جميعاً والتي توحدنا جميعاً على نحو متزايد."()
في سياق النقد الاجتماعي لهذه المقالة، ندرك الأهمية الأكبر التي يكتسبها التاريخ بالنسبة لحياة الإنسان، بالنسبة لغادامير. فالكائنات المتأثرة تاريخياً تعني أنه لا توجد فجوة بين العالم التاريخي للماضي وعالمنا في الحاضر. ومع ذلك، فإن انتشار المعلومات يهدد بفصلنا عن هذا التاريخ الحي، ويحاصرنا في الحاضر ويقيد قدرتنا على التفكير الحقيقي. وعلى هذا فإن جادامر يخشى أن يكون "العالم بلا تاريخ" عالماً يكون فيه البشر خاضعين وقابلين للتلاعب.()
المبحث الخامس، "القديم والجديد" (1981)()، تقدم تحليلاً ظاهراتياً لفئات "القديم" و"الجديد". وهنا يزعم جادامر أن "القديم" بالمعنى الدقيق للكلمة هو ما يبدو مألوفاً إلى الحد الذي يجعله غير ذي صلة. قد نصبح مهتمين بالفعل بالأشياء "القديمة" بمعنى كونها من الماضي، ولكن بقدر ما نفعل ذلك، فإننا نكتشف إمكانيات جديدة لتطبيقها، وبالتالي نجعلها "جديدة" مرة أخرى.
"إن عبارة "دائماً وراء الجديد"() تكشف عن حقيقتنا: فليس القديم والجديد هما اللذان يمكن الاختيار بينهما، بل هذا أو ذاك، ما يعد بشيء ولأنه يعد بشيء. ويمكن أن يكون هذا أو ذاك شيئاً قديماً أيضاً. والواقع أن الاختيار لا يكون أبداً بين القديم والجديد. فالقديم لا يكون أبداً مطروحاً للاختيار باعتباره شيئاً قديماً. وبقدر ما يكون قديماً، فإنه يصل إلى حد الوضوح الذي يميز ما هو مألوف. ولا يمكن طرحه للاختيار باعتباره احتمالاً مضاداً إلا في ضوء إمكانيات جديدة، ولا يمكن أن يثير انتباهنا إلا في ضوء هذه الإمكانيات الجديدة."()
ثم ينتهز غادامير الفرصة للتفكير في تجربتنا الظاهراتية للزمن، والتي تنقسم بين أبعاد الماضي والحاضر والمستقبل. فما هو ماضي أو قديم حقاً هو ما لم يعد ممكناً. أما المستقبل، على النقيض من ذلك، فيتصوره جادامر باعتباره ما يقف أمامنا، وبهذا المعنى قد يشمل إمكانيات "الماضي" التي أصبحت جديدة:
"هذه هي التجربة التي نختبرها نحن مع الزمن: إن بُعديه، المستقبل والماضي، لا يمثلان الحاضر أبداً. ولكن هذا يعني أنهما لا يقفان أمامنا كإمكانيتين متساويتين. أحدهما هو الممكن، والماضي قد ولّى حقاً. وحتى الإله لا يستطيع أن يمحو ما حدث. إن ما يقف أمامنا [ما الذي ينتظرنا] هو ما قد ينتظرنا [ما الذي قد ينتظرنا في المستقبل]. وحتى عندما يكون الأمر يتعلق بشيء معروف ينتظرنا، فإنه لم يعد ما هو معتاد ومعروف، بل يظهر في ضوء جديد". ()
بالنسبة لغادامير، فإن فئة "الجديد" ــ باعتبارها ما ينتظرنا في المستقبل ــ سوف تشمل دوماً عناصر الماضي [الزماني] التي وجدنا لها تطبيقات وإمكانيات جديدة.
المقال الأخير من الجزء الأول، وهو تأمل فلسفي حول الموت من عام 1975 بعنوان "الموت كسؤال"()، يقدم صياغة للنشاط الفلسفي الذي يربطه بالتقاليد. بالنسبة لغادامير، تعني عالمية التأويل أننا دائمًا نترجم أنفسنا وعالمنا. وبهذا المعنى، تصبح الفلسفة معرفة بما هو معروف بالفعل، وهو ما يربطه غادامير بنظرية التذكر أو سوابق مريض الأفلاطونية:
"هذه أسئلة يجب على الفلسفة أن تكرس نفسها لها بطريقتها الخاصة لأن مهمة الفلسفة هي الرغبة في معرفة ما نعرفه دون أن نعرف أننا نعرفه. هذا هو التعريف الدقيق لما هي الفلسفة ووصف مناسب لما أدركه أفلاطون لأول مرة: المعرفة التي نتعامل معها هنا، "فحوصات سوابق المريض"()، هي إخراج من الداخل ورفع إلى الوعي. دعونا، إذن، نسأل عما نعرفه دون أن نعرفه عندما نعرف عن الموت. ماذا يقول التقليد الفلسفي الذي نعيش فيه عن ذلك؟ هل يجب أن نسأل أيضًا عن محاولات التفكير هذه ما إذا كانت محاولات للمعرفة أم أنها مرة أخرى طرق لعدم الرغبة في معرفة ما نعرفه؟"()
بقدر ما تكون الحياة البشرية والفلسفة جزءًا من التاريخ، يزعم جادامير أن التأمل الفلسفي هو عملية تذكر. وعلى وجه التحديد، نحاول أن نجعل ما كنا نعرفه بالفعل بحكم التقاليد التي ننتمي إليها حاضرًا لأنفسنا.
من مراجعة فلسفة التاريخ التي تم عرضها في الجزء الأول، نتعلم أن الحياة البشرية، بالنسبة لغادامير، جزء من التاريخ، والذي يوفر أفقًا لإمكانياتنا المستقبلية. ليس تاريخنا البشري متميزًا عن التاريخ الطبيعي للكون فحسب، بل لا يمكننا تجنب الطريقة التي يحدد بها ويقيد ما هو ممكن بالنسبة لنا. تصبح المهمة التأويلية مهمة مسح الماضي، وإعادة اكتشاف ما يستمر في التحدث إلينا عبر الزمن، وجعله جديدًا مرة أخرى من خلال تطبيقه على الحاضر.
إذا كانت هذه هي النظرة العامة التي يتبناها غادامير لمكانة ودور التاريخ في حياة الإنسان، فإنني أرغب في تطبيق فلسفة التاريخ هذه في بقية هذا الاستعراض على النظرة الخاصة لتاريخ الفلسفة التي يقدمها غادامير في هذا المجلد. وفي القيام بذلك، أهدف إلى اختبار حدود رواية غادامير من أجل طرح السؤال حول ما إذا كان ينبغي للقراء المعاصرين أن يتبنوا تأويلات غادامير كجزء من "الجديد الفلسفي"، أو ما إذا كان ينبغي لهم، بدلاً من ذلك، أن يحصروها في مكان في تاريخ الفلسفة مع "القديم الفلسفي".
وكما هو واضح في هذا المجلد، وخاصة في المقالات عن هايدغر في الجزء الرابع، فإن غادامير نفسه فهم فلسفته الخاصة كجزء من تقليد غربي/أوروبي أوسع يمتد إلى العصور القديمة اليونانية. إن هذه البداية اليونانية للفلسفة، وآثارها اللاحقة، تمكننا من تكوين تمييز مبدئي بين الفلسفة كما مورست في أوروبا والعالم الغربي على نطاق أوسع، وما قد نفكر فيه، على سبيل المثال، تحت عنوان "الفلسفة الشرقية". وكما يصف غادامير موضوع هايدغر "نهاية الفلسفة" في محاضرة "بداية الفكر"() في عام 1986:
"عندما يتحدث هايدغر عن نهاية الفلسفة، نفهم على الفور أننا لا نستطيع أن نتحدث بهذه الطريقة إلا من منظور غربي. في أماكن أخرى، لم تكن هناك فلسفة تميز نفسها كثيرًا عن الشعر أو الدين أو العلم، لا في شرق آسيا ولا في الهند ولا في الأجزاء المجهولة من الأرض. "الفلسفة" هي تعبير عن مسار القدر الغربي. إذا تحدثنا مع هايدجر: إنه قدر الوجود الذي أصبح في الواقع قدرنا. إن حضارة اليوم، كما يبدو، تجد اكتمالها في هذا القدر".()
ووفقاً لـ "تاريخ الوجود" الذي رسمه هايدغر، فإن البداية اليونانية للفلسفة تشكل أهمية حاسمة بقدر ما تشكل أصداءها التطور اللاحق للفكر الغربي. وفي نظر غادامير، فإن الفكر الفلسفي كما ينحدر من اليونان يميز نفسه عن الدين بوعي. فضلاً عن ذلك، تهدف الفلسفة إلى المعرفة النظرية بالطبيعة، وكما يتضح في العصر الحديث وفصل الفلسفة عن العلوم الطبيعية، فإنها تحاول إنتاج مبرر منهجي للنشاط المعرفي الذي يتم تنفيذه في العلوم الطبيعية. ويمكن العثور على هذه السمات للفلسفة الغربية المستوحاة من اليونان في حالات تاريخية مثل تدوين الميتافيزيقا اليونانية في التقليد اللاتيني، وظهور الذاتية والمنهج الديكارتي في القرن السابع عشر، والنقد الكانطي للميتافيزيقا، والأنظمة الفلسفية العظيمة للمثالية الألمانية، والهيمنة التكنولوجية المستمرة على العالم الطبيعي. وهكذا يبدو أن غادامير يؤكد التمييز بين الفلسفة باعتبارها تقليداً فكرياً "غربياً" على وجه التحديد وأشكال النشاط الفكري التي تتم في إحداثيات أخرى في العالم البشري:
"عندما نسمع عن نهاية الفلسفة، فإننا نفهم ذلك من مثل هذا الموقف. وندرك أن الفصل بين الدين والفن والفلسفة، وربما حتى الفصل بين العلم والفلسفة، ليس مشتركاً في الأصل بين جميع الثقافات، بل إنه شكل بدقة التاريخ الخاص للعالم الغربي. ويمكن للمرء أن يسأل نفسه عن نوع المصير الذي يمثله هذا. من أين أتى؟ كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتطور إلى مثل هذه القوة المستقلة للضرورة حتى أصبحت السمة المميزة للثقافة الإنسانية في الوقت الحاضر؟ عندما نتساءل بهذه الطريقة، فإن أطروحة هايدغر المدهشة والمتناقضة على ما يبدو تبدو فجأة معقولة بشكل مقلق: إنه العلم والميتافيزيقيا اليونانية، التي تهيمن آثارها في الحضارة العالمية اليوم على حاضرنا".()
على أساس هذا السرد لتاريخ الفلسفة، يصبح من الطبيعي أن نحدد المهمة الفلسفية باعتبارها مهمة تفسير وتوضيح التراث الفلسفي الخاص بنا. والواقع أننا رأينا أن هذه المهمة تتوافق مع فلسفة التاريخ الخاصة بغادامير كما حددها الجزء الأول من هذا المجلد(): فبهذه الوسائل فقط يمكن للمرء أن يفهم التأثيرات اللغوية والمفاهيمية التي تشكل آفاقه الفلسفية، وبالتالي يكون لديه أي أمل في التحرر أو التفكير في شيء جديد حقًا.
ولكن ماذا لو لم يتماهَ المرء مع هذا التقليد الفلسفي بعينه؟ أو ماذا لو رفض السرد الغاداميري الخاص لتاريخ الفلسفة؟ وفي هذا الصدد، قد يتشكك القراء، على سبيل المثال، في التمييز الذي يرسمه غادامير، على غرار هايدغر، بين "الفلسفة" [أي "الفلسفة الغربية"]() والتقاليد الغنية من التفكير الميتافيزيقي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي الموجودة في أجزاء أخرى من العالم البشري. ورغم أن هذا التمييز يرتكز على ادعاء جوهري بشأن وجود تقليد متميز من التفكير الفلسفي نشأ في العصور القديمة اليونانية الكلاسيكية، فقد يجادل المرء في الاستمرارية التاريخية أو اللغوية أو النظرية وتكامل مثل هذا التقليد باعتباره منفصلاً عن بقية التاريخ الفكري العالمي. وعلاوة على ذلك، إذا افترضنا وجود الفلسفة، فقد نشعر بالقلق من أن تخصيص اسم "الفلسفة" لها وحدها قد يسمح للفلاسفة بتجاهل مساهمات المفكرين من أجزاء أخرى من العالم، بقدر ما لا يشارك أولئك الذين لا يتحاورون مع التقاليد الغربية، بحكم التعريف، في "الفلسفة".
بالنسبة للقراء المتشككين على هذه الأسس، قد يكون مقياس استمرار أهمية غادامير الفلسفية أو "جدته" هو الدرجة التي يكون المرء على استعداد لفصل فلسفة التاريخ الأوسع لغادامير عن تاريخ الفلسفة كما تصورها هو نفسه. والواقع أنه في دفاعنا عن غادامير، قد نتخيله يرد بأن كل تساؤل إنساني أصيل يتكشف على خلفية بعض التقاليد، وبالتالي سيكون من الخطأ رفض هذه الرؤية وعواقبها نتيجة للخلاف حول حقائق التاريخ الفلسفي. في كل الأحوال، فمن المرجح أن يتفق معي على أن مهمة تحديد النطاق الحقيقي للفلسفة ومعناها وطبيعتها هي مهمة لابد من تجديدها باستمرار، ولا سيما في سياق التفاعل مع أولئك الذين ينتمون إلى خارج التقاليد الخاصة التي قد نعتبرها موطننا.
وأخير. كما هو واضح هذا المجلد من الأبحاث حول فلسفة التاريخ عند غادامير، فإن أهمية تأويلات غادامير بالنسبة لنا اليوم تعتمد على استعدادنا وقدرتنا على تطبيقها في إطار موقفنا الفلسفي وأسئلتنا. وفي هذا الصدد، لا يسعني إلا أن أتصور أن المحررين كان بوسعهم أن يبذلوا المزيد من الجهد لتقديم التوجيه بشأن الكيفية التي يمكن بها لتأويلات غادامير أن تساهم بشكل منتج في المشاريع الفلسفية الجارية. ورغم أن هذه الدراسات تشير، على سبيل المثال، إلى العلاقة النقدية التي تربط جادامير بالتفكيكية الدريدية ()، أو إلى أن الفيلسوف جون ماكدويل (1942 -)()أقر بوجود إلهام yاداميري في كتابه الصادر عام 1994 بعنوان العقل والعالم()، فهل هناك مشاريع فلسفية أكثر حداثة ونشاطاً يجري تنفيذها بما قد نعتبره روح غادامير؟ وهل نجح نقد غادامير لمنهجية الموضوعية في العلوم الطبيعية، أم قد يجد آذاناً صاغية لدى ممارسي فلسفة العلوم ما بعد الوضعية المعاصرين؟ ومن وجهة نظر هذا المراجع، فإن المجالات التي قد تثبت فيها فلسفة ادامير للتاريخ أهميتها وفعاليتها تشمل المناقشات المنهجية في التأريخ الفلسفي (على سبيل المثال، كاتانا 2008، 299-304)()، والفلسفة المقارنة التي تهدف إلى الحوار بين الثقافات (برغر وآخرون 2017)(). وفي ضوء إصرار غادامير على أن الحقيقة الفلسفية تظهر في تطبيق الأفكار من تاريخ الفلسفة إلى الوقت الحاضر، ربما فات المحررون فرصة اختبار مدى إمكانية تطبيق غادامير اليوم وتقديم المزيد من الدعم لاستمرار أهمية تأويلاته الفلسفية.
للمزيد. نوصي بالإطلاع على الكتاب:
العنوان: التأويل بين التاريخ والفلسفة
المؤلف: هانز جورج غادامير
الناشر: بلومزبري
رقم الكتاب الدولي المعياري 13: 978-1350091405
تاريخ الإصدار: 2016
نوع الغلاف: مقوى
عدد الصفحات: 348
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Copyright © akka2025
المكان والتاريخ: طوكيو ـ 02/24/25
ـ الغرض: التواصل والتنمية الثقافية
ـ العينة المستهدفة: القارئ بالعربية (المترجمة).
#أكد_الجبوري (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بإيجاز: وجودية -عقل راسكولينكوف الاخلاقي-/ إشبيليا الجبوري -
...
-
بإيجاز: وجودية -عقل راسكولينكوف الاخلاقي
-
بإيجاز: ميشيل فوكو بين سلطة العقل و سلطة الدولة/ إشبيليا الج
...
-
صنعة الأنطباع عند إيرفينغ غوفمان / شعوب الجبوري - ت: من الأل
...
-
قصة -ذاكرة شايكسبير- / بقلم خورخي لويس بورخيس - ت: من الإسبا
...
-
بإيجاز: وليام شايكسبير وحفريات الروح البشرية/ إشبيليا الجبور
...
-
الفكر والخلود/ بقلم حنة آرندت - ت: من الألمانية أكد الجبوري
-
زيجمونت باومان والحرية غير المكتملة/ الغزالي الجبوري- ت: من
...
-
إضاءة: -رسائل سكروتيب- للكاتب سي. إس. لويس/ إشبيليا الجبوري
...
-
إضاءة: -حياة هنري برولارد- لستندال/ إشبيليا الجبوري - ت: من
...
-
العمل بين الأغتراب والحرية وفقًا لزيجمونت باومان/ الغزالي ال
...
-
إضاءة: رواية -كاميلا- لفرانسيس بورني/إشبيليا الجبوري -- ت: م
...
-
إضاءة: قِصَر الحياة ووهم الخلود في تأملات سينيكا / إشبيليا ا
...
-
إضاءة: البحث عن الزمن المفقود لمارسيل بروست/ إشبيليا الجبوري
...
-
إضاءة؛ -في مديح الحماقة- لإيراسموس روتردام/ إشبيليا الجبوري
...
-
بإيجاز: -الزمن الكافكوي: الاغتراب من أجل غرس عبثية الوجود/ إ
...
-
برفقتك/ بقلم مانويل التولاغوير - ت: من الإسبانية أكد الجبوري
-
صناعة الضحية؟… جيجيك مواجهًا فوكو/ شعوب الجبوري - ت:من الألم
...
-
النافذة/ بقلم مانويل التولاغوير بولين - ت: من الإسبانية أكد
...
-
الدراما الخفية للفقر في مجتمع الاستهلاك/ بقلم زيجمونت باومان
...
المزيد.....
-
تحقيق فرنسي يستهدف الممثل جيرار دوبارديو بشأن -مقر ضريبي وهم
...
-
اتحاد الأدباء يحتفي بعبد الملك نوري وفؤاد التكرلي..
-
الكتاب الإلكتروني والنشر الذاتي.. هل يدقان المسمار الأخير في
...
-
مؤتمر الحوار الوطني السوري .. انتقادات للاستعجال وضعف التمثي
...
-
فيلم يوثق زيارة مراسل إسرائيلي إلى دمشق يُعرض الليلة وسط موج
...
-
أبوظبي تحتضن مهرجان -صنع في روسيا- لتعريف الزوار بالثقافة وا
...
-
جوائز السينما كانت خارج التوقعات.. الفائزون بجوائز نقابة ممث
...
-
-صناعة الأفلام- أسلوب مبتكر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغ
...
-
فيلم -يونان- لأمير فخر الدين: رحلة كاتب مغترب في البحث عن ال
...
-
غارديان: كتاب عمر العقاد يفضح القيم الأخلاقية الغربية وصمتها
...
المزيد.....
-
نحبّكِ يا نعيمة: (شهادات إنسانيّة وإبداعيّة بأقلام مَنْ عاصر
...
/ د. سناء الشعلان
-
أدركها النسيان
/ سناء شعلان
-
مختارات من الشعر العربي المعاصر كتاب كامل
/ كاظم حسن سعيد
-
نظرات نقدية في تجربة السيد حافظ الإبداعية 111
/ مصطفى رمضاني
-
جحيم المعتقلات في العراق كتاب كامل
/ كاظم حسن سعيد
-
رضاب سام
/ سجاد حسن عواد
-
اللغة الشعرية في رواية كابتشينو ل السيد حافظ - 110
/ وردة عطابي - إشراق عماري
-
تجربة الميج 21 الأولي لفاطمة ياسين
/ محمد دوير
-
مذكرات -آل پاتشينو- عن -العرّاب-
/ جلال نعيم
-
التجريب والتأسيس في مسرح السيد حافظ
/ عبد الكريم برشيد
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة