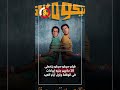|
|
دراسة حول مجموعة قصص -أبرياء... وجلّادون- للكاتب الفلسطيني فرج نور سلمان، من طلائع كتب -أدب المقاومة النثري-، صدر عام 1960 في الدّاخل الفلسطيني.
زاهر بولس


الحوار المتمدن-العدد: 8178 - 2024 / 12 / 1 - 10:50
المحور:
الادب والفن
دراسة حول مجموعة قصص "أبرياء... وجلّادون" للكاتب الفلسطيني فرج نور سلمان، من طلائع كتب "أدب المقاومة النثري"، صدر عام 1960 في الدّاخل الفلسطيني.
بقلم: زاهر بولس
تمهيد:
بتاريخ 20.4.2024 فقدت فلسطين كاتبها الطليعي المحامي فرج نور سلمان، عن عمر ناهز ال88 عامًا، في مدينة الناصرة، الذي وُلد بتاريخ 25.11.1936 في قرية اعبلين الجليليّة، وانتقل للدراسة في شفاعمرو ومن ثم مدينة النّاصرة حيث سكن مع اخته الكبرى، التي كانت هي ايضًا تتعلّم في الناصرة، وتخرّج من ثانويتها عام 1956. وبعد تخرّجه أصبح معلّمًا في قريتَي طمرة وسخنين، وهي مُدُنًا اليوم، لكنّه أراد متابعة تعليمه الجامعي فالتحق بالجامعة العبريّة في القدس ليدرس المحاماة، وأنهى تعليمه الجامعي عام 1963، وعمل في مدينة حيفا بعد تخرّجه، وتزوّج وعاش هناك، ثم انتقل إلى الناصرة واستقرّ وعمل بها مدى عقود كمحامٍ اتسعت شهرته مهنيًا، كتب المقالة الصحافيّة مدى حياته، وقرض الشعر، لكنّ الأهم أنّه أصدر كتابًا يحوي سُباعيّة قصص قصيرة في فترة الحكم العسكري، الذي فرضته سلطات احتلال الكيان الصهيوني بعد نكبة فلسطين عام 1948، بالامكان تصنيفه تحت راية "أدب المقاومة النثري"، وكان من الطلائع رغم القمع والمخاطر المحفوفة في ذلك الحين، وهذه الدراسة تدور حول الكاتب وكتابه، علّها توفيه بعض حقّه، بعد أن أُسقط اسم الكتاب والكاتب من معظم الدراسات حول هذه الحقبة الهامّة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، أو على الأقل التي تسنّى لي مراجعتها، على كثرتها، أو ذُكر بشكل عابر دون ايلائه حقّه كما يجب.
مقدمة:
هل الفردُ هو من يصنع التاريخَ، أم على العكس من ذلك، التاريخُ هو من يصنع الفردَ؟ هذا سؤال عميق لا تحديد فيه للنِسَبِ ما بين دور الفرد في دفع حركة التاريخ وما بين دور المرحلة التي يمر بها، ولكن مما لا شكّ فيه أن الدور الأساس هو للمرحلة وللظروف الموضوعيّة ومدى نضوجها، ليتحوّل الفرد بوعيه إلى جزء من نضوج الظرف الموضوعي، ويبقى دور الفرد ووعيه وإدراكه للظروف الموضوعيّة هام جدًا، مما يجعل دوره في مرحلة أو ظرف ما حاسم إذا ما وعى مسارات حركة التاريخ، فهذا هو دور المثقف ودور القائد. وكما يكتب جورجي بليخانوف في كتابه الفلسفي "دور الفرد في التاريخ" فإنّ "الرجل العظيم يُعَدّ عظيمًا لا لأنّ صفاته الشخصيّة تطبع الأحداث التاريخيّة بطابعها الخاص بل لأنّه يتحلى بصفات تجعله اقدر من الآخرين على الاستجابة للضرورات الاجتماعيّة العظيمة في عصره". ومن هذه الزاوية سوف أتناول مجموعة القصص القصيرة التي كتبها المحامي فرج نور سلمان "أبرياء... وجلّادون" ونُشرت في كتاب رأى النور في 30 تشرين الثاني من العام 1960، طبع في "المطبعة التجارية في عكا"، وكان ثمنه ليرة "إسرائيليّة" واحدة و25 أغورة، أي اثنتي عشر سنة بعد النكبة، مما يثير العديد من التساؤلات حول موقع هذا الكتاب أدبيًا وتاريخيًا. والذي لم يأخذ حقّه في مسيرة "أدب المقاومة النثري" كما يليق.
جنون اليراع
نحن نكتب عن كتاب مجموعة القصص القصيرة للقاصّ المحامي فرج نور سلمان، الذي صدر عام 1960، اثنتي عشر سنة بعد نكبة فلسطين، وهو لا يزال ابن اربعة وعشرين عامًا. أكتب هذه الكلمات في تشرين الأوّل من العام 2024م، في خضم حرب بدأت بتاريخ 7.10.2023 ولا تزال مستمرّة لحين كتابة هذه السطور، ونشاهد على الفضائيات، منها الوطنيّة ومنها عميلة الإستعمار، مشاهد الدمار الشامل الذي قام ويقوم به الكيان الصهيوني بداية في غزّة ولاحقًا في لبنان مرورًا بايران وسوريا واليمن. دمار وقتل وتجويع وتشريد ونزوح، أو باختصار محاولة تحويل ما تبقّى من فلسطين إلى ارض بلا شعب حتّى تصح مقولتهم: لشعبٍ بلا أرض.. لكن هيهات!
في العام 1948م كانت النّكبة، وهي بهذه القساوة والوحشيّة، لا بل اكثر. فنحن نشاهد الآن تمامًا ما جرى لأهالينا واجدادنا بالصوت والصورة مباشرة. بقدرة أقل على المقاومة في حينه. وإن كان معظم جيلهم الذي عايش ووعى هذه المرحلة قد ارتقى، إلا أنّ روح المرحلة انتقلت إلينا، وحجم المأساة استوعبناه الآن اكثر.. بالصوت والصورة والدّم.
هنالك أمور ليست مفهومة ضمنًا في السنوات الأولى ما بعد النّكبة: من يستطيع أن يحمل قلمًا ويكتب، ولمن، تحت وطأة وهول ما جرى؟!
أنا أقول، وقد أُخطئ بتقييمي، انّ معظم من حمل قلمًا وكتب أو درّس في هذه المرحلة الحرجة، وحافظ على قيم الإنسان التي فينا من خلال الحفاظ، مثل الحفاظ على بيضة الخِدر، على الحرف الذي أنرنا به العالم منذ فجر التاريخ، هو مقاوم بالمفهوم الأوسع للكلمة، حتّى لو قرض شعر نسيب وغزل أو ألّف كتب دراسيّة أو مسرحيّة أو خطبة دينيّة، وأَسَالَ عشق الضّاد في دمنا فصار لا يُبَارِحُنَا إنّما يُبَرِّحْنَا، فما بالكم بمن كتب وتحدّى وواجه واصطدم في مرحلة يكون فيها قول كلمة حق في وجه ظالم لها استحقاق باهظ الأثمان، يطال الحريّة إلى سجون فاغرةً فاها لكل فلسطيني، أو قطع الأرزاق وتجويع الأطفال وأكثر.
في هذه المرحلة كتب الطلائعيّون، وعلينا أن نوفيهم حقّهم، جميعهم، ولو بعد عقود، نقيّم إبداعهم تحت وطأة شراسة المرحلة، ونقدّر عاليًا هذا الصدامي الذي لم يأبه بالعواقب وتبع جنون اليراع مع الأخذ بعين الاعتبار السياق العام.
بدايات ما بعد النكبة:
حينما نشر الاديب المقاوم غسان كنفاني كتاب "أدب المقاومة في فلسطين" ذكر في صفحة 21 من كتابه الذي صدر عن "منشورات دار الآداب- بيروت"، دون ذكر سنة الإصدار، وأعتقد سهوًا، وبحسب نتائج البحث في محرّك غوغل فإن سنة الإصدار هي عام 1966، والأمر منطقي أقبله، ذكر ما يلي: "وتقدّر السلطات الإسرائيليّة عدد الذين يكتبون بالعربيّة، من شعراء وكتّاب، في الأرض المحتلة 28 شاعرًا وكاتبًا بينهم 8 من اليهود الشرقيين". ويضيف كنفاني: "ولكن الذي صدر وطبع من الكتب العربيّة في الأرض المحتلّة بعد 1948 لا يتعدى خمسة عشر ديوانًا شعريًا وحوالي خمس روايات، لا داعي للحكم على أكثرها- ما دامت قد حصلت قبل ذهابها للسوق على اذن الرقيب". ويذكر كنفاني في الصفحة 20 من نفس الكتاب أن "أوّل رواية عربيّة طبعت في اسرائيل هي رواية ابراهيم موسى ابراهيم، اليهودي العراقي". ويُطرح السؤال التالي: هل كتاب المحامي فرج سلمان كان واحدًا من الخمسة التي لم يذكر اسمها كنفاني، ويكون بذلك قد عمّم بين الرواية والقصة القصيرة لنقص في المصادر؟ وهل يعتبر أوّل نص لقصص قصيرة يدخل تحت تعريف "أدب المقاومة النثري" نُشر لكاتب عربي فلسطيني في الداخل الفلسطيني؟. حتّى "سداسيّة الأيّام الستّة" للكاتب الشيوعي اميل حبيبي، فقد طبعت عام 1968، ولكن مع إضافة قصص قصيرة كانت قد نشرت في مجلّة الجديد، التابعة للحزب الشيوعي، وبضمنها قصة قصيرة بعنوان "بوابة مندلباوم" التي نشرت عام 1954، رغم ان ذكرها لم يرد في كتاب/ فهرست "الجديد في نصف قرن- سرد ببليوغرافي" الذي أعدّه وقدّم له محمود غنايم، وبرأيي فإن هذه القصّة القصيرة، على أهميتها، مؤدلجة ومسيّسة، تتساوق مع طرح الحزب الشيوعي لحل القضيّة الفلسطينيّة من خلال التسوية والتقسيم، لكنّها لا تدخل تحت تبويب "أدب المقاومة النثري" في هذه المرحلة من أدب اميل حبيبي، لأن عنصر المواجهة والصدام مع المحتل غير قائم، بل تدخل الطفلة منطقة الحرام في الوسط بين جيش الكيان وجيش الأردن، منطقة قبول تسوية الوضع القائم ما بعد النكبة. فنكرّر السؤال: هل يكون كتاب المحامي فرج نور سلمان هو أول كتاب يتضمن مجموعة أو سباعيّة قصص قصيرة، دون الانتقاص من قيمة قصص قصيرة نشرت في مجلة الجديد أو في غيرها، تدخل في تصنيف "أدب المقاومة النثري" لدى فلسطينيي الداخل؟ إن الجواب على هذا السؤال بحاجة الى بحث خاص في أولى المجموعات القصصية التي صدرت قبله، سنأتي على ذكرها لاحقًا، والحصول على هذه الكتب لمراجعتها أمر شاق مضنٍ، لاختفاء بعضها عن رفوف المكتبات العامّة والخاصّة في ظل غياب مؤسّسات وطنيّة ومراكز دراسات وطنيّة تحفظ هذه الإصدارات ووثائق هامّة أخرى، وهذا جهد بحاجة إلى تفرّغ، ولكن من المؤكّد انّ المجموعة القصصيّة مبحثنا هي واحدة من طلائع هذا المصنّف، في مقابل طلائع مجموعات قصصية أدبيّة اجتماعيّة.
لقد رصد الكاتب الفلسطيني محمد علي سعيد الروايات والمجموعات القصصيّة التي صدرت باللغة العربيّة في الكيان منذ العام 1948 حتى العام 1966، بما فيها لكتّاب يهود شرقيين (يهود عرب) وهي بحسب ترتيب السنوات، الروايات: (1) عزرا عابد (يهودي). العالم السعيد. 1951- (2) حسني زعبي (فلسطيني). جنون وانتقام. 1954- (3) كامل نعمة. القضاء والقدر. جزءان 1954- (4) يهودا بورلا (يهودي). صراع انسان. 1955- (5) توفيق معمّر (فلسطيني). مذكّرات لاجئ (حيفا في المعركة). 1958- (6) توفيق معمّر (فلسطيني). بتهون. 1959- (7) محمود كناعنة (فلسطيني). والأرض وضعها للأنام. 1960- (8) ابراهيم موسى (ييهودي عراقي). اسمهان. 1961- (9) ابراهيم موسى ابراهيم يهودي عراقي). الأرض والمال. 1963- (10) محمود عبّاسي. حب بلا غد. 1962- (11) توفيق فياض البطاح. المشوّهون. 1962- (12) عطالله منصور. وبقيت سميرة. 1962- (13) محمود كناعنة. قلب في قرية. 1963- (14) سليم خوري. أجنحة العواطف. 1966. وبحسب هذه القائمة يكون قد صدر حتّى عام 1966 أربعة عشر كتابًا ادبيًا، وليس خمسة كما ذكر كنفاني.
أما المجموعات القصصية أو القصص القصيرة، وهي ما لم يذكرها أو يحدّدها كنفاني بالمرّة، وهي الفئة التي يندرج فيها كتاب مبحثنا: (1) أقاصيص من هنا وهناك. ميشيل حداد. 1955. (جمع وإعداد)- (2) يحيى الفاهوم. الفلاحون في الأرض. 1957 – (3) توفيق معمر. المتسلل. 1957 – (4) نجوى قعوار فرح. دروب ومصابيح. 1956 – (5) فرج نور سلمان. أبرياء وجلادون. 1960- (6) الوداع الأخير. سليم خوري. 1961- (7) لمن الربيع؟. نجوى قعوار فرح. 1963.
وبحسب القائمة التي رصدها الكاتب محمد علي سعيد، فإن كنفاني أخطأ بعدد الروايات وبمن كان أول ناشر لروايته، وهو حتمًا ليس ابراهيم موسى ابراهيم، الكاتب اليهودي من اصول شرقيّة عراقيّة.
ولكن كنفاني يعتذر مسبقًا في الفقرة الأولى من مقدّمة كتابه عن افتقار "هذه الدراسة الى عنصر أساسي يتوقف عليه عادة جزء جوهري من نجاح البحث، وهو وفرة المصادر"، صفحة 5. ويضيف أنّ "تعقّب الانتاج الأدبي لعرب الأرض المحتلة هو عمل من أصعب الأعمال التي يمكن لباحث ان يتصدّى لها، وهذه الإشارة ليست تبريرًا لشيء ولكنها اعتذار عن أي تقصير".
ذِكْرٌ متواضع في بعض الدراسات:
وكما ذكرت سابقًا فإنّ هذه الدراسة تدور حول الكاتب فرج نور سلمان وكتابه، علّها توفيه حقّه، بعد أن أُسقط اسم الكتاب والكاتب من معظم الدراسات حول هذه الحقبة الهامّة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، أو على الأقل التي تسنّى لي مراجعتها، على كثرتها. نستثني منها ورود فقرة يتيمة في كتاب الباحث د. حبيب بولس، انطولوجيا القصة العربيّة الفلسطينيّة القصيرة في اسرائيل خلال نصف قرن، الجزء الثاني، 2012: "يعدّ الكاتب فرج سلمان من اوائل الذين اصدروا مجموعة قصصيّة في البلاد. قصصه تتميّز في التحامها بهموم الجماهير وخاصّة طبقة الفقراء الكادحين. احداثه مسحوبة من واقع هذه الجماهير المأساوي إبّان فترة الحكم العسكري. شخوص قصصه واقعيون لا تنقصهم الاستدارة.تتكئ معظم قصصه على المباشرة، فهي صرخة نقد مدوّية، سرده جميل قوي وحواره عادة يكون باللغة العاميّة كي يناسب واقع الشخصيّات. قصصه اقرب الى الصور منها الى القصّة الفنيّة النّاجحة". الجزء الثاني، صفحة 679.
كما ويذكره د. محمود عبّاسي بشكل عابر ومقتضب في كتابه: "تطوّر الرواية والقصة القصيرة في الأدب العربي في اسرائيل/ 1948- 1976". صفحة 141.
وفي كتاب: "خصوصيّة المكان في القصّة العربيّة القصيرة في اسرائيل" للمؤلفة عالية كمال القاسم، يُذكَر اسم فرج سلمان (بالخطأ تكتبه سليمان) مرّة واحدة صفحة 34 ضمن مجموعة مثل: حنا ابراهيم واميل حبيبي وسليم الخوري وزكي درويش ومحمد علي طه ومحمود عباسي وتوفيق فياض ومصطفى مرار ومحمد نفاع وغيرهم، دون التطرّق إلى الخاص الذي بالخاص ضمن المجموعة.
ولم يُذكر الكتاب والكاتب، على سبيل المثال لا الحصر، في: "أنطولوجيا القصّة القصيرة الفلسطينيّة" التي أصدرتها دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينيّة (م.ت.ف) عن دار الكرمل في عمان عام 1990.
مجموعات القصص القصيرة التي سبقت إصدار مجموعة فرج سلمان، وهي أربعة:
أولى المجموعات القصصيّة القصيرة التي رُصدت كان كتاب "أقاصيص من هنا وهناك"، من اصدار منشورات "المجتمع" ومطبعة الحكيم في الناصرة 1956. وهو مكوّن من تسع قصص قصيرة لكتّاب من مختلف أنحاء العالم، أعدّها وقدّم لها الشاعر والأديب ميشيل حدّاد، ابن مدينة الناصرة، لكنّها ليست من تأليفه، وبالامكان تسميتها فسيفساء من فنون القصّة القصيرة من الأدب العالمي: " اللبناني مارون عبّود، الأمريكي و. هنري، المصري فؤاد فهمي، الرّوسي أنطون تشيخوف، الفرنسي جي دي موباسان، العراقي شاكر خُصباك، السوري محمد حيدر، الألماني فيكي باوم، العبري يوشكي". وتكمن أهميّة هذا الكتاب بكونه أوّل مجموعة قصص قصيرة تصدر بالعربيّة في الداخل الفلسطيني بعد النكبة، لكن مضمونها على أهميّته في نشر وإشباع الذائقة الفنيّة حين تعذّرت في تلك المرحلة، هي خارج إطار مبحثنا.
وبما يتعلّق بالإصدار الثاني فهو مجموعة قصصيّة أصدرتها الكاتبة الفلسطينيّة ابنة مدينة الناصرة نجوى قعوار- فرح عام 1956 عنوانه "دروب ومصابيح"، وهي مكوّنة من ثماني قصص قصيرة، وكتبت في فاتحة مقدّمتها: "هذه مجموعة اخرى من القصص، الست الأولى هي صور من المجتمع الفلسطيني قبل سنة 1948" وهي بهذا خارج مبحثنا في هذه الدراسة رغم أهميّتها وجمال سرديّتها، وتضيف: "والقصتان الاخيرتان تصفان شيئًا مما حدث أو يحدث بعد سنة 48"، وهاتان القصّتان تدخلان في نطاق دراستنا، "نداء الأطلال" و"ليلى وعطر البرتقال"، وفيهما توصيف حال ومأساة اللاجئين الفلسطينيين بعد النّكبة، بسرديّة جميلة، لا تصل إلى الحالة الصداميّة، ولا تدخل تحت تعريفنا للأدب النثري المقاوم، رغم أهميّة الكتاب لدراسات ذات عناوين مغايرة.
أما الإصدار الثالث فهو كتاب "الفلّاحون في الأرض" للكاتب الطليعي الفلسطيني ابن الناصرة يحيى فاهوم، والذي نشره تحت اسم ي. فاهوم، عام 1957، فطابعه فلسفي اجتماعي تحت تصنيف القصص القصيرة. على أهميّة هذه المجموعة القصوى، كأحد طلائع الكتب التي نشرت بعد النكبة، وأهميّة مضامينه الاجتماعيّة والفلسفيّة، بغض النظر عن الموقف من المضامين المثيرة للنقاش، سلبًا أم ايجابَا، إلا انّه لا يصنّف ضمن "أدب المقاومة النثري"، وهذا ليس انتقاصًا منه، فلا قانون في الابداع يفرض على الكاتب مضامين اهتمامه.
وأما الإصدار الرابع فهو كتاب يحوي مجموعة القصص القصيرة التي نشرها ايضًا الكاتب الطلائعي المحامي توفيق معمّر تحت اسم: "المتسلل" والذي طبع في مطبعة الحكيم في الناصرة ونشر عام 1957، بموازاة كتاب يحيى الفاهوم "الفلاحون في الأرض"، وخلافًا له، فقد قام بتوصيف معاناة الفلسطينيين في دولة الكيان بعد النّكبة، وحتّى توصيف الظلم في سياق الحكم العسكري يستدعي جرأة، والكتاب هام، إلا أنّ ابطاله استكفوا بتوصيف الظلم، دون تجاوز خطوط المواجهة، حتّى الكلاميّة، في غالب الأحيان، وربما كانت هذه امكانات مرحلة الصدمة، وجيل الكاتب، واعتباراته. لِيَلِيهِ بعد سنتين برواية "بتهون" عام 1959 عن مطبعة الحكيم في الناصرة. ونرى هنا تطوّرًا على محور المواجهة مع سلطة الاحتلال كلاميًا لشخوص الرواية في حافلة تنقل العمّال من الناصرة إلى حيفا (فيما بينهم)، لكن المواجهة لا تحدث في النهاية بِتَدَخُّلٍ من الكاتب على طريقة المسرح الإغريقي مستخدمًا ما يسمّى "الآلهة من الآلة" لتحل إشكاليّة نسيان تصريح الحاكم العسكري للعمل دون مواجهة. وبهذا نرى تطوّر مواقف الشخوص على محور الزمن، لكنها لا تصل إلى مواجهة فعليّة كضرب احد ابطال قصص فرج سلمان للشرطي أثناء اضراب العمّال بشكل فعلي. نضف إلى ذلك بأن "بتهون" هي رواية و"أبرياء... وجلّادون" هي مجموعة قصص قصيرة، وهي مبحثنا.
ولأهميّة الرواية والمضمون نستذكر رواية اضافيّة للكاتب توفيق معمّر: "حيفا في المعركة- مذكرات لاجئ فلسطيني"، نشرت عام 1958 عن مطبعة الحكيم في الناصرة، رغم ان مبحثنا القصص القصيرة، انما الشيء بالشيء يُذكَر. فهذه رواية رائعة من روائع الروايات التي تحدّثت عن مقاومة الفلسطينيين قدر مستطاعهم ضمن امكانياتهم، في فترة حرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني، فترة نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين وتسليم السلاح لليهود ودعمهم لتهجير الفلسطينيين. وما يهمنا هنا نهاية الروايه ومصير بطليها المقاومين، غالب وأبي دياب، بعد نزوحهما الى الأردن واكتشافهما خيوط خيانة الانجليز تمتد إلى عمّان، وقرارهما بالعزوف عن مقاومة الخيانة وخيارهما بالابتعاد: "وبعد حديث قصير استقر رأينا على ان نغادر الأردن ونمضي الى بلاد ليس فيها بريطانيون من امثال كريستوفر ولا نفوذ بريطاني ولا اجنبي مهما كان نوعه ولونه. لذلك عقدنا العزم خصوصًا ونحن لاجئون فلسطينيون من بلد واحد جمعتنا خطوب واحدة وآلام واحدة وآمال واحدة على شد الركاب الى بلد ينعم بالحريّة الصحيحة الكاملة والعيش فيه حيث لا نفوذ اجنبي نخشاه". حيفا في المعركة، الطبعة الثانية، 1987، المطبعة الشعبيّة- الناصرة، صفحة 229. (الطبعة الأولى عام 1958).
وهنا ايضًا لا يمكن ادخال هذه الرواية ضمن روح أدب المقاومة ما بعد النكبة، رغم حديثها عن المقاومة في فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين.
"أدب المقاومة النثري": تعريف
هو أدب يتوجّه إلى مركّب الوعي والإدراك لدى المتلقّي ليثور على واقع الظلم من أجل تحقيق العدالة، والتمرّد على ثقافة سائدة قامعة لتغيير واقع ظُلمي قائم، من خلال نصوص نثريّة كالقصّة والقصص القصيرة، تدعو إلى حالة صداميّة تتدرّج من المخيال والحوار الذاتي الداخلي، حتّى الصدام الخارجي، بما يتلائم مع منظومة فكريّة تستند إلى أعراف وقيم انسانيّة وقانونيّة دوليّة، تكون الحالة الصداميّة هي المركّب البارز.
حياة الكاتب في خضم الأحداث السياسيّة:
إنّ تقاطع حياة الكاتب فرج سلمان مع بانوراما الأحداث التاريخيّة- سياسيّة أثّر في مضامين قصصه القصيرة السبع:
ولد الكاتب فرج نور سلمان بتاريخ 25.11.1936 في اعبلّين، قرية فلسطينيّة جليلية من قضاء عكا، في فترة الاستعمار البريطاني الذي امتد من العام 1917م حتّى العام 1948م، عام النكبة، وقد عايش الثورة الكبرى ضد الاستعمار البريطاني (1936- 1939)، إلا انّه لم يكن بجيل كاف ليعِ هذه الفترة، لكن الرّوح والبيئة الثوريّة شكّلت الأمزجة الشعبية المتوارثة والمنتقلة، خصوصًا وأنّ والده كان قائد فصيل في هذه الثورة، لتليها الحرب العالميّة الثانية (1939-1945) حيث انتهت وهو في سن التاسعة من عمره، وهي سن بداية تشكّل الوعي السياسي والاجتماعي متداخلة، لننتقل إلى العام 1947 وقرار تقسيم فلسطين وهو ابن الحادية عشرة، ليليها عام النكبة (1948) وهو في الثانية عشرة من عمره ومذاق اللجوء المؤقّت في لبنان. وفي العام 1952م تفجّرت ثورة الضبّاط الأحرار في مصر وهو في السادسة عشر من عمره، ثورة 23 يوليو/ تموز التي الهبت العالم العربي والإسلامي والعالم الثالث بعمومه، بقيادة جمال عبد الناصر، ليليها تأميم قناة السويس ورد العدوان الثلاثي ومجزرة كفر قاسم، كلّ هذا في العام 1956م، والوحدة المصريّة السوريّة في إطار الجمهوريّة العربيّة المتحدة في 22 شباط من عام 1958 وفي خضمّها ثورة تحرير الجزائر (1954-1962) التي انتهت باستقلالها عن الاستعمار الفرنسي بعد ارتقاء اكثر من مليون شهيد. ويتخلل هذا المشهد العالمي العاصف تخرُّج الكاتب عام 1956م من المدرسة الثانوية البلديّة في مدينة الناصرة، المدينة العربية الفلسطينيّة الوحيدة الباقية الناجية من الهدم أو التهويد بعد عام النكبة (1948) في الدّاخل الفلسطيني، والتي تخرّج منها كوكبة من الدارسين من القرى العربية الباقية ومن النّاصرة، ليتصدر فيما بعد عدد لا بأس به منهم المشهد العلمي والثقافي بين فلسطينيي الدّاخل، بمن فيهم الطبيب أحمد توفيق الريناوي، ابن قرية الرينة الجليليّة المحاذية لمدينة الناصرة، الذي درس وتخرّج معه من ذات المدرسة في نفس العام، وهو الذي قدّم للمحامي فرج سلمان كتابه. وبعدها التحق سلمان بالجامعة العبريّة في القدس لدراسة الحقوق، ويبدو من أحداث قصصه وتاريخ طباعة الكتاب، أنّه كُتب في المرحلة ما بين تخرّجه من الثانويّة (1956) وبداية دراسته الجامعيّة، إذ تخرّج من الجامعة عام 1963، أي بدأ دراسته الجامعيّة عام 60/1959، وقد أكّد لي صحّة هذا التخمين أخوه الاستاذ أسد سلمان حين التقيته، ووَجَدَتْ الأحداث الجَلَل للمرحلة وتأثيراتها على الأمزجة والوعي السياسي والاجتماعي طريقها إلى ثنايا قصصه القصيرة، ولا يمكن دراستها وإدراك صياغاتها بمعزل عن ربطها ببيئتها الحاضنة فكريًا.
وقد تزّوج المحامي فرج سلمان بتاريخ 11.8.1968 من السيّدة آمال جريس جمّال أثناء مكوثه في مدينة حيفا قبل انتقاله إلى النّاصرة، ورُزِق بابنين درسا الحقوق كوالدهما: المحامي جوهر فرج سلمان والمحامي جريس فرج سلمان، اللذان لا يزالا يزاولان المهنة في ذات مكتب المحاماة ذائع الصيت.
مذكرات الكاتب:
كتب المحامي فرج نور سلمان، الكاتب، في مذكراته ملمّحًا عن شخصيته، ما يعيننا على سبر غور النصوص وفهمها أكثر، لتداخل افكار ابطال قصصه بآرائه ونهج حياته، مما يجعلنا نفهم انفتاح شخوص القصص على مواقف تيّارات سياسيّة وفكريّة كانت تُعتبر متباينة وأحيانًا متصادمة في تلك الفترة، فنتلمس فيها الموقف الوطني العام غير المتشنّج لتيّار سياسي بعينه، ما دام هذا التيّار يناضل من اجل إحقاق الحق، فنرى مقارعة السلطة الغاشمة، ومحاربة العمالة ومخاتير السلطة، تتجمع في القومي العروبي والاشتراكي والشيوعي، وكل هذا مشمولًا بالإنساني، وهي التيارات الفاعلة على ساحة فلسطينيي الداخل في خمسينيّات القرن الماضي، سنوات كتابة النصوص وتشكّل آراء الكاتب، قبل أن يشتدّ ساعد التيّارات الفكريّة الإسلاميّة، إذ بعد احتلال الكيان للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران عام 1967، توحّد الشعب الفلسطيني على أرضه من جديد وأمكن تواصله بعكس مراد الاحتلال ومكّن التأثيرات الفكريّة والسياسيّة ان تتفاعل بين جنبي "الخط الأخضر"، لتليه تأثيرات الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة ومعاهدة كامب ديفيد التطبيعيّة سيئة الصيت مع مصر عهد السادات، والتي لها جانب ايجابي لفلسطينيي الداخل، ألا وهو الانفتاح على العالم العربي بعد سنوات الانقطاع، بما في ذلك التواصل الثقافي والسياسي مع تيارات أساسية في مصر ومن خلالها. ويبدو انّ سلمان كان قادرًا على اخذ مسافة متساوية وناصعة من جميعهم، وتحكم علاقته بهم حريّة الرأي والموقف، وهو ما يرشح عن شخوص قصصه ومن مذكراته.
فيكتب في مذكراته: "لم انتمِ.. لا انتمي ولن انتمي إلى إطار سياسيّ طيلة حياتي وذلك حفاظًا على حريّتي في العمل، في التفكير، في التعبير، وفي اتخاذ قراري بنفسي". ويضيف: "لم اطمع ولا أطمع ولن اطمع في منصب أو مكافأة، وأنا أكره أكثر ما أكره التملّق والتزلّف والتبجّح وأومن ايمانًا مطلقًا عقلانيًا ومنطقيًا بكل ما اكتبه أو أقوله.. آثرت الحياة البسيطة والعزّة على حياة الرّغد والجاه مع طمس ولو ذرّة واحدة من أصولي العربيّة..".
وانحيازه لقضايا شعبه وعزّته وكرامته ديدنه، فكتب: "لست شخصيّة اجتماعيّة، لست قائدًا سياسيًا، لا يمينيًا ولا يساريًا، ولا بين بين، لست وزيرًا ولست أعلى من وزير، ولست ساعد وزير، لست نائبًا في البرلمان ولست من أعوان نائب، لست مصلحًا اجتماعيًا ولست مشرّعًا بل انني انسان بسيط من عامّة الشعب الغلابى، يتوجّع شعبي أئِنّ أنا، يجوع شعبي أخور أنا، يحزن شعبي أنوح أنا، يضحك شعبي أُشقرق أنا..".
الحكم العسكري:
كتبت الأديبة الفلسطينيّة نجوى قعوار- فرح، ابنة مدينة الناصرة في كتاب مذكّراتها واصفة فترة الحكم العسكري الذي فرضه الكيان الصهيوني على فلسطينيي الداخل (48) "وكان صباح... وكان مساء- أمالي الذكريات" الصادر عن دار النشر الأردنيّة " البيروني" عام 2014، ما يلي: "كوارث عام 48 كانت كثيرة ومتعدّدة الجوانب، لا يكاد المرء إن تكشّف له جانب، إلا واجهته جوانب لا عدد لها. وهي بذاتها لها تداعيات وتذييلات تُضَيِّق الحياة على الإنسان الفلسطيني إن لم أقل تزهده فيها. وبالنسبة للفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم، وكما ذكرت، فقد فُرِض الحكم العسكري علينا. لقد فُرِض على كل قرية ومدينة على العرب الذين أصبحوا تحت سلطة الحكومة الإسرائيليّة، وكانت (إسرائيل) قد تبنّت أحكام الحكم العسكري وغيرها من القوانين، كما سمّته حكومة الانتداب البريطاني "بأنظمة الدفاع"، وما تفرّع منها من تشريعات في غاية الإجحاف والبعد عن حقوق الإنسان، وكأنّه ميراث أورثته لربيبتها (إسرائيل)، منها حق الحاكم العسكري أن يفعل كما يشاء بالفلسطيني المقيم في منطقة ما، دون حق الفلسطيني بالشكوى لمحكمة مدنيّة، وذلك بحجّة "الأمن"، وهذا يشمل حريّة السفر، والتنقّل، ورُخَص العمل، والتوظيف، والإقامة الجبريّة، والنفي، ونسف البيوت، وقطع الأشجار، والسجن الفوري لستّة أشهر أو سنة دون سبب شرعي" صفحة 150.
حول التهجير والكتاب على لسان أخيه أسد نور سلمان:
جمعني لقاء بالاستاذ أسد نور سلمان، ابو خالد، أخو الكاتب فرج سلمان، في منزله في اعبلّين، يوم الأحد الذي وافق 27.10.2024 مساء. وكان من المخطط أن أسأل بضعة أسئلة حول الكتاب، بما قدّرته مسبقًا بجلسة قد تمتد إلى نصف ساعة، لكنك حين تزور بيت علم وأهل كَرَم تستطيع أن تحدّد متى تزور ومتى تدخل المنزل، لكن المغادرة تخرج عن دائرة قرارك، فلم اشعر كيف امتد اللقاء إلى ساعتين ونصف، والاستاذ أبو خالد يفيض بذاكرته المتّقدة عن النكبة وحامية قرية شعب والتهجير إلى لبنان والعودة والدراسة والكتاب الذي أصدره أخوه والتداعيات.. وهنا أنقل شذرات تتعلق بالكاتب والكتاب والبيئة الحاضنة، رغم أن ما زاده الأستاذ أسد يستحق التوثيق، وليته يخطّه بيده لئلا نفقد هذه المعلومات القيّمة. فما يُكتَب هو ما حدث، وما لا يُكتب كأنّه لم يحدث. هي معركة على الوعي، والتوثيق جزء منها.
ولد فرج سلمان في عائلة مؤلّفة من أحد عشر شخصَا: الوالد نور والوالدة كاملة وتسعة أبناء بحسب ترتيب اعمارهم: غزالة، معزّز، موسى، ميخائيل، فرج، أسد، عكرمة، نصر، عواطف. يتوسّط ثلاث أخوات وخمسة اخوة، في قرية اعبلين الجليليّة.
نزحت العائلة الى لبنان في عام النكبة، وقضت هناك نحو سنة وأربعة أشهر، سبعة أشهر منها في قرية رميش الحدوديّة ثمّ انتقلت العائلة إلى قرية عين ابل، إلى أن نجحت بالعودة إلى بلدتها اعبلّين. وكان هَمّ الوالدين العمل في الأرض من أجل تعليم الأبناء، وقد نجحا في هذا أيّما نجاح، وقد ذكرنا في مكان سابق عن رحلة دراسة فرج سلمان حتّى استقرّ به المطاف في مدينة الناصرة.
يقول الأستاذ أسد أنّه درس في الناصرة ثم انتقل في السنتين الأخيرتين إلى مدرسة خاضوري الزراعيّة وتخرّج منها: "بعد ان تخرّجت من مدرسة خضوري بجانب جبل الطور بتاريخ 20.8.1960 تعيّنت مدرّسا في قريتي اعبلّين، مدرسة اعبلّين الابتدائيّة (ب)"، ويشدّد: "بدون واسطات كما كان متّبعًا آنذاك بسبب حاجة وزارة المعارف إلى معلّمين". ويضيف أنّ أخيه المحامي فرج سلمان طبع مئات النسخ من كتابه، ما يربو على الألفي نسخة، لكن لا يذكر كم نسخة تحديدًا. ومنعت السُلطات والرقابة بيع الكتاب بسبب مضامينه التي اعترض عليها الحكم العسكري.
وكان الاستاذ أسد قد بدأ بتدريس الزراعة في بلدته اعبلين، وصدر الكتاب بعد ثلاثة أشهر من بدئه التدريس، فأخذ على عاتقه نشر قسم من الكتب، فحمل نُسخًا منه طاف بها في القرى المجاورة في محاولة لبيعه ونشره بين القراء والمثقفين. ووصلت الوشاية عنه إلى وزارة المعارف، واستدعاه المفتش العربي في وزارة المعارف، وخيّره بين التبرّؤ من أخيه أو طرده من العمل، فأجابه رأسًا ودون تردّد أو مقدّمات: "أنا سأعلن براءتي، ولكن سأعلن براءتي منكم ومن الوظيفة"، وفعلًا قدّم استقالته من وظيفته كمدرّس وعمل مزارعًا في أرض العائلة، وهو الخبير والمدرّس الزراعي. وبقي يعمل في أرضه نحو اربعة عشر عامًا، واحتاجت وزارة المعارف الى معلّمي زراعة متخصّصين، فتوجّه اليه مفتش المعارف للعودة الى التعليم، وعاد الى المدرسة دون ان يذهب الى مكتب الوزارة، وبموازاة التعليم عمل في أرض والده التي تقدّر بواحد وثلاثين دونمًا من الأرض الزراعيّة المرويّة، لأكثر من أربعين عامًا.
أمّا المحامي فرج سلمان، فقد استدعته سلطات الأمن للتحقيق معه حول الكتاب ومضامينه عدّة مرّات مسببين له العديد من المضايقات.
لمحة عن القصص القصيرة لا تغني عن قراءتها:
1 – إنسان. صفحة 4
يبدو أن جزءًا من القصص، أو جلّها ان لم يكن جميعها، قد كتبها اثناء دراسته حين كان الكاتب طالبًا في كلية الحقوق في الجامعة العبريّة في القدس، وهذا ما ترشح به بعض تفاصيل القصص، كما في هذه القصّة التي عنونها ب"إنسان"، فالراوي، وربما هو الكاتب نفسه، كان مسافرًا في القطار باتجاه القدس، ليقدّم امتحانًا بذل جهدًا في دراسته، ولا يريد أن يتبادل الحديث مع أحد كي لا يفقد قدرته على التركيز، وكي لا ينسى بعض مواد دراسته.
لكن تشاء المصادفة ان يجلس قربه ثرثار يهودي مستعمر، الذي تتدلّى من عنقه نجمة داوود السداسيّة، حاول استدراجه بالحديث بدءًا من حالة الطقس، مرورًا بانعدام القيم الأخلاقيّة، ثم عن المسكن فإذ به يقول انّه من سكان حيفا، الفلسطينيّة، وكأن حيفا بلد شعبه الموعود بها، ثم يجرّ الحديث غِلابًا نحو رأيه عن الحرب، ولم يُجْدِ الرّاوي نفعًا محاولة تهرّبه، فتحدّث هذا المستعمر عن بطولاته في الحرب وكيف اجهز على أسير جريح بالسكّين متفاخرًا، الأمر الذي تحرّمه كافة القوانين والاعراف الدوليّة، وكاد الراوي أن يصيح به "أنت وغد أنت سافل لا ضمير له". صفحة 9. هذا المستعمر تأثّر وتغير لون وجهه رحمة بحمار دهسه القطار، ليتبيّن لنا انّه سكرتير جمعيّة الرفق بالحيوان. وينهي الكاتب قصّته الاولى على لسان راويه: "ونظرت اليه باحتقار..." صفحة 9. فالكاتب لا يتوانى عن اتخاذ موقف معلن للنشر، بعضه في قرارة نفس بطله وبعضه جهارة، ينم عن وعي أممي بذكره الكونغو، وعن وعي قومي بمنظور انساني متشبث بمنظومة قيم القوانين الدوليّة، كما يليق بمحامي المستقبل.
2- مش مهم. صفحة 10
وفي القصّة الثانية التي يدعى بطلها بمحمود ويكنّى بأبي حسن، وهو عامل متزوّج وأب لسبعة اطفال عليه اطعامهم واشباعهم، فيضطر إلى النهوض باكرًا كل يوم الى العمل، في ظل الحكم العسكري، مما يوجب استصدار تصريح عمل ليستطيع الخروج إلى مناطق جغرافيّة خارج سياج الحكم العسكري الذي فُرض على العرب بعد نكبة عام 1948. وهو لاجيء من قرية مجاورة "طُرد منها بعد أن احتلّها الجيش بعد عدّة أسابيع، كما طُرد جميع سكان القرية، بحجّة من الحجج وقد وعدهم المسؤول عن ذلك بإرجاعهم الى القرية بعد عدّة ايام، ولكن، مضت ايام، وتبعتها اسابيع وتبعتها شهور وسنين عديدة "وعدّة أيام" هذه لم تنته بعد، و.. وقد هُدمت القرية كلها او.. القسم الأكبر فيها". صفحة 10. وهنا نرى تداخل القصّة بأحداث سياسيّة من تبعات النكبة كما حدث واقعيًا مع قريتي إقرث وكفر برعم وغيرهما. وابو حسن شخصيّة ايجابيّة في تعامله مع زوجه وأطفاله رغم شظف العيش.
تصف لنا القصّة عذابات الطبقة العاملة وشقاءها، وكثرة ساعات العمل من اجل تأمين لقمة العيش لأفواه الأطفال، المتداخلة بالقمع على أساس الصراع القومي. وعندما وصل ابو حسن إلى مركز الحكم العسكري، وعادة ما يكون في مركز الشرطة، لتجديد تصريح العمل الخاص به، وجد ان العمّال مضربون عن العمل من اجل تحسين ظروف وشروط عملهم وزيادة عدد الحافلات من اجل تقليل كثافة المسافرين من العمّال في طريقهم إلى العمل. واشتبك المضربون مع الشرطة، وانتصر ابو حسن لعروبته وكرامته، ورغم انه ليس من ذات البلدة "اشترك، نعم اشترك في المعركة، وخبط رجلًا من رجال البوليس، قذف بحجر وشعر بأن ضربته كانت شديدة ولكنّها ليست أشد من ضرباتهم هم.. وتهاوى رجل البوليس على الأرض يتلوّى من الألم". صفحة 12. وهرب ابو حسن، دون ان يجدّد تصريح العمل، بعد أن تلقّى العديد من الضربات.
وفي اليوم التالي احتار جمع العمّال من باقي البلدات بما عليهم أن يفعلوا لدعم اخوانهم المعتقلين، فهل يُضربون هم بدورهم؟! وجاء اقتراح ابو حسن الذي استحسنوه: "يذهب كلٌّ الى عمله ويتبرع براتب يوم أو يومين لعائلات المنكوبين في البلدة المجاورة، وعلت تعليقات الاستحسان من جميع الحاضرين"، صفحة 14. وهنا نلمس تداخلًا بين الوعي القومي والوعي الطبقي الذي انعكس بالتضامن العمّالي، والوعي النقابي الذي انعكس بالدعم المادي لعائلات المعتقلين.
وفي الحافلة، يهاجم ابو حسن المختارَ، الذي يعتبر أحد ركائز الحكم العسكري وأحد أعوانه، بسخريته الّلاذعة المؤلمة، ويجعله أضحوكة العمّال في الحافلة التي تنقلهم صباحًا إلى العمل.. (ملاحظة تستدعيها الأمانة: لم يكن جميع المخاتير بهذه الصورة السلبيّة بعضهم توارث هذا المنصب او الموقع الاجتماعي- سياسي وقام بدوره بجدارة، حتّى أنّ البعض كان من قيادات الثورات)، ويهاجم أبو حسن إجحاف محاكم الكيان ومنظومة القضاء وينتقد بجرأة وسخرية عدم عدلها لقضايا العرب، خصوصًا إذا ما تعلّق الأمر بملكيّة الأراضي.
والحوار بين الشيوعي المثقَّف، معين صادق من جهة، وجبران، الإنسان البسيط من جهة اخرى، حول مجزرة كفر قاسم وقرار محاكم الكيان بتغريم المجرمين بقرش! وعن الانتخابات وانتقاد تصويت العرب في الانتخابات البرلمانية للأحزاب الصهيونيّة التي هجّرتهم ودمّرت قراهم، ولا تزال تلاحق الآخرين بشتّى الوسائل، ودور المختار الرجعي العميل في الانتخابات، واذدنابه للاحزاب الصهيونيّة ضد مصالح أبناء شعبه، كلّ هذا ينم عن وعي سياسي لشروط المرحلة، وانفتاح على القوى الوطنية الفاعلة، وإن لم ينتمِ المؤلّف إلى صفوفها وعضويتها الرسميّة.
وفي النهاية لا يتوانى ابو حسن عن دفع ثمن مواقفه. حاجز الشرطة يوقف حافلة العمال، ويبحث في صحّة تواريخ تصاريح العمل، فتعتقل الشرطة ابو حسن لأنه مسافر دون تصريح عمل، إذ انه لم يجدده في خضم الإضراب والمعركة اللتان شارك بهما، وتبيت زوجته وأطفاله السبعة دون قوت.
3- يحيا.. العدل. صفحة 25
الراوي ورفيقه، بعد أن طُردا من العمل أو توقف عملهما لأجل غير مسمّى، يتجولان في الشارع العام، دون هدف، ودون مال: "لكن عينيَّ قد التصقتا بشدّة وبعنف في وجه اصفر عجوز وكأنّما كُتب عليه "هنا يرقد البؤس والفقر" وكان حامل هذا الوجه قد "كوّم" نفسه وعظامه في إحدى زوايا الشارع مادًا يديه للمارّين ومددت يدي إلى جيبي لأناوله بعض النقود ولكنها.. اصطدمت باللحم.. و.. تابعت سيري" صفحة 26. لم يكن لديه أجرة الباص ليعود إلى القرية. وكذلك رفيقه، والطقس حار جدًا، فقرّرا التريّث لحينما تُغرب الشمس، فيبترد الجو قليلًا بحيث يصبح بوسعهما السير على الأقدام عودة إلى قريتهما.. وريثما تغيب الشمس قرّرا الذهاب إلى قاعة المحكمة القريبة منهما، لتمضية الوقت. وورقة تصريح الراوي التي استصدرها من الحاكم العسكري في جيبه، تأكد من وجودها. "ودخل الحاكم يلبس جبّة سوداء.. ولكنّها لا تعادل في سوادها قلب رجل استعماري". صفحة 30. وهذا التشبيه ينم عن موقف رافض للاحتلال الصهيوني ربيب الاستعمار العالمي، الأبيض.
هذا القاضي يحاكم بحسب قانون المستعمر المحتل ظلمًا، فجعل من الرجل العجوز مذنبًا وهو صاحب حق، فصاح جمهور المستوطنين المستعمرين "يحيا العدل" طربًا للقرار، لأنه عدل السارق ضد صاحب الحق. وحاكَم المرأة العجوز، وصرخ الجمهور عقب القرار الجائر مرّة اخرى: "يحيا العدل". وبعدها بدأت محاكمة ضبّاط الكيان الثلاثة الذين نفّذوا مجزرة بالعرب، حيث تلقّوا الأوامر بالّلاسلكي: "احصدوا كلّ مشتبه به" صفحة 37، وهي اشارة واضحة تحيلنا الى مجزرة كفر قاسم، لم يذكرها بالاسم، التي نفّذها جيش الكيان عام 1956 عشيّة العدوان الثلاثي على مصر، وشارك به الكيان مع كل من فرنسا وبريطانيا، بهدف اسقاط نظام جمال عبد الناصر بعد تأميمه لقناة السويس ودعمه لثورة الجزائر بكامل الإمكانات. وتسلسل احداث المحاكمة يؤكد ارتباطها بمجزرة كفر قاسم.
يقول الراوي في مجرى المحاكمة، عند سماعه علل المجرمين: "وشعرت بعضلات وجهي تتقلّص وأردت ان اصرخ شيئًا.. مسبّة مثلًا.. أي شيء.. أيّة كلمة نابية "ألصقها" في وجه هؤلاء السفّاكين الفاشيين.. ولكن صديقي أمسكني بشدّة" صفحة 38-39. وإن لم يتّخذ هنا الراوي موقفًا جهارًا في القصّة، إنما في دخيلته التي أصمتها رفيقه، فقد اتّخذ الكاتب موقفًا جهارًا من خلال الصوت الداخلي لراوي قصّته الذي وصل واضحًا إلى المتلقّي/ القارئ/ والحكم العسكري الفعلي/ وسلطة الرقيب.. وهو أمر منوط بدفع أثمان باهظة في تلك الفترة قد تصل حد السجن وإغلاق ابواب العمل ومنع اصدار التصاريح.. وأكثر.
وفي النهاية يكون الحكم على الضبّاط مجرمي المجزرة شكليًا ويغرّم كبيرهم بعشرة ملّات ( والمِل عملة زهيدة جدًا ليست بذات قيمة)، مما يذكّرنا بقرش شدمي ومجزرة كفر قاسم، فيصرخ الجمهور المستعمر الحاضر في المحكمة، كما يصرخ بعد كل قرار، "يحيا العدل" فيصرخ الرّاوي معترضًا على اجحاف القرار: "العدل.. العدل.. العدل.." صفحة 41 بمعنى المطالبة بالحق والعدل. وهنا ايضًا نرى الكاتب يأخذ موقفًا حازمًا ضد الاستعمار وقوانينه الجائرة، ويمزّق بمبضعه محاكمهم الموهومة.. وأكرّر أنّ هذا الموقف جريء فيه مخاطرة ومنوط بدفع أثمان قد تصل حد السجن وملاحقة المخابرات وسحب رخصة المحاماة (التي كان يدرسها أثناء كتابة ونشر الكتاب)، وربما أكثر، إذ اننا نتحدّث عن سياق الحكم العسكري وأنظمة الطوارئ بعد نكبة فلسطين.
4 – قديسة. صفحة 42
يتحدّث الكاتب في قصّته الرابعة من سباعيّته عن مومس تدعى ناديا، ويُعَنْوِن القصّة بعنوان "قدّيسة"، وتلتقطها عدسة مخيّلة القارئ وهي مستلقية على سريرها، وفي قبضتها نقود من زبونها، رجل نهم ينهش جسدها دون مشاعر تحسّها هي أو يشعر بها هو، أثناء ممارستة حب جسدي ميكانيكي خالٍ من أي عاطفة! وتسمع مواء قطّة ولدت حديثًا ومواء هريراتها ليستثار اشمئزازها من الوضع والحال الذي آلت اليه مرغمة بسبب ظروفها وقساوة ما مرت به الذي نهش ولا يزال ينهش بجسدها. تلك الظروف التي افقدتها امكانيّة العيش بكرامة وتكوين أسرة كالقطّة.. كحق أساسي طبيعي.
فتقف المومس بعدها أمام المرآة لتتفقد جسدها العاري، وترى ما فعلت به الأيام وقد كان آية في الجمال، "رأت نهديها وقد ترهّلا.. لا.. لم ترهما قبل اليوم هكذا.. كانا دائمًا وكأنّهما جنديان من جنود نابليون في أيام انتصاراته يسيران في مقدمة الصف، أما اليوم.. فإنّهما كجنديين من ابناء هذا الشعب.. فتك بهما ابناء الجزائر". صفحة 46.
لقد كان هذا الدمج رائعًا في التشبيه، يغرف من عمق التاريخ ويقارنه بالحاضر المُعاش، مشبّها نهدي المومس المترهلين بجنود الاستعمار الفرنسي بعد اندحارهم أمام ثوّار الجزائر، تلك الثورة التي اندلعت بين عامي 1954م و1962م، الفترة الموازية لكتابة هذه السباعيّة، والتي الهبت شباب العالم التقدمي، فما بالكم بشباب العالم العربي والإسلامي، والتي أثّرت بكاتبنا دون ادنى شك. ملمحًا، بحُسن وظرافة ودون اقحام غرائب التشبيه رغم بعد الموضوعين، ليستنتج المتلقي ان المومس ضحيّة مجتمع هو بدوره ضحيّة احتلال واستعمار، مما يجعل المومس ضحيّة او قديسة بمفهوم نسبي، وهي رؤية ذات منظور طبقي ماركسي اجتماعي.. دون أن ينتمي الكاتب لأي من الأحزاب السياسيّة التي رفعت هذا اللواء، وبالأخص الحزب الشيوعي، وهو الأقوى في حينه في مدينة الناصرة التي عاش ودرس فيها الكاتب، وبين فلسطينيي الداخل في تلك الفترة، في مقابل الأحزاب الصهيونيّة. إذا ما أضفنا اليها تأثير جماعة "حركة الأرض" ذات الميول القوميّة الاشتراكيّة، والتي تأسست عام 1959م.
5- نقطة سوداء. صفحة 50
"خرج فريد من قاعة الاجتماع"، هكذا يبدأ قصّته، لكن لا نفهم من البداية عن أي قاعة يتحدّث او اي اجتماع عنى! حتّى يتكشّف لنا قبل نهاية القصّة بقليل أنّ فريد كان طالبًا جامعيًا في سنته الأخيرة، وقد قارب على التخرّج، لم يتبقّ له سوى أشهُر معدودات، في فترة الحكم العسكري الذي فرضه الكيان الصهيوني على من صمد وبقي على ارض وطنه، أرض الآباء والأجداد، فلسطين ما بعد النّكبة، وهي الفترة الممتدة من العام 1948م حتّى العام 1967م، وبعدها أُحيلت صلاحيّات الحكم العسكري إلى جهازي الشرطة والمخابرات بإشراف قيادة اركان جيش الكيان، ثم رُفع نهائيًا في نهاية العام 1968م. وكان قد صمد على أرض وطنه 156،000 فلسطيني في الجليل والنقب والمثلث. وكان التنقل من منطقة الى اخرى لعلّة العمل او الدراسة أو زيارة الأهل أو غيره يتطلّب تصريحًا من الحاكم العسكري وحاشيته في كلّ منطقة ومنطقة، عمليّة منوطة بإهانة السكان وتعذيبهم بالوقوف في طوابير طويلة لساعات وساعات، وقد يُرفض الطلب بعدها على أساس سياسي واعتبار امني وأحيانًا أهواء الضبّاط، مما جعل التصاريح واستصدارها أرضًا خصبة لنشاط العملاء وسوقًا فاسدة سوداء لتجبّر المتعاونين مع الكيان، الأمر الذي اعتبر منذ البدايات نقطة سوداء على من يتعاون، في عيون الناس، ونقطة سوداء لدى السلطة لمن يعترض او يثير وعي الناس ضد الظلم والطغيان.
بطل قصّتنا، فريد، ابن لمجاهد كان يقود فرقة صغيرة من الثوّار ضد الاستعمار البريطاني قبل قيام دولة الكيان، أو على الأقل هكذا يُفهم من النّص، وكاد يُنَفَّذ به حكم اعدام، مما "أشعر فريد بشيء من الاعتزاز والرِفعة" صفحة 52، "كان يشعر بأنّ أباه أب، وبأنّه هو عليه أن يكون كأبيه، يجب عليه ألّا يكون خنوعًا ذليل النّفس" صفحة 52، هذا الذي ضحّى من أجل شعبه وكرامة شعبه. وقد بلغ فريد الرابعة والعشرين من عمره، وهو تقريبًا من جيل الكاتب فرج سلمان حين نشر كتابه، نضف إلى ذلك ما ذكره أخو الكاتب، أسد نور سلمان، في الكُتيِّب الذي أصدرته عائلتهما "في ذكرى المحامي والكاتب فرج نور سلمان"، الذي يفتقد الى ترقيم لصفحاته، أنّ والدهما نور المخايل "كان وطنيًا وفصيلًا في ثورة 1936". مما يؤكّد ادّعاءنا بتداخل سيرة الكاتب ببعض جوانب قصصه.
بالعودة إلى فريد، "فهو لم يعد يستطيع بعد أن سمع ما سمعه، لم يستطع ان يقرأ شيئًا. إنّ هنالك نقطة سوداء قاتمة في تاريخه وعليه أن يتخلّص منها".. " وتاريخه وتاريخ والده لا يشفعان له ولا يخلّصانه من هذه النقطة السوداء القاتمة" صفحة 53. ونرى بهذا التزام بطل القصّة بقضايا شعبه وابتعاده عن مناصب القيادة والتزعّم: "إنّه ليس ضد شيء سوى الأوضاع القائمة، سوى هذه الأحكام المجحفة المفروضة عليه".. عليه بمعنى على شعبه. إنّه لا يميل لأيّة فئة من الفئات المختلفة والمتناحرة... إنّه لا يفكّر في زعامة، إنّه لا يفكّر في كرسي البرلمان.." صفحة 54. ويكتب سلمان في مذكّراته: "لست شخصيّة اجتماعيّة، لست قائدًا سياسيًا، لا يمينيًا ولا يساريًا، ولا بين بين، لست وزيرًا ولست أعلى من وزير، ولست ساعد وزير، لست نائبًا في البرلمان ولست من أعوان نائب، لست مصلحًا اجتماعيًا ولست مشرّعًا بل انني انسان بسيط من عامّة الشعب الغلابى، يتوجّع شعبي أئِنّ أنا، يجوع شعبي أخور أنا، يحزن شعبي أنوح أنا، يضحك شعبي أُشقرق أنا.."، وهذا مما يؤكّد مرّة أخرى نظرتنا بتداخل سيرة بعض ابطال قصصه بسيرته الذّاتيّة. وينتقد الكاتب، على لسان بطله فريد، تعامل الحكم العسكري وقمعه لشعبه الفلسطيني، وطوابير الانتظار في سبيل الحصول على تصاريح العمل، وإن رُفض طلب التصريح لعامل معناه أن يبيت وأفواه أطفاله وزوجته دون قوت يومهم، مما يجعل شعور فريد بالذنب لحصوله على تصريح عمل أو دراسة دون جهد ومعاناة مبرّرًا إلى أقصى حد أمام معاناة العمّال في طوابير الانتظار، وإن لم يكن له ذنب في هذا، ويجعله محط ريبة في عيون من يشقى! فلم يستطع صبرًا، وتمرّد انتصارًا لشعبه وللطبقة العاملة المُهانة المُذَلَّة على طول الطابور، مما أدخل اسمه في قائمة الحاكم العسكري السوداء! ولكن فريد فخر بهذا، فهو يسير على درب والده الثائر ضد الاستعمار، واعتبر هذا وسام شرف، ولكن ما اعتبره نقطة سوداء قاتمة في تاريخه وجود ابن عمّه المدعو شاكر والمتعاون مع الحكم العسكري! فقد كان يومها فريد "واقفًا في دوره لتجديد تصريحه، وكان ما يزال يثير في الناس شعور الكرامة والعِزَّة، ويشجعهم على عدم الخوف من هذه الحثالات. ودخل شاكر احد هؤلاء الذين يكونون النقطة السوداء في تاريخه، وكان يحمل اكثر من ثلاثين هويّة في يده وحيّاه بصوت عالٍ، واضطر فريد يومها ان يردّ التحيّة، وعندما وقف شاكر امام المساعد ليعدّ له هذه التصاريح لكلّ هذه الهويّات التي يحملها، سأله أحد الواقفين من أين يعرف شاكرًا واضطرّ يومها ان يصرّح بالحقيقة المرّة، نعم، فشاكر هو ابن عمّه.." صفحة 56. مما أشعره بالخزي والخجل. مما اضطرّه في النهاية إلى ان يلجأ لاستعمال السلاح الذي يرقد في جيبه، القلم، فكتب إعلان براءة من ابن عمّه العميل المتعاون مع منظومة الحكم العسكري القامعة لشعبه، كصفعة لكل العملاء، وهذا موقف وطني جريء من الكاتب، اذا ما علمنا بأن الكاتب اتخذ هذا الموقف لبطل قصّته ونشر كتابه في فترة الحكم العسكري، وموقف كهذا باهظ الثمن منوط بمخاطر قد تؤدي الى السجن ومنع التنقل واغلاق فرص العمل ومضايقات لا نهاية لها.
6- وحش. صفحة 61
وتتحدّث هذه القصّة عن "جميل"، رجل قبيح مشوّه الخلقة بعكس اسمه، فقير، مهمّش، يحلم بفتاة يحبّها، ويرى بحصوله على أي فتاة مهما كانت أمر مستحيل، متوهّج الغرائز حدود الوحش الداخلي، حتّى يتعرّف على امرأة أقرب إلى الرجال بهيأتها، قبيحة، فاقدة للأنوثة، اسمها "آمنة"، وهي أيضًا فاقدة الأمل ببناء عش الزوجيّة التي تحلم به، تحلم بأن تضم رجل، هي جارته في كوخ آخر، تعرّف عليها، ساعدها في توضيب وترميم كوخها، وهي تساعده في شؤون منزله، وتهتم به عند مرضه، حتّى تتفجر غرائزهما: "وثار وحش.. وثار وحشان.. وحشان هائلان.. وثارت غريزتان عاشتا عشرات السنين مكبوتتين.. ثارتا دفعة واحدة.. ورفع جميل نظره إلى عينيها، وبدون ان يتردد امسكها من خصرها واجتذبها واجتذبها بشدّة.. بوحشيّة وارتمت هي بشدّة وبوحشيّة على الفراش الممزّق وزمجر الوحشان واشتبكا في عراك.. عراك عنيف يحاول احدهما ان يقتل الآخر بشدّة وبوحشيّة". صفحة 70.
وإن كانت هذه القصّة خارج مثار بحثنا المباشر في إطار "أدب المقاومة النثري" بمفهومه الضيّق ضد الاحتلال، إلا انها توسّع هذا المفهوم ضد الظلم الاجتماعي من اجل إحقاق الحق الطبيعي، الحق بالحب والارتباط بالجنس الآخر وبناء عش الزوجيّة رغم انعدام المقدرات بأشكالها. وهنا ايضًا نرى بطَلَي القصّة يتخذان موقفًا ثائرًا، حتّى يتجاوز حدود العرف والشرع، أملاه عليهما ظلم الطبيعة والمجتمع.
7 – ثأر. صفحة 71
"لم يتحرّك أحد، كل شخص بقي في مكانه وكأنّ أحد لم يدخل، وأخذ البعض يتلهّون بالجرائد أو المجلّات التي في ايديهم، أو يُظهرون النعاس، حتّى لا تصطدم عيونهم بعينيها، لأنها اذا اصطدمت فلا شك انها ستولّد شيئًا من الحياء ولا شك ان هذا الحياء سيحرم شخصًا من مكانه، ومن منهم مستعد أن يطويها ساعتين ونصف الساعة واقفًا؟ كانت السفرة طويلة حقًا، وكان من الصعب على أي شخص أن يضحي ساعتين ونصف الساعة من اجل شخص آخر". هذا ما دار في خلد بطل قصّتنا حسن، ابن الثالثة والعشرين من عمره، وهو يستقلّ الحافلة في سفرة طويلة، ويبدو انّ الركّاب المسافرين معه كلّهم من اليهود وهو العربي الوحيد، وقد صعدت الحافلة امرأة تجاوزت الخامسة والسبعين من عمرها، وهي ايضًا يهوديّة، ولا يوجد مقعد شاغر لتجلس عليه.
ولكن حسن يدخل في صراع داخلي بين ما تربّى عليه من قيم انسانيّة في ثقافتنا العربيّة الإسلاميّة، وبين حقّه بالانتقام لمقتل ابيه وأخيه على يد جيش الكيان: "فقد كان يعرف كل شيء عن مقتل ابيه.. في أحد أيام الصيف الجميلة قبل اثنتي عشرة سنة دخل البلدة جيش بعد ان تركها الجيش وأمر جميع رجال بلدته وشبابها ان يتجمعوا في ساحة البلدة العامة، وتجمعوا ووقف حولهم بعض الجنود المدججين بالسلاح. وكان ابوه من جملة الذين وقفوا.. وبعد فترة قصيرة سمعت اصوات طلقات نارية وخيم هدوء على القرية. ودفن خمسة عشر من ابنائها في قبر واحد". صفحة73.
وفي حادثة اخرى تليها يُقتل أخوه وزوجة أخيه الحامل، فالمجازر مشهد عام متكرّر في الصراع العربي- الغربي بتجلّيه "الإسرائيلي"، والناس كتلة مشاعر من لحم ودم، تبغي معاقبة المجرم في كيان يشرعن ويبرّر ويبرّئ المجرم اذا ما كان الضحايا عرب، كما في مجزرة كفر قاسم عام 1956م وغيرها من المجازر. قد يكون زوجها أو ابنها قاتل أبيه! وقد.. وقد.. ولكن لا يحرّك أحد ساكنًا في الحافلة، فيقف، ربما لا إراديًا بدافع رُقيّ شواحن الحضارة والتربية، ويجلسها مكانه، ويذهب تردّده هباءً، وتتغلّب انسانيته على حقّه بالانتقام الرّمزي! وبرأيي، فإنّ عدم التشبّه بوحشيّة المُحتَل، والحفاظ على القيم رغم الطغيان، هو نوع من أنواع المقاومة، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة والمُشرّعة دوليًا، وتتماشى مع قيمنا العليا.
خاتمة
حاولنا في هذه الدراسة، تحت ظلال الحرب على غزّة ولبنان (طوفان الأقصى، 24/2023) والنكبة المستمرّة التي تشنّها الولايات المتحدة الأمريكيّة والغرب الأوروبي عبر وكلائهم وأذيالهم كالكيان وبعض الأنظمة العربيّة، أن نستعيد الحالة الثقافيّة في فترة الحكم العسكري في الداخل الفلسطيني لنعيد تقييم كتاب "أبرياء... وجلّادون" الذي ألّفه الكاتب المحامي فرج نور سلمان، ولم يأخذ حقّه في الأبحاث والدراسات، رغم أهميّته القصوى كأوّل مجموعة قصص قصيرة تُنشَر في الداخل الفلسطيني تحت عنوان: "أدب المقاومة النثري"، دون الانتقاص من أي من المؤلّفات التي سبقته ولم تدخل تحت هذا العنوان والتصنيف، لأنّها أدّت أدوار وظيفيّة هامّة أخرى.
ما يميّز هذه الدراسة، وان كانت تبحث كتابًا وكاتبًا محدّدَين، فإنها تبحث في طريقها عن سؤال امتداد وبدايات الثقافة في فلسطين الداخل مباشرة بعد النّكبة وتحت الحكم العسكري، وهواجس فرسان الثقافة وإدراكهم للدور التاريخي الذي يرفعونه على كاهلهم مع إدراكهم لأثمان هذا الدور. فها هو الشاعر جورج نجيب خليل يذكر في مقدمة ديوانه "ورد وقتاد" الذي طبع في مطبعة الحكيم في الناصرة عام 1953 ويُعتبر أول ديوان يُنشَر بعد النّكبة في الداخل الفلسطيني: "هنالك سبب ثالث كان له أشد الأثر على اسراعي في طبع هذه المجموعة.. هو وقوف الادب العربي في البلاد مشلولًا طيلة السنوات الأخيرة المنصرمة. لذلك أهيب بذوي القرائح الوقادة ان يتكاتفوا لاحياء الادب الذي وقف دولابه- على الأقل- ان لم يكن تدهورًا ملموسًا". ليليه الشاعر عيسى لوباني فيذكر في مقدّمة ديوانه "أحلام حائر" الذي طبع أيضًا في مطبعة الحكيم في النّاصرة عام 1954 : "الفن تضحية وطموح يجب على كل فنان أصيل ان يتصف بهما، فلولا ذلك لما كانت حضارة ولا فنون..."، ويضيف، "بعد انتظار طويل وصبر كبير تخلّلتهما فترات مفعمة باليأس وأخرى مشبعة بالرجاء، استطعت ان اتغلّب على بعض الصعوبات واخرج هذه المجموعة الشعريّة التي لا اقول بأني بلغت بها حدّ الكمال ولكني بها أضع حجرًا- ولو كان صغيرًا- في المدماك الأوّل من عمارة الثقافة العربيّة" في الداخل الفلسطيني.
نحني هاماتنا لهذا الجيل الطليعي الذي نقرأه في سياق المرحلة، والذي نهض مثل عنقاء الرماد من بين الأنقاض ليبني لنا صرح الثقافة.
-انتهت الدراسة-
قائمة بالمراجع:
بليخانوف جورجي، دور الفرد في التاريخ، ترجمة إحسان سركيس، دار دمشق للطباعة والنشر، 1974.
بولس حبيب، انطولوجيا القصّة العربيّة الفلسطينيّة في اسرائيل خلال نصف قرن، دار الهدى- كفر قرع ودار الفكر- عمّان، 2012.
حبيبي إميل، سداسيّة الأيّام الستّة- الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد ابي النحس المتشائل وقصص اخرى، منشورات عربسك، حيفا، 1974.
حدّاد ميشيل، إعداد وتقديم، أقاصيص، منشورات "المجتمع" ومطبعة الحكيم، النّاصرة، 1956.
خليل جورج نجيب، ورد وقتاد، شعر، مطبعة الحكيم، الناصرة، 1953.
سلمان فرج، أبرياء... وجلّادون، المطبعة التجارية في عكا، عكا، 1960.
عبّاسي محمود، "تطوّر الرواية والقصة القصيرة في الأدب العربي في اسرائيل/ 1948- 1976"، ترجمة حسين محمود حمزة، مكتبة كل شيء- حيفا ودار المشرق للترجمة والطباعة والنشر- شفاعمرو، 1998.
غنايم محمود، الجديد في نصف قرن- سرد ببليوغرافي، مركز دراسات الأدب العربي، بيت بيرل، 2004.
فاهوم ي. (يحيى)، الفلّاحون في الأرض، مطبعة الحكيم، الناصرة، 1957.
في ذكرى المحامي والكاتب فرج نور سلمان، 2024، كُتيِّب من اصدار عائلته في ذكرى وفاته
قعوار- فرح نجوى، وكان صباح... وكان مساء، دار البيروني للنشر والتوزيع، عمان 2014.
قعوار- فرح نجوى، دروب ومصابيح، مطبعة الحكيم، الناصرة، 1956.
كنفاني غسان، أدب المقاومة في فلسطين المحتلّة 1948-1966، منشورات دار الآداب، بيروت، 1966.
القاسم كمال عالية، خصوصيّة المكان في القصّة العربيّة القصيرة في اسرائيل، دار الهدى، كفر قرع، بدون سنة الاصدار
لوباني عيسى، أحلام حائر، شعر، مطبعة الحكيم، الناصرة، 1954.
م.ت.ف.، دائرة الثقافة، أنطولوجيا القصّة القصيرة الفلسطينيّة، دار الكرمل، عمان، عام 1990.
معمّر توفيق، المتسلّل وقصص اخرى، مطبعة الحكيم، الناصرة، 1957.
معمّر توفيق، بتهون، مطبعة الحكيم، الناصرة، 1959
معمّر توفيق المحامي، حيفا في المعركة- مذكّرات لاجئ فلسطيني وقصص اخرى، المطبعة الشعبيّة، الناصرة، الطبعة الثانية 1987. (الطبعة الاولى عن مطبعة الحكيم في الناصرة عام 1958).
#زاهر_بولس (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أَمْست.. دَام العِّزّ
-
جنون اليراع
-
شِهَارُ المَوَاضِي صَوَارِيْنَا
-
دراسة حول رواية أغصان حسن: -أنثى ما فوق الخطيئة-
-
(الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي لفل
...
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي لفلس
...
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (14)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (13)
-
الوطنيّة والمواطنة، مشروع تدجين طوعي (12)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (11)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (10)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (9)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (8)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (7)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (6)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (5)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (4)
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (2)+
...
-
الوطنيّة والمواطنة ومسؤوليّة الأقليّة: مشروع تدجين طوعي (1)
-
وَنَبِيْذِي سَيَّالٌ عَلَى جِيْدٍ تَقِيْ
المزيد.....
-
فنان مصري يوجه رسالة بعد هجوم على حديثه أمام السيسي
-
عاجل | حماس: إقدام مجموعة من المجرمين على خطف وقتل أحد عناصر
...
-
الشيخ عبد الله المبارك الصباح.. رجل ثقافة وفكر وعطاء
-
6 أفلام تتنافس على الإيرادات بين الكوميديا والمغامرة في عيد
...
-
-في عز الضهر-.. مينا مسعود يكشف عن الإعلان الرسمي لأول أفلام
...
-
واتساب يتيح للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى الحالة
-
“الكــوميديــا تعــود بقــوة مع عــامــر“ فيلم شباب البومب 2
...
-
طه دسوقي.. من خجول المسرح إلى نجم الشاشة
-
-الغرفة الزهراء-.. زنزانة إسرائيلية ظاهرها العذاب وباطنها ال
...
-
نوال الزغبي تتعثر على المسرح خلال حفلها في بيروت وتعلق: -كنت
...
المزيد.....
-
تحت الركام
/ الشهبي أحمد
-
رواية: -النباتية-. لهان كانغ - الفصل الأول - ت: من اليابانية
...
/ أكد الجبوري
-
نحبّكِ يا نعيمة: (شهادات إنسانيّة وإبداعيّة بأقلام مَنْ عاصر
...
/ د. سناء الشعلان
-
أدركها النسيان
/ سناء شعلان
-
مختارات من الشعر العربي المعاصر كتاب كامل
/ كاظم حسن سعيد
-
نظرات نقدية في تجربة السيد حافظ الإبداعية 111
/ مصطفى رمضاني
-
جحيم المعتقلات في العراق كتاب كامل
/ كاظم حسن سعيد
-
رضاب سام
/ سجاد حسن عواد
-
اللغة الشعرية في رواية كابتشينو ل السيد حافظ - 110
/ وردة عطابي - إشراق عماري
-
تجربة الميج 21 الأولي لفاطمة ياسين
/ محمد دوير
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة