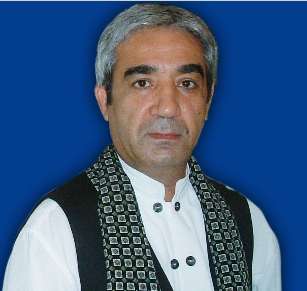ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)


الحوار المتمدن-العدد: 1503 - 2006 / 3 / 28 - 09:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إن اشد المراحل مرارة بالنسبة للعقل النقدي والضمير الحر هي تلك التي تختلط فيها دماء الأبرياء برياء الساسة ونزواتهم التي لا تكترث بشيء غير السلطة والجاه. وهي حالة لا حول فيها ولا قوة لغير الدجل والاستعداد للانغماس فيه بفعل تغلغل الرذيلة في الوعي والإرادة. وهي حالة عادة ما تستفحل زمن الانقلابات الحادة وغياب فكرة الدولة والقيم الاجتماعية في الفكرة السياسية. عندها تتكثف جميع القيم في بؤرة مستعدة لقبول مختلف أصناف الرذيلة والانغماس فيها. ويصبح الفعل والفاعل مجرد دوران في فلك التطويع المتفنن للغريزة. إذ لا عقل يحكم السلوك ولا حدود تحكم الإرادة!
وحالما يصبح هذا النموذج الصيغة الأكثر انتشارا وسيادة في الوعي والممارسة السياسية، حينذاك تصبح رعشة الجسد المرتوية من لذة الجنس، وطعنة السكين، ومطالبة الدائن بدينه، ومواجهة النتائج المخيبة، وانتظار الأمل المفرح، أمورا متكافئة. وذلك لان التباين في المشاعر والمواقف يفترض تكامل الرؤية وإدراك الأولويات. فإدراك وتحسس حمرة الخجل وصفرة الوجل تفترض تباين المشاعر تجاه النفس والعالم المحيط. وهو تباين محكوم بتمايز العقل والوجدان وترابطهما في الإرادة الإنسانية. أي كل ما يهذب ويشذب القيم الأخلاقية ويرفعهما إلى مصاف المنظومة العملية القادرة على توجيه السلوك الفردي والاجتماعي صوب إدراك أولوية المصالح العامة والفعل بموجبها. وهي أخلاق تشكل من حيث الجوهر مضمون الأخلاق السياسية بوصفها أخلاق إدارة شئون المجتمع والدولة بالشكل الذي يضمن على الدوام الحد الأدنى من تراكمهما بمعايير الدولة والمصالح القومية العليا.
لكننا حالما ننظر إلى واقع العراق الحالي وسلوك الخواص والعوام، أو النخب والجمهور، فإننا نقف أمام حالة تختفي معها اشد المفاهيم والقيم جلاء، كما لو أننا نقف أمام الفكرة التي بلورتها الفلسفة الإسلامية والقائلة، بان سبب خفاء الله هو لشدة ظهوره. وهي الحالة التي "يحققها" العراق ونخبه السياسية والمجتمع عموما، بحيث يصعب رؤية الانحطاط فيه لشدة انتشاره وظهوره. وفي هذا تكمن فيما يبدو مرارة المرحلة وضرورتها في الوقت نفسه. بمعنى أن العراق والعراقيين ينبغي أن يمروا بطريق الآلام لكي يكون بإمكانهما التفريق بين دفئ النار وحريقها. فالتحولات العاصفة التي تمس الأمم ما هي في الواقع سوى الوجه الظاهري لما يجري في أعماقها من تغيرات فعلية. وهي فكرة سبق وأن صورها ابن عربي قبل قرون عديدة عندما قال بان ما يجري هو استعداد لما فينا، فما اثر فينا غيرنا. وهي فكرة حالما ننقلها من دهاليز الباطنية المتسامية إلى ميدان الحياة السياسية الخشنة فإنها تبدو حكما اقرب إلى البديهة.
لكننا نعرف جيدا بان البديهة في ميدان السياسة هي ليست ذاتها في العلم والمنطق، مع أن السياسة لا تقل منطقية عن غيرها. إلا أن الذي يعطي للسياسي المغامر إمكانية تجاوز أمورها البديهية كون نتائجها ليست مباشرة بالضرورة. مع أنها تحتوي في كل فعل على نتائجه الملازمة. فالاستبداد مهما طال بسبب "منظومة" العنف والإكراه المقننة يؤدي بالضرورة إلى الانهيار والخراب.
غير أن التاريخ السياسي يكشف عن أن البديهيات في ميدان الحياة السياسية قد تكون أمور اقرب إلى الفرضية. وهي حالة تشير أما إلى واقع التخلف الشامل أو الانحطاط الشامل. وفي ظروف العراق الحالية، نعثر على تداخل وتضافر الاثنين. وهي حالة لا تخص العراق، إلا أنها تتميز في ظل ظروف الانتقال من التوتاليتارية إلى الديمقراطية بنزعة مخربة وهوجاء. وسببها الجوهري يقوم في ضعف وفقدان البنية التحتية للدولة الشرعية وتقاليدها السياسية، وانهيار المجتمع المدني وسيادة الرخوية في كل جزيئات وجوده الفعلي، وخراب الثقافة العامة. والحصيلة هو فقدان أو تشوه الفكرة الوطنية والقومية ومرجعيات تأسيسها الواقعية والعقلانية. وفي ظل هكذا ظروف بصعب تصور صيرورة النخب بشكل عام والسياسية بشكل خاص في غضون فترة قصيرة.
إضافة لذلك أن تاريخ الأمم والدول يبرهن على أن البديهيات السياسية النظرية لا تغير شيئا من ذهنية ونفسية رجال السياسة المغامرين دون القضاء على مقدمات وشروط الانتهاك الممكن للبديهيات في السياسة العملية. بعبارة أخرى إن الإمكانية الرادعة في البديهيات السياسية تصبح واقعية فقط عندما تصبح السياسة علما وعندما تكون الممارسة السياسية جزء من رؤية عقلانية ذات أبعاد إستراتيجية معبرة عن مصالح الدولة والمجتمع. وهي نتيجة تبدو جلية للعيان على خلفية التاريخ العراقي الحديث، وبالأخص تجربة التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية.
إلا أن تأمل تجربة ثلاث سنوات بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية تكشف عن أن بديهيات التاريخ السياسي العراقي ما زالت معضلة وإشكالية في وعي النخبة السياسية الحالية في العراق، كما نراه في استمرار زمن الخروج على قواعد المنطق السياسي وقواعد المصلحة الاجتماعية والوطنية. بمعنى أن النخب السياسية والأحزاب لم تتوصل بعد إلى إدراك الحقيقة القائلة، بان العمل من اجل المصالح الكبرى والعامة هو أيضا الضمانة الأكبر والأقوى للمصالح الخاصة والجزئية. أما عدم إدراك هذه البديهة والعمل بموجبها فهو مؤشر تام على انعدام الرؤية العقلية والعقلانية للفكرة السياسية. وان مضمون السياسية عند الأحزاب والنخب هو العيش بمعايير الغريزة والجسد. وهي معايير لا يمكنها الاستفادة من تجارب التاريخ العراقي الحديث العامة منها والخاصة.
كل ذلك يدفع من جديد السؤال الجوهري بهذا الصدد، وهو: ما هي بديهية التاريخ العراقي التي يمكن استخلاصها من تاريخه الكلي والجزئي، القديم والحديث والمعاصر لكي يكون قادرا على التحرر الفعلي والتكامل الذاتي؟ أنها الفكرة العامة! فالتاريخ العام والخاص، القديم والحديث والمعاصر للعراق يبرهن أن سر خرابه المستمر هو فقدان الفكرة العامة، أي غياب أو ضعف أو عدم تكامل الفكرة العامة (الوطنية). فتجارب الأمم في بناء الدولة، بما في ذلك تاريخ العراق العريق، يبرهن على أن إرساء أسس الدولة منذ البدء على فكرة عامة هو ضمان استمرارها وقوتها. وذلك لما فيها من قدرة على تقبل التراكم المتنوع وضبطه بمعاييرها العامة. وفي هذا كانت تكمن مقومات "الإمبراطورية الثقافية" للعراق القديم. وهو الذي جعله مركز العالم الثقافي لقرون عديدة وواضع أسس فكرة الدولة والقانون والعلوم والآداب. بينما يبرهن تاريخ الدولة العراقية الحديثة على أن الخروج عن منطق الفكرة العامة هو سر خرابه الشامل. فقد وضعت الدولة العراقية الحديثة لبنات الفكرة العامة عن الدولة (الوطنية) لكنها سرعان ما جرى تخريبها بفعل تغلغل الطائفية السياسية المبطنة (السنية) وتحولها إلى الفكرة الحاكمة في بنيتها ومؤسساتها. مما جعل منها دولة سلطوية. وفي هذا كان يكمن تراكم العناصر الراديكالية في الفكر والممارسة. فالفكرة الجزئية تولد الراديكالية. والراديكالية تعيد إنتاج الفكرة الجزئية وتجعلها منظومة "شرعية".
فعندما نتأمل تاريخ العراق العام والخاص في مجرى صيرورته الحديثة في القرن العشرين، فإننا نقف أمام انقلابين حادين فيه. الأول وهو سقوطه في بداية القرن العشرين تحت السيطرة البريطانية، والثاني سقوطه تحت السيطرة الأمريكية في بداية القرن الحادي والعشرين. أي انه يكرر تجربة السقوط كل مائة عام. بمعنى أن تاريخه بلا تاريخ، بل مجرد زمن، أي بلا تراكم ولا حكمة. وهو أمر يشير إلى ما أسميته بغياب الفكرة العامة، التي تجعل من القوى الجزئية أيا كان شكلها ومحتواها دودة تنخر أعماقه الباطنة بحيث تجعله صلب المظهر خاوي الباطن. وهي نتيجة جلية أمام سقوطه السريع والمريع تحت ضربات الغزو الأمريكي الأخير.
وإذا كان سقوطه الأول هو النتاج الطبيعي لغياب الفكرة الوطنية المستقلة بسبب جزئية وجوده في السلطنة العثمانية، فان سقوطه الأخير هو النتيجة المترتبة على فقدان الفكرة الوطنية العامة بسبب الطائفية السياسية، أي القوى الجزئية التي حولت العراق إلى جزء من مصالحها الضيقة. بعبارة أخرى، لم يكن "تحريره" من السيطرة التركية ووقوعه تحت "الانتداب" البريطاني في بداية القرن العشرين، ثم "تحريره" من السيطرة الصدامية ووقوعه تحت الاحتلال الأمريكي في بداية القرن الحادي والعشرين، سوى التكرار الفج للحقيقة القائلة، بان ما حدث آنذاك وما يحدث الآن هو "استعداد لما فينا"، ومن ثم "فما اثر فينا غيرنا". وهو استعداد محكوم بغياب الفكرة الوطنية العامة، أي بغياب مرجعياته الذاتية الكبرى.
إن المرجعيات الذاتية الكبرى لا تصنعها قوى عابرة، ولا تؤسس لها قوى طائفية أو أقليات قومية لأنها جميعا قوى جزئية. وفي هذا تكمن بديهية سقوط العراق. كما أن بديهية صعوده تفترض الإدراك الواعي والتحقيق العملي للفكرة القائلة، بان البديل الممكن للسقوط العراقي هو مرجعية الفكرة الوطنية العامة.
#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)


 Maythem_Al-janabi#
Maythem_Al-janabi#



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة