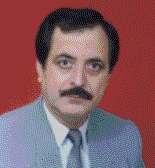(3)
إن قراءتنا في الفكر الماركسي تستهدف الكشف عن المفاهيم والرؤى فيه التي أصبحت ميتة، أو ولدت كذلك، وعن تلك التي لا تزال تنبض بالحياة، مقدمين ما أمكننا وحيث نجد ذلك ضروريا مقترحاتنا الخاصة .
نبدأ بالتمييز بين جانبين متداخلين، لكنهما متمايزين في الفكر الماركسي: الجانب الأول يتعلق بالمنهج المادي الجدلي والتاريخي، والجانب الثاني يتعلق بالنظرية الماركسية، باعتبارها تتكون من جملة المعارف العامة والخاصة التي تفسر مختلف جوانب الوجود الاجتماعي .
المنهج الماركسي غير النظرية الماركسية، ولقد أدى الخلط بينهما في السابق إلى جملة من الإشكالات النظرية والعملية، ساهمت في عجز هذه الأخيرة عن مواكبة المتغيرات في الواقع، وتفسيرها بصورة معللة. وليس خافيا على أحد حجم الضرر الذي لحق بقضايا العمل في سبيل التقدم الاجتماعي من جراء ذلك (1).
وتفريعا عن الموقف المنهجي السابق نشير إلى أن استخدام المنهج المادي الجدلي والتاريخي في البحث والدراسة والاستكشاف، لا يؤدي بالضرورة إلى إنتاج معرفة علمية صحيحة، إلا إذا اعتبرنا أن إنتاج هذه المعرفة هو المعيار للاستخدام المستقيم للمنهج الماركسي. ولا شك أن مثل هذا الاشتراط يتضمن نوعا من الجبرية تتجاهل الشروط البحثية، الذاتية والموضوعية .
من جهة أخرى فإن المنهج الماركسي، والنظرية الماركسية مترابطان. المنهج يستخدم عادة المفاهيم والمقولات الأساسية في النظرية، وبعض معطياتها المعرفية، كأدوات لمتابعة البحث والاستكشاف. بدورها المكتشفات المعرفية تضاف إلى النظرية فتغنيها وتوسع من نطاق شموليتها.
المنهج، كما نفهمه، هو طريقة في التفكير، وثيق الصلة بالموضوع الذي يجري التفكير به، يتغير بتغيره. لذلك عندما يجري الحديث عن المنهج الماركسي، يقفز إلى الذهن مباشرة، الطريقة التي اتبعها ماركس في المعالجة النظرية للموضوعات التي كانت محط اهتمامه، وإن أكمل عرض له يمكن ملاحظته في كتاب "رأس المال" لماركس .
تتميز طريقة ماركس في التفكير، أي الطريقة المادية الجدلية والتاريخية بسمات جوهرية ثلاثة هي :
أولاً، أنها مادية، وهذا يعني الإقرار بوجود الأشياء والظواهر موضوعيا، بغض النظر عن إرادة الإنسان ووعيه بها .
وثانيا، أنها جدلية، بمعنى أنها تنظر إلى الأشياء والظواهر، على أنها ظواهر متناقضة، وفي تغير مستمر، وتخضع لنوع من الترابطات الشمولية، يؤثر بعضها في البعض الأخر ويتأثر .
وثالثا، أنها تاريخية، وهذا يعني، من جهة، أن الوجود الموضوعي للأشياء والظواهر هو وجود تاريخي متغير، يختلف من حيث زمن وجوده، ومن جهة ثانية، إن معارفنا عن الأشياء والظواهر ذات قيمة تاريخية وحسب .
إذا دققنا النظر في هذه المنطلقات المنهجية الماركسية، فإنه يمكن قراءتها بطريقة مختلفة عن القراءات الشائعة لها. فالقول بالوجود الموضوعي للأشياء والظواهر؛ أي ماديتها، لا يحمل بذاته، أية حمولة معرفية، هو في الحقيقة منطلق منهجي، ليس غير، يتعين بموجبه موقف الباحث من موضوع بحثه. بهذا المعنى، يمكن النظر إلى أية ظاهرة في الوجود الاجتماعي، في الفكر أو في الوجود الفيزيقي للأشياء، على أنها ظاهرة مادية. أما إذا حمل هذا القول معرفة ما، فإنه يقود إلى الضلال، لأن نطاق الظواهر والأشياء التي يتوقف وجودها على الإنسان ووعيه يتوسع باستمرار. لقد سمحت الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة للإنسان بالتوغل أكثر فأكثر، في الوجود الاجتماعي و الطبيعي ،مكتشفا انتظامه القانوني الداخلي، ومعيدا خلقه بطريقة هادفة، وفق تصورات ورغبات جديدة. وإن نطاق الخلق الإرادي للإنسان في المجتمع،والطبيعة، يتوسع باستمرار، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإنسان كائن جماعي له فكر وإرادة جماعية .
من حيث المبدأ، لا يوجد شيء في الوجود الاجتماعي،إلا بإرادة الإنسان ووعيه. لقد ذكرنا سابقا أن العلاقات الاجتماعية تتكون من خلال مرورها، أولا عبر الفكر الذي يصوغها كهدف، أو كمشروع. بمعنى أن وجودها الموضوعي لا يكون إلا بدلالة الفكر، الذي يشترطها بداية، وعند التحقق. .لنأخذ مثلا العلاقة الجمالية، باعتبار أن الموقف من موضوع الجمال(الجميل)، وموضوعية وجوده (ماديته) من المسائل الخلافية في الأدب الماركسي. من وجهة نظرنا مواضيع الجمال من أشياء وظواهر، في الطبيعة أو في المجتمع، محايدة جماليا، بمعنى أنها ليست جميلة بذاتها، بل هي جميلة بدلالة الإنسان، فالجمال موجود بوجود الإنسان كمتلقي جمالي. ونظرا لأن وجود الإنسان هو وجود تاريخي، يشترطه دائما زمان ومكان محددين، فان وجود الجمال هو وجود تاريخي أيضا. ينطبق المبدأ ذاته على جميع الطوباويات الميتافيزيقية، مع أن بعض موضوعات الجمال أو الطوباويات الميتافيزيقية تبدو بلا حدود زمنية، فهي بمعنى معين عابرة للزمن.
معروف جيدا قول ماركس، بأن العامل على خلاف النحلة والعنكبوت ينتج بناء موضوعاته في ذهنه أولاً، هذا يعني أن الوجود الواقعي لهذه الموضوعات يتوقف، من جهة على صورتها في ذهن الإنسان، ومن جهة ثانية، يتوقف على إرادته. وبناء عليه إذا أخذنا بدلالة المنطلق المنهجي الأول بصورة حرفية، تكون موضوعات عمل الإنسان الفيزيائية غير مادية.
لا شك بأن للأشياء، والظواهر، التي يخلقها الإنسان بوعيه وإرادته،وجود ما على شكل(مبادئ،عناصر،مكونات) في الطبيعة أو في المجتمع. لكن ذلك لا ينفي كونها في شكلها الجديد الملموس موجودات جديدة في عالم المادة المميز(العياني). فالخلق عملية مستمرة تتجاوز باستمرار حدود الخلق الأول.
يفترض المنطلق المنهجي الثاني، أن الأشياء والظواهر توجد متناقضة، تتغير باستمرار، في إطار من الترابطات الشمولية. للوهلة الأولى يبدو هذا القول من البداهة بحيث لا يقبل أية قراءة جديدة، خصوصا إذا أُخذ هذا القول بالمعنى الضيق المباشر. حقا، إن كل شيء في الوجود يبدو متناقضا، أي يتكون من بنية مركبة متخالفة داخليا تقوم بين مكوناتها روابط تعاكسيه. هذا ما تدل عليه المشاهدات التجريبية، ويقبل البرهنة المنطقية. فالقول(أ) هو(أ) وغير (أ) في الوقت ذاته، للدلالة على أبسط حالة وجودية، يعني بالضرورة أن طرفي هذه العلاقة مختلفان، بسبب اختلاف عمليات التعاكس بينهما واختلاف وضعيات الترابطات الشمولية .
لندقق أكثر في التناقض الذي تبديه ظواهر الواقع وأشياؤه المميزة، عندئذ سوف نكتشف أن هناك إمكانية لقراءة مفهوم " التناقض " بطريقة مختلفة عن قراءة الماركسية المدرسية له. في المثاقفة الدارجة إلى جانب مفهوم " التناقض" تستخدم عادة مفاهيم أخرى مثل مفهوم " الاختلاف" و مفهوم " التمايز" ومفهوم " التضاد"..الخ. ونضيف إليها تدقيقات تحددها وتنوعها، كأن نقول تناقض جوهري، وتناقض ثانوي، أو تضاد عدائي، وتضاد غير عدائي..الخ. يبدو أننا نقف إزاء عائلة من المفاهيم التي تقرأ مستويات مختلفة من التمايز الداخلي للأشياء والظواهر .
لكن لماذا يوجد التناقض؟ الجواب الماركسي المدرسي يكون عادة: أن التناقض هو من الخصائص الجوهرية للمادة، وهو في الأشياء والظواهر المميزة، السبب في تغيرها الدائم. وقد ظل هذا المفهوم بحكم بداهيته الظاهرية، خارج دائرة المراجعة، ينتمي إلى دائرة اللامفكر فيه ماركسيا. مع ذلك، ثمة فسحة لإعادة مراجعة هذا المفهوم وقراءته بصورة مختلفة عن القراءة المستقرة له في الماركسية المدرسية؟ لكن ذلك يتطلب الاستعانة بمفهوم أخر نقترحه هو مفهوم " اللاتوازن". فاللاتوازن هو من السمات الجوهرية للمادة، سواء للمادة في وجودها العام، أو في وجودها المميز. وعليه تكون المادة بصورة عامة، أو المادة المميزة غير متوازنة داخليا، وفي ذلك يكمن السبب الحقيقي لتغيرها المستمر. أما مفهوم " التناقض " وجميع المفاهيم الأخرى ثنائية الدلالة، المعبرة عن التمايز الداخلي للمادة، فهي تقرأ الشكل الذي تظهر به وضعية " اللاتوازن " العامة. بهذا المعنى تكون وضعية " التوازن " حالة خاصة من وضعية " اللاتوازن" العامة، كما "السكون" حالة خاصة نسبية من وضعية " الحركة " .
إن مفهوم " اللاتوازن" يساعد في تفسير مبدأ الحركة والتغير في المادة. فالمادة بصورة عامة غير متوازنة داخليا، لأن حصيلة قوى الاختلاف المحددة لعلاقات وروابط وجودها، غير متعادلة. أما مفهوم " التوازن" النسبي، فانه يفيد في تفسير وجود المادة المميزة في أشياء، وظواهر فيزيائية.
في الحقل الاجتماعي، تظهر وضعية اللاتوازن العامة من خلال العلاقات الاجتماعية المتناقضة، غير أنها المتكاملة وظيفيا، وبما ينجم عنها من تفاعل صراعي، يحاول كل طرف فيه أن ينفي الطرف الأخر، وإذا تثنى له ذلك، فإنه ينفي ذاته بالضرورة، لتولد على قاعدة النفي المزدوج هذه، علاقات اجتماعية متناقضة جديدة .
في ضوء ذلك تصبح المقولة المادية التي تفيد بإمكانية خلق نظام اجتماعي متوازن داخليا، يتطور بصورة منتظمة، على أساس اللاتوازن الخارجي بينه وبين الطبيعة، مقولة مبتذلة وبلا معنى. فلا يمكن إلغاء التناقضات الداخلية في المجتمع، بل العمل على إيجاد أفضل التوليفات بينها. بكلام أخر يستطيع الإنسان في نشاطه أن يستهدف وضعية معينة لحالة " التوازن" النسبي، أي لشكل محدد للوجود الاجتماعي، وهو ينشط في سبيل ذلك فعلا، أما حالة " اللاتوازن" فهي من خصائص الوجود العام الجوهرية، وهي بالتالي خارج نطاق الحركة الغائية للمجتمع (2).
لننظر في المنطلق المنهجي الثالث للطريقة الماركسية في التفكير، الذي يفيد بأن جميع الأشياء والظواهر ،والوعي بها يتسم بالتاريخية ،أي يشترط وجودها زمان ومكان محددين .يبدو أن هذا المنطلق المنهجي من البداهة بحيث لا مجال للشك به.التساؤل يتوجه حقيقة نحو مدى التقيد المستقيم والصارم به في سياق الحركة العملية والبحثية العامة. سوف نؤجل البحث في هذا المنطلق المنهجي لبعض الوقت،غير أننا هنا نود التأكيد مباشرة على مسألتين منهجيتين متفرعتين منه وهما :
أ- إن منطق المفاهيم محدد بمنطق الأشياء والظواهر،وان مصداقية المفاهيم، والفكر ،عموما ليست في ذاتها، بل في مدى اقترابها من حقيقة الأشياء في ذاتها.
ب- إن حدود معارفنا عن الأشياء والظواهر تتغير باستمرار ،باتجاه الاقتراب أكثر فأكثر، من حقيقة الأشياء في ذاتها دون أن تبلغ ذلك أبدا .
يترتب على المسألة الأولى، أن الفكر الذي شكل في لحظة إنتاجه صياغة ذهنية للواقع ، يبدأ منذ تلك اللحظة مسارا تفارقيا مبتعدا عنه، لذلك عليه أن يعود باستمرار إلى الواقع لاكتشاف مدى التفارق بينهما وإجراء الدقيقات والمقاربات الضرورية .وعندما يصل التفارق حدا معينا يتطلب الوضع إعادة إنتاج الفكر من جديد ليقترب أكثر من وضعية الواقع الجديد.
أما المسألة الثانية فإنها تؤسس للقول بأن معارفنا التي نصوغها عادة في مفاهيم ومقولات وقوانين ونظريات ..الخ، تغتني باستمرار بمضامين جديدة مع كل توسع في حدود معارفنا . وبعد حد معين من التطور فان العديد من أدواتنا المعرفية (مفاهيم، مقولات ، نظريات..الخ) تنحجز تاريخيا لتفسح المجال لمفاهيم ومقولات ونظريات جديدة لتحل محلها ، وهكذا دواليك في سيرورة لا نهاية لها.
إن المنطلقات المنهجية السابقة الذكر هي منطلقات عامة ، بمعنى أنها تشكل المدخل إلى التفكير العلمي .ومع أنها تنسب عادة إلى أسلوب التفكير الماركسي، إلا أنها واسعة الاستخدام في أساليب التفكير الأخرى ، لذلك لا يمكن اعتبارها موضوع خلاف جدي بين الماركسية وغيرها من النظريات الفكرية الكبيرة. وعلى العموم ليست العبرة في المنهج، بل في النتاج المعرفي (المعبر عن حقيقة الأشياء في ذاتها) المتحصل بواسطته. هذا لا يعني بالطبع أن استخدام مناهج خاطئة ، أو الاستخدام الخاطئ للمناهج العلمية ، يمكن أن يساعد في تحصيل المعارف العلمية. وإذ نشدد على ذلك، فلا يعني أن الحالة العكسية صحيحة. فالاستخدام المستقيم للمناهج العلمية لا يؤدي بالضرورة إلى تحصيل المعارف العلمية،أو الإفصاح عنها، إذ لا بد إلى جانب توفر الشروط الذاتية للتحصيل العلمي ،من توفر جملة من الشروط الموضوعية ،وفي مقدمتها وجود مصلحة اجتماعية عامة، أو طبقية، أو فئوية، أو فردية ،في التحصيل المعرفي العلمي (3).
إن العلوم ومناهجها في تطور مستمر ، يساهم في ذلك وبنشاط العلماء والمفكرون من الدول الرأسمالية المتقدمة، في حين كان زملاؤهم في الدول " الاشتراكية " السابقة يجترون العموميات الأيديولوجية .لقد سادت حالة يكفي معها ترداد قوى إنتاج وعلاقات إنتاج ، بناء فوقي وبناء تحتي … وربما تمجيد هذا أو ذاك ، حتى تتحصل المعرفة العلمية المتعلقة بالتنمية وتحسين جودة المنتجات ، أو حل مسألة القوميات أو حل مسألة الثقافة أو تفسير التخلف وإيجاد المخارج منه ..الخ .
لقد نجحت البرجوازية في حسم الصراع لصالحها على الصعيد الوطني والدولي ، وقد يستغرب البعض ( أولئك الذين يسعون إلى حل المسائل الملموسة بطريقة عامة ) ، أن البرجوازية حققت ذلك بدون أن تمتلك منهجا عاما في التفكير، ولا نظرية عامة للتطور الاجتماعي . حقيقة ليس ثمة ما يدعو إلى الاستغراب إذا نظر إلى الأمر بشكل مستقيم ، وهذا لم يكن متاحا دائما للأسف بسبب ضغط العوامل السياسية والأيديولوجية، والمصالح الضيقة للقوى المتسلطة ، وبالتالي غياب الديمقراطية والحرية. مهما يكن من أمر فان الاستنتاج الأهم الذي يترتب على ذلك يتعلق بالدور المتزايد الذي أخذ يلعبه العلماء والمفكرون في الحياة الاجتماعية وفي التطور الاجتماعي .
لقد ظل الفكر الماركسي زمنا طويلا أسير الصيغ النظرية الكلية المجردة ، وفقد بالتالي تماسه الفعال مع الواقع المتغير باستمرار . لقد جرى التعامل مع المفاهيم والمقولات والقوانين العامة ، وكأنها مفاهيم ومقولات وقوانين للظواهر الملموسة ، فتخلفت العلوم الاجتماعية وفقدت الحياة السياسية معناها وفعاليتها، وغرقت في بحر الأيدولوجيا الآسن(4).
في الماضي كان اغتراب الإنسان عن منتجاته الفكرية يقوده إلى تقديسها ، والخروج بها خارج المسار الزمني الواقعي ، ومما لا شك فيه أن الفكر الماركسي تعرض لنوع من أسوأ حالات التقديس ، مع أنه في مبدأه، لا يقبل التقديس ،(أليس فكرا نقدياً!؟) وكان ذلك عن طريق جوهرته ( وهل يتقدس الفكر إذا لم يتجوهر ؟) مما كاد أن يفقده نسغ الحياة.
المراجع
1-أ.لوتشف (( التطور هو وسيلة الوجود )) ، دراسات اشتراكية ، العدد 7 ( 1987 ) ص 58
2- المجتمع الشيوعي كما تصورته الفلسفة الماركسية المدرسية، سوف يكون بلا طبقات وبلا صراع طبقي وبلا دولة ،محرك التطور فيه ينتقل من الداخل إلى الخارج، من صراع الطبقات إلى الصراع مع الطبيعة . على افتراض حصل ذلك ، لأدى إلى إلغاء القانون الثاني والقانون الثالث من القوانين العامة للحراك الاجتماعي، والاحتفاظ بالقانون الأول فقط وهذا غير ممكن لا نظريا ولا عمليا .
3–يعتبر أوسكار لانكه أن وجود المصلحة الطبقية شرط لا بد منه للبحث العلمي . من جهتنا نرى أن المصلحة في التحصيل المعرفي العلمي تتجاوز الحدود الطبقية في الاتجاهين ، صعودا إلى المصلحة الاجتماعية ونزولا إلى المصلحة الفردية، على الأقل كدافع مباشر إلى البحث والتحصيل المعرفي .
4- لقد تطورت العلوم الاجتماعية التطبيقية كثيرا في الدول الرأسمالية المتقدمة ، وخصوصا العلوم الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام وتطوير المناهج البنيوية الوظيفية، والبرغماتية ،بل الماركسية أيضاً..الخ .
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة