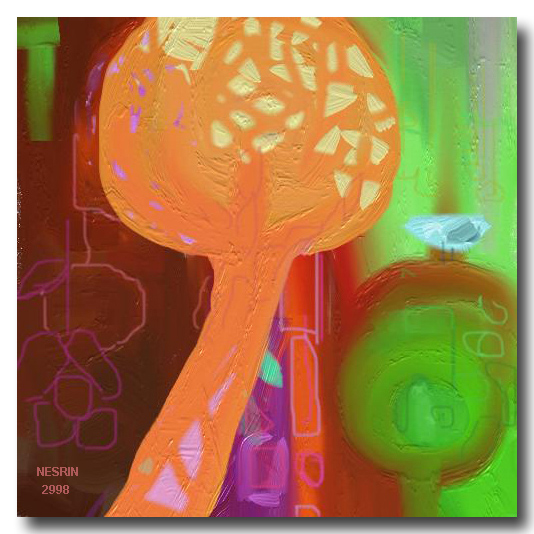|
|
تقدمة- إكليل خزمى تضعه في الليل عشتار على ضريح تموز - (قصيدة حب2003)
سعد محمد مهدي غلام


الحوار المتمدن-العدد: 8302 - 2025 / 4 / 4 - 00:43
المحور:
الادب والفن
تقدمة" إكليل خزمى تضعه في الليل عشتار "الشعراء هم مشرعو العالم غير المعترف بهم. "
"بيرسي شيللي"
1/
لتقريب وجهة نظرنا نقول وفق فهمنا لنظريات القراءة والتبادلية وما طرحه "هابر ماس" وما جاء بعده نذهب للقول أن علاقة الذات بالموضوع هي في جدلية عامة من غير الممكن فصلها أو ترجيح طرف على أخر كما أن علاقات العقل الفردي بالفضاء الاجتماعي هي علاقة تبادل وتفاعل منتج ، وليست عملية إتلافية .الحقيقة لن يتمكن عقل" سوبرمان نيتشه "بامتلاكها بذاته كما لن تتمكن مكونات العموم المجتمعي من فرض هيمنتها وألزام الافراد على الاصغاء والتسليم لخطابها مع هدر قوة الأفراد على الحكم وامتلاك حرية التقدير والتقويم مع توقع الاحتكاك العنفي وجدنا طرائق تكفل السلام المجتمعي وتحقق التواصلية والتوافقية بفتح آفاق الحوار حول كل المتطلبات الفردية والعامة بحرية مكفولة للجميع ..خلاصة ما نرغب قوله إن علاقة منجز الحداثة بمنجز مابعد الحداثة لا يكون بخلق تقاطعات حدية وإيجاد فوالق تشرخ سياق الارتباط الجدلي بين المرحلتين ..ولواخذنا الأدب مثاًلا وخصوصًا القصيدة الشعرية لوجدنا أن الأكثر استقرارًا هو التحليل العميق والعقلاني والذي يقول، إن لا تضارب قطعي بين قصيدة المرحلتين وأنما التطور يفرض إعادة تقييم لكل مرحلة كما أن أي مرحلة سابقة ستكون محتواة داخل المرحلةاللاحقة وعلى صعيد قصيدة الشعر فإن قصيدة ما بعد الحداثة هي جميع ما انتجته الحداثة مضاف إليه ما استجد فعندما تكون قصيدة الحداثة فردية وذاتوية وتعبر عن قلق انطولوجي وتكون قصيدة الوحدة الموضوعية فيها هي وحدة الغاية والمقصد وتحكمها قيود التفعيل والالتزام بشروط عروضية صارمة استمرت عملية التخلص منها سنوات من التجريب ،والتحديث عبر تداخل البحور وتنوعها في القصيدة الواحدة والتدوير ثم كسر قواعد التسكين وتخفيف صرامة الالتزام بالموضوع الواحد ...الخ وفي القصيدة بالنثر إلى بلوغها ما هي عليه اليوم من فقدان الحدود الفاصلة بينها وبين القصيدة الحرة المطلقة وبين كسر محددات سوزان برنارد وميشيل ساندرا ، وأدونيس الخمسينات ، والحاج في الستينات ...الخ إلى قصيدة غير مجانية غير مقيدة بالأفقية متنوعة التشكيل ومتباينة البنية تستخدم البلاغة الجديدة والصور والتناص والاستعارة ولا تشترط السردية والعامية والكثافة التقليلية... وليس حتميًا استخدام اللهجة العامية ولا استدعاء مفردات مغرقة بالسطحية ( هذا لا يشمل المنشور الورقي والألكتروني العبثي والذي كثير منه هراء وفي أحسن التوصفات خواطر غزت فضاء العالم الأفتراضي ..) .إن قصيدة
ما بعد الحداثة كما كتبها سليم بركات أو محمد بنيس...الخ وكما نجدها اليوم في قصائد بشرى البستاني هي قصيدة تتمكن من ضم كل المنجز الحداثي بل حتى ماقبل الحداثي عبر التناص والاقتباس والاستعارة مع صرامة التقيد بعدم انفلات القصيدة وخروجها عن المسار، ربما يقول ،البعض أن خلفية الشاعرة والناقدة الأكاديمية تحول دون فسح المجال لنفسها بتحطيم كل القواعد والقوانين الحاكمة للقصيدة والتي يفترضها جزافًا البعض في قصيدة مابعد الحداثة ،فأقول أن قصيدة البستاني تمتلك كل خصائص مابعد الحداثة الشكلية والنوعية والبنيوية ( نحن نعتبر البنية توسط مابين الشكل والمحتوى/ المضمون تأخذ منهما وتتأثر بهما وتعطيهما وتوثر فيهمابمعنى أن البنية هي تصير الفكرة عبر التشكيل نصًا " وفق مفهوم رولان بارت كل منتج الإبداعي وحتى غير إبداعي هو نص " أو ملفوظًا) فقصيدة البستاني فيها السرد والتفعيل والعمودي وقصيدة النثر والتشكيل مابعد الحداثي والتنوع المفرداتي وتوظيف الأسطورة والرمز مابعد الحداثي واستخدام القناع والتناص البسيط والمركب والمتداخل والتداخل الأنواعي والعبور الأجناسي والتعاشق القصيدي كما استدعت البستاني في القصيدة مفردات الواقع وبذات الوقت أستدعت مفردات كونية مستعينة بمعطيات اللغة غير المحدودة...الخ كل ذلك دون أن تمكن القصيدة من الانفلات هذا الكم الكبير من المقاصد وطبقات المعاني وزحم التحرر من القيود القصيدية ...والتفكك والتشتيت والتشظي والتنوع المتضارب ...الخ لم يجعل القصيدة تقع في شراك العبث واللامعنى بل العكس تم تعميق المعاني وحشد كم من المداليل وفتح منافذ وثقوب في القصيدة لتشغلها الدوال الزئبقية واتكأت على تنغيمات وايقاعات تخدم أبعد من إعطاء الموسقة للقصيدة بل تعطي معان وغايات ومأرب ومقاصد مفتوحة .. تتناول فيها مجتمعها وأمتها وتاريخها الذاتي والموضوعي وسيرورتها الجندرية
وأفق تطلعها الإنثوي كونيًا والمشكلات العالمية الشائكة والصادمة والمعقدة...
2/
تُعدُّ هذه القصيدة " إكليل خزمى تضعه في الليل عشتار على ضريح تموز "شهادة حيّة على الصراع الداخلي والخارجي الذي يعيشه الإنسان الفرد المعبر عن ذاته أو باعتباره المعبر عن جماعة المجتمع العراقي/ العربي في ظلّ الأزمات المتفاقمة والواسعة والعميقة والحروب المستمرة التي تُرخي بظلالها على مصير شعوب بأسرها. هي نصٌّ مفعم بالألم، والحزن، والوعي العميق بالتحولات التي أصابت العراق وعموم المنطقة العربية باشتغلات تلائم هذا التداخل الغرائبي للكوائن والمكنونات ولذلك اتخدت القصيدة نمطًا شكليويًا وتشكيليًا وبنيويًا مابعد حداثي ، على الرغم من هول الأزمات التي تعيشها، ما تزال هناك شرارات مقاومة وأمل تجاهد في الانبعاث صداه يلعلع شعرا في قصيدة البستاني ..للاحاطة الأولية بمسارات قصيدة د.بشرى قيد القراءة توخينا وضع المتلقي حيال حقائق عامة عن القصيدة وسيما نجد أن لا مناص من التوسع في جانب ما حيوي يساعد على فهم البنية الخلوية / العنقودية للقصيدة والتي تنبئ عن كلية منتج مابعد الحداثة شعريًا من تداخل أنواعي وعبور أجناسي كبيرين وعن تصادم وشائج التعاشق القصيدي مع صرامة الانضباط في احكام السيطرة على مداخل ومخارج القصيدة وعلى صراع الأواصر المتقاطعة في خضم القصيدة مابين تلاحم وشائج الإنساق التخليقية وانفلات حويصلات درنية من أرومة البنية لتشكل بنيات جديدة ( مع احتفاظها جميعًا بمطلع قصيدة واحد وخلوص قصيدة شامل )ولكنها لم تفارق السياق وبقيت حركتها النوعية ضمن تواصل صلات الانساق الكلية في السياقات المنتجة شعريًا . ما نجده من تفكك مقصود ليس مفتعًلا في تشكلات مابين دواخل الحدود وأصول التكوينات التخليقية الشاعرية لشعرية هذه القصيدة بمعنى التعقيدات المعبر عنها شسوع سعت الطيف المعرفي وليس مستغربًا ان توظف الشاعرة معطيات قصيدة مابعد الحداثة في تمرير تعدد غاياتها وتنوع مقصدها وعنكبوتية استدعائتها التناصية والترميزية والاسطورية.
القصيدة التي بين يديّنا هي صورة مُعذبة عن وطن محطم، يصرخ تحت وطأة الاحتلال والغدر. يتجلّى في النص استخدام الصور البلاغية( ننوه إلى أن المقصود هو البلاغة الحديثة ) المدهشة، التي تأخذ القارئ في رحلة قاسية عبر أزقة الحزن والدم. هي ملحمة حية، نبضها ينبض بقوة المكان والزمان، حيث تتداخل همسات الواقع مع ملامح الخيال. كل بيت من أبيات القصيدة يتنفس ألمًا عميقًا، يرسم مشهدًا من التدمير والتشريد، ولكنه في الوقت ذاته يحمل رسائل عن الصمود والمقاومة
3/
القصيدة تسبر أغوار الجرح العراقي بصدق وواقعية، فتغمر القارئ في بحر من الوجع، بينما تُنبئه بلغة الشعر القوية بمستقبل الأمل المتجدد. ما يميز القصيدة ليس فقط مأسويتها، بل قدرتها على استحضار التراث والهوية في كل تفصيل، بدءًا من الأسماء التاريخية مرورًا بالأماكن التي كانت يومًا رمزًا للمجد والتقدم، وانتهاءً بالكلمات التي تلتقط خيط الحياة حتى من تحت رماد الخراب.
تعكس القصيدة تأثير الاحتلال على الروح الوطنية، فتدخلنا في جدلية الإحساس بالهزيمة وعدم الفهم لما يجري. لكنها أيضًا لا تخلو من توجيه بصيص الأمل، بأن هذه المأساة ليست النهاية، بل قد تكون بداية لولادة جديدة. الصراع في النص ليس مجرد معركة حربية، بل هو صراع وجودي مع الذات، مع التاريخ، ومع الأسئلة التي لا تجد إجابة.
القصيدة تضعنا أمام مواجهة مريرة مع مشهد الحروب التي تجتاح الوطن، وتدعونا للتفكير في الإنسانية التي تشوهها أطماع القوى الكبرى. هي لا تقتصر على الشجب أو اللوم، بل هي شهادة على الحضور المستمر للروح العراقية التي لم تفقد قدرتها على الحلم رغم كل شيء.
البنية اللغوية والأسلوب:
توظف القصيدة لغةً عالية الدهشة، قادرة على تكثيف المعنى وبلوغ لحظات الصراع الفكري والجسدي والتاريخي في آنٍ واحد. تُمَثِّل البنية اللغوية عنصرًا مهمًا في نقل الشحنة العاطفية والرمزية العميقة التي تكتنف القصيدة. فالمزج بين العبارات الرقيقة والتعبيرات الصاخبة يعكس صراعًا داخليًا مستمرًا بين الرغبة في السلام وبين الواقع المؤلم الذي يحاصره القارئ من كل جهة والتشكيل اللغوي المعقد الموظف في القصيدة هو من متطلبات قصيدة مابعد الحداثة ذات التركيب البنيوي المشتظي والتشكيل التداولي الأسلوبي المتنوع والتنضيد القصيدي( تعددالقصائد في ذات القصيدة ) ...الخ كل ذلك يتطلب حشد مفرداتيًا وتنوعًا في استدعاء اللعب اللغوي وضخ قدر هائل من الأفكار المتعارضة ولولا حنكة الشاعرة ومكنتها المتأتية من خلفيتها الأكاديمية الرصينة لوجدنا قصيدة كهذه تنفلت من عقال سياقاتها وقدمت فرشت من تزاحم كلمي مدعوم بالانزياحات الشطحية والتي ربما تفقد المتلقي إمكانيات السيطرة على أفاق توقع مدركة ..
4/
الرمزية:
تتجلى الرمزية في القصيدة من خلال الصور الشعرية البليغة التي تمسك بخيوط الحياة والموت في آنٍ واحد. فشجرة العراق، التي تذكرها القصيدة، تمثل الحياة في خضمّ الخراب، وتقدم رمزًا للمقاومة التي لا تموت. الموت هنا ليس النهاية، بل بداية لولادة جديدة، كما هو الحال في رمزية طائر الفينيق الذي يبعث من بين الرماد. العراق يصبح نقطة التقاء بين الذاكرة والتاريخ، والحضارة التي لا يمكن أن تُمحى مهما كانت قسوة الظروف. كما أن السموات والدماء، من خلال تكرار "سيول الدم"، تظل تشهد على المجازر، لكنها أيضًا تحمل أسطورة الثبات ونلفت هنا الى ان توظيف الرمز في قصيدة مابعد.الحداثة يأخذ ابعادا واشكالا أكثر تعقيدا مما هو في توظيفات قصائد الحداثة فهي يعتري الرمز ما يعتري القصيدة من تعدد الطبقات للمعنى واشتباك المقاصد وتداخل المرامي من المجازات والصور والاستعارات .
الأسطورة والتاريخ:
تستخدم القصيدة الأسطورة لتكون وسيلة لتوجيه الوعي الجماعي وتحفيز الذاكرة الثقافية. الشاعر يستدعي التاريخ العربي البعيد، ويذكّرنا بمجد بغداد وتاريخها العريق. أسوار نينوى، الخيالات المعلقة بين الشرق والغرب، تمثل هذه الرموز تاريخًا مشتركًا للمصير العربي، الذي يواجه الحروب المعاصرة. في السياق ذاته، لا تغفل القصيدة عن ذكر «الحضارة الإنسانية» وحجم الخيانة التي تعرضت لها من خلال اجتياح الحروب العسكرية. "قتلة حضارة الإنسانية"، هي كلمة تحمل في طياتها نقدًا حادًا للعدوان الذي يطوي على الخراب كل شيء جميل والاسطورة في مثل هذه القصيدة تتحرك خارج الفهم القاموسي لها لتتتلبس تيمائيات غير المتعارف عليها .
5/
التناص :
هو من المصطلحات الرئجة في الدراس النقدي المابعدي، وقد كان منتجا فعالا في عملية تفكيك وسبر وفهم النصوص الأدبية. فكل نص وفق نظرية التناص نضدًا لتراكم هائل لنصوص سابقة.
بوعي أو لا وعي ظهرت متناصة/ متضمَنة ,في نصه. ومن المفروغ منه في الدرس النقدي قيام الناقد بعملية مسح طبوغرافي للنص تعقبها عملية تنقيب بالحفر للوصل إلى لقى عبر عملية أركيولوجية يعتمدها كاستراتيجية في التنقيب عبر طبقات النص غير السطحية . والتناص من باختين الى كرستيفا
التي اعتبرت النص لا يكتب عنديات الناص ومحض مخيال وخواء ولا يكون منطلقة العدم وانما نقطة شروعه متراكم النصوص في عقل الناص التي تعيها الذاكرة أو القارةفي مناطق تحت الوعي في عقل وذاكرة الناص. نتلمس وجود النصوص المتراكمة والمخفية عبر المشتركات النصية بين النقد المبحوث فيه ونصوص خارجية . ويمكن تعقب تلك النصوص والوقوف على تفاعلها مع بعضها البعض في دايلكتيك تناصي يقود إلى إنتاج نص جديد كليا
محق كان تودورو عندما أشار إلى حقيقة كون العمل الأدبي لايمكن أن يكون له وجود مستقل بذاته بل هو وجود اندماجي لعدد من الأعمال الأدبية والموضوعات المختلفة والمفاهيم المضمرة تستدعي حال كتابة النص أو إخراجه ملفوظا ،فالنص مستوعَبٌ
هاضم لعديد النصوص الأدبية والموروثات والحكم والامثال ظواهر التاريخية والسير والأقوال المأثورة ....الخ
1. التناص في قصيدة مابعد الحداثة وفق كرستيفا وتعزيزات تدوروف:
أ. مفهوم التناص
أعادت كرستيفا صياغة مفهوم التناص متأثرة بميخائيل باختين، حيث ترى أن أي نص هو نتاج تفاعل نصوص أخرى سابقة، فالنص ليس كيانًا مستقلًا، بل شبكة من التداخلات والتأويلات المتعددة.
ب. تمظهرات التناص وظهوراته العامة عبر قراءة خارجية لبنية
"قصيدةإكليل خزمى تضعه في الليل عشتار على ضريح تموز "
يظهر التناص عبر:
تفكيك المعنى وإعادة تشكيله: يتم استدعاء النصوص السابقة لا لتأكيد معناها، بل لتفكيكه وإعادة إنتاجه.
اللعب بالأنواع الأدبية: إذ لا تكون القصيدة وحدة مغلقة، بل تنفتح على السرد والأسطورة والفلسفة.
تفكيك مركزية الذات: يذوب صوت الشاعر في شبكة من الأصوات المتعددة، فلا يعود للنص سلطة نهائية.
2. منهجيات استدلال المعنى في النصوص: الأركيولوجيا والجينولوجيا والإتمولوجيا.
أ. الأركيولوجيا (Archaeology of Text) عند فوكو
يتعامل هذا المنهج مع النص باعتباره طبقات متراكمة عبر التاريخ، حيث يتم تحليل النصوص لا باعتبارها انعكاسًا لوعي فردي، بل كنتيجة لسياقات تاريخية متشابكة. في قصيدة ما بعد الحداثة، يمكن استخدام هذا المنهج لكشف الحفريات النصية داخل النص، أي تتبع المرجعيات السابقة التي تشكل بنيته العميقة.
ب. الجينولوجيا (Genealogy) عند نيتشه وفوكو
بينما تسعى الأركيولوجيا إلى الكشف عن بنية النصوص، تهتم الجينولوجيا بتتبع نشوء الأفكار وتطورها، كاشفة كيف تتحول المعاني عبر السلطة والمعرفة. في قصيدة ما بعد الحداثة، يسمح هذا المنهج بكشف كيف يتم تحوير الخطابات التقليدية داخل النص، وكيف يتم إزاحتها أو إعادة تشكيلها.
ج. الإتمولوجيا (Etymology) ودراسة التحولات الدلالية
تدرس الإتمولوجيا أصل الكلمات وتحول معانيها عبر الزمن، وهو أمر جوهري في قصيدة ما بعد الحداثة، حيث تلعب الكلمات بأبعادها التاريخية والسياسية والثقافية، مما يخلق طبقات من التأويل تتجاوز المعنى المباشر للنص.
3. كيف تتكامل هذه المناهج في تحليل قصيدة ما بعد الحداثة؟
باستخدام الأركيولوجيا، يمكن كشف النصوص المخفية التي تكمن تحت سطح القصيدة.
من خلال الجينولوجيا، يمكن تتبع تحول الخطابات داخل النص.
باستخدام الإتمولوجيا، يمكن الكشف عن الطبقات الدلالية العميقة داخل المفردات المستعملة.
بهذه الطريقة، لا يصبح النص مجرد خطاب مغلق، بل فضاءً مفتوحًا للتأويلات المتعددة، ما يتفق مع جوهر ما بعد الحداثة في رفض المركزية واليقين المطلق.
خلاصة التناص:
1. التناص وفق جوليا كرستيفا
التناص هو فكرة أن أي نص ليس كيانًا مستقلًا، بل هو تقاطع بين نصوص سابقة، سواء بشكل مباشر (اقتباسات واضحة) أو غير مباشر (تأثيرات غير ظاهرة). في ما بعد الحداثة، يتحول التناص إلى لعبة لغوية تهدف إلى تقويض المعنى المستقر وإعادة تشكيله، مما يجعل النص فضاءً مفتوحًا لا نهائيًا من العلاقات.
2. مناهج تحليل النصوص في ما بعد الحداثة
الأركيولوجيا (الحفر النصي): تنظر إلى النص باعتباره مكونًا من طبقات تاريخية، حيث يتم تحليل أصوله واستعاراته المتراكمة.
الجينولوجيا (التتبع الجيني): تبحث في كيفية تشكّل الأفكار داخل النص وتحولها عبر الزمن، متأثرة بالسلطة والسياقات الثقافية.
الإتمولوجيا (أصل الكلمات): تدرس كيف تتغير معاني المفردات داخل النص، مما يسمح بفهم أعمق للتحولات الدلالية والمجازات المستخدمة.
3. التكامل بين هذه المناهج
في قصيدة ما بعد الحداثة، يتفاعل التناص مع هذه المناهج الثلاثة ليكشف كيف أن النصوص ليست مستقلة، بل هي إعادة تدوير وتحوير لنصوص سابقة، وكيف أن اللغة نفسها ليست محايدة بل متغيرة حسب الزمن والسلطة والتأويل.
هذا الفهم يجعل القصيدة بعد الحداثية ليست مجرد تجربة شعرية، بل ساحة مفتوحة للنقد والتأويل المتعدد، حيث لا يوجد معنى نهائي، بل سلسلة من الانزياحات المستمرة في الدلالة.
النقد السياسي والإنساني:
إن القصيدة تتخذ من الواقع العربي الحديث، ومن الأزمات التي عصفت بالدول العربية، مجالًا نقديًا واسعًا. فما بين صواريخ الحروب، ودماء الأبرياء، والموت الذي يطارد كل شيء حيّ، تتجلى الصرخة المدوية ضد الظلم الاجتماعي والسياسي. الحروب، التي تحولت إلى أدوات لتدمير الحياة بدلًا من الحفاظ عليها، تُصوَّر هنا كأداة لتدمير البشر وتدمير القيم الإنسانية التي تأسس عليها المجتمع. النص لا يقتصر على الهجوم على السياسة الخارجية، بل يوجه الضوء أيضًا على كيفية التفكك الداخلي للدولة وخراب مؤسساتها. "لا جيش، لا شرطة، لا أمن"، معركة الحروب لا تنتهي إلا بتدمير الأسس التي كانت قائمة. فالمواطن العربي اليوم، داخل هذا السياق، يعاني من العزلة والانكسار الناتج عن قلة الأمل، مما يعكس هزيمة النفس البشرية أمام صراعات خارجية مُدمِّرة.
6/
الأبعاد الإنسانية:
القصيدة تعيد تذكيرنا بأن الأسى ليس في الحرب فقط، بل أيضًا في الذاكرة المجتمعية التي تحتفظ بجرحها عبر الأجيال. هي حالة إنسانية تراجيدية تجد نفسها تراقب الانهيار الثقافي والوجودي في وقت واحد، وعليه، يتم استدعاء أصوات الضحايا والمجاهدين والأطفال الذين يُقتَلون وهم يحملون أحلامًا لا تتحقق. صورة المرأة المبتورة يدها، وهي تطلب طفلها لا يدها، تبرز حجم المعاناة والتمزق الذي يعصف بالإنسان، رغم أنه يحاول الوصول إلى إنسانيته رغم كل هذا العنف المحيط ويجد المتلقي الحضور الجندري على امتداد جسد القصيدة وتاخل في الرمز والاسطورة ....الخ بل في الاشتغال بالبلاغة الجديدة
7/
الحداثة في الشعر:
الحداثة الشعرية ظهرت في القرن العشرين كرد فعل على التقليد الشعري العربي الكلاسيكي. تأثرت بحركات عالمية مثل الرمزية والسريالية والتعبيرية، وأبرز معالمها:
1-كسر عمود الشعر الخليلي والاتجاه نحو قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثر.
2-تفكيك البنية التقليدية للقصيدة من حيث الوزن والقافية.
3-اللغة الشعرية المكثفة ذات البعد الرمزي والمجازي العميق.
4-التجربة الذاتية والفلسفية في تناول الهمّ الإنساني.
5-التأثر بالمدارس الغربية وإعادة تشكيل الموروث العربي في ضوء الرؤية الجديدة.
أسس قصيدة الحداثة
1. التجديد في الشكل:
- تكسير الوزن والقافية التقليديين.
- استخدام عناصر جديدة مثل قصيدة التفعيل، مما يمنح الشاعر حرية أكبر في التعبير مع البقاء ضمن مقيدات شكليه ، وقصيدة بالنثر
2. الرمزية والتجريد:
- التركيز على الرموز والمعاني العميقة.
- استخدام الصور الشعرية بشكل مكثف، حيث يسعى الشاعر لخلق تجربة جمالية متفردة.
3. المواضيع و الوجودية:
- تناقش قضايا الهوية، الاغتراب، والبحث عن الذات.
- تعكس التوترات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي.
قصيدة الحداثة
- تناولت موضوعات الانكسار، وقضايا الوجود والتهميش الاجتماعي والسياسي.
4. اللغة:
- استخدام لغة مركبة وغامضة تتطلب من القارئ تفكيك المعاني.
- التركيز على الجماليات اللغوية.
قصيدة ما بعد الحداثة
- تركز على موضوعات مثل الهويات المتعددة، والتشكيك في السرديات الكبرى.
- تعكس قضايا العولمة، والتكنولوجيا، والتحولات الثقافية.
- لغة مكثفة وغامضة في كثير من الأحيان، تهدف إلى خلق معانٍ جديدة.
- استخدام الصور الشعرية بشكل مكثف.
- غالبًا ما تتسم باللعب، والفكاهة، وتقديم نصوص غير متجانسة، مما يعكس فوضى العالم الحديث.
- لغة أكثر مباشرة وعامية، مع استخدام السخرية والتهكم.
- تداخل بين الأنواع الأدبية واستخدام أساليب السرد المختلفة.
السياق الثقافي
- تميزت بتعدد الأصوات والأنواع، واستخدام تقنيات مثل التناص والاقتباس.
- غالبًا ما تتسم باللعب، والفكاهة، وتقديم نصوص غير متجانسة، مما يعكس فوضى العالم الحديث.
- تركز على موضوعات مثل الهويات المتعددة، والتشكيك في السرديات الكبرى.
- تعكس قضايا العولمة، والتكنولوجيا، والتحولات الثقافي
- لغة أكثر مباشرة وعامية، مع استخدام السخرية والتهكم.
- تداخل بين الأنواع الأدبية واستخدام أساليب السرد المختلفة.
- تتأثر بالتغيرات العالمية السريعة، مثل العولمة، وتقنية المعلومات، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل الفهم الثقافي.
8/
التطورات العالمية وتأثيرها
مع تطور الفكر النقدي والإبداعي في العالم، تأثرت الشعر العربي بالاتجاهات العالمية مثل السريالية، والوجودية، والتفكيكية. هذه التأثيرات ساهمت في تعزيز التجريب والابتكار في الشعر العربي، مما أدى إلى ظهور قصائد تعكس التعقيد والغرابة في الحياة المعاصرة.
بهذا الشكل، يمكن القول إن قصيدة الحداثة وما بعد الحداثة تمثلان تطورًا في التعبير الفني عن التغيرات الاجتماعية والثقافية، مما يعكس التحديات والتعقيدات التي تواجه المجتمعات العربية والعالم بشكل عام.
أسس قصيدة ما بعد الحداثة
1. التعددية والاختلاف:
- تقبل تعدد الأصوات والوجهات النظر، حيث يُعتبر النص مجالاً للتفاعل بين أفكار متعددة.
- يُعبر عن تفاوت الهويات الثقافية والانتماءات.
2. التناص والاقتباس:
- استخدام نصوص وأفكار من ثقافات وأعمال أدبية مختلفة، مما يُعزز من شبكة المعاني ويعكس التفاعل الثقافي.
- يُشجع على إعادة قراءة النصوص القديمة في سياقات جديدة.
3. صعوبة تحديد المعنى:
- تعكس عدم وجود معنى ثابت، حيث يقوم المعنى على التفسير الشخصي والتجربة الفردية للقارئ.
- تعتمد على الغموض والتعقيد، مما يُشجع القارئ على التفكر والتأمل.
4. الأسلوب اللغوي:
- استخدام لغة أكثر مباشرة وأحيانًا شعبية، مع التركيز على اللعب اللغوي والسخرية.
- تداخل بين الأنواع الأدبية المختلفة، مثل الشعر والنثر والمسرحية.
5. تفكيك السرد التقليدي:
- الابتعاد عن الحبكة الخطية، مما يمكن النص من الانتقال بين الزمان والمكان بشكل حر.
- تفاعل النص مع نفسه، حيث يمكن أن يحتوي على تكرار أو تداخل.
الاختلافات الرئيسية
الشكل: بينما تسعى قصيدة الحداثة إلى التجديد من خلال كسر الأشكال التقليدية، فإن قصيدة ما بعد الحداثة تتجاوز هذه الأشكال إلى تعددية الأصوات والتلاعب بالشكل بشكل أكبر.
-المعنى في قصيدة الحداثة، يسعى الشاعر إلى خلق معاني جديدة، بينما في ما بعد الحداثة يصبح المعنى غير ثابت ويعتمد على تفاعل القارئ مع النص.
المواضيع بينما تركز الحداثة على القضايا الوجودية، فإن ما بعد الحداثة تتعامل مع قضايا الهوية والعولمة والتقنيات الحديثة.
التفاعل مع المتلقي: في قصيدة الحداثة، يُعتبر القارئ مُفسرًا للنص، بينما في قصيدة ما بعد الحداثة، يُعتبر القارئ جزءًا من بناء النص نفسه.
9/
الاختلافات الشكلية:
قصيدة الحداثة:
تحرر من الوزن والقافية التقليديين، وظهور قصيدة التفعيلة والشعر الحر.
استخدام الرموز والصور الشعرية المكثفة.
تنوع في الأشكال الشعرية، مع ميل إلى التجريد والغموض.
قصيدة ما بعد الحداثة:
تجاوز أكبر للقيود الشكلية، مع تجريب أشكال شعرية جديدة وغير تقليدية.
استخدام اللغة العامية واليومية، ودمجها مع اللغة الفصحى.
تداخل الأجناس الأدبية، واستخدام تقنيات السرد والمسرح في الشعر.
الاعتماد على التفكيك، والتناص، والتهجين.
ونحن نعتبر قصيدة بالنثر ( البروس) شكل حداثي تواصل وجودة وتطويره في مابعد الحداثة
2. الاختلافات الموضوعية:
قصيدة الحداثة:
التعبير عن القلق الوجودي والضياع الإنساني.
الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية، والتعبير عن روح الثورة والتغيير.
استكشاف الذات والهوية، والتعبير عن التجارب الفردية.
قصيدة ما بعد الحداثة:
رفض الثوابت والقيم المطلقة، والاحتفاء بالتعددية والاختلاف.
التركيز على تفكيك الخطابات المهيمنة، والكشف عن السلطة والتحيزات.
الاهتمام بالواقع اليومي والتفاصيل الصغيرة، والتعبير عن عبثية
3. الاختلافات الأسلوبية:
قصيدة الحداثة:
استخدام اللغة الرمزية والمجازية، والتعبير عن الأفكار المعقدة بأسلوب مكثف.
الاهتمام بالصورة الشعرية، واستخدام تقنيات بصرية وسمعية جديدة.
التركيز على التجريب والابتكار، وتجاوز الأساليب التقليدية.
قصيدة ما بعد الحداثة:
استخدام اللغة العامية واليومية، ودمجها مع اللغة الفصحى.
الاهتمام بالتناص والسخرية والمفارقة، والتعبير عن الواقع بأسلوب ساخر وناقد.
التركيز على تفكيك اللغة، وإظهار قدرتها على توليد معانٍ متعددة.
4. الاختلافات البنيوية:
قصيدة الحداثة:
تفكيك البنية التقليدية للقصيدة، واستخدام تقنيات القطع والمونتاج.
الاهتمام بالتجريب البصري، واستخدام الفراغات والبياض في الصفحة.
تعدد الأصوات والوجهات النظر داخل القصيدة الواحدة.
قصيدة ما بعد الحداثة:
تجاوز مفهوم القصيدة كوحدة متكاملة، والاهتمام بالنصوص المفتوحة والمتعددة التأويلات.
استخدام تقنيات التناص والتداخل النصي، ودمج نصوص مختلفة في نص واحد.
الاهتمام بتفكيك الخطابات المهيمنة، والكشف عن السلطة والتحيزات.
ارتباط ذلك بتطور حركة الشعر العالمي:
تأثرت قصيدة الحداثة العربية بحركات الحداثة الغربية، مثل الرمزية والسريالية والتعبيرية.
تأثرت قصيدة ما بعد الحداثة العربية بحركات ما بعد الحداثة الغربية، مثل التفكيكية والبنيوية وما بعد البنيوية.
ساهم الشعراء العرب في تطوير حركة الشعر العالمي، من خلال تقديم تجارب شعرية جديدة ومبتكرة.
آمل أن يكون هذا التوضيح مفيدًا.
10/
الاختلافات الرئيسية بين قصيدة الحداثة وقصيدة ما بعد الحداثة:
1. الشكلية (البنية الشعرية):
- قصيدة الحداثة العربية: تميل إلى تجاوز القوالب التقليدية كالبحر والوزن مع الحفاظ على البنية المتماسكة والجماليات الواضحة. يُظهر هذا النهج تركيزًا على الاستمرارية والانسجام الداخلي.
- قصيدة ما بعد الحداثة: تتجه نحو التفكيك والهدم البنيوي، حيث لا تلتزم بالبنية أو الصياغة الموحدة. يمكن أن تحتوي على مقاطع متداخلة وغير مترابطة تعكس التشتت الفكري.
2. الموضوعية (الثيمات):
- قصيدة الحداثة: تركز على موضوعات تتعلق بالوجود، الصراع الإنساني، والقضايا الوجودية مع لمسة من التفاؤل أو البحث عن المعنى.
- قصيدة ما بعد الحداثة: تُبرز التشكيك والمعاني المتعددة، مع اهتمام بالتفاصيل اليومية والهامشية، وغالبًا ما تعكس إحساسًا بالاغتراب أو التناقض.
3. الأسلوبية (التعبير):
- قصيدة الحداثة: تستخدم لغة رمزية وأحيانًا غامضة، لكنها تميل إلى بناء صورة متماسكة وشاملة.
- قصيدة ما بعد الحداثة: تميل إلى السخرية والتداخل ما بين الجدي والفكاهي، مع إسقاط الجماليات التقليدية لصالح التعبير الحر والمفتوح.
4. البنية (الإيقاع والتنسيق):
- قصيدة الحداثة: ما تزال تحاول تقديم إيقاع معين وإن كان مختلفًا عن التقليدي، مع سعي للتجديد.
- قصيدة ما بعد الحداثة: تتجنب الإيقاع الثابت وتتقبل العشوائية والفوضى كأسلوب شعري.
الارتباط بالتطور العالمي:
ما يحدث في الشعر العربي يعكس تطورات الشعر العالمي.
- الحداثة: تأثرت بحركات مثل الرمزية والسريالية الأوروبية، مع رغبة في التجديد مع الحفاظ على الهوية.
- ما بعد الحداثة: تأثرت بفلسفات التفكيك التي برزت في الغرب، مثل فوكو ودريدا، مما أدى إلى تعزيز فكرة تعددية المعاني وانهيار المركزية.
هذه التغيرات تدل على رغبة مستمرة في مواكبة التحولات الفكرية والفنية التي تحدث عالميًا. إذا كنت بحاجة لتفاصيل أعمق عن أي من النقاط، يمكنني التوسع فيها.
البُعد الشكلي البنيوي (العلاقة مع النص الشعري):
- قصيدة الحداثة: تسعى لإعادة تشكيل العلاقة مع النص الشعري عبر خلق توازن بين التحرر من القوالب الشعرية التقليدية مثل الوزن والقافية، مع الحفاظ على عمق الرمزية والتعبير الفني. تأخذ النصوص أحيانًا شكلًا سرديًا أكثر تنظيماً، مدمجًا بصور غنية تساعد في خلق وحدة داخلية.
- قصيدة ما بعد الحداثة: ترفض تمامًا الالتزام بأي شكل أو بنية ثابتة. يمكن أن تبدو النصوص متشظية أو متعددة الأصوات (Polyphonic)، حيث تسود فكرة التناقض والتداخل بين الحكي والصورة الشعرية.
البُعد الموضوعي (ما تحمله النصوص من معانٍ):
- قصيدة الحداثة: الموضوعات تدور حول البحث عن الهوية، العلاقات البشرية، والتجربة الفردية والكونية. غالبًا ما تحتوي على إحساس داخلي بالمعاناة والبحث عن المعنى الأعمق في واقع معقد.
- قصيدة ما بعد الحداثة: تنطلق نحو تشكيك المعاني المطلقة والسرديات الكبرى، مع تقديم تجارب يومية هامشية. تعبر عن الشعور بالتشظي والتناقضات الثقافية والوجودية، لتصبح انعكاسًا للتغيرات الجذرية في الفكر المعاصر.
(التقنيات التعبيرية):
- قصيدة الحداثة: تُركز على استخدام الرمزية والاستعارة بكثافة لصنع صورة متماسكة، مع لغة تجريدية تفتح المجال للتأويل.
- قصيدة ما بعد الحداثة:تُقدم لغتها بشكل مباشر ومتعدد الأبعاد، وغالبًا ما تتجاوز الحدود لتدمج بين الجدي والسخرية مع صور غير مكتملة تهدف إلى إثارة الجدل بدلاً من الإيضاح.
ارتباطها بالشعر العالمي:
- قصيدة الحداثة: تأثرت بحركات أدبية عالمية مثل الرمزية في فرنسا، السريالية في أوروبا، والتعبيرية في ألمانيا. هذه الحركات ساهمت في دفع الشاعر العربي للبحث عن صوت جديد يجمع بين الأصالة والتجديد.
- قصيدة ما بعد الحداثة: تأثرت بالتطورات الفكرية في الفلسفة والتفكيك مع دريدا، والوجودية المتأخرة، حيث ظهرت الرغبة في رفض المقولات النهائية. الشعر العربي في هذه المرحلة أصبح جزءًا من الحركة العالمية التي تعيد تعريف ماهية الإبداع الأدبي.
11/
أبرز شعراء الحداثة:
بدر شاكر السياب، نازك الملائكة،عبدالوهاب البياتي، محمود درويش، أدونيس، محمد الماغوط
.ططططططط
ما بعد الحداثة في الشعر:
تطورت الحداثة إلى ما بعد الحداثة، وهي حركة رفضت القواعد والأنظمة، حتى تلك التي فرضتها الحداثة نفسها. أهم سماتها:
تفكيك المعنى واللعب باللغة بشكل عبثي أحيانًا.
تداخل الأجناس الأدبية بحيث لا يمكن التمييز بين الشعر والنثر والسرد.
تفكيك الذات الشاعرة وإلغاء مركزيتها.
توظيف المفارقة والسخرية والتناص مع النصوص القديمة والجديدة.
غياب الأيديولوجيا السياسية والعقدية الكبرى، حيث لم تعد القصيدة ملتزمة بأي قضية كبرى، بل تحولت إلى لعبة لغوية وفكرية مفتوحة.
أبرز شعراء ما بعد الحداثة:
سليم بركات، وديع سعادة، قاسم حداد، أمجد ناصر.ويمكننا إضافة د. بشرى البستاني (بكل ثقة)
مقارنة بين الحداثة وما بعد الحداثة:
1. الاختلافات الشكلية (الفنية):
- قصيدة الحداثة العربية:
- التحرر من الوزن والقافية: اعتمدت على الشعر الحر (التفعيلة) وانزياحات عن القصيدة العمودية، مع الحفاظ على إيقاع داخلي (مثل شعر أدونيس ونازك الملائكة).
- التجريب المحدود: انفتحت على الأسطورة والرمز، لكنها بقيت مرتبطة ببنية شعرية متماسكة نسبيًا.
- الصورة الشعرية: اعتمدت على الاستعارة المركبة والمجاز العميق، مع محافظة على منطق داخلي (مثال: صلاح عبد الصبور).
- قصيدة ما بعد الحداثة:
- تفكيك الشكل تمامًا: استخدمت النثر الشعري، والقصيدة النثرية، والتشكيل البصري (كقصيدة النص الواحد أو الكتابة التفاعلية).
- الفوضى المُنظمة: تكسر الإيقاع المتوقع، مثل قصائد أمجد ناصر أو فاطمة قنديل، حيث تتداخل السرد مع الشعر.
- التشظي البصري: استخدام الفراغات، والكلمات المبعثرة، ودمج الفنون (كالقصيدة المرئية).
الارتباط بالشعر العالمي:
- الحداثة العربية تأثرت بتجارب ت.س. إليوت وباوند في الانزياح عن الكلاسيكية.
- ما بعد الحداثة العربية تواكب تيارات مثل "شعر اللغة" الأمريكي (Language Poetry) الذي ركز على تفكيك اللغة نفسها.
2. الاختلافات الموضوعية:
- قصيدة الحداثة:
- الهمّ الوجودي والإنساني: التركيز على الذات المتمردة، والبحث عن الهوية (مثل قصائد محمود درويش السياسية-الوجودية).
- الالتزام السياسي والاجتماعي: النضال ضد الاستعمار، وطرح أسئلة الحريّة والعدالة.
- الأسطورة والتراث: إعادة تفسير الرموز التراثية (كاستخدام أدونيس لأسطورة "تموز").
- قصيدة ما بعد الحداثة:
- تفكيك اليقينيات: التشكيك في المرويات الكبرى (كالدين، السياسة، الهوية)، والسخرية من المفاهيم الثابتة.
- التركيز على الهشاشة: تصوير التفاصيل اليومية التافهة، واللحظات العابرة (كما في شعر عباس بيضون).
- اللا-التزام: تجنب الرسالة المباشرة، واللعب على تعددية الدلالات.
الارتباط بالشعر العالمي:
- الحداثة العربية تشابهت مع حركات مثل "الوجودية" الأوروبية.
- ما بعد الحداثة تتفاعل مع فلسفات دريدا وفوكو في تفكيك السلطات، كما في شعر جون آشبيري الأمريكي.
3. الاختلافات الأسلوبية
- قصيدة الحداثة:
- اللغة المكثفة: استخدام لغة شعرية مرتفعة، مع ميل إلى البلاغة الجديدة.
- الوحدة العضوية: محاولة الحفاظ على تماسك النص (حتى عند استخدام الرمز).
-قصيدة ما بعد الحداثة:
- اللغة اليومية: تدخل العامية والكلام العادي إلى النص (مثل تجارب محمد بنيس).
- التناصّ: حوار مع نصوص أخرى (دينية، سينمائية، إعلانات...) بشكل فجّ أحيانًا.
- الانزياح اللغوي: كسر قواعد النحو، وخلق تعابير غير مألوفة.
الارتباط بالشعر العالمي:
- أسلوب ما بعد الحداثة يعكس تأثير تيارات مثل "البوب آرت" في دمج الثقافة الشعبية، كما في شعر ألن غينزبرغ.
4. الاختلافات البنيوية:
- قصيدة الحداثة:
- البناء المتدرج: تطور الأفكار في تسلسل منطقي (بداية، ذروة، نهاية).
- المركزية: وجود صوت شعري مهيمن (الشاعر كـ"نبي" أو مثقف ملهم).
- قصيدة ما بعد الحداثة:
- للا-تراتبية: نصوص متشظية، بدون بداية أو نهاية واضحة.
- تعدد الأصوات: تدمير سلطة الشاعر، وإشراك القارئ في بناء المعنى (كما في نصوص سنية صالح).
الارتباط بالشعر العالمي:
- بنية ما بعد الحداثة تعكس تأثير الرواية الجديدة (مثل رولان بارت) وتفكيك السلطة المؤلفة.
أولًا: شعراء الحداثة العربية (ومن أبرز تأثيراتهم العالمية):
1. عرب:
- أدونيس (علي أحمد سعيد)
- مثال: "هذا هو اسمي" – اعتمد على الأسطورة والرمز، مع تحرر جزئي من الوزن.
-نازك الملائكة
- رائدة الشعر الحر (التفعيلة) في قصيدة "الكوليرا". مع بدر شاكر السياب في قصيدة " هل كان حبًا"
-محمود درويش
- مزج بين الهمّ السياسي والوجودي في "بطاقة هوية" أو "جدارية".
- صلاح عبد الصبور
- مثال: "رسالة من تحت الماء" – صورٌ مكثفة وانزياحات رمزية.
- بدر شاكر السياب
- قصيدة "أنشودة المطر" – توظيف التراث مع تجديد إيقاعي.
2. أجانب (تأثروا بهم العرب):
- ت.س. إليوت (T.S. Eliot)
- قصيدة "الأرض اليباب" – تأثير واضح في استخدام الأسطورة (مثل أدونيس).
-عزرا باوند (Ezra Pound)
- حركة "التصويرية" (Imagism) – أثرت في بناء الصورة الشعرية العربية.
- فيديريكو غارثيا لوركا (Federico García Lorca)
- قصائده المليئة بالرمزية والغرابة (مثل "مرثية لإغناثيو سانشيث").
ثانيًا: شعراء ما بعد الحداثة العربية (ومن أبرز تأثيراتهم العالمية):
1. عرب:
- أمجد ناصر
- مثال: "حياة كسرد متقطع" – نصوصٌ تشبه اليوميات، تدمج السرد بالشعر.
- عباس بيضون
- قصيدة "الوقت بجرعات كبيرة" – تركيز على التفاصيل الهشّة واللغة اليومية.
- فاط
- استخدام التشظي والانزياح البصري في "كتاب اللاوجود".
- سنية صالح
- قصائد تفكك السلطة الذكورية وتعيد تشكيل اللغة (مثل "مرايا نرسيس").
- محمد بنيس
- "هاجر صاحيتها" – تناصّ مع التراث الصوفي والثقافة الشعبية.
2. أجانب (تأثروا بهم العرب):
- جون آشبيري (John Ashbery)
- قصيدة "التدفق الذاتي" – غموض متعمد وتعددية دلالية (تشبه نصوص عباس بيضون).
- ألن غينزبرغ (Allen Ginsberg)
- "عواء" – لغة صادمة وانزياح عن الشكل الكلاسيكي (مؤثر في تيار القصيدة النثرية العربية).
- آن كارسون (Anne Carson)
- مزجت بين الشعر والنثر والفلسفة في "انزياح الجمال" (تشبه تجارب سنية صالح).
- رون بادجيت (Ron Padgett)
- من شعراء "لغة نيويورك" الذين كسروا قواعد النحو (مؤثر في الانزياح اللغوي الع ثالثًا: كيف تفاعل العرب مع التطور العالمي؟
1. الحداثة العربية والغربية:
- التقاطعات:
- أدونيس تأثر بالسوريالية الفرنسية (أندريه بريتون) و"الانزياح الرمزي" ل ت.س. إليوت.
- محمود درويش حوار مع شعراء الالتزام مثل بابلو نيرودا.
2. ما بعد الحداثة العربية والغربية:
- التقاطعات:
- أمجد ناصر تأثر بـ"شعر السرد" الأمريكي (مثل تشارلز سيميك).
- محمد بنيس حوار مع فلسفة جاك دريدا في تفكيك النصوص.
- الخصوصية العربية:
- احتفظت ما بعد الحداثة العربية بلمحات من القضية الفلسطينية والهوية (مثل درويش المتأخر في "لا تعتذر عما فعلت").
- تفاعلت مع الثورة الرقمية (قصائد تفاعلية على منصات مثل "فيسبوك" – مثال: قصائد الشاعر العراقي سركون بولص).
12/
رابعًا: نماذج قصائد توضح الفروق:
1. حداثية نموذجية:
- قصيدة "الغريب" لأدونيس:
- بنية متماسكة، إيقاع داخلي، واستعارة أسطورية (تموز).
2. ما بعد حداثية نموذجية:
-قصيدة "رسالة إلى لا أحد" لعباس بيضون:
- نثر شعري، لغة يومية، وتشظٍّ زمني:
"أكتبُ إليكِ لأنني لا أعرفُ ماذا أفعلُ بالضوءِ الذي يملأ غرفتي...".
لتحليل الاختلافات بين قصيدة الحداثة العربية وقصيدة ما بعد الحداثة، يمكننا النظر إلى الموضوعات والأسلوب والبنية من منظور تاريخي ونقدي، مع ربط ذلك بتطور الشعر العالمي. هذه المقارنة ليست فقط تقنية بل تكشف عن تحولات فكرية وثقافية عميقة.
قصيدة الحداثة العربية:
- اعتمدت على تحرر نسبي من قيود القافية الموحدة والبحور الصارمة
- استخدمت السطر الشعري بدلاً من البيت التقليدي
- حافظت على قدر من التماسك الشكلي والإيقاع الداخلي
- اهتمت بالتكوين البصري للنص على الصفحة
قصيدة ما بعد الحداثة:
- تحررت بشكل أكبر من أي قيود إيقاعية أو شكلية
- دمجت بين النثر والشعر والسرد والشذرات
- تجاوزت حدود النوع الأدبي (تهجين الأنواع)
- اهتمت أكثر بالتجريب الشكلي المتطرف
- استخدمت الفراغات والبياض كعناصر تعبيرية
الاختلافات الموضوعية:
قصيدة الحداثة العربية:
- اهتمت بالقضايا الكبرى (الهوية، التحرر، القومية)
- حملت رؤى شمولية تجاه المجتمع والوجود
- سعت إلى تقديم تفسيرات كلية للعالم
- آمنت بدور الشاعر كمصلح اجتماعي أو رائي
قصيدة ما بعد الحداثة:
الاختلافات الشكلية:
قصيدة الحداثة العربية:
- اعتمدت على تحرر نسبي من قيود القافية الموحدة والبحور الصارمة
- استخدمت السطر الشعري بدلاً من البيت التقليدي (قصيدة التفعيلة)
- حافظت على قدر من التماسك الشكلي والإيقاع الداخلي
- اهتمت بالتكوين البصري للنص على الصفحة
- تبنت نظاماً بنائياً متماسكاً رغم تحررها من الشكل الكلاسيكي
قصيدة ما بعد الحداثة:
- تحررت بشكل كامل من أي قيود إيقاعية أو شكلية
- دمجت بين النثر والشعر والسرد والشذرات
- تجاوزت حدود النوع الأدبي (تهجين الأنواع)
- اهتمت بالتجريب الشكلي المتطرف والتشظي
- استخدمت الفراغات والبياض والتشكيل البصري كعناصر تعبيرية أساسية
- وظفت التقنيات البصرية والرقمية والوسائط المتعددة في بعض أشكالها المتطورة
الاختلافات الموضوعية:
قصيدة الحداثة العربية:
- اهتمت بالقضايا الكبرى (الهوية، التحرر، القومية، الاستعمار)
- حملت رؤى شمولية وميتافيزيقية تجاه المجتمع والوجود
- سعت إلى تقديم تفسيرات كلية للعالم والإنسان
- آمنت بدور الشاعر كمصلح اجتماعي أو رائي أو متنبئ
- تعاملت مع الذات الشاعرة كمركز للوعي والإدراك
- احتفت بالأساطير الكبرى وأعادت توظيفها (تموز، عشتار، السندباد)
قصيدة ما بعد الحداثة:
- انشغلت بالتفاصيل الصغيرة والهامشي واليومي
- شككت في السرديات الكبرى والمفاهيم المطلقة
- اهتمت بتفكيك المسلمات الثقافية والأيديولوجية
- تناولت قضايا مثل الجسد والجنسانية والتهميش
- فككت الذات الشاعرة وأخضعتها للتشظي والتشكيك
- احتفت بالعبثية والسخرية والمفارقة
- تجاوزت الثنائيات التقليدية (خير/شر، جميل/قبيح، ذكر/أنثى)
الاختلافات الأسلوبية:
قصيدة الحداثة العربية:
- استخدمت لغة مكثفة مشحونة بالرمز والإيحاء
- وظفت الصورة الشعرية المركبة والممتدة
- حافظت على قدر من الغنائية والتعبير الذاتي
- اعتمدت على التناص مع النصوص التراثية والدينية
- سعت إلى خلق معجم شعري جديد
قصيدة ما بعد الحداثة:
- مزجت بين المستويات اللغوية (الفصحى والعامية ولغة الإعلام)
- وظفت التشظي اللغوي والتفكك النحوي والدلالي
- اعتمدت على التقطيع والمونتاج والتوليف
- استخدمت التناص بصورة مكثفة ومتعددة المستويات
- احتفت بالمحاكاة الساخرة (الباروديا) والتلاعب اللغوي
- دمجت المرئي مع المكتوب والصوت مع الصورة
الاختلافات البنيوية:
قصيدة الحداثة العربية:
- اعتمدت على بنية درامية متماسكة رغم تعدد الأصوات
- حافظت على خط سردي أو فكري يتطور داخل القصيدة
- سعت إلى تحقيق وحدة عضوية بديلة عن الوحدة التقليدية
- بنت القصيدة على أساس المقاطع المترابطة
- اعتمدت على تقنيات كالتكرار والتوازي لخلق إيقاع داخلي
قصيدة ما بعد الحداثة:
- تبنت البنية المفككة والمشظاة والمتشعبة
- تخلت عن الخط الدرامي المتماسك لصالح التداعي الحر
- وظفت التعدد الصوتي والتناقض والتضاد داخل النص
- جمعت بين أزمنة وأمكنة متباعدة دون رابط منطقي
- اعتمدت على أسلوب القطيعة والمفاجأة والصدمة
ارتباط التطور بحركة الشعر العالمي:
1. التأثر بالمدارس الغربية:
- تأثرت الحداثة العربية بالرمزية والسريالية والرومانسية الغربية
- تأثرت ما بعد الحداثة العربية بتيارات ما بعد البنيوية والتفكيكية
2. العولمة الثقافية:
- سرعة انتقال التأثيرات الشعرية عبر الترجمة ووسائل التواصل
- تزامن التحولات الشعرية العربية مع نظيراتها العالمية بشكل أكبر
3. التحولات السياسية والاجتماعية:
- ارتبطت الحداثة بمرحلة التحرر الوطني والقومية والنهضة
- ارتبطت ما بعد الحداثة بانهيار المشاريع الكبرى وصعود العولمة وتفكك اليقينيات
4. التطور التكنولوجي:
- أثرت وسائل الاتصال والإعلام الجديدة على بنية القصيدة ولغتها
- ظهور أشكال شعرية تفاعلية ورقمية متأثرة بالتكنولوجيا
5.التفاعل مع الفنون الأخرى:
- تأثر الشعر بالفنون التشكيلية والسينما والموسيقى
- ظهور أشكال شعرية بينية تتجاوز حدود الكتابة التقليدية
يمكن القول إن شعراء الحداثة العربية مثل بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وأدونيس وصلاح عبد الصبور أسسوا لمشروع حداثي عربي أصيل رغم استفادتهم من التجارب العالمية، بينما اتجه شعراء ما بعد الحداثة مثل محمد بنيس ومحمد الماغوط وسعدي يوسف (في مراحله المتأخرة) ووديع سعادة وأنسي الحاج نحو آفاق تجريبية تتقاطع بشكل أكبر مع تيارات الشعر العالمي المعاصر.
محمد عفيفي مطر يمثل صوتاً أساسياً في حركة الحداثة الشعرية العربية، حيث قدم نموذجاً فريداً يجمع بين الالتزام السياسي والاجتماعي والتجديد اللغوي. تميزت قصائده بلغة مركبة كثيفة تستدعي التراث وتعيد صياغته برؤية معاصرة، وقد طور أسلوباً خاصاً في بناء الصورة الشعرية يتسم بالتكثيف والعمق والتركيب المعقد. من أبرز دواوينه "من أوراق الأرض المحتلة" و"أقوال جديدة عن حرب البسوس" و"رباعيات الفرح الروماني".
أما حسب الشيخ جعفر فيعد من الأصوات الشعرية العراقية المهمة التي جمعت بين الروح الصوفية والهم الإنساني المعاصر، وقد استطاع أن يقدم تجربة شعرية متفردة تستلهم التراث الصوفي وتوظفه في سياق حداثي. تميزت قصائده بالتأمل العميق والنفس الروحاني والتناص مع التراث الإسلامي والصوفي، مع اهتمام خاص بقضايا المعاناة الإنسانية والآلام المعاصرة. من أهم أعماله "المعبد الغريق" و"فارس السراب" و"خلف السدرة".
إضافتهما إلى قائمة الشعراء المؤثرين تثري بالتأكيد الصورة الشاملة لمشهد الحداثة الشعرية العربية وتنوع تياراتها وأصواته
1.الاختلافات الشكلية:
قصيدة الحداثة العربية:
- الشكل:
- اعتمدت قصيدة الحداثة على كسر القوالب التقليدية للشعر العربي (كالعمودي)، لكنها لم تتخلَ بالكامل عن الإيقاع أو الموسيقى.
- ظهرت قصيدة التفعيلة التي تعتمد على نظام تفاعيل متغير داخل البيت الواحد، مما أتاح مرونة أكبر مقارنة بالوزن الخليلي.
- تميزت بأشكال شعرية جديدة مثل الومضة، الحوار، والقصيدة النثرية في بداياتها.
- التأثير العالمي:
- تأثرت قصيدة الحداثة العربية بشكل كبير بالشعر الغربي الحديث (مثل تجارب ت.س. إليوت، إزرا باوند، وبودلير)، حيث ركزت على استخدام الرمزية، التداعي الحر، والتركيز على الذات الشاعرة.
2. الاختلافات الموضوعية:
قصيدة الحداثة العربية:
- الموضوعات:
- ركزت على القضايا الكبرى مثل الهوية الوطنية، الاستقلال السياسي، والعلاقة بين الفرد والمجتمع.
- كانت هناك محاولات للتعبير عن الذات الشاعرة بشكل أعمق، مع التركيز على القلق الوجودي، العزلة، والبحث عن المعنى.
- استخدمت الرمزية والغموض للتعاطي مع موضوعات حساسة مثل الدين، السياسة، والحب.
- التأثير العالمي:
- كانت قصيدة الحداثة مرآة للتحولات الثقافية والسياسية في العالم العربي، مع تأثر واضح بالحداثة الغربية التي ناقشت قضايا مشابهة مثل الحرب العالمية الثانية، الثورة الصناعية، والاغتراب.
قصيدة ما بعد الحداثة:
- الموضوعات:
- ركزت على التشكيك بالمفاهيم الكبرى مثل التاريخ، الحقيقة، والهوية. أصبحت الموضوعات أكثر غموضًا وتجريدًا.
- ظهرت مواضيع جديدة مثل الهجين الثقافي، العولمة، والتكنولوجيا.
- أصبحت الشخصية الشاعرة أقل مركزية، مع التركيز على تنوع الأصوات والتجارب الفردية.
- التأثير العالمي:
- تأثرت قصيدة ما بعد الحداثة بالتحولات الفكرية المرتبطة بما بعد الحداثة الغربية، حيث أصبحت القضايا البيئية، التكنولوجيا الرقمية، والهجرة محورية.
3. الاختلافات الأسلوبية:
قصيدة الحداثة العربية:
- الأسلوب:
- اعتمدت على الرمزية والبلاغة المركزة، مع استخدام الصور الشعرية الغامضة التي تحتاج إلى تفسير.
- كان هناك تركيز على اللغة الجميلة والمُتقنة، مع سعي نحو التجديد دون التخلي الكامل عن التقاليد.
- كانت اللغة أداتًا للتعبير عن المشاعر العميقة والرؤى الفلسفية.
قصيدة ما بعد الحداثة:
-الأسلوب:
- اعتمدت على الأسلوب المفتوح والمتعدد، مع استخدام تقنيات مثل التضمين، السخرية، والتهكم.
- تخلت عن البلاغة التقليدية، واعتمدت على اللغة اليومية أو اللغات المختلطة (الهجينة).
- أصبحت اللغة أداة للتشويش أو الكشف عن التناقضات، بدلاً من كونها مجرد وعاء للمعنى.
4.الاختلافات البنيوية:
قصيدة الحداثة العربية:
-البنية:
- رغم كسر القوالب التقليدية، ظلت البنية الداخلية للقصيدة منظمة ومتماسكة.
- كانت القصيدة تقوم على فكرة الوحدة العضوية، حيث تتكامل الأجزاء لتشكيل رسالة أو رؤية موحدة.
قصيدة ما بعد الحداثة:
- البنية:
- أصبحت البنية أكثر هشاشة وتفتتًا، مع التركيز على التنوع والتشظي.
- ظهرت بنى جديدة مثل "النصوص المتداخلة"، "التناص"، و"البنية اللامركزية".
- أصبحت القصيدة أقرب إلى "العمل الفني المفتوح" الذي يعتمد على تفاعل القارئ لإكمال المعنى.
5. التطور العالمي وتأثيره:
-الحداثة العالمية:
- شهد القرن العشرون تحولات كبيرة في الشعر العالمي، حيث انتقل الشعر من الواقعية إلى الرمزية ومن ثم إلى الحداثة التي ركزت على الذات والرمز.
- تأثر الشعر العربي بهذه الحركات، خاصة في فترة الستينيات والسبعينيات، حيث سعت القصيدة العربية إلى مواكبة التطورات العالمية.
ما بعد الحداثة العالمية:
- جاءت ما بعد الحداثة رد فعل على الحداثة، حيث بدأت بالتشكيك في المركزية، اليقينية، والمعاني الثابتة.
- تأثر الشعر العربي بما بعد الحداثة الغربية، خاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث أصبح الشعر العربي أكثر انفتاحًا على التعددية والتجريب
13/0
الخاتمة:
سعت الحداثة لتطوير الشعر عبر تجديده ضمن رؤية فلسفية واضحة، بينما ما بعد الحداثة لم تلتزم بأي رؤية، بل مزجت بين الأساليب بطريقة عبثية أو مفتوحة على التأويل.
قصيدة الحداثة العربية وما بعد الحداثة تمثلان محطتين رئيسيتين في تطور الشعر العربي، حيث تعكس كل منهما تحولات ثقافية وفكرية عميقة. بينما ركزت الحداثة على التجديد الشكلي والرمزي، جاءت ما بعد الحداثة لتتحدى حتى هذه الأسس، مقدمة نصوصًا أكثر انفتاحًا وتعددية. في كلا الحالتين، كان هناك تأثير واضح للشعر العالمي، مما يجعل هذا التطور جزءًا من حركة أدبية عالمية أوسع.
{اختلافات جذرية في الشكل، الموضوع، الأسلوب، والبنية تعكس تحولات فكرية وثقافية عميقة بين الحداثة وما بعد الحداثة.}.
الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في الشعر العربي ليس انفصالًا، بل تطورًا يعكس تحولات فلسفية وتكنولوجية عالمية، مثل:
- صعود العولمة وانهيار الحدود بين الثقافات.
- تأثير الثورة الرقمية على مفهوم النص (التفاعلية، التشعب).
- تحوّل الذات من "بطل متمرّد" إلى "شظية ضائعة" في عالم فوضوي.
لكن تبقى الخصوصية العربية في تعاملها مع إرث التراث والهوية، مما يجعل هذه التيارات ليست نسخًا عن الغرب، بل حوارًا معه ومع الذات معًا.
فالحداثة سعت لتطوير الشعر عبر تجديده ضمن رؤية فلسفية واضحة، بينما ما بعد الحداثة لم تلتزم بأي رؤية، بل مزجت بين الأساليب بطريقة عبثية أو مفتوحة على التأويل.
قصيدة ما بعد الحداثة تمثل تحولًا جذريًا في الشعر العربي، حيث تتجاوز الأسس التي وضعتها الحداثة لتحتوي على تنوع أكبر من الأصوات والتجارب. يعكس هذا التطور التغيرات الثقافية والاجتماعية العالمية، مما يجعل الشعر وسيلة للتعبير عن التعقيدات المعاصرة.
الحداثة العربية (من الخمسينيات إلى الثمانينيات) مثلت تمردًا على التقليد، بينما ما بعد الحداثة (من التسعينيات إلى اليوم) مثلت تمردًا على الحداثة نفسها، عبر:
- تفكيك اللغة (محمد بنيس /جون آشبيري).
- تداخل الأجناس (أمجد ناصر / آن كارسون).
- تحويل القصيدة إلى "فضاء تشكيلي" (فاطمة قنديل / شعراء الفن .
هذا التطور يعكس تحولًا من "الشاعر المُلهم" إلى "الشاعر الهامس"الذي يبحث عن المعنى في تفاصيل العالم المبعثرة.
الحداثة الشعرية ظهرت في القرن العشرين كرد فعل على التقليد الشعري العربي الكلاسيكي. تأثرت بحركات عالمية مثل الرمزية والسريالية والتعبيرية، وأبرز معالمها:
كسر عمود الشعر الخليلي والاتجاه نحو قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثر.
تفكيك البنية التقليدية للقصيدة من حيث الوزن والقافية.
اللغة الشعرية المكثفة ذات البعد الرمزي والمجازي العميق.
التجربة الذاتية والفلسفية في تناول الهمّ الإنساني.
التأثر بالمدارس الغربية وإعادة تشكيل الموروث العربي في ضوء الرؤية الجديدة.
بخصوص قصيدة الشاعرة بشرى البستاني
القصيدة تستحق أن تُقرأ بعناية، لا فقط من أجل الفهم العميق لها، بل أيضًا من أجل استشعار الإيقاع الذي تم بناؤه بعناية، حيث يطغى اللحن الأليم على الكلمة، وتصبح كل سطر من القصيدة دعوة للتأمل في العالم الممزق بين الموت والأمل. فكل كلمة، وكل صورة، وكل رمز، ينقلاننا إلى عالم حيث الحروب لن تكون النهاية، بل بداية جديدة تشرق منها بغداد.
في النهاية، هذه القصيدة تتخذ من الحروب والمعاناة مكانًا لفتح أفق المقاومة الإنسانية، وتذكّرنا أن الصوت لا يجب أن يُسكت، بل أن يصبح مصدرًا للحياة رغم الظلام.
وها هي بغداد، بين أنقاضها، تُخفي أسرار العراقة في جدرانها المنهارة، تروي للزمن قصصاً من ألم وحلم. لا تسقط بغداد، فهي ستظل في قلب الأرض، كما في قلوب الأحرار الذين لن ينسوا. ولن يغيب الندى عن الزهور، ولن تهتز الطيور إلا في سماء حرية، تلك التي ترفض أن تُهدم، حتى وإن اختنق صوتها. تلك بغداد التي لن تموت مهما اشتد الظلام، ولا تهون إلا في أيدي الطغاة. إنها عاصمة الشعر والمجد، وحب العراق، وهذا هو عهدنا معها، أن تظل حية، تنتصر من كل جرح وتعلو فوق الأنقاض، لتعود وتحلم من جديد.
تمتلك القصيدة البستانية كامل مقومات قصيدة مابعد الحداثة
ولكنها بحترية في ضبط إيقاع التفكك والتفلت والفوضى والتفكك والزئبقية وذلك لجذورها الأساسية الأكاديمية التي تحول دون تمكنها من امتلاك ناصية الانطلاق الحر المنفلت الكلي وكما ان رصانة مرجعياتها وتناصاته رغم جسامة الثراء المعرفي فانها قيدت حرية التفلت في القصيدة المعنقدة بنيوية وتشكيليا واسلوبيا ولها بصماتها المميزة ولكن تسليط الضوء على تجربتها الثرية والعميقة والكثيفة الواسعة الإنتاج والعريقة زمنيا تعود إلى اسباب ذاتية وموضوعية لسنا الان بصددها ولكن نلفت عناية المتلقي إلى ذلك
#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
(رايةٌ وشهقةٌ وانتظار )
-
(انتِ فأل الأفول)
-
(سَجْف رَاحتْ تُعلِّق أَوْقَاتها فِي المِرْآة)
-
(أَمْشِي عَلَى جَمْرِ أَشْوَاقِي)
-
(مَلامِحُ جَسَدٍ بثَوْبٍ شَفيفٍ)
-
(وَإِذا حَبَستُ الدَمعَ فاضَ هُمولا)*
-
( لا أجدُ جٰوابًا)
-
(نُورانيات)
-
(يُوجِعُني وَلَع وَطَني بِالأَنِين) ...(لَهُ الأَمْر)
-
(بداية اللغز )
-
(أعباءٌ وظلالٌ)
-
(قراءةُ حُبٍّ في مِرآةٍ سوداءَ مُدَلّاةٍ على صَدرِ الخَرابِ)
-
(أَنْوار قُدْسِيّة )
-
(تَأَوُّه وأَكْثر )
-
(تاكوتسوبو)
-
(دَعِيني بكِ أَهيمُ)
-
(بُزُقٌ مَعطوبٌ فِي زَمنٍ عَاطِلٍ)
-
(أَحِبِّينِي... وَكَفَى!)
-
نسخة معدلة من قصيدة ( جَدولُ الأقْحُوَان في دِجْلةَ السالكين
...
-
1(شَذَراتٌ)
المزيد.....
-
-نيويورك تايمز- تنشر فيديو لمقتل عمال الإغاثة في غزة مارس ال
...
-
سفير ايران لدى موسكو: الثقافة والفن عنصران لاستقرار العلاقات
...
-
الرواية القناع.. توازي السرد في -ذاكرة في الحجر- لـ كوثر الز
...
-
وزير الخزانة الأمريكي: زيلينسكي -فنان ترفيهي- محاط بمستشارين
...
-
بعد هجوم النمر.. دعوة برلمانية في مصر لإلغاء عروض الحيوانات
...
-
صدور لائحة اتهام ثالثة في حق قطب موسيقى أمريكي (صور)
-
المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب يستضيف وفدا طلابيا أميركيا ف
...
-
مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة الأبحاث وأخلاقيات ا
...
-
الشرطة البريطانية توجه خمسة اتهامات جنسية لفنان كوميدي شهير
...
-
-ترويكا-- برنامج جديد على RT يفتح أمامكم عوالم روسيا
المزيد.....
-
عشاء حمص الأخير
/ د. خالد زغريت
-
أحلام تانيا
/ ترجمة إحسان الملائكة
-
تحت الركام
/ الشهبي أحمد
-
رواية: -النباتية-. لهان كانغ - الفصل الأول - ت: من اليابانية
...
/ أكد الجبوري
-
نحبّكِ يا نعيمة: (شهادات إنسانيّة وإبداعيّة بأقلام مَنْ عاصر
...
/ د. سناء الشعلان
-
أدركها النسيان
/ سناء شعلان
-
مختارات من الشعر العربي المعاصر كتاب كامل
/ كاظم حسن سعيد
-
نظرات نقدية في تجربة السيد حافظ الإبداعية 111
/ مصطفى رمضاني
-
جحيم المعتقلات في العراق كتاب كامل
/ كاظم حسن سعيد
-
رضاب سام
/ سجاد حسن عواد
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة