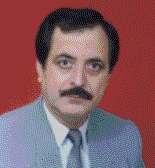|
|
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الرابع)
منذر خدام


الحوار المتمدن-العدد: 8317 - 2025 / 4 / 19 - 10:02
المحور:
قضايا ثقافية
الفصل الرابع
الديمقراطية والنظام السياسي العربي
بداية لا بد من التساؤل حول جدوى الحديث عن الديمقراطية في الدول العربية مجتمعة، وبالتالي أليس من الصواب أن نتحدث عن الديمقراطية في كل قطر عربي على انفراد، فذلك أقرب إلى التشخيص ويعالج موضوعا مميزا. بمعنى آخر هل هناك من وجهة النظر العلمية نظام سياسي عربي قائم بذاته يمكن أن تسائله الديمقراطية باحثة عن ممكناتها فيه.
1-مفهوم النظام السياسي.
مفهوم النظام السياسي هو من المفاهيم التحليلية الحديثة المستجدة التي ترتبط بعلم اجتماع السياسة. يشير هذا المفهوم إلى شبكة من العلاقات والتفاعلات الإنسانية المرتبطة بالسلطة والتي تحدد إلى درجة كبيرة منطلقاتها الأيديولوجية وأشكال تنظيمها وكيفية ممارستها. وتتميز هذه العلاقات والتفاعلات بطابع الاستمرار والتجدد، بحيث أن أي تغيير في إحدى مكوناتها يؤدي إلى تغيرات في الوحدات الأخرى المكونة لها.
من الواضح أن مفهوم النظام السياسي بهذا المعنى يشكل مجالا لنوع معين من التفاعلات والعلاقات والترابطات المتميزة تجعله يختلف عن مفهوم الدولة ولا يقتصر على نظام الحكم (1). وباعتباره جزءا من البناء الاجتماعي فإنه يدخل في علاقات مع بقية المكونات الأخرى لهذا البناء ويتبادل معها التأثير والتأثر. وفي عالم اليوم حيث تتسع وتتعمق العلاقات الاندماجية والتكاملية لم يعد من الممكن لأي مجتمع أن ينأى بنفسه عن التأثر بما يجري في العالم والمساهمة في صنعه سواء أكان ذلك في المجال الاقتصادي أو الثقافي أو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المنوفي ، كمال،" أصول النظم السياسية المقارنة " (الكويت ،شركة الربيعان للنشر والتوزيع،1987) ص39-45.
السياسي وغيره (2). النظام السياسي العربي باختصار يشير إلى مجموعة بشرية متمايزة عن غيرها بنمط حياتها السياسية تسكن رقعة متصلة من الأرض المتميزة عما يجاورها تسمى الوطن العربي.
2- الوطن العربي: مزايا المكان وإشكالياته.
ومع أن هذه المجموعة البشرية التي يشير إليها مفهوم النظام السياسي العربي ونعني بها الأمة العربية قد خضعت للاستعمار الذي مزقها إلى دويلات تفصلها حدود مصطنعة، فهي لم تنقطع
عن التواصل والتفاعل الثقافي والسياسي والتوجه نحو صياغة مستقبل مشترك. وحافظت على سماتها المميزة مع أنها تشترك مع الدول النامية في العديد من السمات المشتركة مثل التخلف، وانتشار الأمية، والتبعية الاقتصادية، ومحدودية الموارد، وغياب العقلانية وغيرها.
وهي لم ترضخ للضغوطات الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تمارس عليها من قبل الدول الاستعمارية لتحويلها إلى وحدات متمايزة متنافرة أو لجذبها ودمجها في تكوينات إقليمية أخرى وإبعادها عن مجالها الحيوي المتميز الذي يشكل الوطن العربي، فاخترع لها بدائل عديدة كان من أخطرها مفهوم الشرق الأوسط كنظام سياسي إقليمي يضيق أو يتسع حسب الطلب، لكن في جميع حالاته تكون إسرائيل في القلب منه.
الوطن العربي بصفته إقليما سياسيا يختلف عن مفهوم الشرق الأوسط الذي اخترع في بداية هذا القرن لأغراض استعمارية واستشراقية واضحة (3)، في انه يمثل امتدادا جغرافيا من المحيط إلى الخليج يقوم عليه كيان أقوامي متميز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 -هلال، علي الدين. مسعد، نيفين " النظم السياسية العربية :قضايا الاستمرار والتغير" بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،1999) ص 10.
3-هلال، علي الدين. مسعد ، نيفين "النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتجدد" مرجع سبق ذكره، ص 24.
بثقافته وبتاريخه وبالتفاعلات التي تجري فيه (4). فهو يواجه نفس التحديات الأمنية بالمعنى العام لكلمة أمن بالدعوة إلى التضامن حينا أو الوحدة حينا آخر، ويسعى إلى تنظيم قواه وجهوده من خلال جامعة الدول العربية أو من خلال الدعوة إلى إنشاء السوق العربية المشتركة أو منطقة التجارة الحرة وغيرها (5). ورغم الاهتزازات الجدية التي تعرض لها مفهوم الأمن العربي من جراء الخلافات والصراعات العربية وكان أخطرها على الإطلاق حرب الخليج الثانية وما ترتب عليها من تداعيات، فإن مفهوم الأمن العربي لا يزال له ما يبرره ويحظى باهتمام الدول العربية سواء بسبب وجود إسرائيل، أو بسبب احتلال إيران لبعض الجزر العربية، أو بسبب أطماع أثيوبيا في مياه النيل، واحتلال تركيا للواء اسكندرون وكيليكيا، وأطماعها في مياه الفرات ودجلة، واستمرار احتلال أشبانيا لمدينتي سبته ومليلة في المغرب.
إن مشروع الشرق الأوسط كما طرح في أواخر القرن العشرين، وكما تتصوره أمريكا التي ترفع رايته في الوقت الراهن له هدف رئيس واحد هو إدماج إسرائيل في المنطقة مع الاحتفاظ لها بالموقع المتقدم، أي موقع القيادة. ونظرا للتنافس بين أمريكا وأروبا على المنطقة سعت هذه الأخيرة إلى مجاراة أمريكا، فطرحت مشروعها الخاص تحت عنوان المشروع المتوسطي (النظام المتوسطي)، وصيغته التنفيذية الشراكة الأوربية المتوسطية والذي يهدف إلى تعميق تجزئة الوطن العربي من خلال تعامل أوربا مع كل دولة عربية على حده. ورغم النجاحات التي حققها كل من المشروعين الأمريكي والأوربي، فليس بمقدورهما أن يشكلا بديلا عن النظام السياسي العربي ومجاله الجغرافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- مطر، جميل و هلال، علي الدين " النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربي" ، (بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،1979) ص22-38.
5-مصالحة، محمد "الأمن العربي بين المفاهيم والواقع والنصوص"،(مجلة شؤون عربية ،العدد 35 ، كانون الثاني /يناير 1984) ص 27.
الحيوي الوطن العربي، مع أنهما أدخلتا إليه بعض عوامل الإرباك. وللرد على هذه العوامل وتحييدها لا بد من معالجة أسباب النزاعات بين الدول العربية وخصوصا تلك التي تركها المستعمر (مثل خلافات الحدود) وإيجاد آليات معينة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية وربما إيجاد محكمة عدل عربية. ولا بد أيضا من تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية على أساس من تبادل المنافع، وتقوية الهياكل العربية القائمة في إطار جامعة الدول العربية وغيرها، وربما إدخال تعديلات أساسية على طريقة اتخاذ القرارات فيها.
إن أكثر ما يعزز النظام السياسي العربي هو بناؤه على أساس من المنافع والمصالح المتبادلة وخصوصا في المجال الاقتصادي، في إطار مشروع نهضوي عربي متكامل.
يمتد الوطن العربي على مساحة شاسعة من الأرض تقدر بنحو (13.6) مليون كم2 , متمايزة الحدود والمعالم. ففي الغرب المحيط الأطلسي وفي الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس، وفي الشرق جبال زاغروس والخليج العربي وبحر العرب، وفي الجنوب الصحراء الكبرى والبحيرات الأفريقية (6). وعلى العكس من ذلك فإن الحدود الداخلية بين الأقطار العربية غير واضحة المعالم ومصطنعة وكانت على الدوام محل شك من قبل الشعب العربي مع أنها كانت ولا تزال سببا للعديد من النزاعات المؤسفة.
يتميز الوطن العربي بموقعه الاستراتيجي الهام الذي يتوسط القارات القديمة الثلاث، وتمر فيه أو في المياه المحيطة به أهم طرق المواصلات القديمة والحديثة، ويمتلك العديد من الثروات الهامة وفي مقدمها النفط المصدر الحيوي للطاقة في الوقت الراهن، منه انطلقت أهم الدعوات الثقافية الكبرى، وخصوصا الدينية منها، وقامت فيه أهم الحضارات في العالم القديم التي لا تزال حتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- مجموعة من المؤلفين " دراسات في المنطقة العربية " ،(القاهرة،دار النهضة العربية ، 1961) ص 8.
اليوم شامخة في غناها وتنوعها، وتعرض عبر تاريخه الطويل إلى غزوات كثيرة ولا يزال يتعرض لمنعه من إعادة تجديد ذاته حضاريا بعد طول ثبات وتغييب. هذه الخلفية الغنية والكبيرة بكل تفاعلاتها مع محيطها القريب أو البعيد حاضرة اليوم في تكوين الإنسان العربي المعاصر سواء في استعداداته أو ميوله أو في نظرته إلى نفسه أو في نظرته إلى غيره، تحدد معالم سلوكه وقيمه وتصوره لمستقبله الآتي الذي يحاول صنعه.
باختصار يمكن القول إن الإنسان العربي بتفاعله مع خصائص المكان قد تصير عبر التاريخ إلى كائن ثقافي من نوع خاص. من سمات خصوصيته تعلقه القوي بماضيه، وميله إلى النمذجة
وبالأخص النماذج الكاملة منها، يعيش الحلم واقعا، يتداخل لديه الممكن النظري والممكن الواقعي، تنمو لديه النزعة الكلامية، يتطلع إلى الماضي وهو يحاول بناء المستقبل، ضعيف الحساسية بالزمن، شديد التمسك بالكاريزما(الزعامة) الفردية ويحاول دائما خلقها في جميع أشكال وجوده الاجتماعي، يميل إلى نفي الآخر أكثر من تغييره، شديد التمسك بالتقليد والتقاليد.
3- بيئة النظام السياسي العربي ودور الخارج فيها.
بما أن النظام السياسي العربي هو تكوين من روابط وعلاقات متحركة متفاعلة بين مختلف مكونات النظام، فإن عملية التفاعل وطبيعة الروابط التي تنشأ عنها تتأثر بما يمكن الاصطلاح عليه المجال الحيوي للنظام أو بيئة النظام. في إطار هذا المجال الحيوي يتفاعل العنصر البشري بما لديه من موارد اقتصادية وثقافية وسياسية مع عناصر الموقع في إطار مؤسسي هو حصيلة خبراته المتراكمة عبر تاريخه، لتحدد في النهاية توجهات النظام السياسية والاقتصادية والثقافية وطبيعة التغيرات التي تحدث فيه.
حتى عصر الاستعمار كان يحصل كل ذلك تحت تأثير العوامل الداخلية بالدرجة الأولى، لكن الاستعمار ادخل تعديلات جوهرية على طبيعة النظام السياسي والتفاعلات التي تجري في داخله وحدد إلى حد بعيد خياراته. ويتنامى تأثير الخارج في الداخل الوطني كثيرا مع تعمق العلاقات الاندماجية الجارية على الصعيد العالمي في إطار ما يسمى بالعولمة. فالتوجه نحو الخارج في المجال الاقتصادي والثقافي والسياسي أصبح سمة العصر الراهن وخاصة بالنسبة للبلدان المتخلفة. كل ذلك جعل الإنسان العربي يتعرض لتأثير قوى عديدة مختلفة في الاتجاه تكاد تشطره إلى أكثر من شطر، من جهة قوى السكون التقليدية التي تحاول إبقاءه على ما هو عليه أو إرجاعه إلى الوراء تحت دعاوى الأصالة والتراث والتميز، وقوى الحركة والتغيير التي تعصف بالعالم وتحاول اقتلاعه من جذوره وتعيد تكوينه شخصية اغترابية متكيفة مع متطلبات الخارج وأهدافه. في إطار تجاذب القوى الذي يتعرض له الإنسان العربي أخذ يتأثر كثيرا من حيث الشكل بنتائج قوى التغيير فانفتحت شهيته على الاستهلاك من كل لون وبلا قيود وضوابط، لكنه بقي في العمق إنسانا تقليديا في نمط تفكيره وفي حياته الاجتماعية. لقد أصبح الإنسان العربي المعاصر يجمع في ذاته المتناقضات دون أن يشعر بالحرج من ذلك. ففي الوقت الذي يقبل على استهلاك آخر منتجات الغرب وصرعاته باندفاع ورغبة، نراه يحجم وبعناد عن تقبل طريقته في التفكير، وأسلوبه في التنظيم والإدارة المجتمعية. كل ذلك انعكس في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعمليات التحديث الجارية والتي في مجملها أعادت تكييف النظام السياسي العربي في إطار علاقات التبعية للمراكز الرأسمالية، دون أن تحدث تغييرا جوهريا فيه .فلا الطبقات تصيرت ولا البنى القبلية والعشائرية اختفت ولا البنى الاقوامية للأقليات اندمجت في المجتمع، ولا تصيرت كبنى قائمة بذاتها في إطار الوطن العربي فبقيت من جملة القضايا العالقة التي تسبب النزاعات المستمرة .باختصار حافظت البنية المجتمعية على طابعها التركيبي ،مع كل ما يطابقها من أنماط تفكير ومنظومة قيم وعلاقات اجتماعية وغيرها.
3-1-البيئة الاجتماعية للنظام السياسي العربي.
تعتبر المجتمعات العربية مجتمعات شابة حيث أن أكثر من 65% من عدد السكان ينتمون إلى الفئات العمرية الشابة (ما دون العشرين سنة). وتتميز أيضا بمعدلات نمو مرتفعة تزيد عن 3% في أغلب الدول العربية. يتركز القسم الأكبر من السكان في الريف (7)، تنتشر في صفوفهم الأمية والتقاليد والعديد من الأمراض الاجتماعية الأخرى، ويتميزون بضعف قابليتهم للتنظيم والتفاعل مع معطيات العصر ومنجزاته خصوصا في الحقل الاجتماعي. وحتى ذلك القسم من السكان الذي يسكن المدن لم يبتعد كثيرا عن أصوله وروابطه الريفية وذلك بسبب ضعف التشكل الطبقي في المجتمع العربي. بصورة إجمالية يمكن ملاحظة ثلاث طبقات في المجتمع العربي هي التالية:
1-الطبقة البرجوازية بكل شرائحها البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية والتقليدية.
2- البرجوازية الصغيرة.
3-طبقة العمال والفئات الفلاحية الكادحة (8).
من زاوية الموضوع الذي نبحث فيه، أي قضية الديمقراطية في الدول العربية من الأهمية بمكان عدم الاكتفاء بالتوقف عند الحدود الخارجية للتشكيلات الطبقية القائمة بل الدخول إلى بنيتها وتفحصها، عندئذ ولا شك سوف تبدو متمايزة كثيرا وخصوصا من ناحية الدور الذي تلعبه أو يمكن أن تلعبه في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- الأمانة العامة وآخرون " التقرير الاقتصادي الموحد لعام 1995"، (القاهرة، جامعة الدول العربية ،1995)
8-عبد الفضيل، محمود " تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي نظرة إجمالية- نقدية" المستقبل العربي السنة (9) العدد (95) ،كانون الثاني/يناير 1987،ص 74-79.أنظر أيضا عبد الفضيل، محمود" التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة( 1945-1985)، ص (112-205).
الحياة الاجتماعية والسياسية.
لقد ذكرنا أن الطبقة البرجوازية تتكون من أربع فئات هي البرجوازية التقليدية، والبرجوازية البيروقراطية، والبرجوازية الطفيلية، والبرجوازية الكمبرادورية، لكل منها سماتها المتميزة ودورها الاجتماعي والسياسي الخاص.
لقد بدأت البرجوازية التقليدية سيرورة تشكلها خلال مرحلة الاستعمار نتيجة للتحولات التي أجراها المستعمر في بنية الاقتصاد خدمة لمصالحه فجرى التحول من الاقتصاد الزراعي التقليدي إلى الإنتاج الزراعي والصناعي المنفتح على السوق وبشكل خاص على الخارج. ومن البداية جاء تكوينها هجينا من عناصر إقطاعية ومن زعماء العشائر والقبائل إلى جانب كبار التجار والمرابين. وبسبب افتقارها إلى التصيير الطبيعي المكتمل فإن البرجوازية التقليدية باعتبارها الممثل الاجتماعي للأشكال الطبيعية لدوران راس المال المحلي، ورغم مضي نحو نصف قرن على الاستقلال الوطني لا تزال تحمل سمات النشأة الأولى مع كل التغيرات التي طرأت على العالم. ففي مجال استقصاء الربح تبرز بوضوح العناصر الرأسمالية، أما في المجالات الاجتماعية والسياسية فتبدو واضحة السمات الإقطاعية المتخلفة.
الفئة البرجوازية الأخرى التي لعبت دورا خطيراً في جميع الدول العربية وبشكل خاص في الدول التي حكمتها الفئات الثورية الجديدة، هي البرجوازية البيروقراطية. ومع أن المصطلح لا يزال إشكاليا إلا انه أصبح محدد الدلالة وهو يشير إلى تلك الفئات التي تحتل مواقع معينه في جهاز الدولة أثرت من خلالها. من خصائص هذه البرجوازية أنها لا توجد خارج جهاز الدولة، وما إن تسيطر عليه حتى تقوم بتوسيعه بصورة كبيرة وتزيده فعاليته ، وتحول الدولة إلى دولة أمنية، وهي تتميز بالحد الأقصى من الفساد والتملق السياسي. يقول كارل بروتنتس" وعندما يتكلمون عن البرجوازية البيروقراطية فإنهم يقصدون عناصر معينة بين جهاز الدولة وفي الدوائر الحكومية العليا، المعزولة عن الشعب، بل والمعادية له والتي تستخدم وضعها من أجل الإثراء الذاتي ومن أجل كل العمليات غير الشريفة … وبسبب وضعها الخاص وأساليب ثرائها ، تتميز البرجوازية البيروقراطية بالحد الأقصى من الفساد والملق السياسي وهي قادرة على أن تحتل أكثر المراكز عداءاً للوطن والشعب " (9).
إن توسيع البرجوازية البيروقراطية لرأسمالية الدولة هو في نفس الوقت تعظيم لدورها في المجتمع. وعند حد معين من التوسع الرأسمالي تتكون ظروف ملائمة لولادة فئة برجوازية جديدة هي البرجوازية الطفيلية الشريك الرئيس للبرجوازية البيروقراطية في اقتسام فائض القيمة المستحوذ عليه من قطاع رأسمالية الدولة ومن الاقتصاد الوطني ككل.
تتميز البرجوازية الطفيلية في تعميم النشاطات الاقتصادية غير الإنتاجية وتشجيع ما يسمى بمشاريع الأبهة وتنمية النزعة الاستهلاكية في المجتمع، وتعميم وضعية اللاقانون والفساد.
ونظرا لسرعة جنيها للثروة وتعظيمها فإن قسما هاما من البرجوازية التقليدية ينتقل من وضعية المستثمر والمنتج إلى وضعية الطفيلي.
ومع توسع الطلب على القروض من المصادر الخارجية وتوسع دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية تزداد وتتعمق علاقات التبعية. وإذا أخذنا بعي الاعتبار أن السياسات الإنمائية التي تنتهجها البرجوازية البيروقراطية والطفيلية تركز على الاستهلاك وعلى استنزاف الموارد المحلية وخصوصا من المصادر الاستخراجية، فإن تشويه الهياكل الاقتصادية والوقوع في فخ المديونية الخارجية والداخلية هي النتيجة المنطقية التي لا مفر منها. في هذا السياق يتعاظم شان البرجوازية الكمبرادورية كمتطفل على مسار العلاقات الاقتصادية مع الخارج.
لقد ظهرت البرجوازية الكمبرادورية تاريخيا كوسيط لترويج سلع المستعمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9-بروتنتس، كارل "الاستعمار الجديد : جوهره وأشكاله"،(موسكو ،دار التقدم،1966 ). ص 52-53.
والسلع المستوردة بصورة عامة. استخدم مصطلح (البرجوازية الكمبرادورية) لأول مرة في الصين من قبل ماو تسي تونغ في الثلاثينات من القرن العشرين للإشارة إلى الممثليات التجارية للمصالح والشركات الأجنبية وتوسع لاحقا استعمال المصطلح ليشمل أيضا جملة النشاطات المتعلقة بالترويج للاستثمارات الأجنبية وما يرتبط بها من صفقات وعقود خارجية وعمولات. ومن الطبيعي أن يكون لهذه البرجوازية تأثير قوي على جهاز الدولة. يقول بولنتزاس " إن ما تعنيه تقليديا البرجوازية الكمبرادورية جزء من البرجوازية الذي ليس له قاعدة خاصة لمراكمة رأس المال، والذي يتصرف نوعا ما كمجرد وسيط للإمبريالية الأجنبية (لهذا يقرنون بعض الأحيان هذه البرجوازية بالبرجوازية البيروقراطية) وهو بذلك تابع بتمامه لرأس المال الأجنبي من النواحي الثلاث: الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية" (10).
إذاً الحلف الطبقي البرجوازي الحاكم في الدول العربية يتكون من البرجوازية البيروقراطية، والبرجوازية الطفيلية، والبرجوازية الكمبرادورية، إلى جانب البرجوازية التقليدية، التي تمثل التعبير الاجتماعي عن الأشكال الطبيعية لدوران رأس المال الخاص المحلي وتضم بشكل رئيسي البرجوازية الإنتاجية والبرجوازية التجارية والبرجوازية الخدماتية. وبطبيعة الحال لا يشكل هذا الحلف الطبقي حالة مستقرة، بل يتعرض إلى انزياحات مستمرة في مواقع الهيمنة فيه بحسب الظروف المستجدة. من حيث المبدأ يجري الصراع بين البرجوازية البيروقراطية بصفتها التعبير الاجتماعي عن رأسمالية الدولة، والبرجوازية التقليدية باعتبارها التعبير الاجتماعي عن رأس المال الخاص. في سياق هذا الصراع تصطف البرجوازية الطفيلية بحزم إلى جانب البرجوازية البيروقراطية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10-بولنتزاس، نيكوس ((الطبقات الاجتماعية في النظام الرأسمالي اليوم ))، ترجمة إحسان الحصني ، (وزارة الثقافة، دمشق ، 1983 ) ص 118 .
نظرا لاشتراكهما في الوضعية الطبقية في حين تتردد البرجوازية الكمبرادورية.
إن احتمال تغير موقع الهيمنة الطبقية في داخل الحلف البرجوازي المسيطر بين البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية التقليدية لا يتعلق بالمعطيات الداخلية فقط، بل وبدرجة التبعية للخارج. من حيث المبدأ تقف الإمبريالية إلى جانب الشكل الخاص للرأسمالية في البلدان المتخلفة وما يعبر عنها من برجوازية تقليدية وتعمل في الوقت نفسه على تنمية طابعها الكمبرادوري خصوصا عندما تكون الظروف الداخلية غير مستقرة وتشهد نمو تيارات سياسية واجتماعية غير مرغوبة، وهذا ما يحصل في جميع الدول العربية في الوقت الراهن تحت عنوان الخصخصة والإصلاح الاقتصادي.
الطبقة الاجتماعية الأوسع انتشارا في البلدان العربية هي طبقة البرجوازية الصغيرة. لقد توسعت هذه الطبقة كثيراً بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في البلدان العربية خلال العقود الأربعة الماضية، نجم عنها حراك بعض الفئات الاجتماعية صعوداً أو هبوطاً. ففئة ملاك الأراضي التي تأثرت كثيرا بإجراءات الإصلاح الزراعي التي اتخذها وطبقها العديد من الدول العربية هبطت إلى وضعية البرجوازية الصغيرة، في حين ازداد نفوذ العسكر وتحسن واقعهم المادي فانتقلوا إلى وضعية البرجوازية الصغيرة.
كثيرا ما يختلط مصطلح "الطبقة الوسطى" مع مصطلح "الطبقة البرجوازية الصغيرة" في ظروف التخلف. لقد ظهرت الطبقة الوسطى تاريخيا في سياق الصراع بين الفلاحين والطبقة الإقطاعية وتصدت لإنجاز الثورة البرجوازية في البلدان الأوربية. في البلدان المتخلفة من الأصح الحديث عن البرجوازية الصغيرة بدلا من الطبقة الوسطى، وذلك بسبب خصوصية البناء الاجتماعي وعدم تمايزه بما يكفي نظرا لضعف النمو الرأسمالي.
تضم البرجوازية الصغيرة القسم الأكبر من الطبقة الفلاحية إلى جانب جمهور الحرفيين والمهن الحرة والعديد من الفئات الاجتماعية الأخرى. لقد كانت الطبقة الفلاحية النقيض الفعلي للحلف البرجوازي الإقطاعي الذي سيطر على مقاليد الحكم بعيد الاستقلال، منها انبثقت أغلبية الحركات والأحزاب السياسية خلال مرحلة النضال ضد الاستعمار أو بعده. ومع أنها تشكل جزءا من البرجوازية الصغيرة إلا أنها تتميز بجملة من الخصائص تجعلها طبقة خاصة بذاتها. تعود هذه الخصائص بشكل عام إلى طبيعة الحياة الريفية وشروط العملية الإنتاجية الزراعية.
في المجتمع الريفي يمكن التمييز بين الفئات الاجتماعية التالية:
أ-الفلاحون الكادحون. تضم هذه الفئة جماهير العمال الزراعيين وأشباه العمال والفلاحين الصغار والفلاحين المتوسطين. السمة الجامعة لهذه الفئة هي انهم جميعا يعملون لتحصيل قوت عيشهم دون أن يستغلوا أحدا، بل على العكس هم ذاتهم موضوع للاستغلال.
ب-الفلاحون الأغنياء. تضم هذه الفئة الفلاحين الذين يشتركون مع البرجوازية الريفية في الوضعية الاجتماعية، لكنهم يختلفون عنها في انهم يعملون في الزراعة على وسائل الإنتاج التي يملكونها، ويستأجرون قوة عمل إضافية لإنجاز العمليات الإنتاجية.
ت- البرجوازية الريفية وهي تتحدد ليس بحجم ما تملك من وسائل الإنتاج وإنما بحجم استثماراتها وبطريقة استثمارها لها وهي من منابت وأصول اجتماعية مختلفة.
3-2- البيئة الاقتصادية للنظام السياسي العربي.
على الصعيد الاقتصادي فإن جميع البلدان العربية تنتمي إلى مجموعة بلدان الجنوب، فهي تمتلك ثروات هائلة مع ذلك فإن اقتصاداتها تتبع اقتصادات المراكز الرأسمالية هيكليا ووظيفيا. ونتيجة لذلك فهي اقتصاديات ريعية تلعب فيها الصناعة الاستخراجية والخدمات الدور الحاسم (11).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11-هلال، علي الدين و مسعد، نيفين (2000)، ((النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير))، مرجع سبق ذكره، ص 116.
من الناحية النظرية يعد الوطن العربي إقليماً اقتصاديا متكاملاً، خصوصا إذا آخذنا بالحسبان ما يجري على الصعيد العالمي من توجهات جدية نحو نوع من التفكير الإقليمي الجديد، يتوقع له أن يشكل علاجا للعديد من المشكلات على الصعيد العالمي مع مطلع الألفية الثالثة. ومما يعزز التوجهات الإقليمية الجديدة النجاحات الظاهرة التي حققتها جهود التعاون الإقليمي في أوربا منذ أن عقدت اتفاقية روما في عام 1957، وتحول الولايات المتحدة الأمريكية عن توجهها التقليدي المحبذ لتحرير التجارة على الصعيد العالمي إلى إنشاء مناطق للتجارة الحرة كخيار مكمل وذلك وفق اتفاقيات أبرمتها بهذا الشأن مع كندا في عام 1988(GUSTA ) ثم مع كندا والمكسيك في عام 1992 (NAFTA ) (12).
لقد انتشرت التوجهات الإقليمية الجديدة في جميع أنحاء العالم ولم تعد مقتصرة على أوربا وأمريكا الشمالية، فقد أعيد إحياء السوق المشتركة لأمريكا الوسطى (CACM ) واتحاد أمم جنوب شرق أسيا (ASEAN ) ، والسوق المشتركة في أمريكا اللاتينية (MERCOSUR ) بين الأرجنتين والبرازيل والاورجواي والباراجواي.
لم يكن باستطاعة الدول العربية البقاء بعيدة، في منأى، عن التفاعلات والتوجهات الاندماجية الجارية على الصعيد العالمي، وها هي القمة العربية التي انعقدت في عام 1996 تفتح الباب من جديد أمام إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول العربية تقوم على أساس تبادل المنافع وتغليب المصالح الاقتصادية على غيرها من المصالح الأخرى. وبالفعل فقد عقدت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول العربية لإنشاء مناطق للتجارة الحرة. ومن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12-د. محي الدين، محمود، أ.عبد الحكيم ،رشا(( حول التعاون الاقتصادي العربي في السياسة المصرية)) بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي العاشر للبحوث السياسية، 7-9 كانون الأول/ديسمبر 1996 (مركز البحوث للدراسات السياسية، جامعة القاهرة، ،1996)، ص 2.
المتوقع أن تعقد قمة اقتصادية في القاهرة في خريف عام 2001 لإعطاء دفعة جديدة للتعاون العربي في المجال الاقتصادي.
إن التوجهات التكتلية العربية في المجال الاقتصادي ليست جديدة فهي تعود إلى بداية إنشاء جامعة الدول العربية. فهناك العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي عقدت بين الدول العربية منذ مطلع الخمسينات شملت جميع الميادين بدءاً من تحرير التجارة إلى إقامة المشروعات المشتركة، مرورا بتحرير انتقال رؤوس الأموال والعمالة إلى التنسيق العام بين السياسات الاقتصادية. انظر الجدول (1).
جدول (1) أهم الاتفاقيات بين الدول العربية (1)
تحرير التجارة -اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية (1953).
-تسديد مدفوعات المعاملات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية (1953).
-اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية (1964).
-قرار السوق العربية المشتركة (1964) الصادر من مجلس الوحدة الاقتصادية.
-اتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته بين دول الجامعة العربية(1981).
المشروعات المشتركة -اتفاقية إنشاء شركة الملاحة العربية (1962).
-المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقي ا(1974).
-الشركة العربية للاستثمارات البترولية (1975).
رؤوس الأموال -اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات (1953).
-الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية(1980).
اتفاقية استثمار رؤوس الأموال (1982).
انتقال العمال -الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة (1967) و(1977).
التنسيق العام -معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية (1950)
-اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية (1957).
-اتفاقية تنسيق السياسات البترولية (1960).
اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (1976)
-اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (1971).
-اتفاقية صندوق النقد العربي (1976)
استراتيجية العمل العربي المشترك (1980).
ا لمصدر: شقير، محمد لبيب((الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها))، (مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،1986)، جزءان، ص336.
ومع كل الجهود التي بذلت ظل البون شاسعاً بين ما استهدفته الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية وواقع العلاقات الاقتصادية العربية. فالتجارة البينية على سبيل المثال لم تزد عن 9% بالمتوسط خلال الفترة من عام 1989 إلى عام 1995، في حين بلغت الصادرات الأوربية في إطار الاتحاد الأوربي نحو61%، والصادرات الأسيوية إلى الدول الأسيوية الأخرى بلغت نحو 39% خلال الفترة نفسها. (13). وانخفضت الاستثمارات العربية في الدول العربية خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993 من 923 مليون دولار إلى 308 مليون دولار. كما تراجعت مساهمة الدول الخليجية (السعودية والكويت والإمارات) في المساعدات الإنمائية للدول العربية الأخرى من 3.5% من الناتج القومي لهذه الدول في عام 1990 إلى 0.7% في عام 1994 وذلك من جراء حرب الخليج الثانية. (14)
وإذا كان انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية لا يزال ضعيفاً خصوصاً إذا ما قورن بحجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج والبالغة أكثر من 670 مليار دولار، فإن انتقال العمالة العربية يشكل نجاحا ملحوظا بلا شك، فهناك نحو 12% من العمالة المصرية ونحو10% من العمالة السورية واليمنية والسودانية وغيرها تعمل في بلدان عربية أخرى. ولا تزال هناك إمكانيات كبيرة على هذا الصعيد غير مستفاد منها إذا أخذنا بالحسبان حجم العمالة الأجنبية الوافدة إلى دول الخليج وغيرها من البلدان العربية الأخرى.
إن حصيلة نصف قرن من العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي لا تزال هزيلة، وهناك أسباب عدية تقف وراء ذلك من أهمها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13-Galal ,Ahmed ,(( Incentives for Economic Integration in the Middle East : An Egyptian Perspective)) , (The Egyptian Center for Economic Studies, Cairo,1996),p 3.
14-د.محي الدين، محمود،أ، عبد الحكيم((حول التعاون الاقتصادي العربي…))،مرجع سبق ذكره، ص 12.
أ-تغليب حافز الربح الفردي على الحافز المجتمعي.
ب-تنامي الانقسامات بين الدول العربية وفي داخلها، والتهوين من خطر النزعات الانعزالية.
ت-تباين مستويات الدخل بين الدول العربية.
ث-عدم احترام حقوق الإنسان، وانعدام الحريات الديمقراطية الحقيقية، وشخصنه السلطة.
ج-التخوف من أن يؤدي التكامل الاقتصادي إلى اندماج سياسي.
ح-إحجام القطاع الخاص عن المشاركة الفاعلة في العلاقات الاقتصادية العربية البينية.
خ-دور القوى الخارجية في إعاقة التكامل الاقتصادي العربي والتشكيك في جدواه.
د-فقدان القرار السياسي والاقتصادي المستقل ونمو علاقات التبعية مع الخارج. (15)
ذ- في النصف الثاني من العقد الأخير من القرن العشرين، أخذت ترتسم ملامح لتفكير إقليمي عربي جديد، شكل مؤتمر القمة الذي انعقد في القاهرة في عام1996 بداية انطلاقته. يمكن لهذا التفكير الإقليمي العربية الجديد أن يكتب له النجاح في حال توفرت له الإرادة السياسية خصوصا وانه يسترشد بجملة من المبادئ تجعله مختلفا عن التوجهات الإقليمية القديمة. انظر الجدول (2)
ومما يعزز نجاح التوجهات التكتلية الإقليمية الجديدة لدى البلدان العربية توفر مجموعة من العوامل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15-Sayigh ,Yusif A" Arab Economic Integration : The poor Marvest of 1980s” ( Arab Economic Journal ,1993) ,p 48.
جدول(2) مقارنة بين الإقليمية القديمة والإقليمية الجديدة
التفكير الإقليمي القديم التفكير الإقليمي الجديد
- إحلال محل الواردات - توجه تصديري
-تخصيص الموارد وفقاً لخطط مركزية تخصيص الموارد عن طريق السوق
-ريادة القطاع الحكومي -ريادة القطاع الخاص
-تكثيف الاعتماد على السلع الصناعية -تنويع المنتجات بما فيها الخدمات والاستثمار
-التعامل مع الحواجز الجمركية -التنسيق بين السياسات وتعميق الاندماج
-معاملة تفضيلية للدول الأقل تقدماً -معاملة بالمثل مع السماح بفترات للتكيف
المصدر : Galal (1996) ,p 8 مصدر سبق ذكره.
1-تنوع الموارد الطبيعية العربية وتكاملها، وتوفر العمالة ورؤوس الأموال العربية. لقد قدر حجم الاستثمارات العربية في الخارج بنحو 670 مليار دولار حتى عام 1993، في حين لم تزد الاستثمارات العربية البينية عن 12 مليار دولار.
2-اتساع السوق العربية والقوة الشرائية المتاحة فيها.
3-إمكانية إزالة العوائق من أمام التجارة البينية (16).
ويمكن ان يحقق التكتل الاقتصادي العربي الجديد في حال إنشائه فوائد عدية إضافية لجميع الدول العربية، منها تعزيز موقفها التفاوضي مع التكتلات الأخرى خصوصاً الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالشراكة الأوربية المتوسطية وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا.
ومما يدعو إلى التفاؤل اقتناع الدول العربية بضرورة التكامل الاقتصادي فيما بينها وما حققته قمة القاهرة (1996) من تنقية للأجواء العربية. فقد أشار الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن إحياء مشروعات التعاون الاقتصادي العربي من أهم القرارات التي اتخذتها القمة، ومن بينها القرار المتعلق بالشروع في إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16 -El Erian & Ficher " Is MENA a Region ? The scope for Regional Integration " ,IMF Working Paper,(1996)
العربية على طريق إقامة السوق العربية المشتركة (17)
من المعروف ان إقامة المنطقة التجارية الحرة بين الدول العربية هي خطوة خجولة في الاتجاه الصحيح على طريق إقامة التكتل الاقتصادي العربي، بل ويعتبرها البعض خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع الاتفاقيات العديدة للتكامل الاقتصادي الموقعة بين الدول العربية والتي لم تخرج إلى حيز التطبيق (18). مع ذلك تتوفر لهذه الخطوة مقومات للنجاح لم تتوفر لغيرها من قبيل الإجماع العربي على ضرورتها في ظل المتغيرات العالمية وظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في مختلف مناطق العالم، وحاجة الدول العربية لأسواق جديدة، وضرورة زيادة معدلات النمو لامتصاص البطالة الآخذة في التفاقم، بالإضافة إلى تقارب السياسات الاقتصادية العربية وتبينها لاقتصاد السوق وتحرير التجارة (19).
ومع افتراض وجود الإرادة السياسية والجدية في التوجهات العربية الجديدة لإقامة تكتل اقتصادي عربي فاعل، فإنه لا يجوز الاستهانة بالعديد من العقبات ذات الطابع الاقتصادي التي لا بد من إزالتها والموجودة في جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة. من هذه العقبات نذكر ما يلي:
أ - ضعف الهياكل التنظيمية القائمة وعدم كفايتها لضبط السوق.
ب – تفاقم المديونية الداخلية والخارجية.
ت – تدني كفاءة الموارد البشرية.
ث –ضعف الادخار المحلي والأجنبي.
ج – انتشار الفساد والبيروقراطية في أجهزة الدولة وفي المجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17-مجلة (العالم اليوم، القاهرة،6 تموز/يوليو 1996.)
18-د.محي الدين ،محمود و أ. عبد الحكيم، رشا(( حول التعاون الاقتصادي العربي …)) ص19. مرجع سبق ذكره.
19- المرجع السابق ص 19.
3-3-البيئة الثقافية للنظام السياسي العربي.
في الحقل الثقافي يبدو الوطن العربي أكثر تجانسا وتماسكا وتمايزا عن غيره. فالثقافة العربية الإسلامية تشكل الفضاء العام للمجتمعات العربية فيه تتحدد مختلف التفاعلات الثقافية، وتتكون الاستعدادات الثقافية وتتشكل منظومة القيم العامة وغيرها. ونظرا لأهمية الثقافة في تكوين الشخصية العربية وفي وعيها لذاتها فإنها الأكثر تنظيما وتأطيرا في مؤسسات ترعى شؤونها على امتداد الوطن العربي.
وفي إطار الوحدة الثقافية العامة التي تجمع الوطن العربي، تبدو الثقافة السياسية هي الأخرى ذات طابع عام ومشترك. في الوقت الراهن تتمحور الثقافة السياسية العربية حول عدة قضايا رئيسية هي:
أ-قضية الانتماء والهوية. الانتماء هو نوع من التمايز المنطبع في الشعور الذي يجيب عن تساؤل من نحن؟ بهذا المعنى فهو يتضمن مجموعة من القيم الرمزية التاريخية التي تجعل من أي مجموعة بشرية تختلف عن غيرها وتحدد في الوقت ذاته العلاقة معها إن منافسة وصراعاً أو صداقة وتعاوناً. سؤال الانتماء هو سؤال عن الوجود.
أما الهوية فهي بالإضافة إلى استيعابها لبعض محددات مفهوم الانتماء وخصوصا البعد القومي، أي الشعور بالانتماء إلى تكوين أقوامي محدد، فإنها تتضمن العديد من المتغيرات التي تتولد في سياق السيرورة التاريخية والتفاعل مع الغير وتأخذ طابع العصر. سؤال الهوية هو سؤال كيف نحن؟ وبالتالي فهو سؤال عن الوضعية.
الانتماء يمكن أن يتحرك في مستويات عديدة بدءاً من أصغر شكل للوجود الاجتماعي، أي الأسرة وحتى مستوى المجتمع والدولة والأمة مرورا بالعشيرة والقبيلة والطائفة والطبقة أو الفئة الاجتماعية (20).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20-علي الدين هلال،مسعد، نيفين((النظم السياسية العربية)) مرجع سبق ذكره ،ص126.
في الوطن العربي لا تزال الانتماءات إلى أشكال الوجود الاجتماعي العائدة إلى ما قبل الدولة حاضرة وقوية ويزيد من قوتها تنامي الطابع الأمني للدولة وإلحاق جميع المنظمات الجماهيرية بها وتغييب المجتمع المدني أو منع تفتحه بصورة طبيعية.
ب- القضية الثانية التي تشغل الثقافة السياسية في الوقت الراهن هي قضية المشاركة السياسية. في جميع الدول العربية، لا فرق بين نظام ملكي أو جمهوري، تكاد تكون المشاركة السياسية للجماهير معدومة أو محدودة وشكلية إلى حد بعيد، وذلك بسبب طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة وخوفها من المساءلة. إن احتكار السلطة السياسية من قبل نخب معينة عسكرية أو مدنية أو عائلية أو تكوين مركب منها جميعا، يجعل القرار السياسي ذا طابع نخبوي فوقي لا علاقة للجماهير به مما يدفعها نحو مزيد من السلبية (21). مع ذلك قد تنتفض في بعض الحالات الانعطافية وخصوصا عندما تمس في وجودها القومي أو في قضاياها القومية متحدية حكامها ومتجاوزة لهم كما حدث على إثر حرب الخليج الثانية وكما حصل ويحصل مع الانتفاضة الفلسطينية.
ت-القضية الثالثة التي تشغل الثقافة السياسية العربية هي قضية الدين والقومية. هل الوعي القومي أم الوعي الديني يؤدي الدور الحاسم في تكوين الشخصية العربية؟ سؤال طالما أستجر سجالات ونقاشات حامية دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، وذلك بسبب كون السؤال خاطئ مبدئيا ومن حيث الأساس. الدين والقومية يتداخلان في الوعي العام وفي الثقافة العامة وفي الثقافة السياسية على وجه الخصوص لدى الأغلبية الساحقة من جماهير الأمة العربية، فلا يفرقون بينهما، وبالأحرى لا يجدون أي تعارض بينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21- هلال، علي الدين وآخرون،" الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي"(بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،1983)، ص 110-111.
وعلى المستوى الرسمي تكاد جميع دساتير الدول العربية أو أنظمتها الأساسية تنص على أن دين الدولة هو الإسلام (باستثناء لبنان)، وأن الشريعة الإسلامية هي من المصادر الأساسية للتشريع أو المصدر الرئيس له. كما تنص الدساتير العربية على أن كل قطر عربي هو جزء من الأمة العربية. أضف إلى ذلك تتفق جميع الدساتير العربية على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، لكن في الممارسة العملية، وهذه أيضا تتفق فيها الدول العربية، ثمة فارق كبير بين النص والتطبيق خصوصا عندما تتعلق الحقوق المنصوص عنها بالسياسة وحرية التعبير والتنظيم والتظاهر. حالة الطوارئ والحكم بالقوانين الاستثنائية هي الحالة السائدة في الدول العربية حتى في تلك التي أخذت بشيء من الانفتاح (22). وأكثر من ذلك فلا تزال الأسرة الخلية الأساسية لغرس القيم العامة وتنشئة الأجيال عليها ومنها القيم السياسية على وجه الخصوص، ففيها يتقرر إلى حد بعيد مستقبل الأبناء وطريقة تفكيرهم وفلسفتهم في الحياة، تليها وسائل الاتصال الجماهيري من صحف ومجلات وكتب وراديو وتلفزيون، وأخيرا يأتي دور المنظمات السياسية من أحزاب وأندية وغيرها (23).
3-4-البيئة الأيديولوجية للنظام السياسي العربي.
الأيديولوجيا هي نسق فكري تقرأ به كل طبقة مصالحها ومصالح غيرها من الطبقات والفئات الاجتماعية وتحدد دورها في الصراع الطبقي باعتباره المحرك الرئيس للتقدم الاجتماعي. بهذا المعنى يبدو الوطن العربي منظورا إليه من الحقل الأيديولوجي مجالا لنظام سياسي عربي واحد أيضا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22-إبراهيم، سعد الدين، محرر، "التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي"،(عمّان منتدى الفكر العربي ،1989) ص 228-243.
23-رشاد، عبد الغفار،" الثقافة السياسية: الثابت والمتغير" دراسة استطلاعية،(الخرطوم ، مطبعة خطاب الحديثة، 1991) ص64. أنظر أيضا المنوفي، كمال " الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي"،المستقبل العربي، السنة 8،العدد 8 تشرين الأول/أكتوبر،ص68.
تسود في الوطن العربي وفي كل قطر من أقطاره الأيديولوجيات التالية: الأيديولوجيا الدينية والأيديولوجيا القومية والأيديولوجيا الماركسية والأيديولوجيا الليبرالية.
الأيديولوجيا الدينية واسعة الانتشار، نظرا لما للدين من دور كبير في تكوين الشخصية العربية وتحديد هويتها، ومن حضور بارز في الوعي الاجتماعي وفي العلاقات الاجتماعية. تتميز الأيديولوجيا الدينية في طابعها المتعالي وفي تعدد قراءاتها كل من موقعه الطبقي.
لقد أدت الأيديولوجيا الدينية دورا مهما في النضال ضد المستعمر والفوز بالاستقلال، ومع أنها تراجعت بعض الشيء خلال المد القومي واليساري في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، إلا أنها عادت وتنشطت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين على أثر تراجع المد القومي والماركسي، وتؤدي في الوقت الراهن الدور الأبرز في النضال ضد الصهيونية والإمبريالية وتحتل موقعا متقدما في صفوف المعارضة للأنظمة العربية. تقدم الأيديولوجيا الدينية نفسها باعتبارها الحافظ لهوية الأمة في وجه عمليات التغريب والاندماج في العالم. وفي بعض الدول العربية تمثل مصدر شرعية النظام ولا تستطيع جميع الدول العربية تجاهلها بل تحاول خطب ود القائمين عليها لما لها من قوة تعبوية كبيرة خصوصا في مرحلة الانحطاط السياسي التي تعيشها الأمة العربية في الظروف الراهنة.
أما الأيديولوجيا القومية فهي تركز على مسألة الانتماء إلى الأمة وتدعو بالتالي إلى وحدتها وتقدمها لتلعب دورها في الحضارة الإنسانية. ومع أن الأيديولوجيا القومية حديثة نسبيا في الوطن العربي ،فهي تعود إلى بداية ما يسمى بعصر النهضة العربية عندما اعتبر العامل القومي هو المكون الرئيس للشخصية العربية ،وله الدور الكبير في نضال العرب في سبيل الاستقلال والتمايز عن العثمانيين وعن غيرهم من القوى الاستعمارية الأخرى.
لقد مرت الأيديولوجيا القومية في مراحل عديدة شهدت خلال بعضها انتشارا وفعالية وجرت تحت رايتها أهم النجاحات وأخطر الانتكاسات التي تحققت في القرن العشرين، وفي مراحل لاحقة تراجعت كثيرا لصالح تقدم الفكر الانعزالي والسياسات القطرية الضيقة وتقدم الفكر الديني والإسلام السياسي. وفي جميع المراحل التي مرت بها صعودا أو هبوطا لم تنفصل عن الدين ولم تناصبه العداء فالدين هو مكون أساسي من مكونات الشخصية العربية ومحدد هام لهويتها، لقد جرى الصراع بين القوى القومية والقوى السياسية الدينية خصوصا خلال مراحل المد القومي تحت رايات التقدمية وشعاراتها كما كانت تطرها التيارات القومية، أو تحت راية ((الإسلام هو الحل)) كما رفعتها ولا تزال ترفعها التيارات السياسية الإسلامية، والرابح الوحيد من كل ذلك كان أعداء الأمة والدين من إمبرياليين وصهاينة.
إن تلازم البعد الديني والبعد القومي في تكوين الشخصية العربية على العكس مما جرى في أوربا ميز الفكرة القومية العربية بطابعها الإنساني على خلاف الفكرة القومية الأوربية التي كانت قائمة ولا تزال على التعصب والعرقية والاستعمار (24)
التيار الأيديولوجي الليبرالي هو التيار الثالث الذي لاقى انتشارا في الوطن العربي باعتباره قراءة محلية للفكر الليبرالي الأوربي الذي تصيّر بعد القرن السابع عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشر مستقلا عن الديمقراطية بداية ومتحدا معها لاحقا. تقوم الفكرة الليبرالية على إطلاق الحرية في المجال الاقتصادي وتركز على محورية الربح وقدسية الملكية الخاصة، وتطالب بالحد من تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، على أن تنظم العلاقة بين الملاك والعمال في جو من الحرية وعلى أساس التعاقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24-السيد يسين، مشرف، ((تحليل مضمون الفكر القومي العربي)) ،ط2،( بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1982)
غير أن تطور الرأسمالية وتعمق التمايزات الاجتماعية التي خلقتها الليبرالية وحدة الصراعات الطبقية فرضت على القوى الليبرالية إعادة النظر في تنظيم الإدارة الحكومية للدولة، وفتح مجال المشاركة أمام ممثلي القوى الاجتماعية المختلفة، فكان لا بد من التحول إلى الديمقراطية. ولم تكن عملية التحول هذه سهلة بل شهدت صراعات حادة في حقل الفكر والأيديولوجيا كما في حقل الممارسات الطبقية. ومع أن الديمقراطية تقوم على فكرة المساواة التي تولدت في رحم التمايزات الطبقية، إلا أنها لم تكن تعني اكثر من المساواة الشكلية أمام القانون. مع ذلك فقد أضافت إلى الحياة السياسية عناصر هامة مثل التعددية الحزبية والسياسية والانتخابات الدورية وتبادل السلطة وإقامة هيئات تشريعية يحترم فيها رأي الأغلبية وغيرها.
لقد لاقى الفكر الليبرالي بعض الانتشار في الوطن العربي خصوصا بين المثقفين، وشكلت المطالب الليبرالية مثل المطالبة بالدستور وفصل السلطات والتعددية السياسية جزءا من المطالبة بالاستقلال، واستطاعت القوى الليبرالية أن تفرض الكثير منها خلال مرحلة الاستعمار أو بعيد الاستقلال في العديد من الدول العربية. إلا أن صعود المد القومي بحامله الجديد البرجوازية الصغيرة ، استطاع أن يعطي للخطاب الليبرالي قيمة انفعالية سلبية لدى أوسع الجماهير العربية من خلال ربط الديمقراطية وغيرها من مكونات الفكر الليبرالي بالاستعمار والصهيونية ، وأنها ليست اكثر من حصان طروادة لعودتهم إلى الوطن العربي وسيطرتهم عليه. لكن في العقدين الأخيرين من القرن العشرين خصوصا بعد الفشل الذريع للخطاب القومي والتجارب القومية التي كانت سائدة في الخمسينات والستينات وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية، عاد الفكر الليبرالي من جديد ليطرح نفسه كمخرج من الاختناقات التي تعاني منها الأقطار العربية .ومن جديد أصبحت المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الراية التي تتحرك تحتها قوى اجتماعية عديدة وخصوصا قوى المثقفين ، بل وأخذت الأنظمة العربية الحاكمة تسمح ببعض الهوامش لحرية التعبير والنقد ، وذهب بعضها إلى مدى أبعد فركب الموجة وأعاد تنظيم سلطته وحكمه على أساس ديمقراطي فصّله على مقاسه.
إن الخطر الأكبر الذي يواجه الموجة الليبرالية الجديدة يتمثل في المقاومة العنيفة التي يبديها تجاهها الفكر الديني المستنفر والقوى السياسية الإسلامية التي قطعت شوطا بعيدا في التعبئة السياسية لقسم هام من الجماهير العربية.
التيار الأيديولوجي الرابع الذي أدى دورا مهما في رسم ملامح الثقافة السياسية العربية وفي مقاومة الاستعمار هو الأيديولوجيا الماركسية. تمثل الماركسية العربية قراءة تأملية اغترابيه للفكر الماركسي الأوربي وبصفتها هذه لم يكن من الممكن أن تقدم قراءة علمية للواقع العربي، مما جعل أغلبية الأحزاب الشيوعية تعادي الفكر القومي والديني وتقلل من شأنهما في الحياة السياسية والاجتماعية العربية وفي تكوين الشخصية العربية والهوية العربية. لقد انعكست الأحزاب الشيوعية في وعي أوسع الجماهير بكونها قوى تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، إلى جانب ممارساتها السياسية الخاطئة وتبنيها شبه الأعمى للسياسات السوفييتية تجاه المنطقة.
لقد تراجع التيار الأيديولوجي الماركسي كثيرا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى، وأخذت تطرأ على الحركات الشيوعية العربية تحولات باتجاه الاشتراكية الديمقراطية في مسعى منها للتأقلم مع المتغيرات الدولية، وإعادة بناء وتجديد ذاتها على أسس مختلفة اقل جمودا وأكثر انفتاحا خصوصا تجاه الديمقراطية.
هذه هي التيارات الأيديولوجية الرئيسة في الوطن العربي، ومع أنها تبدو للوهلة الأولى متمايزة إلى درجة القطيعة إلا أنها في حقيقة الأمر تشترك في العديد من السمات:
أ-تتميز هذه التيارات الأيديولوجية بنزعتها التوفيقية والتلفيقية، بحيث يحاول كل منها المزج بين أكثر من تيار أيديولوجي، أو يحاول أن يركّب منها جميعا أيديولوجيته الخاصة. فمن المعلوم أن التيار الديني خلال مرحلة المد الاشتراكي حاول استيعاب بعض عناصر الخطاب الاشتراكي في داخله، ونشاهد اليوم كيف أن التيارات القومية والماركسية والدينية تحاول احتواء بعض عناصر الخطاب الليبرالي، كما أن الخطاب الديني والخطاب القومي لم ينفصلا في الحياة الواقعية، بل كثيرا ما استعان الخطاب القومي بلغة الخطاب الديني في عملياته التعبوية، ويلجأ الخطاب الديني نفسه إلى استيعاب بعض عناصر الخطاب القومي من أجل زيادة قدرته على التجييش والتعبئة. ولم يقتصر ذلك على الأنظمة الحاكمة بل وتعداها إلى المعارضة بكل ألوانها. (25)
ب-تتميز الأيديولوجيا العربية على اختلاف تياراتها بأنها تروج للعلاقات الشخصانية في الحياة السياسية والاجتماعية. لقد أصبحت الأحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي تعرف من خلال زعاماتها، بل وفي بعض الحالات تنسب الأيديولوجيا إلى أشخاص معينين مثل الناصرية. (26)
ت- تتميز الأيديولوجيا العربية بعدم الوضوح والتناقض، وهي سمة تتولد من طابعها الشخصاني ونزعتها التوفيقية. تبرز هذه السمة كثيرا في ظروف التخلف وضعف تبلور الطبقات، وضغط الأيديولوجيات الخارجية، وضعف الكادر الفكري المحلي وعدم قدرته على إنتاج انساق أيديولوجية أكثر تجانسا تقرأ بها كل طبقة مصالحها الخاصة في سياق الحراك الاجتماعي العام.
ث -الطابع النخبوي للأيديولوجيا العربية. من المعروف أن النخبة هي جزء بنيوي من أي تركيب اجتماعي مهما تغيرت الظروف، لها وظيفة محددة هي أن تقف في طليعة الحركة وتقودها، مهما اختلفت الأشكال الاجتماعية للكائن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25-الغزالي حرب، أسامة " الأحزاب السياسية في العالم الثالث"، سلسلة كتب عالم المعرفة،117،(الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،1987 )
26-محمد معلوم، حسين" قراءات في نقد اليسار العربي-التجربة الحزبية العربية "،( القاهرة، الهيئة العربية للكتاب ،1991) ص 311-333 .
المتحرك. في الحقل السياسي تبدو النخب العربية القابضة على السلطة مستقرة نسبيا وضعيفة الحراك، فسواء كانت نخب ملكية أم جمهورية، تقليدية أو ثورية لا تتخلى عن موقعها إلا بالقوة أو الوفاة، وهي غالبا تنتمي إلى أصول عائلية أو عشائرية أو مذهبية. ولكي تحافظ على وجودها واستمرارها فإنها تنسج منظومة من العلاقات الشخصانية تكون هي في المركز منها مع كل ما يلزم لذلك من مسوغات أيديولوجية. نخبة من هذا النوع لا يمكنها أن تكون إلا نخبة متسلطة تقدم نفسها على أنها المدافع عن مصالح الوطن والمواطن في الوقت الذي تستعبد المواطن وتنهبه، وتحول الوطن إلى مزرعة خاصة.
3-5-البيئة السياسية للنظام السياسي العربي.
في الحقل السياسي تتشابه الأنظمة السياسية العربية بغض النظر عن كونها أنظمة جمهورية أو ملكية فهي فاقدة للشرعية السياسية المستمدة من خيارات الشعب، كما أن أساليب الحكم وطريقة اتخاذ القرارات، والهياكل الخاصة بذلك تكاد تكون واحدة، فجميعها أنظمة استبدادية فردية. ولا تختلف كثيرا الأحزاب السياسية العربية سواء ما كان منها في موقع السلطة، أم في موقع المعارضة.
لقد ساد حتى وقت قريب مفهوم للحزب السياسي باعتباره ممثلا سياسيا لطبقة من الطبقات الاجتماعية أو لمجموعة من الفئات الاجتماعية التي تشترك في الوضعية الطبقية. لكن هذا المفهوم تعرض لامتحان تاريخي ثبت خلاله عدم دقته، لذلك فهو يتعرض للنقد (27)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27-( … من قبل هذه الوصاية السحرية ظهر" قانون" وحدانية تمثيل الطبقة العاملة الذي يستمد تبريره من "قانون" وحدتها كطبقة غير مالكة لوسائل الإنتاج تبيع قوة عملها. إن الأمر يقوم في الحقيقة على مغالطة موجهة ضد التعددية قبل كل شيء تمثل أحادية نظر الفكر قبل ان تمثل أحادية مصلحة الطبقة العاملة). /العزواي، فاضل ((كيف تفسد الثورات))، (لندن، مجلة الناقد،العدد13/تموز/يوليو1989) . انظر أيضاً (مجلة اليسار العربي) العدد88 كانون الأول/ديسمبر 1989، ص 40.
من المعروف أن الأحزاب الشيوعية هي أكثر الأحزاب ادعاء في تمثيلها الطبقي، غير أن الأحداث التي جرت في العقد الأخير من القرن العشرين وأدت إلى انهيار النظام الاشتراكي الذي كان قائما قد بينت مدى اتساع الهوة بين الأحزاب الشيوعية وخلفياتها الاجتماعية التي ادعت تمثيلها سياسيا. (28)
وفي الغرب الأوربي ثمة العديد من الأحزاب التي تدعي تمثيل الطبقة البرجوازية أو غيرها من الطبقات مع أنها متعددة. وتوجد في البلدان النامية العديد من الأحزاب القائمة على أساس طائفي أو عرقي أو قبلي وغيرها.
في الوقت الراهن يجري الحديث عن استقلالية الأحزاب السياسية عن خلفياتها الاجتماعية، باعتبارها شكلاً موضوعياً للوجود الاجتماعي ظهر تاريخيا في ظروف محددة، وهو يقوم على مجموعة من المبادئ أو الرؤى السياسية الموجهة نحو السلطة بالدرجة الأولى ونحو بناء المجتمع بالدرجة الثانية (29). فحسب كمال المنوفي الحزب هو: " تنظيم سياسي له صفة العمومية والدوام له برنامجه يسعى بمقتضاه للوصول إلى السلطة " (30).
لقد ارتبطت ولادة الأحزاب السياسية في أوربا بالتوسع بحق التصويت والمشاركة التي نمت مع التوسع الرأسمالي، إلا أن هناك أحزاب سياسية خصوصا في الدول النامية وفي بعض بلدان أوربا الشرقية لم يرتبط وجودها بالحياة البرلمانية، بل على الضد منها. هنا يجب البحث عن أسباب ولادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28-يقول خضر ذكريا ((إن مقولة شاعت وكرست منذ نشوء الأحزاب الشيوعية حتى الآن تقول: إن هذه الأحزاب هي وحدها التي تمثل الطبقة العاملة وتعبر عن مصالحها وبالتالي مصالح حلفائها وارى أنه آن الأوان لإعادة النظر في هذه المقولة)). زكريا،خضر،" حزب واحد أم أحزاب متعددة"/مجلة النهج،العدد29،(1990)/ص38.
29-خدام، منذر(1992)،" في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي "،مخطوطة غير منشورة،ص66.
30-المنوفي، كمال " أصول النظم السياسية المقارن"،(الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع،1987) ص 183-185.
الأحزاب السياسية بالنضال ضد الاستعمار والعمل على التطور والخروج من دائرة التخلف. وفي مختلف الظروف كان البرنامج السياسي الموجه نحو السلطة بالدرجة الأولى هو الجامع للحزب.
في الوقت الراهن ومع تسارع عمليات الاندماج العالمية مع تطور الرأسمالية وانتقالها إلى مرحلة أعلى، وتحسن المستوى الثقافي للشعوب في البلدان النامية ونمو الوعي بضرورة المشاركة السياسية بدأت الأحزاب السياسية في هذه البلدان تتبلور بصورة مستقلة عن خلفياتها الاجتماعية.
في البلدان العربية تتشابه الأحزاب السياسية كثيرا سواء من ناحية برامجها السياسية أو بناها التنظيمية بغض النظر عن مدى استقلاليتها عن خلفياتها الاجتماعية، ومهما كانت الراية الأيديولوجية التي ترفعها. فهي في الغالب الأعم تقوم على الروابط الشخصانية وتعرف من خلال أمنائها العامين، أو مجموعة من الأشخاص (وفي الغالب شخص واحد) يؤدون دور الرابط الداخلي لهذه الأحزاب. بل وهناك أحزاب يتوارثها الابن عن الأب فهي أقرب إلى الأحزاب العائلية. من الناحية الأيديولوجية تنضوي الأحزاب السياسية العربية في إطار مجموعات أربع هي الأحزاب الماركسية والأحزاب القومية والأحزاب الدينية والأحزاب الليبرالية. ومع أن تاريخ هذه الأحزاب أظهر فيها طابعها النفووي ونزعتها الدكتاتورية خصوصا بعد أن تستلم السلطة، إلا أنها تحت ضغط المتغيرات العالمية وعمق الأزمات التي تعصف بالوطن العربي تحاول البحث عن القواسم المشتركة، وتغليب لغة الحوار في سعيها إلى خلق البديل الديمقراطي.
خلال تطور الحياة السياسية الحزبية في الوطن العربي تعرضت مختلف الأحزاب السياسية إلى ما يسمى بظاهرة الانقسام وإعادة البناء، وذلك تحت ضغط الصراعات الاجتماعية وانعكاسها عليها، مما استهلك منها جزءا كبيرا من طاقتها وفعاليتها. وقد طبعت ظاهرة الانقسام التي تعرضت لها الأحزاب السياسية الحياة السياسية العربية منذ بداية الاستقلال وذلك نتيجة اتساع رقعة العمل السياسي وانتشار التعددية الحزبية في أغلب الأقطار العربية، والأهم من ذلك القبول بالأراء المختلفة في داخل الأحزاب نفسها. واللافت للانتباه أن قضية فلسطين وقضية الوحدة العربية والعلاقة مع الخارج كانت في صلب الصراعات الداخلية للأحزاب السياسية العربية وسبباً رئيساً في انقسامها، في حين غابت قضية الديمقراطية (31)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
31- فرح،الياس "الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية "،( بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1975)
#منذر_خدام (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثان
...
-
رهانات الاسد والسقوط الكبير
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
-
العرب والعولمة( الفصل السادس)
-
العرب والعولمة( الفصل الخامس)
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
-
العرب والعولمة(الفصل الثاني)
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
-
العرب والعولمة( مدخل)
-
العرب والعولمة(مقدمة)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الحادي عشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الهاشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل التاسع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثامن)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل ااسابع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل السادس)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الخامس)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الرابع)
المزيد.....
-
نتنياهو يعاود الحديث عن حرب القيامة والجبهات السبع ويحدد شرو
...
-
وزير خارجية إسرائيل: الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين -خطأ جسيم
...
-
معلقون يتفاعلون مع قرار حظر الإمارات التحدث باللهجة المحلية
...
-
بوتين يعلن عن هدنة في شرق أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح وزيلينس
...
-
المحكمة العليا الأمريكية تقرر تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنز
...
-
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن عودة 246 جنديا من الأسر في عملي
...
-
البحرية الجزائرية تجلي 3 بحارة بريطانيين من سفينتهم بعد تعرض
...
-
الأمن التونسي يعلن عن أكبر عملية ضبط لمواد مخدرة في تاريخ ال
...
-
-عملناها عالضيق وما عزمنا حدا-... سلاف فواخرجي ترد بعد تداول
...
-
بغداد ودمشق.. علاقات بين التعاون والتحفظ
المزيد.....
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
/ منذر خدام
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
/ منذر خدام
-
ازمة البحث العلمي بين الثقافة و البيئة
/ مضر خليل عمر
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
/ منذر خدام
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
قواعد اللغة الإنكليزية للأولمبياد مصمم للطلاب السوريين
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
أنغام الربيع Spring Melodies
/ محمد عبد الكريم يوسف
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة