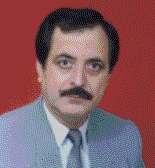|
|
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثالث)
منذر خدام


الحوار المتمدن-العدد: 8309 - 2025 / 4 / 11 - 21:53
المحور:
قضايا ثقافية
الفصل الثالث
الديمقراطية وبيئتها المفهومية
1-ولادة المصطلح وحدوده الواقعية.
لقد شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين نقاشا مستفيضا حول مسألة الديمقراطية وارتبط ذلك على وجه الخصوص بالتحولات التي جرت في بلدان الكتلة السوفييتية. ونظرا لاتساع الاهتمام بالديمقراطية وعمق وشمولية المناقشات التي دارت حولها يمكن القول دون مبالغة أن ثمة إعادة اكتشاف للقضية من جديد على الصعيد العالمي، وعلى الصعيد العربي أيضاً. واللافت أن غزارة النقاش حول قضية الديمقراطية لم يخف حقيقة أن هناك اختلافاً وتبايناً في مدلول المصطلح. فكل مساهم في النقاش يعطي الكلمة مدلولا وصفيا معينا ويسحب ذلك على البناء الاجتماعي فتتعقد القضية وتتعدد الأسئلة. ورغم الاختلاف والتباين في فهم المصطلح وتحديد حمولته الدلالية، فإنه ترك في جميع الأوساط الاجتماعية قيمة انفعالية إيجابية.
كلمة " ديمقراطية “من أصل يوناني قديم(اغريقي) وهي تعني في اللغة " حكم الشعب" وقد يضاف إلى الترجمة العربية للكلمة عبارة " نفسَه بنفسِه "، فتصبح الترجمة الكاملة لكلمة ديمقراطية هي: "حكم الشعب نفسه بنفسه". من جهة أخرى فإن المدلول الاصطلاحي لكلمة ديمقراطية أي إشارتها إلى بناء اجتماعي معين يسود فيه نوع من الحياة السياسية كان ضيقا جدا على الدلالة اللغوية لمصطلح ديمقراطية. فمنذ البداية كان ثمة فارق كبير بين المعنى اللغوي لكلمة "ديمقراطية" والمعنى الاصطلاحي بما هو إشارة إلى بناء اجتماعي محدد له حياته النوعية الخاصة. وإن إحدى التفسيرات الأكثر رجحانا لهذا الجانب الاصطلاحي لمفهوم الديمقراطية، أي إشراك العامة في إدارة شؤون الدولة، تعيد المسألة إلى ظروف الحروب العديدة التي نشبت بين دول-المدن اليونانية القديمة وتحديدا إلى المجتمع الأثيني. في ذلك الزمن ونتيجة للحروب العديدة التي قامت بين اليونانيين كادت تنقرض طبقة النبلاء-الفرسان مما استدعى صعود أناس من عامة الشعب لقيادة الجيش والحصول بالتالي على ألقاب النبالة دون أن يكون النبيل الجديد سليل أسرة نبيلة. ومع تزايد حضور العامة في الجيش والحصول على ألقاب النبالة تصاعدت المطالب بإشراكها في إدارة شؤون الدولة. وهكذا بدأ يجري انتخاب كل مسؤولي الدولة بصورة مباشرة من قبل الشعب، وسمي هذا الطراز من الحكم المباشر بالديمقراطية.
وكان الإشكال الأول الذي واجه الديمقراطية اليونانية القديمة هو تحديد من يحق له المشاركة في الانتخابات، وهو السؤال الذي لا يزال يطرح حتى وقتنا الراهن مع اختلاف الظروف التاريخية. ونظرا لأن المجتمع اليوناني القديم كان مجتمعا عبوديا فقد أجاب عن سؤال المشاركة بأن استثنى الأرقاء والنساء من عملية المشاركة في الانتخابات وحصرها في طبقة الأحرار أي أولئك الذين كانوا يتميزون بكونهم أرباب المواقد. فرب الأسرة هو رب الموقد فيها، ولكي يكون رباً للموقد عليه أن يكون صاحب أسرة وان يمتلك أرضا وعددا من العبيد. في اليونان القديمة بلغ عدد من ينطبق عليهم هذا التحديد لمفهوم رب الموقد نحو 12% من عدد سكان اليونان آنئذ.
تميزت الديمقراطية اليونانية القديمة بأنها ديمقراطية مباشرة يشارك فيها جمهور الشعب مباشرة أثناء انتخاب المسؤولين أو عزلهم، كما كان يشارك أيضا في المناقشات المتعلقة بشؤون الدولة والحكم (1)
هذه هي البدايات التاريخية لعملية ولادة مصطلح" الديمقراطية " وتمثيله واقعيا، لكن في سياق التطور التاريخي الاجتماعي العام توسعت الدلالة الاصطلاحية للمفهوم وأصبح يشير إلى بنى اجتماعية مختلفة تسود فيها أنماط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-عبد الرحمن حبيب، " كيف ظهرت الديمقراطية في الحضارة اليونانية القديمة" ، اليوم السابع: https://www.youm7.com، 29/8/2021.
من الحياة الاجتماعية متباينة إلى حد كبير. من هذه الزاوية لا يزال المصطلح في وضعية عدم التعيين ويشكل موضوعا ساخنا للسجال وربما سوف يستمر ذلك في المستقبل. فالمحمول الدلالي للمصطلح من زاوية الرؤية الغربية يختلف عنه من زاوية الرؤية في بلدان العالم الثالث. وحتى في الدول المتقدمة التي لها تاريخها الخاص والمتقدم في مجال الديمقراطية ثمة اختلاف وتباين في رؤيتها لما يشير إليه المصطلح واقعيا. وأكثر من ذلك ثمة اختلافات جدية في رؤية المفكرين والسياسيين الذين اشتغلوا على قضية الديمقراطية في مختلف البلدان والظروف، مما يبرهن على أننا إزاء ظاهرة معقدة ومتعددة ليس لها حدود معيارية بل حدود تاريخية، تتسع أو تضيق من بلد إلى آخر، وتختلف أيضا في داخل كل بلد بحسب رؤية كل شكل من أشكال الوجود الاجتماعي لها ومصلحته فيها. يقودنا ذلك إلى استنتاج مبدئي يفيد بأن الديمقراطية هي ديمقراطية واقعية فحسب، وكل ديمقراطية واقعية هي ديمقراطية حقيقية بهذا المعنى. أما أن يقال هناك ديمقراطية حقيقية كحالة معيارية حدية فهو قول بلا معنى، لأن الديمقراطية من حيث الأساس ذات طابع تاريخي ترتبط مباشرة بمصالح قوى اجتماعية مختلفة. ويزيد في طابعها التاريخي أيضا كون مفهوم " الشعب " ومفهوم " الحكم" يتغيران عبر التاريخ. يترتب على ذلك استنتاج آخر يفيد بان كل اختيار ديمقراطي له مشروعيته التاريخية، بمعنى أن هناك مصالح اجتماعية معينة استدعته، وان المقارنة والمفاضلة بين اختيار ديمقراطي وآخر لا يكون استنادا إلى مقياس معياري حدي، بل إلى اختيار آخر يكون أكثر فعالية في مجال التقدم الاجتماعي وفي اقترابه من حقوق الإنسان كما تتحدد تاريخيا.
وبالفعل ما كان يمثل نظاماً ديمقراطياً " حقيقياً " بالنسبة للكتلة السوفييتية والمتأثرين بمناخاتها الفكرية والسياسية هو غيره بالنسبة للدول الغربية. وحسب عالم الاجتماع البريطاني انتوني غيدنز هناك ثلاثة أنواع من الديمقراطيات: الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية متعددة الأحزاب والديمقراطية ذات الحزب الواحد. (2)
2-الديمقراطية الحديثة وبيئتها المفهومية.
لا شك أن الديمقراطية الحديثة هي الديمقراطية التي ولدت في أوربا نتيجة الانقلاب التاريخي الذي حصل في المجتمع بقيادة البرجوازية، لذلك من الشائع أن يطلق عليها اسم الديمقراطية البرجوازية. هذه الديمقراطية لم تولد مكتملةً وناجزةً بل تصيّرت عبر تاريخ طويل نسبيا من التطور واكب تطور الرأسمالية ذاتها وهي لا تزال بعيدة جدا عن الصورة المثالية التي رسمها لها فلاسفة أوربا، وأكثر بعدا عما يتوقعه منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948.
ومع أن الديمقراطية كنمط حياة وكنظام في السياسة قد شكلت قطيعة بالمعنى التاريخي مع النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في أوربا قبل صعود الرأسمالية، إلا أن بعض الجذور الأولى لها كانت ضاربة في عمق الحياة الإقطاعية ذاتها. من المعروف أن الإقطاع الأوربي كان يتمتع باستقلالية كبيرة تجاه السلطة المركزية وكان كل إقطاعي مستقلا تجاه غيره من زملائه، وعلى قاعدة هذه الاستقلالية والندية كانت تقوم الروابط والعلاقات بين الإقطاعيين بعضهم تجاه بعض وبينهم وبين الدولة. الإقطاعي الأوربي كان يتحدد بدلالتين مختلفتين: من جهة كان يتحدد بدلالة زملائه من الإقطاعيين، فهو بهذه الدلالة إقطاعي بقدر اعترافه بوجود زملائه وتكامله معهم. بكلام آخر إن العلاقات التي كانت قائمة بين طبقة النبلاء الإقطاعيين كانت من طبيعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 C .P . Macpherson, The real world of Democracy (New York , Oxford University Press ,1972) - p p 1-11 .
انظر أيضا علي الدين هلال " مناهج الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث " في(( أزمة الديمقراطية في الوطن العربي))، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربي، (بيروت ،المركز ،1987) ص 36 .
تكاملية وجود كل منهم فيها يشترطه وجود الأخر الإقطاعي، وان وجودهم جميعا كطبقة كان يشترطه وجود الدولة الإقطاعية بالشكل الذي يحافظ على حدود كل منهما.
ومن جهة أخرى كانت طبقة الإقطاع تتحدد بدلالة الفلاحين الأقنان وغيرهم ممن ينتمون إلى الطبقات والفئات الاجتماعية الأخرى. هنا كانت العلاقة ذات طابع تفارقي، بمعنى أنها كانت ذات اتجاه واحد من الإقطاعي إلى الفلاح، جوهرها التمايز والاختلاف والصراع بين وضعيتين اجتماعيتين متميزتين، ومن خلال هذه العلاقة الصراعية كانت كل منهما تتحدد بدلالة الأخرى، أي أن وجود طبقة النبلاء بالشكل الذي كانت عليه كان شرطا لوجود طبقة الفلاحين بالوضعية التي كانوا عليها والعكس بالعكس.
في الحالة الأولى كان الحوار والتعاون والندية هي التي ترسم ملامح حياة الطبقة الإقطاعية. هنا العلاقات التفاعلية كانت تجري في إطار دائري وعلى أساس المساواة.
أما في الحالة الثانية فكانت التبعية والتسلطية والأوامرية هي التي ترسم ملامح العلاقات بين الإقطاعيين والفلاحين على أساس من التمايز والصراع. من هنا فإن مقولة أن الديمقراطية كانت سلاح الفقراء والضعفاء المتطلعين إلى عالم أفضل تسود فيه المساواة وتتحقق فيه الحقوق الاجتماعية والسياسية لها ما يبررها. (3)
وبالفعل فإن الدعوة إلى الحرية والمساواة كانت في جوهر الخطاب الديمقراطي كما قدمه فلاسفة أوربا الديمقراطيين. فحسب جون لوك الحرية والمساواة من السمات الطبيعية للإنسان لا يجوز انتزاعها منه وإلا فقد طبيعته. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3-علي الدين هلال " مناهج الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث " في(( أزمة الديمقراطية في الوطن العربي))، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربي، (بيروت ،المركز ،1987) ص 36 .
يقول جون لوك: "لما كان الناس جميعا أحرارا ومتساوين بالطبيعة فلا يمكن انتزاع شخص من حالته هذه وإخضاعه للسلطة السياسية لشخص آخر إلا برضاه"(4). وأن " لا بقاء للحرية بدون المساواة" حسب جان جاك روسو (5). لكن المساواة التي نادى بها كل من لوك وروسو لا تتعدى المساواة أمام القانون، والمساواة في الإرادة على المساواة ذاتها. فحسب روسو " لكل فعل حر سببان يجتمعان لإنتاجه أحدهما معنوي وهو الإرادة التي تحدد الفعل، والآخر مادي وهو المقدرة على التنفيذ" (6). وكان يردد دائما " إذا أردت أن تضفي على الدولة استقراراً قرِّب بين الحدود القصوى بقدر الإمكان، فلا يبقى فيها غنى فاحش ولا فقر مدقع" ، فالغنى والفقر وضعان يضران بالخير العام وببناء الدولة واستقرار المجتمع وفي كليهما تكمن بذور الاستبداد والطغيان، فإحداهما " يؤدي إلى وجود أعوان الطغاة والآخر إلى الطغاة، وفيما بينهما تشترى الحرية وتباع " (7)
بين لوك وروسو كانت تنوس قضية الديمقراطية في الحياة العملية تارة تقترب من لوك فتأخذ طابعا نخبويا، وتارة أخرى تبتعد عنه وتقترب من روسو فتأخذ طابعا إنسانيا عاماً. فحسب لوك الذي يعتبر فيلسوف الديمقراطية البرجوازية فإن الديمقراطية لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية نخبوية لذلك وبتأثير من مونتسكيو النخبوي صيغت المادة الثانية من دستور عام 1791 الفرنسي لتأكيد ذلك. تنص المادة الثانية من الدستور المذكور على "أن الأمة التي تنبع منها كل السلطات لا يمكن أن تمارس إلا بواسطة مفوضين ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-لوك، جون، الفصل الثامن من الرسالة الثانية، فقرة 95 من كتابه رسالتان في الحكم.
5- روسو، الفصل الحادي عشر- الكتاب الثاني من العقد الاجتماعي.
6- روسو، الفصل الأول –الكتاب الثاني من العقد الاجتماعي.
7- روسو، الفصل الثالث عشر- الكتاب الثالث من العقد الاجتماعي.
ونتيجة لذلك فقد حصر حق الانتخاب بمن يملك ما يؤمن له 150 يوم /عمل في المدينة أو 400 يوم /عمل في الريف، علما أن الحد الأقصى لأجر اليوم الواحد كان فرنك فرنسي واحد (8) لكن في عام 1793 وضع دستور جديد على هدى فلسفة روسو أقر بأن " إنسانية الإنسان غير قابلة للمساس بها فلا يعترف القانون بأن يعمل إنسان في خدمة إنسان آخر"، وبناء على ذلك أعطى الحق لكل مواطن فرنسي يبلغ 21 عاما ولكل أجنبي يقيم في فرنسا منذ أكثر من عام بأن يشارك في الانتخابات بشرط واحد هو أن يعيش من عمله. (9).
وبين الميل إلى تجريد فكرة الديمقراطية ومنطق الواقع وضروراته لا تزال الحياة تجري يعيد إنتاجها الفاعلون الاجتماعيون باستمرار وبشكل مختلف. فكيف كانت هذه الحياة التي استدعت الديمقراطية لتشكل نمطها الخاص وشكل بنائها السياسي مع كل أفراد عائلتها من المفاهيم الأخرى.
من المعروف أن عمليات الانتقال من التشكيلة الإقطاعية إلى التشكيلة الرأسمالية في أوربا كما هو متفق عليه على نطاق واسع قد بدأ فعليا في نهاية القرن الخامس عشر بداية القرن السادس عشر لتكتمل بشكل حاسم في القرن التاسع عشر. خلال هذه الفترة الطويلة نسبيا جرت تحولات جوهرية في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أدت إلى ولادة إنسان ثقافي جديد.
من ناحية الأساس الاقتصادي للمجتمع جرى التحول من الريف إلى المدينة، من الزراعة إلى الصناعة والتجارة، وأعيد بناء المجتمع وهيكلته ليتلاءم مع ذلك. لقد أزيلت طبقة النبلاء الإقطاعية لتحل محلها في قيادة المجتمع الطبقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8-سيف الدولة، عصمت، معقب، " أزمة الديمقراطية في الوطن العربي "، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، (بيروت، المركز،1987) ص58
9-المرجع السابق ص59.
البرجوازية، وتراجع دور الفلاح في الصراع الاجتماعي ليبرز دور العامل الحر، وتغيرت بالنتيجة طبيعة العلاقات التي تربط العامل برب العمل من كونها علاقات تابعة يتم فيها استحواذ القسم الأكبر من القيمة المنتجة بالوسائل السياسية إلى علاقات تقوم على أساس التعاقد الحر، يتم فيها استحواذ فائض القيمة المنتجة بالوسائل الاقتصادية.
في المجال الاجتماعي أعيد بناء المجتمع على أساس انصهاري، اضمحل فيه دور البنى العشائرية والقبلية والطائفية، لصالح بروز دور الطبقات والفئات الاجتماعية المنظمة في تنظيمات مدنية مختلفة.
وفي المجال السياسي تم الانتقال من الدولة الأوتوقراطية إلى الدولة المدنية وأعيدت هيكلتها بحيث تم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأصبح القانون هو الناظم لحياة الناس، بدلا من الولاءات ذات الطابع الشخصاني.
إن جميع هذه التغيرات التي طرأت على الرأسمالية ما كان بالإمكان قراءتها باللغة المفهومية السابقة، لذلك كان لا بد من ولادة لغة مفهومية جديدة مناسبة. وهكذا جرى الانتقال من الأيديولوجيا الميتافيزيقية التي تحيل كل شيء إلى الما ورائيات إلى اللغة الوضعية التي تنمو وتتطور بين الناس. بهذا الشكل تشكل ما نسميه بالبيئة المفهومية للديمقراطية التي سوف نحاول التوقف عند بعض مفرداتها.
2-1 الديمقراطية والحرية
إن العلاقة بين الديمقراطية والحرية لا تزال ذات طابع إشكالي، على الرغم من الارتباط القوي بينهما بحيث من الشائع أن تتحدد كل منهما بالأخرى. ثمة أسباب عديدة لذلك، منها ما هو ذو طابع تاريخي عائد إلى الظروف الاجتماعية والسياسية التي أحاطت سيرورة كل منهما، ومنها ما هو عائد إلى إشكالية كل من مفهومي الديمقراطية والحرية والعلاقة بينهما.
الحرية والديمقراطية تنتميان إلى سياقين تاريخيين مختلفين، ففي حين تنتمي
الديمقراطية إلى السياق الأوربي، فإن الحرية تنتمي إلى السياق الإنساني العام. أضف إلى ذلك لم تعالج الحرية في مواجهة الديمقراطية وبالعلاقة معها إلا حديثاً وفي الحقل السياسي تحديداً.
مفهوم الحرية مفهوم مركب فلسفي وأخلاقي وسياسي واقتصادي واجتماعي وغيره، وهو من المفاهيم المتعالية التي لا يمكن إدراكها إلا من خلال ارتباطها بسياق تاريخي محدد وبموضوع مميز. لقد اشتغل الفلاسفة كثيراً على مفهوم الحرية من خلال علاقته بمفهوم الضرورة باعتبار أن المفهومين يعكسان سلوك الناس وعلاقاتهم المتبادلة تجاه الظروف الموضوعية والقوانين العامة للطبيعة والمجتمع (10). وعلى الرغم من تعدد المعالجات للعلاقة بين الحرية والضرورة فإنه يمكن التمييز بين ثلاث اتجاهات رئيسة:
الاتجاه الأول ينظر إلى الحرية على أنها تجسيد للروح أو تحرير للإرادة، تجد قوتها المحركة في العالم الداخلي للنفس البشرية ولا علاقة لها بالشروط الخارجية. الحرية المطلقة حسب وجهة النظر السائدة في هذا الاتجاه هي الأساس الوحيد للمسؤولية وللتقييم.
الاتجاه الثاني على النقيض من الاتجاه الأول، فهو يرفض مقولة الحرية من حيث المبدأ ويؤكد أن لا وجود في الحياة إلا للضرورة الموضوعية. حسب زعم أنصار هذا الاتجاه فإن العوامل الخارجية هي التي تحدد مسبقاً حرية الإنسان وتتحكم بإرادته.
الاتجاه الثالث، وهو الأكثر قبولاً في الوقت الراهن والأقرب إلى العلمية، ينظر إلى الحرية والضرورة كمقولة فلسفية واحدة يتبادل طرفاها التأثير والتأثر، وكان الفيلسوف الإنكليزي سبينوزا هو أول من حاول تفسير الحرية بصورة علمية عندما قال: " الحرية هي وعي الضرورة أو الضرورة وقد صارت وعياً" (11).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10-القاموس الفلسفي (صوفيا، الدار الحزبية للنشر،1977) ص 521.
11-القاموس الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص 521.
ومن ثم جاء هيغل بتفسيره الجدلي لوحدة الحرية والضرورة في مقولة جدلية واحدة تحتل الضرورة فيها بالمعنى الوجودي نقطة البداية ومن ثم تُشتق منها لا حقا حرية الإنسان وإرادته (12).
إن التفسير السائد للضرورة في الطبيعة والمجتمع يحيلها إلى القوانين الموضوعية، الطبيعية أو الاجتماعية، حيث تأخذ صورتها. غير أن هذه الإحالة من وجهة نظرنا قاصرة ولا تجعل الحرية تقابل الضرورة في وحدتهما الجدلية. الضرورة بالعلاقة مع الحرية تعبر عن كل ما يجهله الإنسان أو لا يستطيع التصرف تجاهه بإرادة حرة هادفة. فقبل أن يكتشف الإنسان القوانين الموضوعية في الطبيعة والمجتمع مرّ تاريخ طويل كان يكتشف الإنسان خلاله يوميا الأشياء والظواهر المميزة في الطبيعة والمجتمع، ومع كل اكتشاف جديد كانت تتوسع حريته تجاه ما يكتشفه وتصبح ممارسته أكثر وعيا وحرية.
الحرية تعبر عن ذاتها في الممارسة من خلال الإرادة الحرة، فالإنسان الحر هو الإنسان الذي يمتلك إرادة حرة في نطاق حريته. فالإرادة الحرة ليست سوى تعبير عن سلوك هادف وواع للإنسان الحر في إطار الشروط والظروف الموضوعية المحيطة به. فحسب إنجليز الإرادة الحرة هي تعبير عن خاصية اتخاذ القرار في ضوء معرفة العمل (13). ولذلك فإن الخطوة الأولى لامتلاك حرية الإرادة تتمثل في وعي الهدف، يليها اتخاذ القرار بالعمل، ومن ثم البدء بالعمل بعد تسليحه بالوسائل الضرورية لإنجازه والوصول إلى الهدف.
إن طريقة اختيار الأهداف يرجع إلى انعكاس العالم الخارجي في العالم الداخلي للإنسان (حاجات، رغبات، اهتمامات)، في ظروف تاريخية محددة تؤدي فيها الخبرة المتراكمة والتربية دورا حاسما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12-المرجع السابق، ص521.
13- المرجع السابق، ص94.
في الحقل السياسي تأخذ الحرية أيضا دلالات مختلفة. بصورة عامة يمكن النظر إليها في هذا الحقل من زاويتين تكمل كل منها الأخرى. من الزاوية الأولى تبدو الحرية محددة سلباً بدلالة القيود القمعية أو الزجرية. الحرية هنا تمثل صفة ملازمة للأفعال البشرية خارج نطاق أي ضغط أو إكراه، فهي نقيض للعبودية والتبعية. بهذا المعنى ارتبطت الحرية تاريخياً في الوعي العربي وتحددت بدلالتها. يؤكد ذلك أفضل تأكيد مقولة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الشهيرة." متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ".
ومن الزاوية نفسها وبانحراف بسيط تبدو الحرية محددة بدلالة الأخلاق السياسية، وترتفع بالتالي إلى مستوى الحقوق العامة ذات الطابع القيَمي. الحرية بهذا المعنى تمثل بحثاً في شروط تحققها ولذلك فهي ترتبط بجملة من المفاهيم العامة الأخرى مثل المسؤولية، القانون، المؤسسة، السلطة، الشرعية وغيرها.
من الزاوية الأخرى تبدو الحرية محددة إيجابياً بالنضال في سبيل تأمين شروط ممارستها. لذلك فإن تطوير المجتمع، وتعميم التعليم والرعاية الصحية الشاملة، وخصوصاً مأسسة السلطة وإشراك الناس في صنع مستقبلهم السياسي، تشكل ضمانات للحرية. الحرية بدلالتها الإيجابية لا تتجسد إلا من خلال الديمقراطية السياسية والاجتماعية.
من منظور الفكر الليبرالي تتحدد الحرية سلباً من خلال غياب الإكراه وجميع القيود التي يفرضها أي طرف على الطرف الأخر. الإنسان الحر بحسب الفكر الليبرالي هو الذي يستطيع الاختيار بحرية وبوعي بين احتمالين على الأقل لقضية واحدة. يعد جون ستوارت مل في كتابه "عن الحرية" أشهر المفكرين الليبراليين الغربيين الذين دافعوا عن هذا المعنى لمفهوم الحرية (14). وثمة مفكرون آخرون من نفس الاتجاه يعتبرون أن غياب الإكراه يكفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14-الكيالي، عبد الوهاب، رئيسا للتحرير "موسوعة السياسة" ( بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1981) الطبعة الأولى ،ص243.
كي تتحدد الحرية به. وهم في هذه الحالة يوسعون كثيراً من مفهوم الإكراه بحيث يشمل القيود التي تفرضها العوامل والظروف الطبيعية إلى جانب الشروط والعوامل الاجتماعية. الإنسان لا يكون حراً حسب زعمهم إلا بتوفر عوامل ثلاث:
أ-غياب الإكراه والقيود ذات المنشأ الاجتماعي.
ب-غياب الإكراه الناجم عن الطبيعة.
ت-امتلاك الوسائل الكافية لتحقيق الأهداف التي يتم اختيارها بصورة واعية (15).
يقول الفيلسوف الإنكليزي برتراند راسل في تعريفه للحرية " إن الحرية بشكل عام تعني غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات" (16). غير أن نظرة راسل الاطلاقية هذه للرغبات أوقعته باللاتاريخية. فمن المعروف أن الرغبات ذات طابع تاريخ دائما فهي مشروطة بمستوى تطور المجتمع وطبيعة بنائه الداخلي. ففي المجتمعات المتخلفة تكون الرغبات عادة محدودة وتكثر القيود على الحرية بالمقارنة مع البلدان المتقدمة، وفي هذه الأخيرة ذاتها لا يتساوى من حيث الرغبات ولا الحرية الفقير والغني، أو من يملك القوة ومن لا يملكها، بين من يملك الوسائل الكافية لتحقيق أهدافه ومن لا يملكها. من هنا نجد أن الحرية والسلطة بالمعنى العام كانتا دائما عبر التاريخ مترابطتين بعلاقات عكسية، وتشكلان موضعاً للصراعات الاجتماعية الطبقية. يقودنا ذلك إلى الاستنتاج بأن العلاقة بين الحرية والمساواة علاقة ضرورية بالاتجاهين، فلا يمكن الحديث عن الحرية بدلالتها اللغوية أو الفلسفية أو السياسية في غياب المساواة. لكن المساواة لا يمكنها أن تتحقق خارج التاريخ فهي نسبية وتاريخية دائما، والحرية كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15 -المرجع السابق، ص244.
16- المرجع السابق، ص244.
إن الفهم الخاطئ للعلاقة بين الحرية والمساواة قاد أغلب الاتجاهات الفكرية الماركسية إلى النظر إلى الحرية من الحقل الاجتماعي بعيدا عن الحقل السياسي، الأمر الذي تبين خطأه من جراء التحولات الكبيرة التي جرت على الصعيد العالمي كان من نتيجتها انهيار ما كان يسمى بالمنظومة الاشتراكية.
إن منع الناس من المشاركة في صنع مصيرهم واختيار نمط حياتهم لم يحقق المساواة الاجتماعية، لذلك يبدو أن الربط بين الحرية والديمقراطية هو الذي يؤمن أفضل الشروط لتحقيق الربط بين الحرية والمساواة في إطار تاريخي محدد. نشدد على كلمة "تاريخي" ،لأنه في الحياة العملية قد يكون النظام السياسي في بلد معين ديمقراطياً وتكون الحرية فيه مقيدة بقيود عديدة خصوصا تلك التي يمكن اصطناعها بالوسائل غير المباشرة. الحرية كانت دائما مادة للتلاعب من قبل أولئك الذين يملكون السلطة والقوة ويسيطرون على وسائل الإعلام والتعليم وغيرها.
نخلص مما تقدم إلى القول أن الحرية والديمقراطية لا تتحددان سلبا فقط من خلال كثرة القيود على ممارستهما، بل وتتحددان إيجابيا من خلال النضال في سبيل تحققهما على الصعد كافة، الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وهذا يكون من خلال تحقيق حقوق الإنسان.
2-2 - الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لقد ذكرنا أن من ضمن التحولات التي طرأت على المجتمعات الأوربية مع انتصار الرأسمالية فيها انتقال الفرد من وضعية التابع إلى وضعية الإنسان الحر، من وضعية المنفعل إلى وضعية الفاعل مع كل ما يترتب على ذلك من حقوق واسعة اعترف له بها القانون. تتنوع هذه الحقوق كثيرا لتشمل طائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ومنذ البداية كان لا بد من التفريق بين الحقوق ذات الطابع الإنساني العام والتي تحظى عادة باعتراف شامل تفرض على الأفراد وعلى السلطات احترامها ولها الأولوية من حيث الحاجة إلى الحماية القانونية علما أنها من فئة الحقوق القابلة للتطبيق، وبين نوع آخر من الحقوق التي تنتمي إلى حقل الأخلاقيات العامة، وتأخذ صفة المناقب والفضائل الحميدة، لكنها غير ملزمة للتطبيق ولا يمكن حمايتها قانونيا، مع أنها قد تكون مرغوبة ومستحبة من قطاعات واسعة من المجتمع نظريا على الأقل (17)
في الحالة الأولى تندرج جملة من الحقوق مثل الحق في الحياة والحق في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، والحق في المساواة أمام القانون وغيرها. تسمى هذه الحقوق أيضا بالحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الطبيعية. أما في الحالة الثانية فتندرج قيم أخلاقية عامة مثل الصدق والشهامة والإخلاص وغيرها التي لا يمكن النص عليها في القانون (18).
ومن الأهمية بمكان التفريق أيضا بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يفترض أن يتمتع بها المواطنون في البلدان الرأسمالية. بالنسبة للطائفة الثانية من الحقوق، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنها لا تأخذ صفة الإلزام ولا تستطيع الدولة ولا المواطنون تأمين الحماية لها، فهي مرتبطة بشروط حياة المجتمع ومستوى تطوره الاقتصادي والاجتماعي، وبدرجة الانقسامات الطبقية فيه. ومع أن هذه الحقوق تنص عليها دساتير أغلب البلدان الرأسمالية وتتضمنها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صدرت في عام 1948، إلا أنها غير ملزمة واقعيا. فالاعتراف مثلا بالحق في العمل لا يعني أن كل مواطن سوف تؤمن له فرصة عمل، كما أن الاعتراف بالحق في التعليم لا يعني أن كل طفل يولد سوف يجد مقعدا له في المدارس. تفرض الحقوق الطبيعية نوعين من الالتزامات على الآخرين: النوع الأول سلبي ويعني الامتناع عن سلب هذا الحق أو منع التمتع به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17-زيداني، سعيد " الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي " في "حول الخيار الديمقراطي-دراسات نقدية" ،( بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية 1994) ص171
18-زيداني، سعيد، المرجع السابق ص 172.
والنوع الثاني إيجابي ويعني الاعتراف بالحق وتامين شروط ممارسته. وعندما يمنح شخص ما حقا طبيعيا فهذا يعني منحه لكل شخص آخر، لذلك فإن الحقوق المدنية والسياسية تأخذ صفة العمومية عادة، مع الآخذ بالحسبان بعض التشوهات والنواقص التي تحصل في الممارسة العملية نتيجة للطابع الطبقي للدولة الذي يعبر عن نفسه في بعض الأحيان بصورة سافرة. فهذه الحقوق ليست خارج الصراعات الطبقية، بل هي في صلبها رغم الاعتراف الشامل بها في البلدان المتقدمة على الأقل. أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلا تفترض أي نوع من الالتزامات خارج النص عليها في القوانين الأساسية للدولة. في الحياة العملية تشكل هذه الفئة من الحقوق الموضوع الرئيس للصراعات الاجتماعية الطبقية، وهي وثيقة الصلة بمستوى التقدم الاجتماعي. ففي بلد مثل السويد تتأمن هذه الحقوق بصورة أفضل وبدرجة عالية بالمقارنة مع بلد من بلدان العالم الثالث، أو حتى بالمقارنة مع بلد من بلدان أوربا ذاتها.
من جهتها الحقوق الطبيعية المدنية والسياسية لا تشترط بالضرورة مستوى معينا من التقدم الاجتماعي، لذلك فقد تجدها في بلد مثل الهند كما تجدها في السويد مع العلم أن الشوائب التي تعترض ممارسة هذه الحقوق تقل مع تقدم المجتمع وازدهاره.
2-3-الديمقراطية والمجتمع المدني.
المجتمع المدني مفهوم يشير إلى بنية مجتمعية انصهاريه أعيدت هيكلتها، تشكل فيها الطبقات والأحزاب والمنظمات غير الحكومية والنقابات والهيئات الأهلية المختلفة أشكالاً للوجود الاجتماعي مستقلة عن الدولة، بل وتقف في مواجهتها دفاعاً عن مصالح أعضائها. في المجتمع المدني ثمة فصل بين ما هو خاص وما هو عام بحدود تميزهما دون أن يعني ذلك القطيعة الكاملة، وكلاهما مستوعبان في إطار المجتمع وتحت سقف القانون. بهذا المعنى فإن مفهوم المجتمع المدني هو مفهوم تاريخي، ولد في إطار عمليات الانتقال إلى النظام الرأسمالي في أوربا، بلوره فلاسفة العقد الاجتماعي، ليبلغ أوج نضجه وتطوره على يد هيغل.
المجتمع المدني يتحدد بدلالة الدولة، فإذا كانت الدولة بناء مؤسساتياً تنتظم علاقاته الداخلية جملة من القوانين والتشريعات، فإن المجتمع المدني يعبر عن العلاقات والتفاعلات القائمة بين المواطنين المؤطرين في تنظيمات مدنية دفاعا عن مصالحهم الخاصة.
يتداخل مفهوم المجتمع المدني كثيرا مع مفهوم المجتمع الأهلي مع انهما مختلفان في ظروف النشأة وفي الوظيفة الاجتماعية لكل منهما. المجتمع المدني ولد مع صعود الرأسمالية وارتبط بها ويتطور مع تطورها. تنظيمات المجتمع المدني تقوم على أساس الروابط المدنية الطبقية بالدرجة الأولى وبالتالي فهي تنظيمات أفقية. غير أن المجتمع المدني قد يستوعب بعض التنظيمات الأهلية القائمة على أساس العلاقات الشخصانية مثل التنظيمات العائلية او الاقوامية. وظيفة تنظيمات المجتمع المدني هي الدفاع عن مصالح أعضائها في مواجهة الدولة. في سياق عملية الصراع هذه تبرز الوظيفة العمومية للدولة على حساب وظيفتها الطبقية دون أن تحجبها، وتبرز أيضا الوظيفة المدنية العمومية للتنظيمات المدنية على حساب وظيفتها الخاصة.
أما المجتمع الأهلي فهو سابق على المجتمع المدني ويمكن ملاحظته في مجتمعات قديمة جدا. تقوم التنظيمات الأهلية من حيث الأساس على الروابط الشخصانية، مثل روابط الدم أو القرابة أو العقيدة وغالبا ما تكون تنظيمات شاقولية. تكمن وظيفة تنظيمات المجتمع الأهلي بالدرجة الأولى في تمايزها ودفاعها عن حدود هذا التمايز تجاه غيرها من التنظيمات الأهلية أو المدنية الأخرى وثانيا في دفاعها عن مصالحها تجاه الدولة وتجاه التنظيمات الأخرى في المجتمع.
يتداخل مفهوم المجتمع المدني مع مفهوم التنظيمات غير الحكومية. المجتمع المدني مفهوم أوسع ويشمل التنظيمات غير الحكومية وكذلك التنظيمات الأهلية. التنظيمات غير الحكومية تركز في العادة على بعد واحد وهو استقلاليتها عن الدولة، وقد تكون مستقلة عن الأحزاب السياسية وتتميز بالتماسك والاستقرار بالمقارنة مع تنظيمات المجتمع المدني (19).
تتنوع كثيرا ميادين نشاط الجمعيات غير الحكومية لتشمل العديد من مناحي الحياة الاجتماعية، فهناك الجمعيات الخيرية وجمعيات رعاية المشردين ودور العجزة. وتنتشر أيضا المنظمات غير الحكومية في المجالات الخدمية، في مجال النقل والسكن والسياحة، وهناك أيضا الجمعيات الثقافية وغيرها.
المجتمع المدني لا يكون إلا باستقلالية الفرد وتمتعه بحريته، ومن خلال الاستقلالية وممارسة الحرية يمكنه أن يلتقي مع غيره في وعي ضرورة الدفاع عن حريته واستقلاليتهما مما يؤدي في خطوة لاحقة إلى ولادة مختلف التنظيمات المدنية المستقلة وظيفيا عن الدولة وعن غيرها من التنظيمات الأهلية أو غير الحكومية على قاعدة الاعتراف بضرورة الاختلاف والحق به.
2-4- الديمقراطية والعلمانية.
الديمقراطية الحديثة والعلمانية تنتميان إلى سياق تاريخي واحد هو سياق التاريخ الأوربي، أي التاريخ الرأسمالي. خطاب العلمانية موجه إلى تحييد الدولة عن الشأن الديني ونقل الدين من الحيز العام إلى الحيز الخاص وإبعاد الميتافيزيقيا عن قراءة مصالح الناس لصالح القراءات الوضعية لها. هذا يعني الانتقال من القراءات المتعددة للأيديولوجيا الدينية إلى تعدد الأيديولوجيات الوضعية حسب التمايزات الطبقية في المجتمع وحسب وضعياتها التاريخية . وفي هذا الإطار يجري إنتاج مفهوم الفرد المواطن واعتباره الحقيقة الوجودية الوحيدة المتميزة لقيام البناء الاجتماعي ومنظومة الحقوق المختلفة خصوصا تلك التي تندرج تحت عنوان الحقوق الطبيعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19-الباز، شهيدة " المنظمات الأهلية على مشارف القرن الواحد والعشرين- محددات الواقع وأفاق المستقبل "، ( القاهرة ،لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الأهلية العربية، 1997 ) ،ص40-43
أما خطاب الديمقراطية بالمعنى الضيق فهو خطاب موجه إلى إدارة علاقات السيطرة ونظام الحكم بما يعني ذلك في صورتها المتقدمة، اعتبار الشعب مصدر جميع السلطات ومعيار شرعيتها، ومصدر التشريع والرقابة، يحقق ذلك عن طريق ممثلين عنه ينتخبهم بصورة دورية. أما بالمعنى الواسع فهي خطاب موجه إلى إعادة بناء الحياة الاجتماعية ككل على أساس الحرية والمساواة، أي تحويلها لتشمل بالإضافة إلى المستوى السياسي، المستوى الاجتماعي. والاقتصادي والثقافي بحيث تتحول إلى نمط حياة كاملة لجميع أفراد المجتمع في جميع أشكال وجودهم الاجتماعي. الديمقراطية سواء بالمعنى الضيق أو بالمعنى الواسع والعام فهي ضرورية للعلمانية كما أن العلمانية ضرورية للديمقراطية.
العلمانية كما ظهرت في سياق التاريخ الأوربي لم تكن معادية للدين ولا تنكر القيم الدينية سواء الوضعي منها أو السماوي، بل قامت أساسا على معاداة الكنيسة باعتبارها: من جهة مؤسسة فكرية تحارب حرية الفكر وتعرقل تطور العلم والإبداع الحر، وتلاحق المفكرين والعلماء وحتى المجتهدين منهم في مجال تطوير العقيدة الدينية. بالإضافة إلى أنها أمنت الغطاء الأيديولوجي للطبقة الإقطاعية ككل.
ومن جهة ثانية باعتبارها مؤسسة اقتصادية تملك إقطاعيات واسعة تستغل العاملين فيها أبشع استغلال، تحت غطاء ديني.
2-5- الديمقراطية والليبرالية.
الليبرالية هي الأخرى تنتمي إلى السياق الأوربي وقد ظهرت في البداية كمذهب اقتصادي يقوم من حيث الجوهر على اعتبار أن رأس المال هو أساس التمايزات الاجتماعية، وأن استقصاء الربح هو الدافع لصياغة العلاقات الاجتماعية بدلا من النبالة وملكية الأرض (20). لقد هيمنت الليبرالية كمذهب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20-هلال،علي الدين،" مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث" في أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ،ندوة،(بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1987)،ص 38.
اقتصادي طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان شعارها المعروف هو ((دعه يعمل دعه يمر)). غير أنه مع تطور الرأسمالية واتساع الاهتمام بالشؤون السياسية العامة بفضل نضالات الطبقة العاملة وغيرها من الطبقات والفئات الشعبية عمدت البرجوازية إلى نقل مفهوم الليبرالية لحرية الاختيار من المجال الاستهلاكي إلى المجال السياسي لتكتسب بذلك أبعادا ديمقراطية لا تزال تنمو في سياق عملية صيرورة تاريخية معقدة.
تقوم الديمقراطية الليبرالية من حيث المبدأ على أساس تعظيم قدرات الفرد على الاختيار بحيث يحقق من جراء ذلك أفضل المنافع وأكبرها (21). هذا من الناحية النظرية أما في الواقع العملي لم يكن متاحا دائما تحقيق هذا التزاوج بين تعظيم قدرات الفرد على الاختيار وتعظيم المنافع المترتبة على ذلك، إلا على نطاق ضيق جدا هو نطاق النخب الاقتصادية والسياسية. فحق المشاركة في الانتخابات كتعبير عن حق المشاركة السياسية كان في البداية حكرا على الطبقة العليا من المجتمع البريطاني واستمر ذلك حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر. لكن في بداية الثلث الثاني من القرن المذكور (1832) سُمح للطبقة الوسطى بالمشاركة السياسية في عمليات الانتخاب، وكان على العمال أن ينتظروا حتى نهاية القرن التاسع عشر حتى يُسمح لهم بالمشاركة، أما النساء فلم يمنح لهم حق الانتخاب إلا في عام 1928. بل وكان وضع المرأة أسوأ حيث ألزمها القانون بطاعة زوجها، وجردها من حق الملكية الذي أعطاه للزوج منذ تاريخ الزواج، ليتصرف كما يشاء بما كانت تملكه زوجته. ينطبق هذا الحال على أغلب الدول الأوربية (22). ففي فرنسا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21-C .P .Macpherson , Democratic theory ( Oxford : Calerdon press ,1973 ) PP 3-22
22- حريق،إليا " التراث العربي والديمقراطية : الذهنيات والمسالك "(بيروت ، المستقبل العربي ،العدد 1/2000 ) ص22-23 .
ظلت المرأة محرومة من الأهلية التجارية إلا بإذن زوجها حتى عام 1938، ولم تمنح حقوقها السياسية إلا في عام 1944 (23). مع نهاية القرن العشرين أصبحت الديمقراطية الليبرالية تقوم على مجموعة من المبادئ والأسس هي التالية:
- التعددية السياسية وتداول السلطة سلميا.
- دورية الانتخابات وصوت واحد لكل مواطن.
- احترام رأي الأغلبية.
- الدولة الدستورية بما يعني ذلك من وجود قانون أساسي للدولة (دستور) يتضمن فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- سيادة القانون على مختلف المستويات الإدارية والاجتماعية.
- إقرار حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
2-6- الديمقراطية والنخبة (الأكثرية والأقلية).
منذ البداية وبغض النظر عن الدعوة إلى الحرية والمساواة التي رفع رايتها فلاسفة العقد الاجتماعي فإن الديمقراطية البرجوازية ما كان بإمكانها أن تكون غير ديمقراطية نخبوية. ففي ظروف صعود الرأسمالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر وسيطرة الليبرالية بمنطقها الاقتصادي، ولاحقا عندما تدمقرطت في القرن التاسع عشر وخصوصا في القرن العشرين فإن البرجوازية المسيطرة في الحقل الاقتصادي والمهيمنة في الحقل السياسي، هي التي تصدت لمهام إدارة علاقات السيطرة وبناء نظام الحكم المطابق. وإذا كانت قد أرغمت على توسيع المشاركة الجماهيرية في العمل السياسي، وحاولت تحت ضغط الطبقة العاملة والقوى الاجتماعية الأخرى، وفي ظروف التطور العاصف في مجال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23- المرجع السابق ص 22-23 .
العلوم والتقنية وارتفاع مستوى الحياة إضفاء طابع اجتماعي على الديمقراطية فإنها في ظروف العولمة المتسارعة تواجه تحديا جديا يفرض عليها إعادة طرح سؤال الديمقراطية من جديد مشحونا بالشك حول مصيرها القادم. وحتى لا نستبق الأمور نعود لنؤكد على أن مسألة وجود النخب الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية هي مسألة موضوعية يفرضها البناء الاجتماعي نفسه، وعملية التطور اللامتكافئ لأفراد المجتمع في ظروف المجتمعات الطبقية. لذلك فإنه من طبيعة المجتمع كتكوين عضوي أن يحتل الأفراد والجماعات فيه مواقع وظيفية مختلفة يحددها منطق التطور ذاته. فهناك دائما من هو في وضعية العامل ومن هو في وضعية المدير أو القائد وغيرها، وهذه المواقع يحددها انقسام العمل وتكامله. وتوجد النخب أيضا في جميع أشكال الوجود الاجتماعي، في العشيرة أو القبيلة أو النقابة أو في الحزب السياسي وفي غيره نظرا للتراتبية الهرمية التي تحكم بناء هذه التنظيمات.
النخبة إذا حالة وجودية موضوعية لا يمكن إلغاؤها في ظل المجتمعات الطبقية. المشكلة في الحقيقة ليس في وجود النخبة وإنما في احتكار موقع النخبة من قبل جماعات بعينها تحت ذرائع ودوافع مختلفة ومتعددة. من هذه الذرائع ما هو من طبيعة اقتصادية مثل حجم الملكية أو الثروة ومنها ما يأخذ أبعادا عرقية أو دينية. وهناك من يبرر موقعه النخبوي بدوافع سياسية أو اجتماعية أو ثقافية وغيرها. وحيثما وجدت النخبة فإنها تمارس نوعا من السلطة تحاول دائما استحواذ على المزيد منها، لذلك فإن منطق التسلط هو من طبيعة النخب.
وهكذا فإن حرية الاختيار التي نادت بها الليبرالية لم تكن متاحة للجميع بسبب اختلاف الإمكانيات المادية لتحقيقها، لذلك كان لا مفر من بروز النخبة لتلعب دورها الاقتصادي والسياسي على أشلاء الدعوة للمساواة التي نادى بها أيضا فلاسفة الليبرالية.
من وجهة نظر الفكر النخبوي فإن الديمقراطية تتحدد بالشكل الذي تتخذه النخب في إطار النظام السياسي ومدى مرونة بنائها وتنافسها فيما بينها (24). تفترض نظريات النخبة أن المواطن العادي غير قادر على إبداء رأي سليم في القضايا الاجتماعية، بل وتذهب إلى مدى أبعد عندما تفترض أن ازدياد مشاركة الجماهير في العملية السياسية قد يهدد قواعد الاستقرار نظرا للاتجاهات السلطوية النامية لديها (25).
النخبوية في الليبرالية هي فلسفة الأقوياء أساسها تثبيت امتيازاتهم أو كسب امتيازات جديدة على حساب الشعب. وحسب ايلي حريق فإن الديمقراطية الليبرالية أرستقراطية بطبيعتها وفي جوهرها تناسب مبادئ الحرية فيها الأقطاب المتمتعين بقدرة على الاستقلال الفكري والاجتماعي. وما فكرة المساواة التي ترافقها في الآداب الليبرالية سوى إشارة إلى المماثلة بين الأنداد وليس بسائر أفراد الشعب (26). ضمن هذا الإطار تطور أيضا مفهوم الأكثرية والأقلية الذي يشكل هو الأخر ركنا من أركان الديمقراطية الليبرالية. منذ البداية أخذ هذا المفهوم طابعا حسابيا في إطار المجمع الانتخابي ولا يزال هو كذلك حتى الوقت الراهن. المشكلة ليست في الطابع الحسابي لمفهوم الأكثرية والأقلية وإنما هي في حدود المجمع الانتخابي وفي كيفية تحقق هذه الأغلبية التي على الأقلية احترام رأيها وتفويضها الحكم. لقد ذكرنا سابقا أن المجمع الانتخابي كان في مرحلة من مراحل الديمقراطية الليبرالية مقتصرا على الطبقة العليا من المجتمع استنادا إلى معيار الملكية، توسع لاحقا لتدخله الطبقة الوسطى ومنذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24-Robert A .Dahl , A preface to democratic theory ( Chicago III , University of Chicago press 1956) PP 63-90
25-هلال،علي الدين " مناهج الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث " مرجع سبق ذكره ص 43 ،نقلا عن سيمور ليبست.
26- حريق، إيليا "التراث العربي والديمقراطية: الذهنيات والمسالك " ( بيروت، المستقبل العربي، 1/2000) ، ص23.
أواخر القرن التاسع عشر أُفسح في المجال أمام الطبقة العاملة للمشاركة السياسية في إطار اللعبة الديمقراطية. ومنذ أواسط القرن العشرين أذيلت العوائق من أمام مشاركة النساء. في الوقت الراهن يتسع المجمع الانتخابي في الدول الديمقراطية المتقدمة ليشمل جميع أفراد الشعب.
ومن اللافت انه في جميع مراحل تطور المجمع الانتخابي كانت نسبة المشاركين في العمليات الانتخابية لا تغطي جميع أعضاء المجمع، بل في بعض المراحل وفي العديد من الدول، كانت هذه النسبة تقل كثيرا عن ذلك. بكلام آخر ثمة فرق كبير بين حدود المجمع الانتخابي كما يحددها القانون وبين حدود المجمع الانتخابي كما يرسمها المشاركون فعليا في العمليات الانتخابية. ويبدو لي انه في ظروف العولمة المتسارعة وتطور وسائل الاتصالات ووسائل صوغ الوعي العام من إعلام جماهيري مرئي أو مقروء أو مسموع فإن الخيارات الديمقراطية تضيق أكثر فأكثر خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحقل السياسي، لتتسع أكثر فأكثر في الحقل الاجتماعي والثقافي. بكلام آخر ثمة اتجاه آخذ في التبلور في البلدان الرأسمالية المتقدمة، يضيق كثيرا وبصورة مستمرة من الديمقراطية بما هي خطاب موجه نحو السلطة وإدارة علاقات السيطرة، ويوسعها كثيرا بما هي نمط حياة اجتماعية.
3 – الديمقراطية وبيئتها المفهومية في الوعي السياسي العربي.
لقد انشغل العرب بقضية الديمقراطية منذ فجر النهضة الحديثة فاستحضروها في خطابهم الثقافي والسياسي ودعوا إليها تحت مسميات عديدة مثل الشورى أو أهل الحل والعقد وغيرها. غير أن الجيل الأول من مفكري عصر النهضة لم يتعاملوا مع الديمقراطية باعتبارها تكثيفا لنمط حياة اجتماعية لها بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخاصة، بل تعاملوا معها بصورة انتقائية فأخذوا منها بعض العناصر ورفضوا بعضها الآخر. هذا ما يمكن تلمسه عند
الكواكبي والطهطاوي وخير الدين التونسي وغيرهم (27). واستمر الحال في التعامل مع الديمقراطية بصورة انتقائية خلال فترة ما بعد الحربين العالميتين وكان لا بد من الانتظار حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا بعد إنجاز الاستقلال السياسي حتى يشيع استخدام مصطلح الديمقراطية في الأدب السياسي وتحاول بعض الدول العربية إقامة نوع من أنظمة الحكم الديمقراطية التي لم تدم طويلا لأسباب عديدة منها التدخلات الاستعمارية وتفاعلات الغزو الصهيوني لفلسطين وضعف نضج البنى الاجتماعية الداخلية وخاصة عدم جاهزية النخب العربية. وقد تراجع الحديث عن الديمقراطية مع صعود القوى القومية واستلامها للسلطة في العديد من الدول العربية، واكتسبت في الخطاب الرسمي قيمة انفعالية سلبية وأحيلت إلى القوى الصهيونية والاستعمار. غير أن هزيمة حزيران في عام 1967 التي طالت جميع مقومات النظام العربي وضعتها تحت المساءلة، ليس فقط في الجانب العسكري بل وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي. وبالتوازي مع ذلك أخذ الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وضرورة المشاركة في إدارة الشؤون العامة يتسع أكثر فأكثر وبدأت تنشط في سبيل ذلك العديد من المنظمات المطالبة بالحقوق المدنية والمدافعة عن الحريات العامة في مختلف الدول العربية (28). وفي البحث عن أسباب اتساع الاهتمام العربي بالديمقراطية جرت نقاشات فكرية عربية واسعة في العديد من الندوات التي عقدت لهذا الغرض وعلى صفحات الدوريات العلمية بعضهم يحيلها على نمو الطبقة الوسطى،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27 -الدجاني، أحمد صدقي " تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث -" في (( أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية)) ، (بيروت ، المركز ،1984 ) ص 115
28-جقمان، جورج ، " الديمقراطية في نهابة القرن العشرين: نحو خارطة فكرية " في "حول الخيار الديمقراطي :دراسات نقدية " ، مجموعة من المؤلفين ،( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، 1994)
وغياب العدالة في توزيع الثروة (29)، والبعض الآخر يحيلها على فشل بسبب عدم توافر الشروط اللازمة لذلك. فحسب سمير أمين ينتمي الوطن العربي إلى أطراف النظام الرأسمالي العالمي وان الاستقطاب على الصعيد المشروع القومي العربي (30)، في حين يرى فريق ثالث استحالة قيام الديمقراطية في الوطن العرب العالمي يخلق بالضرورة استقطابا داخليا تهمش بنتيجته اغلب فئات المجتمع مما يستحيل معه ضبط المجتمع والمحافظة على الاستقرار بالأساليب الديمقراطية، لذلك القاعدة هنا هي قيام نظام حكم دكتاتوري أو في أحسن حال نظام ديمقراطي في ظل أحكام عرفية (31).
وبالفعل فرغم شيوع مفهوم الديمقراطية وغيرها من المفاهيم المصاحبة لها في الدول العربية، بقراءتها المحلية، فهي لا تزال تتحرك في حدود مستوى النخب السياسية والثقافية العربية. ما نود التوقف عنده في هذا المبحث مسألتان: مسالة حقوق الإنسان ومسألة العلمانية. بقية المفاهيم بما فيها مفهوم الديمقراطية ذاته سوف تمر معنا كثيرا في الفصول القادمة.
على مستوى الأنظمة العربية لم يجر الاهتمام بحقوق الإنسان كقضية سياسية ومدنية إلا في عام 1967 وتحديدا بعد أن وجه الأمين العام للأمم المتحدة مذكرته المشهورة المتعلقة بالموضوع (32)، مع أن الإعلان العالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29-سعد الدين، إبراهيم، "مقدمة في أزمة الديمقراطية في الوطن العربي " بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، (بيروت، المركز، 1984 ) ص12-13.
30-غليون، برهان " الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي: مشاكل الانتقال وصعوبات المشاركة " ( بيروت ،المستقبل العربي ،السنة 13، العدد 135، أيار1990) ،ص 23.
31- أمين، سمير (1991) " قضية الديمقراطية في العالم الثالث " في بعض قضايا المستقبل، (القاهرة، مكتبة مدبولي،1991) ص 49.
32-مذكرة رقم 234(15) تاريخ 15/2/1967.
لحقوق الإنسان كان قد صدر في عام 1948. وبناء على مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض مذكرة خاصة بحقوق الإنسان العربي (33) على مجلس جامعة الدول العربية في دورته الخمسين حيث اتخذ قرارا بإنشاء لجنة إقليمية عربية دائمة لحقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية (34).
ومن الطريف أن المداولات التي جرت بين مندوبي الدول العربية في الاجتماع الذي تم في أوائل تشرين الثاني/أكتوبر عام 1982 لمناقشة مشروع ميثاق حقوق الإنسان العربي تبين كم هي بعيدة المواقف الرسمية عن حقوق الإنسان العربي. لقد جاء في المواقف:
-اعتراض على تسمية الوطن العربي والأمة العربية.
-الاعتراض على أي فقرة ترد فيها عبارة حقوق ((لا يجوز المساس بها)) والإصرار على حذف هذه العبارة.
-الاعتراض على الحق بحرية الانتقال.
-الاعتراض على الحق بالعمل.
-الاعتراض على إلغاء عقوبة الإعدام.
-رفض حق اللجوء لمرتكبي الجرائم السياسية.
-الرفض المطلق لمبدأ عدم جواز الإعدام في الجرائم السياسية.
-رفض مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين بسبب جريمة واحدة أو بعد إثبات براءته.
-الإصرار على إضافة عبارة ((بما لا يتعارض مع الأحكام المقررة في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33-مذكرة رقم1510 تاريخ 5/2/1968.
34-قرار رقم 2343 تاريخ 3/9/1968.
35
الشريعة الإسلامية)) وهناك العديد من المواقف الأخرى التي لا تتفق مع شرعة حقوق الإنسان العالمية بل ولا مع العديد من الاجتهادات الدينية (35).
هذا هو الوضع العام السائد في الدول العربية، مع انه في العقد الأخير من القرن العشرين بدأت بعض الدول العربية تجري بعض التحولات الديمقراطية وتسمح بتشكيل لجان لمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان فيها من الأفراد والمنظمات والهيئات غير الرسمية، لكن ذلك لا يزال في البداية إذ أن حساسية الدول العربية تجاه هذا الموضوع لا تزال عالية.
على الصعيد الشعبي تتركز المطالب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لما لها من تأثير مباشر على حياة الجماهير الشعبية، ومن المشكوك فيه أن تكون قضايا الحريات المدنية والسياسية تحتل موقعا متقدما لديها لأسباب عديدة لا مجال لتكرار ذكرها.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بموضوع العلمانية فإن المواقف الرسمية للدول العربية منها هي الرفض، مع أن هذه الدول سواء من حيث بنائها أم من حيث طريقة الحكم فيها هي أقرب إلى الدولة العلمانية. ولا يغير من حقيقة ذلك كونها تؤكد في دساتيرها على أنها دول عربية إسلامية، الشريعة فيها مصدر رئيس للتشريع. الدولة العربية ليست دولة دينية مع أنها توظف الدين والمؤسسات الدينية الرسمية في سياساتها، لتؤمن لها الغطاء الأيديولوجي في العديد من المناسبات السياسية وغير السياسية.
أما بالنسبة إلى المواقف غير الرسمية فإن حضور العلماني في الخطاب السياسي يكاد يقتصر على الحركات السياسية الليبرالية واليسارية، في حين موقف الحركات القومية منها لا يزال تلفيقيا وغير محسوم. أما الحركات الدينية على اختلافها وتنوعها فإنها ترفض العلمانية وتعتبرها موجهة إليها قبل أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ35- مطر، جميل، في ندوة " أزمة الديمقراطية في الوطن العربي" مرجع سبق ذكره ص 562
تكون موجهة إلى الأنظمة العربية الحاكمة.
وبالنظر إلى حساسية هذا الموضوع بالنسبة إلى الجماهير العربية فقد يكون من المناسب في الحقل السياسي التركيز على مبدأ العقلانية بدلا من مبدأ العلمانية كشعار تعبوي لما لقوة خطاب العقلانية من قيمة انفعالية إيجابية هذا من جهة، ومن جهة ثانية لكون هذا المبدأ يمكن طرحه في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية وليس فقط في المجال السياسي كخطاب موجه نحو الدولة.
قد يعتبر البعض مفهوم العقلانية مفهوما إشكاليا، لما يكتنفه من غموض وملابسات. وبالفعل هو كذلك في الحقل النظري، لكن في حقل الممارسة فثمة العديد من المؤشرات التي تضبط المصطلح وتعايره في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فكما أن هناك عقلانية اقتصادية يمكن قياسها بواسطة مؤشرات الكفاءة، هناك أيضا، في الحقل السياسي والإداري، عقلانية سياسية وادارية، يمكن قياسها بواسطة مؤشرات الأداء التي تعبر عن حجم المشاركة في رسم السياسات المختلفة، وكيفية اتخاذ القرارات، ودور المؤسسات وفعاليتها، ومدى سيادة القانون واحترام الناس له، ومدى انتشار الفساد والبيروقراطية وغيرها.
#منذر_خدام (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثان
...
-
رهانات الاسد والسقوط الكبير
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
-
العرب والعولمة( الفصل السادس)
-
العرب والعولمة( الفصل الخامس)
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
-
العرب والعولمة(الفصل الثاني)
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
-
العرب والعولمة( مدخل)
-
العرب والعولمة(مقدمة)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الحادي عشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الهاشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل التاسع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثامن)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل ااسابع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل السادس)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الخامس)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الرابع)
-
في المنهج= دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الرابع)
المزيد.....
-
أقدم غوريلا في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ68 عامًا.. شاهد
...
-
السعودية تكشف 5 إجراءات قبل موسم الحج 2025 حفاظا على سلامة ا
...
-
ترامب يتجاهل مصافحة زوجة وزير الصحة.. مشهد محرج خلال حدث ريا
...
-
-تنذكر ما تنعاد-، صور من حرب لبنان الأهلية في الذكرى الـ50 ل
...
-
قوة تدميرية غير مسبوقة.. واشنطن في طريقها لتطوير قنبلة ذرية
...
-
الجزائر تعرب عن -احتجاجها الشديد- على حبس أحد موظفيها القنصل
...
-
حماس: قصف الاحتلال مستشفى المعمداني جريمة حرب بغطاء أميركي
-
الجزائر تحتج على توقيف فرنسا أحد موظفي قنصليتها
-
طهران تعلن عن جولة جديدة وترامب يشيد بالمحادثات معها
-
عاجل | مصادر طبية: 7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف سيار
...
المزيد.....
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
/ منذر خدام
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
/ منذر خدام
-
ازمة البحث العلمي بين الثقافة و البيئة
/ مضر خليل عمر
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
/ منذر خدام
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
قواعد اللغة الإنكليزية للأولمبياد مصمم للطلاب السوريين
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
أنغام الربيع Spring Melodies
/ محمد عبد الكريم يوسف
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة