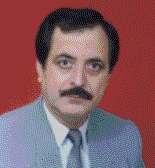|
|
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول)
منذر خدام


الحوار المتمدن-العدد: 8296 - 2025 / 3 / 29 - 08:17
المحور:
قضايا ثقافية
الفصل الأول
الديمقراطية
والأوالية العامة للحراك الاجتماعي
1-مفهوم " الأوالية العامة للحراك للاجتماعي ".
نقصد بالأوالية العامة للحراك الاجتماعي مجموع القوى والعوامل والشروط والظروف السائدة في مجتمع معين، وكيفية ترابطها في البنية الاجتماعية، وطريقة اشتغالها بحيث يتحقق في النهاية حراك اجتماعي عام.
ونقصد بالحراك الاجتماعي العام التقدم الاجتماعي الذي يتحقق نتيجة اشتغال القوانين العامة للحراك الاجتماعي، ويمكن تحقيبه في عصور تاريخية كبيرة نسبياً.
إن البحث في مجال الحراك الاجتماعي العام كان ولا يزال موضوع خلاف بين مختلف التيارات الفلسفية والنظريات الاجتماعية، غير أن المعالجة المادية التاريخية له ربما تكون الأكثر علمية وشمولا. وبالفعل مع ظهور النظرة المادية الجدلية في التاريخ أصبح بالإمكان التحدث عن " نظرية عامة في التقدم الاجتماعي " تتضمن منهجا علميا صارما في دراسة التقدم الاجتماعي وتحقيقه الواعي. يتضمن هذا المنهج جملة من المفاهيم التي لا غنى عنها سواء في دراسة الحراك الاجتماعي العام وتحقيبه أو دراسة الحراك الاجتماعي الخاص لشعب من الشعوب.
سوف نركز اهتمامنا في هذا المبحث على القوانين العامة للحراك الاجتماعي، والبحث في كيفية اشتغالها وتمظهرها في الظروف التاريخية المختلفة، وتحديد دورها في تمرحل التاريخ، والبرهنة على أن الديمقراطية هي المسرع الأكبر للتقدم الاجتماعي. لهذا الغرض وزعنا المادة البحثية على أربع مجالات هي، في الحقيقة، مجالات اشتغال القوانين العامة للحراك الاجتماعي
2-مجال التبادل العضوي بين الإنسان والطبيعة.
يتفاعل الإنسان مع الوسط الصناعي الذي يعيش فيه بصورة مستمرة، بغرض إشباع حاجاته المتزايدة باستمرار. في إطار هذه العلاقة التفاعلية كان الوسط الصناعي محدودا جدا في البداية. وفي لحظة من التاريخ كان وسطا طبيعيا خالصا. عندئذ لم يكن البشر قد تجاوزوا الشكل القطيعي لوجودهم، حيث كانت تسيطر الغرائز المقلدة السافرة.
في إطار العلاقة الوجودية العامة بين الكائن الإنسان والطبيعة كان الإنسان يواجه الطبيعة بصفته مركب حاجات تبحث عن الإشباع، ويملك قوة عمل لتحويل الطبيعة إلى خيرات مادية يشبع بها حاجاته.
الطبيعة بدورها تواجه الإنسان باعتبارها مصدرا للخيرات المادية يسعى الإنسان في سياق تفاعله معها إلى اكتشافه، وتحويل الخيرات المادية الكامنة فيه إلى موارد. وبحدود ما يكتشف
الإنسان من موارد الطبيعة، تتحول الطبيعة إلى وسط صناعي. الوسط الصناعي إذا، هو جزء من الوسط الطبيعي، يتوسع باستمرار على حسابه مع كل تقدم في معارف الإنسان عنه، وامتلاكه فنيا لإشباع حاجاته.
من الناحية العملية يتحقق ذلك على النحو الاتي: في مواجهة الوسط الصناعي تقف الحاجات الإنسانية باحثة عن إمكانية إشباعها. الوسط الصناعي بدوره يعرض دائما إمكانيتين لإشباع الحاجات البشرية: إمكانية فعلية تعبر عن المستوى الفعلي لإشباع الحاجات الإنسانية في مرحلة تاريخية محددة.
وإمكانية لكامنة (متاحة) فإنها تعبر عن المستوى الأعلى الممكن لإشباع الحاجات، الذي يمكن الوصول إليه، في حال توفرت ظروف اجتماعية معينة.
الوسط الصناعي يتيح دائما إمكانية أ كبر لإشباع الحاجات بالمقارنة مع مستوى إشباعها الفعلي الذي تحد منه عادة التمايزات الاجتماعية، غياب العقلانية الاقتصادية، طغيان النزعة الاستهلاكية التبزيرية لدى فئات معينة من السكان، ضعف التنظيم الاجتماعي العام، وخصوصا تكلس المستوى السياسي.
وعلى افتراض استطاع الإنسان الاستفادة من الموارد التي يتيحها الوسط الصناعي بالكامل، تبقى مع ذلك فجوة بين الموارد والحاجات، يعمد الإنسان إلى تجسيرها من خلال تحويل جزء من الإمكانية الكامنة في الوسط الطبيعي(المصدر) إلى إمكانية متاحة في الوسط الصناعي(مورد) ليستخدمها، من ثم، في إشباع حاجاته المحددة تاريخيا. فالقصور النسبي في الموارد قياسا إلى حاجات الإنسان المحددة تاريخيا في إطار تنظيم اجتماعي معين ومستوى ثقافي محدد هو الذي يدفع الإنسان بصورة دائمة إلى التفاعل مع الطبيعة وتحويلها.
أوالية تحقيق ذلك تأخذ المسار الاتي: يحول الإنسان بفعاليته الإمكانية الكامنة في الوسط الطبيعي ( المصدر ) إلى وعي هذه الإمكانية (إمكانية ذهنية ) ، ليحولها في خطوة لاحقة إلى قوى إنتاج جديدة وأساليب إنتاج مناسبة، تعود بدورها لتمارس تأثيرها على الوسط الصناعي فتصوغه كيفيات جديدة ( خيرات مادية ) تلائم إشباع الحاجات .وما إن تنغلق هذه الدائرة حتى تقفز الحاجات إلى مستوى جديد تتطلب بدورها وضعية جديدة للوسط الصناعي، وهكذا تبدأ دورة جديدة في سلسلة لانهاية لها. ومن الواضح أن الحاجات تشمل الحاجات المادية والروحية في إطار المستوى الثقافي الذي وصل إليه المجتمع وبنيته الداخلية. يمكن تمثيل ما قيل أعلاه بالمخطط التوضيحي الاتي:
حاجات قوى إنتاج حاجات جديدة
عمل(أفكار) علاقات إنتاج موارد
وسط صناعي شروط إنتاج وسط صناعي جديد
في المخطط السابق نجد أن الحلقة الحية فيه، ومصدر الحركة، هي حلقة العمل أي حقل النشاط الإنساني، لذلك عندما تتسارع الحركة في الدورة أو تتباطأ، السبب في ذلك يعود إلى كيفية تحقق النشاط الإنساني وقابليات مكوناته الداخلية على التغيير.
من جهته النشاط الإنساني ليس متجانسا في تكوينه، بل بنية معقدة جدا من الفعاليات ذات الميول والاتجاهات المختلفة، انه نشاط اجتماعي تاريخي تقوم به قوى اجتماعية تنتمي إلى مختلف أشكال الوجود الاجتماعي. تترابط هذه الفعاليات داخليا بشبكة من العلاقات المعبرة عن مصالح الناس أفرادا أو جماعات، تحدد إلى درجة كبيرة الكيفية التي يحققون بها هذه المصالح.
عندما يقوم الإنسان بنشاط معين فانه يحمل في ذهنه دائما أفكارا محددة عن خصائص الموضوع الذي يمارس عليه نشاطه، وعن كيفية ممارسة هذا النشاط وفي أية ظروف وشروط يجري. وفي نهاية عملية النشاط هذه (التفاعل مع الموضوع) قد تتولد أفكار جديدة مختلفة إلى هذه الدرجة أو تلك عن الأفكار التي بدأ بها عملية النشاط (يزداد وعيه بنشاطه أو بخصائص موضوع النشاط) لتشكل منطلق دورة النشاط التالية. وفي كل دورة نشاط جديدة قد تنزاح بعض الأفكار السابقة، وقد تستمر أخرى بحسب استجابتها لشروط التفاعل الجديد سواء من ناحية دوافعه (الحاجات)، أو من ناحية خصائص الموضوع، أو من ناحية أدوات ووسائل التفاعل. فالحاجات الاجتماعية باعتبارها الدافع إلى التفاعل (النشاط)، والأفكار التي يحملها الفاعل (الوعي)، وأدوات وشروط التفاعل تمثل جميعها حصيلة تاريخية للوسط الصناعي، الذي يكثف بدوره مستوى تطور المجتمع ثقافيا واقتصاديا وسياسيا. فبقدر ما يسمح التنظيم الاجتماعي، للحاجات بالتعبير عن نفسها بحرية، والبحث عن إشباعها، تكون خصبة الأفكار التجاوزية لوضعيتها القائمة، وبالتالي يتسارع تطور المجتمع (1). وبالعكس عندما لا يسمح التنظيم الاجتماعي للحاجات بالتعبير عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -عندما يطور الإنسان قوى الإنتاج في سياق تفاعله مع الطبيعة يتطور هو أيضا، لذلك فهو في نهاية كل دورة تفاعل يختلف عن تلك التي كان عليها في بدايتها، سواء من ناحية حريته أو حاجاته أو إمكاناته.
نفسها بحرية، يضعف فيه الإبداع الفكري التجاوزي، ويتباطأ الحراك الاجتماعي العام.
الوسط الصناعي بدوره يشمل جميع أشكال الوجود الاجتماعي بما فيها من روابط وعلاقات ووعي اجتماعي، بالإضافة إلى تلك المكونات من الوسط الطبيعي التي امتلكها الإنسان معرفيا و تتوفر لديه الوسائل الفنية والاقتصادية للانتفاع بها بما يخدم مصالحه. بهذا المعنى فان الوسط الصناعي يقترب كثيرا من مفهوم الوجود الاجتماعي، غير انه يظل أوسع منه نظرا لأنه يشمل الظواهر والأشياء المادية ذاتها التي تحيط بالإنسان وتؤثر على طريقة تفاعله مع وسطه الطبيعي أو الصناعي.
يتفاعل الإنسان عادة مع وسطه الطبيعي من أجل تطوير المجتمع ونقله من وضعية إلى أخرى أرقى من سابقتها، انه تفاعل تطوري تراكمي. في سياق هذا التفاعل يستند الإنسان إلى وسطه الصناعي الذي أصبح يمتلكه معرفيا وتنظيميا.
لكن الإنسان يتفاعل أيضا مع وسطه الصناعي، غير إن هذا التفاعل يغلب عليه الطابع السكوني، فهو تفاعل تكراري، غير تطوري، لا ينجم عنه أي تراكم.
إن عملية تفاعل الإنسان مع وسطه الطبيعي وتحويله إلى وسط صناعي هي عملية متكررة باستمرار، فالإنسان لا يستطيع التوقف عن التبادل العضوي مع وسطه، وان حصيلة هذا التفاعل تتجسد دائما في خلق وتطير قوى الإنتاج. وكأي عملية متكررة موضوعيا يحكمها قانون معين نطلق عليه قانون التبادل العضوي مع الطبيعة أو قانون تطوير قوى الإنتاج (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-يعتبر أوسكار لانكه إن قوانين الحراك الاجتماعي العام التي تعرف في الأدب الماركسي بالقوانين الأساسية للتطور الاجتماعي، هي اثنين فقط في حين هي أربعة كما سوف نرى./ انظر أوسكار لانكه " الاقتصاد السياسي ، القضايا العامة " الطبعة الرابعة (بيروت، دار الطليعة) ص 40.
غير أن القانون الاجتماعي (مطلق قانون) هو تجريد نظري للجوهري والمتكرر في الظواهر الاجتماعية، أما الشكل الذي يظهر به فانه يختلف من مجتمع إلى أخر باختلاف الشروط التاريخية، واختلاف البنية الداخلية للنشاط الاجتماعي، ودرجة وعي الناس بمصالحهم وبالكيفية التي يحققونها بها. فمصالح الناس (أفرادا وجماعات) مشروطة دائما بدرجة وعيهم بها، فليس من مصلحة مميزة خارج نطاق الوعي، وبالتالي يتنوع الوعي بالمصالح فتتنوع المصالح المميزة ذاتها.
قد يكتشف العلم مصالح أخرى سواء للأفراد أو الجماعات تكون متفقة أكثر مع متطلبات التقدم الاجتماعي، ويقدمها في صيغة مشاريع أيديولوجية، لكنها تبقى مع ذلك مصالح بالقوة (مصالح ممكنة نظريا)، قيمتها الحقيقية هي في وعي الناس المعنيين بها.
إن اكتشاف هذه المصالح هو نوع من تجاوز الواقع فكريا، يمهد بدوره لتجاوزه فعليا. هنا أيضا تتقابل المصالح بالقوة مع المصالح بالفعل في تفاعل جدلي يستدعي دائما الكشف عن وضعيته المشخصة في كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي. لهذا الغرض لا بد من معرفة الكيفية التي يعمل بها القانون الثاني للحراك الاجتماعي العام وتحديد مجاله (3).
3- مجال العلاقات الإنتاجية الاجتماعية.
في سياق التبادل العضوي بين الإنسان والطبيعة ينتج سيل من الأفكار، يتحول بعضها إلى قوى إنتاج جديدة شروط إنتاج وأشكال للوجود الاجتماعي، في حين يظل بعضها الأخر في الدائرة الفكرية، على شكل تصورات وأراء وغيرها. ومن طبيعة الأفكار أن يختلف اتجاه حركتها وزمن استغراقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3-القول بأن المصالح المختلفة تفترض موضوعيا تنوعا في الوعي المطابق، هو القول الشائع في الأدب الاجتماعي، مع أن وجود المصلحة المميزة يتوقف على الوعي بها. فحسب الأوالية العامة للحراك الاجتماعي تسبق الصورة الذهنية (الفكرة ) للوجود الاجتماعي لحظة الوجود الاجتماعي المميز، ويبدو ذلك واضحاً على الأقل منذ أن تحول الكائن البشري إلى إنسان.
تولد الفكرة عادة فردية في ذهن ما، تتحول لاحقا إلى فكرة جماعية أو اجتماعية بمجرد أن تخلق ما يطابقها من علاقة (علاقات) في الوجود الاجتماعي وتستمر فاعلة فيه طالما استمر وجود العلاقة الاجتماعية المطابقة لها. وقد يحصل أن تستمر الأفكار زمنا طويلا في ساحة الفكر (ساحة الوعي الاجتماعي)، مع أن منطق التاريخ يكون قد تجاوزها، وقد تترك ساحة الوعي إلى ساحة اللاوعي تنتظر فرصة استدعائها منه إلى ساحة الوعي، وقد تنحجر فيه بالمعنى التاريخي.
باختصار فان بعض الأفكار يموت سريعا، وبعضها الأخر يظل حيا زمنا طويلا في وعي الناس يوجه سلوكهم اليومي باتجاه التقدم والتجاوز، أو باتجاه التراجع والنكوص، وقسم ثالث ينحجز في اللاوعي دون أن يموت. لكن بغض النظر عن مدة حياة الأفكار فإنها تسعى دائما إلى خلق مكافئ لها في الوجود الاجتماعي.
إن حراك الأفكار يختلف حسب المجال الذي تفعل فيه. فالأفكار الفاعلة في مجال تطوير قوى الإنتاج هي الأكثر حراكا وقابلية للتغير بالمقارنة مع الأفكار الأخرى، وينطبق ذلك أيضا على العلاقات المكافئة لها في الوجود الاجتماعي. لذلك فان هذه الأفكار والعلاقات التي تعبر عنها هي الأكثر أهمية من منظار التقدم الاجتماعي. ففي دائرة العلاقات الإنتاجية تبدأ موجة التغيرات في بنية العلاقات الاجتماعية (الوجود الاجتماعي) ككل. هنا بالضبط يكمن محرك التغيرات في كامل البناء الاجتماعي، وفي هذه الدائرة تتحدد أيضا الكيفية التي يعاد بها إنتاج الكائن البشري، وانتاج وسائل عيشه، ويتقرر مصير البناء الاجتماعي ككل في نهاية المطاف.
الإنسان لا ينتج ذاته ككائن حي أولا وككائن اجتماعي ثانيا بصورة منعزلة، بل في إطار من العلاقات والميول والاستعدادات والمفاهيم الاجتماعية التي تكونت وتراكمت تاريخيا عبر الزمن. من الخطأ عزل الدائرة التي تنتج فيها وسائل عيش الإنسان عن الدوائر الأخرى التي تتكونن فيها إنسانيته. فالإنسان لا ينتج ويستهلك إلا بصفته كائنا اجتماعيا. انه لتبسيط كبير الاعتقاد بان التقدم الاجتماعي يتسارع بمجرد تغيير علاقات الإنتاج المعبر عنها في أشكال الملكية دون أن تؤخذ بعين الاعتبار شبكة العلاقات الاجتماعية الأخرى وانعكاسها في وعي الناس.
إن البحث عن الوضعية المثلى للعلاقات بين دائرة العلاقات الإنتاجية الاجتماعية والدوائر الأخرى للعلاقات الاجتماعية يسمح بتحقيق أفضل الظروف للتقدم الاجتماعي. غير إن ذلك لا يتحقق في الواقع إلا من خلال مساومات وتسويات مختلفة، تقترب أو تبتعد إلى هذه الدرجة أو تلك عن وضعية التناسب الأمثل الممكن تاريخيا بين مختلف دوائر العلاقات الاجتماعية. ومما يجعل الاقتراب من هذه الوضعية المثلى ممكنا، معرفة اوالية الحراك الخاص بكل دائرة من دوائر العلاقات الاجتماعية.
من المعروف أن العلاقات الاجتماعية في الدوائر التي يحقق فيها الإنسان إنسانيته (دوائر الحياة الاجتماعية)، تميل إلى المحافظة، أي أنها أقل قابلية للتغير من تغير العلاقات الاجتماعية في الدائرة الإنتاجية حيث تنتج وسائل عيش الإنسان ككائن بشري وينتج هو ذاته. السبب في ذلك يعود إلى حضور الماضي فيها بصورة مكثفة على شكل تكوين نفسي وأيديولوجيا وثقافة عامة وغيرها، وهي جميعها تتميز بحراك بطيء جدا.
وفي داخل كل دائرة من دوائر الوجود الاجتماعي توجد اختلافات كبيرة أحيانا بين حراك مكوناتها الداخلية. فعلى سبيل المثال تتغير أفكار وعلاقات الدائرة الإنتاجية (إنتاج وسائل العيش) بسرعة أكبر من سرعة تغير أفكار وعلاقات الدائرة الاستهلاكية. وفي داخل الدائرة الإنتاجية تتغير الأفكار والعلاقات المرتبطة بوجود الإنسان بسرعة أقل من سرعة تغير الأفكار والعلاقات المرتبطة بإنتاج وسائل عيشه.
وبالفعل تتميز الأفكار والعلاقات في دائرة الأسرة حيث ينتج الكائن البشري بالثبات النسبي على الأقل خلال فترة طويلة من الزمن، وذلك بسبب كون الأسرة تخضع للتقاليد والموروثات الثقافية وغيرها. وفي داخل دائرة إنتاج وسائل عيش الإنسان تتغير الأفكار والعلاقات السائدة في دائرة التوزيع والتبادل ببطيء بالمقارنة مع سرعة تغير الأفكار والعلاقات الفنية والتوازنية، فهذه الأخيرة تتميز بقابليتها للتغير السريع بسبب صلتها المباشرة بالأثر المترتب عن اشتغال القانون الأول للحراك الاجتماعي، أي التطوير المتواصل والمستمر لقوى الإنتاج، وبشكل خاص لوسائل الإنتاج. فعندما يتم ابتكار وسيلة إنتاج جديدة فإنها تضمر في ذاتها وضعية معينة للعلاقات الفنية والتوازنية، سرعان ما تتحقق بمجرد دخولها مجال الاستهلاك الإنتاجي. يترتب على ذلك تغير التركيب العضوي لرأس المال، وبالتالي البنية الداخلية للمؤسسات والشركات والفروع الاقتصادية، وكذلك تغير العلاقات المتبادلة بينها، مما يمهد لسلسلة من التغيرات في كامل البناء الاجتماعي.
إن تغير العلاقات الفنية والتوازنية كنتيجة لتطور وسائل الإنتاج، يلعب الدور الحاسم في تمايز البنية الاجتماعية إلى أزمان تطورية، في حين تبقى العلاقات الإنتاجية الاقتصادية (العلاقات في دائرتي التوزيع والتبادل)، محافظة على شكلها لفترة طويلة نسبيا قد تتجاوز العديد من الازمان التطورية. فعلى سبيل المثال تحافظ الملكية على طابعها وأشكالها لفترة طويلة بسبب ارتباطها المباشر بمصالح الطبقات والفئات الاجتماعية، وتختلف أوالية تغيرها من نظام اجتماعي إلى أخر. ففي الرأسمالية الكلاسيكية تتغير العلاقات الإنتاجية الاقتصادية بسرعة أكبر من تغير مثيلتها في التشكيلات ما قبل الرأسمالية، أوفي الرأسمالية الطرفية، وذلك بسبب تمايز الحقول الصراعية وسيطرة الحقل الاقتصادي.
لقد عرفت الرأسمالية عدة أشكال للملكية، بدءا من الملكية الفردية الصغيرة إلى أكثر أشكال الملكية تجريدا وتمركزا مثل ملكية حقوق الملكية. كما إن نطاق الملكية المباشرة يضيق باستمرار لصالح توسع نطاق حقوق الملكية، وهذه الظاهرة الجديدة في الرأسمالية المعاصرة سوف تغير من دور الملكية في الصراعات الاجتماعية.
إن استقصاء الربح في الرأسمالية الكلاسيكية جعل البرجوازية تسير في اتجاهين: في الاتجاه الأول سعت إلى زيادة إنتاجية العمل، وفي الاتجاه الثاني عمدت إلى تعميق التبادل اللامتكافئ بينها وبين الرأسمالية الطرفية.
في الاتجاه الأول طورت البرجوازية وسائل الإنتاج والعلوم والفنون الإنتاجية وتطبيقاتها المباشرة في مجال الإنتاج. فالثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة تغير العلاقات الإنتاجية والعلاقات الاجتماعية ككل بوتائر سريعة جدا.
في الاتجاه الثاني سعت البرجوازية سواء في المراكز الرأسمالية المتقدمة أو في الأطراف إلى تحويل البلدان المتخلفة إلى بلدان تابعة تقوم بوظيفة حيوية خدمة للمنظومة الرأسمالية ككل. من جهة تشكل هذه البلدان مصدراً لجزء من القيمة المنتجة الجديدة التي تتراكم في المراكز الرأسمالية. ومن جهة ثانية تحولت هذه البلدان إلى هامش مرونة يمتص الأزمات التي تحصل في المنظومة الرأسمالية أو تخفف من حدتها من خلال نقلها إليها.
إذا تفحصنا عن قرب مسعى البرجوازية إلى استقصاء الربح في ظروف الرأسمالية التقليدية سوف يبدو انه يتعارض مع مصالح العمال والفئات الاجتماعية الأخرى. أما إذا نظر إليه في السياق الاستراتيجي العام للحراك الاجتماعي فسوف يبدو أقل تعارضا، لأن البرجوازية في الوقت الذي تستقصي فيه الربح تقوم بفعل تغييري كبير على مستوى البناء الاجتماعي ككل ، كان من نتيجته ارتقاء وتحسن وضع العمال، وبقية فئات المجتمع.
بدوره لعب نضال العمال والفئات الاجتماعية الأخرى في سبيل تحقيق مصالحهم موضوعيا، نوع من التكامل الوظيفي مع نشاط البرجوازية، ازدادت بنتيجته إنتاجية العمل وتطورت العلوم والتكنولوجيا، وتطور وعي الناس، وتحسن البناء الاجتماعي، وفي النهاية ارتقى المجتمع ككل إلى وضعية حضارية جديدة.
غير أنه في ظروف الرأسمالية العالمية ونتيجة لعمليات العولمة الجارية، والظروف المستجدة المحيطة باشتغال القوانين العامة للرأسمالية، بدأت تظهر سمات جديدة مختلفة عن تلك التي تميزت بها الرأسمالية التقليدية، وهذا ما سوف نتبينه عندما نبحث في سؤال الديمقراطية والعولمة.
في ضوء ما سبق ذكره يمكن الاستنتاج بأن أوالية تغير التناقضات الطبقية في ظروف الرأسمالية التقليدية، والحد من دور الأثر الاقتصادي الناجم عن ملكية عوامل الإنتاج أو حقوق الملكية فيها يتوقف على تغير العلاقات الفنية والتوازنية." لا تستطيع البرجوازية التوقف عن تطوير قوى الإنتاج " حسب ماركس، ولا تستطيع بالتالي التوقف عن تغيير العلاقات الفنية والتوازنية، وبذلك تكمن قابلية الرأسمالية الكبيرة على التطور والتكيف والتجديد الذاتي.
لا شك بان الأوالية العامة لتحقيق ذلك معقدة جدا، ولا يتوحد اتجاه فعل جميع القوى الاجتماعية الفاعلة في التقدم الاجتماعي إلا في النهاية وكمحصلة عامة، في مناخ اجتماعي ديمقراطي، بعد مساومات وتعرجات عديدة يكون ثمنها الطبقي، أو الاجتماعي، أو الإنساني باهظاً جدا أحياناً.
في رأسمالية الدولة الوطنية (البلدان الاشتراكية السابقة) تبدو أوالية التغيير مختلفة بعض الشيء، مع أنها تجري بصورة مستمرة هنا أيضا، وتلاحظ فيها السمات العامة السابقة. غير أنها على خلاف الرأسمالية التقليدية (الكلاسيكية)، لا تتغير هنا العلاقات الفنية والتوازنية تحت ضغط الاعتبارات الاقتصادية المتمثلة في استقصاء الربح، لأن الأثر الاقتصادي المحفز على التغيير يتقرر خارج الإطار الإنتاجي المباشر من قبل الأجهزة البيروقراطية. فاستبعاد المصالح المباشرة للعاملين وإلغاء الملكية الخاصة قبل أن تستنفد إمكانياتها التاريخية ،وبالتالي إلغاء دورها التحفيزي على الإنتاج ،أعاقت جميعها عملية تغيير العلاقات الفنية والتوازنية، خصوصا بعد أن عجزت الأيديولوجيا عن لعب هذا الدور لفترة طويلة .أضف إلى ذلك لم يكن تدخل الأجهزة البيروقراطية الإدارية والحزبية متوافقا دائما مع ضرورات التغيير والتقدم الاجتماعي .لقد تبين بالتجربة أن ثمة فارقا كبيرا بين ما تراه الأجهزة التخطيطية والسياسية من عوامل التغيير وبين ما هو ضروري أو ممكن أو فاعل حقيقة في التقدم الاجتماعي . بالطبع ليس الخطأ في التخطيط باعتباره قيادة واعية للتقدم الاجتماعي، بل في الآليات التخطيطية المستخدمة وفي اختلاف مصالح العاملين ومصالح الأجهزة البيروقراطية وتعارضها، وفي غياب المناخ الديمقراطي الذي يجعل من المساومات التاريخية ممكنة.
لقد كانت مصالح الأجهزة البيروقراطي السياسية والإدارية تميل إلى التفارق مع مصالح المنتجين المباشرين بسبب طبيعة العمل البيروقراطي في رأسمالية الدولة الوطنية، واستحواذه على القسم الأكبر من فائض القيمة بطرق وأساليب سياسية واستخدامه في الاستهلاك أو في بناء وتطوير مشاريع الأبهة، خصوصا تلك المشاريع المتعلقة مباشرة بقوة الدولة وهيبتها.
لقد تجاهلت رأسمالية الدولة الوطنية دور السوق كمعيار ومقيم نهائي للعمل ونتائجه، وأعاقت اشتغال القوانين الاقتصادية بصورة إرادية، مما أضعف المحفزات الاقتصادية على الإنتاج، لتحل محلها الأساليب الأيديولوجية والسياسية، وهذه الأساليب لا تكون فعالة عادة إلا في الفترات الاستثنائية، عندما يمر المجتمع في ظروف انعطافيه، أما في الظروف العادية فتكون مضللة ومعيقة للتطور إلى حد كبير.
إن هيمنة الأيديولوجيا على الحياة الاجتماعية في البلدان ((الاشتراكية)) السابقة، وغياب الديمقراطية، كان من نتيجتها حصول لا مبالاة شعبية واسعة واغتراب حقيقي للناس عن الإنتاج، وعزلة كبيرة للأحزاب الحاكمة وأجهزتها البيروقراطية عن المجتمع وهمومه.. الخ.
قد تحفز الأيديولوجيا الناس على العمل والتضحية في الظروف الاستثنائية (كوارث طبيعية، حروب أهلية أو وطنية وغيرها)، لكنها سرعان ما تفقد هذا الدور في الحياة العادية في غياب الحرية، وإذا لم تقترن بمحفزات اقتصادية مباشرة وملائمة.
لقد عانى العمال والمنتجون عموما في رأسمالية الدولة الوطنية اغترابا حقيقيا عن وسائل الإنتاج، وذلك وبسبب الافتقار إلى الحرية، وإلى المناخ الديمقراطي الذي يسمح للمصالح المختلفة أن تتقابل وتدخل في صراع وتسويات هذا من جهة، وبسب تغييب الدور التحفيزي الهام للأثر الاقتصادي والاجتماعي للعمل الذي يتوقف عليه مباشرة التقدم الاجتماعي.
باختصار توجد في دائرة العلاقات الإنتاجية الاجتماعية، في ظل رأسمالية الدولة الوطنية، عوامل محافظة تعيق التغيير، ليس لها مثيل في الرأسمالية الكلاسيكية، مثل الحضور الكثيف للعوامل السياسية والأيديولوجية في صورة بيروقراطية حزبية وإدارية. وكما أصبح واضحا فان إعاقة تغير العلاقات الفنية والتوازنية يعيق التغير في كامل البناء الاجتماعي. فمحرك التغيرات في البناء الاجتماعي ككل يكمن في مجال اشتغال القانون الأول للحراك الاجتماعي، وتحديدا في مجال تطوير قوى الإنتاج والعلاقات الفنية والتوازنية. هنا بالضبط يتقرر مصير التقدم الاجتماعي.
في الرأسمالية الكلاسيكية كانت أشكال الملكية تتغير باستمرار مع تطور الرأسمالية، ويتحول موضوعها من ملكية عوامل الإنتاج إلى ملكية حقوق الملكية، وتأخذ طابعا مجردا أكثر فأكثر، وتزداد تركيزا من جراء اشتغال القوانين الاقتصادية، مثل قانون استقصاء الربح، وقانون المنافسة، وقانون تركيز وتمركز رأس المال.. الخ.
في رأسمالية الدولة الوطنية ساد شكلان للملكية هما: الملكية التعاونية والملكية الحكومية وكلاهما متشابهان من حيث الجوهر ويتميزان بقابلية ضعيفة للتغير نظرا لإعاقة اشتغال القوانين الاقتصادية الموضوعية، والحضور الفاعل للعوامل السياسية والأيديولوجية فيها. وإذا كان بالإمكان تحفيز الناس للعمل بواسطة الأيديولوجيا في ظروف خاصة، فليس ذلك قاعدة عامة. الناس يعملون باستمرار ويتسابقون في الاجتهاد فيه، في مناخ الحرية و عندما يرتبط نشاطهم الإنتاجي بالأثر الاقتصادي المترتب عليه، وهذا يتطلب بدوره اشتغال القوانين الاقتصادية الموضوعية بصورة طبيعية.
عندما ترتبط فعالية الناس ونشاطهم الاقتصادي بالأثر الاقتصادي الناجم عنها مباشرة، تكون قد ارتبطت عمليا جميع المجالات الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وتبادل، فالأثر الاقتصادي الذي يتحقق في دائرة الإنتاج ينتهي دائماً في دائرة التبادل.
في رأسمالية الدولة الوطنية لا ترتبط دائرة الإنتاج بدائرة التبادل مباشرة، بل عبر توسط الأجهزة البيروقراطية الإدارية والسياسية التي تتولى التخطيط الشامل، علما أن التخطيط للإنتاج والتوزيع أسهل بكثير من التخطيط للتبادل. في دائرة الإنتاج والتوزيع يبدو التخطيط كعملية فنية بحتة، في حين تبرز في دائرة التداول العوامل الاجتماعية والثقافية إلى جانب العوامل الاقتصادية لتلعب دورها الحاسم.
من الناحية النظرية يستطيع التخطيط إيجاد أفضل التناسبيات بين الحاجات الاجتماعية المحددة تاريخيا وبين الطاقات الإنتاجية المتاحة. لكن الأجهزة التخطيطية في رأسمالية الدولة الوطنية، كانت عاجزة في حالات كثيرة عن إيجاد التناسبيات الضرورية بين دائرة الإنتاج ودائرة التبادل، فتطورت فروع على حساب فروع أخرى، وبالأخص تطورت الفروع التي لها علاقة بقوة الدولة وهيبتها، على حساب الفروع المنتجة لوسائل الاستهلاك الشعبي، وتحقق كل ذلك بالوسائل السياسية في الأغلب الأعم.
في الرأسمالية الكلاسيكية ترتبط دائرة الإنتاج بدائرة التداول عن طريق السوق. هنا تتواجه المصالح بدون أية توسطات أيديولوجية، وتتحقق بالوسائل الاقتصادية.
أما في رأسمالية الدولة الوطنية، فإن المصالح تتحدد مسبقا، من قبل الأجهزة التخطيطية الإدارية والسياسية، فهي التي تسهر على (التوازن) في المصالح وتحدد الكيفية التي تتحقق بها.
في الرأسمالية الكلاسيكية تتحدد اتجاهات حركة رأس المال ومسالكه من خلال الكشف عن الطلب الاستهلاكي وبنيته واتجاه تغيره، أما في رأسمالية الدولة الوطنية فان حركة رأس المال ومستوى الطلب الاستهلاكي وبنيته الداخلية تحددها الأجهزة التخطيطية في ضوء الأهداف السياسية والأيديولوجية، وبتكاليف باهظة عادة.
4-مجال العلاقات بين البناء التحتي والبناء الفوقي.
حسب الترسيمة الماركسية المدرسية فان تغير قوى الإنتاج، يؤدي إلى تغير علاقات الإنتاج، وعندما تتغير علاقات الإنتاج يبدأ البناء الفوقي بالتغير. هذه الترسيمة التي اكتسبت قوة البديهة لكثرة تكرارها في الأدبيات الماركسية المختلفة ليست ترسيمة عامة إلا في التجريد النظري. وهي نموذجية في الرأسمالية الكلاسيكية فقط، وقد تصلح في حدود معينة للتشكيلات الطبقية ما قبل الرأسمالية. في هذه التشكيلات التغير في الحقل الاقتصادي يسبق التغيرات المطابقة في البناء الفوقي ويحدد طابعه.
أما بالنسبة لرأسمالية الدولة الوطنية (البلدان الاشتراكية السابقة) فإن الترسيمة السابقة بصورتها النموذجية تبدو غير صالحة لتفسير أوالية التغير فيها.هنا تقتضي ضرورات التغيير في علاقات الإنتاج الاجتماعية أن يحصل تغيير في البناء الفوقي ، وخصوصا في الحقل السياسي . فلحظة التغيير التطوري في البنية الاجتماعية تنطلق دائما من فوق، من الحقل السياسي، فيتوسع بانطلاقتها الفضاء العام لحركة قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وبقية مكونات البنية الاجتماعية الأخرى. ومن الطبيعي أن يقدم أي تغيير سياسي نفسه في حلة أيديولوجية تناسبه، يتوقف عليها إلى حد بعيد بدء لحظة التغيير التطوري التالي. يمكن تشبيه أوالية التغيرات في البناء الاجتماعي لنظام رأسمالية الدولة الوطنية، بجسم يتحرك على مسار تعترضه مقاومات عديدة متدرجة، وكلما تقدم الجسم على مسار الحركة تتكثف هذه المقاومات، وعند حد معين تصبح حركة الجسم إلى الأمام مستحيلة إذا لم تكسر هذه المقاومات وخصوصا المقاومة الأخيرة التي تستند عليها بقية المقاومات والمتمثلة في السلطة السياسية.
أ 1 2 3 4 5 ب
في الرسم، أ –ب: تمثل زمن سياسي تطوري ينطبق بصورة تقريبية على فترة استمرار السلطة السياسية تحت قيادة واحدة.
1- حركة قوى الإنتاج.
2 – 5 تمثل مقاومات مختلفة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، تعبر عن نفسها بصورة مصالح تميل إلى المحافظة والجمود بدرجات مختلفة. إذا افترضنا أن فترة دوام السلطة السياسية تحت قيادة معينة ( أ-ب ) تمثل زمنا سياسيا تطوريا، فان وتائر التغيير في البناء الاجتماعي خلال هذا الزمن ترسم خطا بيانيا منحدرا، تتحدد عوامل المحافظة في السلطة السياسية وفي ردائها الأيديولوجي (4) .
إن تراجع وتائر التقدم الاجتماعي في رأسمالية الدولة الوطنية لا يعني انه لا يحصل إطلاقا. قد يستثنى من ذلك بعض المراحل الانعطافية كما حصل في عهد غورباتشوف وخصوصا في مرحلة يلتسين، حيث تراجع الناتج الإجمالي العام بمقدار 28% أي أكثر مما خسره الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية حيث خسر نحو 24% من طاقته الإنتاجية (5). في الرأسمالية الكلاسيكية (النموذج الأوروبي) فان لحظة الحركة والتغيير تأتى دائما من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-انظر دراسة شميلوف ( سلفات وديون) المنشورة في مجلة(( الطريق)) العدد الأول، آذار (1988) ص53.
5-استنادا إلى الترسيمة السابقة يمكن اعتبار المرحلة الستالينية والمرحلة الخروتشوفية والمرحلة البريجنيفية والمرحلة الغورباتشوفية أزمان سياسية تطورية
تحت، من الحقل الاقتصادي، وتتسارع بتساوق مع تطور قوى الإنتاج لتزيح من طريقها أي عائق، على شكل علاقات إنتاج أو علاقات اجتماعية أو سياسية وغيرها. هنا لا يوجد ما أسميناه بالزمن السياسي التطوري، بل يوجد زمن تطوري تتحدد معالمه بتطور قوى الإنتاج، لذلك فان الرأسمالية في نموذجها الكلاسيكي تتمتع بفضاء تطوري واسع نسبيا، تتحرك خلاله بمرونة كبيرة.
إن القوانين العامة للحراك الاجتماعي المشار إليها سابقا تشتغل أيضا في ظروف المجتمعات المتخلفة، غير إنها تبدو هنا مثقلة بركام هائل من الاختلاطات، يعود بعضها إلى تعدد الأنماط الإنتاجية في البناء الاجتماعي، وبعضها الأخر يعود إلى علاقات التبعية التي تربط هذه المجتمعات بالمراكز الرأسمالية. لذلك من الصعوبة بمكان معالجة اشتغال القوانين العامة للحراك الاجتماعي بمعزل عن هذه الخصوصيات وبشكل خاص عن علاقات التبعية مع الخارج.
إن احتياجات التطور الداخلي في البلدان المتخلفة واتجاهاته لا تعكس في الغالب الأعم الاحتياجات الحقيقية لهذه البلدان، بقدر ما تعكس مصالح رأس المال العالمي. مع ذلك لا يمكن تجاهل العوامل الداخلية عند دراسة أوالية اشتغال القوانين العامة للحراك الاجتماعي في ظروف التخلف. فإلى جانب دورها الخاص الذي تؤديه، فهي حوامل الفعل والتأثير الخارجي سواء أكانت سلبية أم إيجابية. في هذا المجال يلاحظ الدور الكبير الذي يؤديه العامل السياسي قياسا إلى العامل الاقتصادي، البناء الفوقي قياسا إلى البناء التحتي، الذاتي قياسا إلى الموضوعي، السلطة قياساً إلى المجتمع.
إن تضخم دور العوامل السياسية في البلدان المتخلفة على شكل علاقات شخصانية ومركزية سلطوية، تشكل أكبر إرباك للحراك الاجتماعي في هذه البلدان، سواء تلك التي تسير منها على طريق الرأسمالية الخاصة أو التي تسير على طريق الرأسمالية الحكومية.
في الحالة الأولى يبدو السياسي مرتبطا بصورة واضحة بمصالح رأس المال العالمي وممثليه المحليين (البرجوازية الكولونيالية). وأن تطور الرأسمالية هنا لا يؤدي إلى صهر البنية الاجتماعية الداخلية، بل يبقيها ممزقة موزعة الولاءات الاثنية والطائفية والقبلية والعشائرية، التي تشكل بدورها الأساس للعلاقات الشخصانية، والداعم الأكبر للفئات الحاكمة. في هذه الوضعية تتولد أيضا ولاءات جديدة على شكل نزعات اغترابية كوسموبولوتية، أو نزعات نكوصية ارتدادية مع ما يترتب على ذلك من أثار اجتماعية خطيرة.
في الحالة الثانية كان السياسي يقلد كل ما يجري في البلدان " الاشتراكية " السابقة، يستحضر منها الحلول لمشاكله الداخلية. وفي كلتا الحالتين كان السياسي يتحرك في إطار نظريات أعدت له أساسا في الخارج.
باختصار تبدو القوانين العامة للحراك الاجتماعي في ظروف التخلف معاقة إلى حد كبير عن الاشتغال، يسيطر عليها الخارج ويوجهها لخدمة مصالحه، وذلك في ظروف غياب الحرية والديمقراطية التي تسمح لمختلف القوى الاجتماعية بالتعبير عن مصالحها والدفاع عنها.
5- الحراك الاجتماعي العام.
عودة إلى بدء. في سياق تفاعل الإنسان مع الطبيعة تتطور قوى الإنتاج بما فيها الإنسان ذاته، ومع كل تطور يطرأ عليها تدخل في تعارض مع علاقات الإنتاج السائدة فتدفعها نحو التغير، وبذلك يتغير البناء التحتي للنظام الاجتماعي، فيدخل بدوره بتناقض مع البناء الفوقي، فيدفعه هو الأخر إلى التغير. إن الحصيلة الموضوعية العامة لهذه التغيرات، التي تحكمها كما لاحظنا ثلاثة قوانين رئيسة، هي حصول التقدم الاجتماعي.
وبالفعل فان المجتمع الإنساني يتطور باستمرار كاتجاه عام بغض النظر عن حالات الارتداد والنكوص التي تحصل فيه في بعض المراحل التاريخية. وبسبب كون هذه العملية متكررة باستمرار، فإنه يحكمها قانون عام يسمى قانون الحراك الاجتماعي العام. هذا القانون يصوغ الحصيلة النهائية لاشتغال القوانين الثلاثة الأولى والمتمثلة في التقدم الاجتماعي، لذلك يسمى أيضا بقانون التقدم الاجتماعي.
وهكذا، استنادا إلى الكيفية التي تشتغل بها هذه القوانين والشكل الذي تظهر به يمكن تقسيم التاريخ الإنساني، بل والتاريخ الخاص بكل مجتمع محدد إلى مراحل تطورية كبيرة نسبيا تدعى التشكيلات الاجتماعي الاقتصادية. وعليه فان المشاعية والعبودية والإقطاعية والرأسمالية هي تشكيلات اجتماعية اقتصادية تمثل عصورا تاريخية متراتبة في التطور الإنساني العام.
كما إن حصيلة اشتغال كل قانون من قوانين الحراك الاجتماعي العام تمثل معلما بارزا في تمايز التاريخ. فعلى سبيل المثال يترتب على اشتغال القانون الأول تطور قوى الإنتاج، واستنادا إليها يمكن تمييز عصر الحجر وعصر البرونز وعصر الحديد وعصر الآلة البخارية وعصر الآلة ذات الاحتراق الداخلي وعصر الكمبيوتر.
وعلى حصيلة اشتغال القانون الثاني يتمايز التاريخ استنادا إلى شكل الملكية وشكل استحواذ الفائض، وأشكال الوجود المجتمعي مثل العائلة والعشيرة والقبيلة والشعب والأمة.
أما حصيلة اشتغال القانون الثالث فتؤدي إلى تمايز التاريخ استنادا إلى تغير مؤسسات السلطة، من سلطة رب العائلة إلى سلطة زعيم العشيرة فسلطة زعيم القبيلة فسلطة الدولة..
إن القوانين العامة للحراك الاجتماعي هي تجريدات نظرية عامة قيمتها المعرفية، في الدلالة الاصطلاحية التي تعطى لها. غير أن التاريخ الإنساني هو تاريخ مميز وملموس يتعلق بحدث اجتماعي معين له مسبباته ونتائجه. لذلك تختلف طريقة اشتغال هذه القوانين والشكل الذي تظهر به من بلد إلى أخر، ولا يمكن دراستها واستخدامها بصورة واعية في تقدم المجتمع المعني إلا من خلال الاقتراب منها وتفحص كيفية اشتغالها في الواقع الملموس.
إن ما توصلنا إليه حتى الآن من نتائج تتعلق بالقوانين العامة للحراك الاجتماعي قد تكون ملتبسه بسبب عموميتها الزائدة، ولا تفيد كثيرا في فهم الكيفيات التي يحصل بها التقدم الاجتماعي والقوى الاجتماعية الفاعلة به. لهذا الغرض لا بد من توضيح المسائل المنهجية الأتية:
1-تحديد الشكل الرئيسي لظهور القانون العام للتقدم الاجتماعي على مستوى التشكيلة وفي كل حقل من حقولها.
2-تحديد شكل العلاقات الإنتاجية وكيفية تحققها الاقتصادي.
3-تحديد القوى الاجتماعية التي تقود الحراك الاجتماعي التطوري أو البنيوي وتلك القوى المعيقة له.
4-تحديد أشكال الصراع الاجتماعي الطبقي والحقول التي يتحرك فيها.
في التشكيلات الرأسمالية المتطورة (الرأسمالية التقليدية) يظهر القانون العام للتقدم الاجتماعي في الحقل الاقتصادي على شكل تراكم متعاظم لرأس المال، ويظهر في الحقل الأيديولوجي على شكل تطور متسارع للعلوم والثقافة، أما في الحقل السياسي فيظهر القانون على شكل تطور بناء الدولة وأجهزتها وطرق وأساليب ممارسة السلطة.
أما القانون الأول للحراك الاجتماعي فانه يأخذ شكل تطور متسارع لقوى الإنتاج والعلوم والتكنولوجيا والفنون الإنتاجية المختلفة.
في حين يظهر القانون الثاني المعبر عن علاقات الإنتاج من خلال العلاقات القائمة بين البرجوازية وطبقة الأجراء. تأخذ هذه العلاقة منظورا إليها من زاوية البرجوازية شكل الربح، أما من زاوية طبقة الأجراء فإنها تأخذ شكل الأجر، وتتحقق هذه العلاقة باستخدام الأساليب الاقتصادية بالدرجة الأولى.
في ظروف الرأسمالية التقليدية فإن القوانين العامة للحراك الاجتماعي تشتغل، في مناخ من الحرية والديمقراطية حيث المصالح المختلفة تبدو على السطح، تتصارع في سبيل تحقيقها مختلف القوى الاجتماعية، وتحصل بالنتيجة توليفات معينة بينها، تؤدي إلى تغير أشكال ممارسة السلطة والعلاقات القائمة عليها باستمرار هذا من جهة. ومن جهة ثانية يزداد الاستقطاب ويتعمق بين البرجوازية وطبقة الأجراء، باعتبارها القوى الاجتماعية الفاعلة في الحراك الاجتماعي الداخلي للتشكيلة خلال زمنها التطوري. في سياق عملية الصراع بين القطبين الطبقيين، طبقة البرجوازية وطبقة الأجراء، فان الفئة الاجتماعية التي تقود عملية الحراك خلال كل مرحلة من مراحل الزمن التطوري للتشكيلة، تتغير حسب طبيعة المهام التي يطرحها منطق التاريخ. في البداية كانت فئة التجار ومن ثم تولت القيادة فئة الصناعيين، لتخلي القيادة في فترة لاحقة إلى فئة الماليين. وفي الوقت الراهن يؤدي العلماء والتكنوقراط الدور القيادي الحاسم في تطور التشكيلة.
في هذه الوضعية للتشكيلة يعبر الصراع الطبقي عن جوهره السياسي بصورة مباشرة، باعتباره يتوجه مباشرة إلى العلاقات السلطوية ويعمل على تغييرها أو تغير آلية اشتغالها.
في التشكيلات الإقطاعية يأخذ القانون العام للتقدم الاجتماعي شكل الإنتاج من اجل الاستهلاك، سواء بصورته التبذيرية منظورا إليه من جانب الطبقة الإقطاعية أو بصورة الاستهلاك الضروري منظورا إليه من جانب الفلاحين الاقنان.
وتتحدد علاقات الإنتاج بالطبقة الإقطاعية وطبقة الفلاحين الاقنان، وتأخذ شكل الريع الزراعي منظورا إليه من جانب الطبقة الإقطاعية، الذي يظهر بأشكال مختلفة حسب تغير مراحل الزمن التطوري للتشكيلة الإقطاعية (ريع بالعمل أو ريع عيني أو ريع نقدي).
وتأخذ علاقات الإنتاج الإقطاعية منظورا إليها من جانب طبقة الفلاحين الاقنان شكل المنتوج الضروري. تتحقق هذه العلاقة بشكل رئيسي بالوسائل السياسية، مع الاستعانة بالوسائل الأيديولوجية أحيانا.
خلال الزمن التطوري للتشكيلة الإقطاعية يتحدد الصراع الطبقي في البداية بين الطبقة الإقطاعية وطبقة الفلاحين الاقنان، وفي مرحلة متقدمة منها تولد الطبقة الوسطى وتأخذ جانب الفلاحين في مواجهة الطبقة الإقطاعية. ومع أن الطبقة الإقطاعية هي التي تقود عمليات التغيير خلال الزمن التطوري للتشكيلة، إلا أن الطبقة الوسطى هي التي تقود عمليات الانتقال خلال الزمن البنيوي للتشكيلة في نموذجها الأوربي. أما في ظروف التخلف فان البرجوازية الكولنيالية التقليدية أو المتجددة فهي التي تتولى هذه المهمة.
في النموذج الأوربي للتشكيلة الإقطاعية يتحرك الصراع الطبقي بشكل رئيسي في الحقل الأيديولوجي، ولا ينتقل إلى الحقل السياسي إلا خلال مرحلة الانتقال إلى الرأسمالية.
في التشكيلات الرقية يظهر الشكل الرئيسي للقانون العام للتقدم الاجتماعي على شكل الإنتاج من أجل الاستهلاك الضروري أولا والاستهلاك البذخي ثانيا.
أما علاقات الإنتاج الاقتصادية منظورا إليها من جانب طبقة الأسياد فإنها تأخذ شكل الاستحواذ على المنتوج الضروري والمنتوج الفائض في الوقت نفسه، وبالتالي فإنها تبدو وحيدة الاتجاه، فهي علاقة بين السيد وموضوعات سيادته ومنها العبد ذاته.
أما إذا نظر إلى العلاقة السابقة من جانب طبقة العبيد فتبدو هذه العلاقة سلبية تماما، فالعبد ليس أكثر من أداة للإنتاج، ومثلها مثل أية أداة أخرى فإنها تحتاج إلى الصيانة للمحافظة عليها. ويكون ذلك بتأمين حد معين من الاستهلاك الضروري من اجل إعادة إنتاج قوة العمل لديه.
خلال الزمن التطوري للتشكيلات الرقية استخدمت الأساليب السياسية على نطاق واسع من أجل الاستحواذ على المنتوج الفائض وجزء من المنتوج الضروري. وتحدد الصراع الطبقي أثناء ذلك بالطبقتين المشار إليهما، أما خلال زمن الانتقال فقد لعبت الدور القيادي طبقة الأسياد. هنا يبدو الحقل الرئيسي الذي يتحرك فيه الصراع أكثر تعقيدا واقل تحديدا. مع ذلك يمكن القول بتحفظ أن الحقل السياسي والحقل الايديولوجي، قد شكلا معا وبتداخل
كبير بينهما ميدان الصراع.
قبل أن ننهي هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى تداخل الحقول الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية التي يتحرك فيها الصراع الطبقي، كلما رجعنا بالتاريخ إلى الوراء، لتكون تركيبا معقدا ومتداخلا. على العكس تماما، فإن هذه الحقول تتمايز كلما سرنا مع التاريخ إلى الأمام. ففي الرأسمالية المعاصرة تبدو الحقول الاقتصادية والأيديولوجية والسياسية التي يتحرك فيها الصراع الطبقي متبلورة ومتمايزة إلى حد بعيد. لذلك في التاريخ القديم وفي التشكيلات ما قبل الرأسمالية، كانت الأساليب السياسية لاستحواذ المنتوج الفائض هي السائدة، وهذا يتطلب بالضرورة وجود أنظمة سياسية شديدة المركزية، تعتمد اعتمادا شبه كلي على السلطة وأجهزتها.
أما في التاريخ الحديث (تاريخ الرأسمالية التقليدية) فقد تراجعت الأساليب السياسية لصالح تقدم الأساليب الاقتصادية بصورها المختلفة. وهذا تطلب بالضرورة تغيراً في البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع، بحيث يعاد هيكلته باستمرار، في ضوء النتائج المترتبة على اشتغال القوانين العامة للحراك الاجتماعي. ونظرا لأن مصالح جميع القوى الاجتماعية الفاعلة في التقدم الاجتماعي كان لها مصلحة حقيقية في حصوله، كل منها على طريقته، فكان لا بد من إيجاد مناخ ملائم، كي تتقابل هذه المصالح وتدخل في مساومات وتسويات تاريخية من خلال عملية الصراع، فكانت الحرية والديمقراطية هي هذا المناخ.
6- خاتمة
نخلص من الاستعراض السابق للقوانين العامة للحراك الاجتماعي إلى الاستنتاجات الأتية:
أ-إن القوانين العامة للحراك الاجتماعي تعبر عن العلاقات والروابط الجوهرية في البناء الاجتماعي خلال حراكه العامة وهي تفسر كيفية تحقق هذا الحراك، بصورة عامة وتجريدية إلى حد بعيد.
ففي الرأسمالية التقليدية يبدأ الحراك من الأسفل إلى الأعلى، من الاقتصادي إلى السياسي، من البناء التحتي إلى البناء الفوقي.
أما في رأسمالية الدولة الوطنية فانه يبدأ من فوق إلى تحت، من السياسي والأيديولوجي إلى الاقتصادي، من البناء الفوقي إلى البناء التحتي، لذلك كان التطور هنا يجري على شكل مراحل متمايزة يشكل كل منها زمنا سياسيا تطوريا. يعود ذلك إلى طغيان النزعة الأيديولوجية والمركزية الشديدة للسلطة السياسية. لذلك كان التطور الداخلي هنا يتحقق على شكل أزمان سياسية تطورية كل منها ينطلق من وضعية مأزومة سابقة.
في ظروف الرأسمالية الطرفية يبدو كل شيء ملجوما من الخارج بسبب العمليات الاندماجية الجارية عالميا، مما حولها إلى تابعة بصورة شبه كاملة للمراكز الرأسمالية. في هذه الوضعية فان البنية الداخلية للمجتمعات المتخلفة تبدو معقدة جدا، تتفاوت مكوناتها من حيث مستوى التطور، كما إن الماضي فيها يقبض على الحاضر بقوة على شكل تكوين نفسي واستعدادات وموروثات أيديولوجية وفكر ماضوي وغيرها . في مثل هذه الظروف يقبض العامل السياسي على كل شيء.
ب- في ظروف العمليات الاندماجية الكونية الجارية (ظروف العولمة)، وهي عمليات موضوعية بطبيعتها، صارت القوانين العامة للحراك الاجتماعي قوانين لحراك المجتمع الإنساني ككل، تشتغل على المستوى الكوني. فعلى سبيل المثال لم يعد يقتصر تطوير قوى الإنتاج على مجال التفاعل مع الطبيعة في الإطار الوطني، بل في الإطار الكوني. ولم تعد الحاجات المحلية المتولدة في سياق التفاعل مع الطبيعة في الإطار الوطني هي الدافع إلى تطوير قوى الإنتاج، بل تحول ذلك إلى ممارسة عالمية.
كما إن دوافع تغير علاقات الإنتاج الاجتماعية لم تعد محلية فقط، بل صار الخارج يؤدي دورا هاما في ذلك من خلال حركة رأس المال العالمي. فوسائل الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج تحمل معها جملة من العلاقات، تعمل على تبيئتها محليا. مع ذلك فان مفاعيل هذه العلاقات (الآثار التي تترتب عليها) تختلف في البلدان المتخلفة عنها في البلدان المتقدمة خصوصا إذا نظر إلى ذلك من زاوية التقدم الاجتماعي. ففي البلدان المتخلفة تعمل وسائل الإنتاج المستوردة على تكييف البنى الداخلية من أجل الاندماج في النظام الرأسمالي الكوني على قاعدة التبعية. فالعلاقات الإنتاجية الاجتماعية لم تعد تعبر عن تطور قوى الإنتاج باعتباره النتيجة الموضوعية لتفاعل الإنسان مع الطبيعة في الإطار المحلي، بل تعبيرا عن تطور قوى الإنتاج على الصعيد العالمي..
ج- إن تنامي دور العامل السياسي في النظام الاجتماعي يؤدي موضوعيا إلى تنشيط عوامل المحافظة، التي تعيق وتحد من تطوره أو تربكه، لأن السياسي تشترطه دائما المصالح الطبقية أو الفئوية الضيقة، خصوصا إذا كان يتحرك في فضاء أيديولوجي غير مرن، ويتجدد خلال فترات طويلة نسبيا ضمن إطار اجتماعي ضيق ومحدود.
إن الحراك الاجتماعي النظامي يتوقف على طبيعة العلاقة بين دور الاقتصادي ودور السياسي في كل مرحلة من مراحل التطور. من حيث المبدأ كلما كانت البنية الاجتماعية متخلفة ازدادت أهمية العامل السياسي في النظام الاجتماعي ككل، بالقياس إلى العامل الاقتصادي.
أما في البنية الاجتماعية المتقدمة، فان الدور الأكبر هو للعامل الاقتصادي، يستثنى من ذلك الحالات الانعطافية الحادة على شكل أزمات أو كوارث أو حروب حيث يؤدي السياسي الدور الحاسم.
د- إن الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة أخذت تؤدي دور المسرع الجبار للتغيرات في البناء الاجتماعي وهي تتطلب وجود فضاء سياسي وأيديولوجي مفتوح بصورة دائمة، مما يحول دون وجود أزمان سياسية تطورية في الرأسمالية التقليدية أو في الاشتراكية المنشودة. بكلام أخر سوف يكون لكل من النظام الرأسمالي المتقدم والنظام الاشتراكي المنشود زمنان: زمن بنيوي يقيس مدة وجود التشكيلة، وزمن تطوري يقيس كل مرحلة من مراحل التقدم الاجتماعي في داخل التشكيلة.
بقي أن نشير إلى أن القوانين العامة للحراك الاجتماعي، مع أنها تتميز بالموضوعية، إلا أنها على خلاف القوانين الطبيعية، لا تشتغل إلا بصورة واعية في إطار معين من التنظيم الاجتماعي. فبقدر ما يكون الوعي بهذه القوانين صائبا ودقيقاً، وبقدر ما يكون التنظيم الاجتماعي مرنا قابلا للتغير، بقدر ما يكون الأثر التطوري الناجم عن اشتغال هذه القوانين كبيراً.
لذلك عندما تتباطأ حركة انتقال المعلومات عن تغير الواقع، أو تضعف الحساسية بها يعجز الفكر عن تقديم الصياغات النظرية الأيديولوجية المناسبة لتفعيل التغيير في الاتجاه المطلوب، تضطرب حركة الواقع، وقد تتأزم إلى حد الانفجار، وقد تنفجر أحياناً، بسبب جمود الفكر وعدم ملاءمة الصياغات النظرية الأيديولوجية السائدة لما هو ناضج في الواقع للتغيير.
غير أنه بين الفكر والواقع (الوجود الاجتماعي) ثمة مسافة تشغلها الفعالية الإنسانية (النشاط). عبر هذه المسافة باتجاه الفكر أولاً ومن ثم باتجاه الواقع ثانياً ثمة حركة دائمة، تتسارع حيناً وتتباطأ أحياناً بعلاقة طردية لا تناسبية مع الميل إلى المحافظة في البناء الفوقي، وبشكل خاص في حقل الممارسات السياسية. لذلك عندما يجمد الفكر ويتخلف عن حركة الواقع لنبحث عن السبب لا في الفكر ذاته ولا في حقل إنتاج الفكر، بل في ما يشغل المسافة الفاصلة بينه وبين الواقع؛ أي في حقل النشاط الاجتماعي، وبشكل خاص في الحقل السياسي.
نحن نعيش مرحلة انعطافيه فريدة بسبب عمليات العولمة الجارية وما تولده من سباق محموم على طريق التطور والتقدم، سوف تحرر الفكر عموما، والفكر السياسي خصوصاً (وهي تحررها فعلا) من القيود الأيديولوجية الضيقة، لينطلق على طريق الجدل والحوار والتطور مهتدياً بحقائق الواقع والاحتياجات الوطنية، والقومية، والإنسانية العامة، لا بالرغبات والأحلام، والمصالح الضيقة. ومع انه من الصعوبة بمكان أن نتوقع اتجاها واحدا لنقد الفكر السائد، إلا أن البواكير الايجابية الأولى بدأت تظهر في وطننا العربي على شكل مراجعات نظرية وسياسية، وحوارات خصبة تحاول التحرر من القوالب الجامدة والمواقف الجاهزة، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل والعمل على إنهاض الفعل الجماهيري مسلحا بفكر نقدي تقدمي ديمقراطي لإنجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، والمساهمة في الحضارة العالمية فاعلين لا منفعلين. وكنتيجة أولية لذلك بدأت تتبلور اتجاهات جديدة لم تكن مألوفة في الماضي، على صعيد الحوار والتعاون بين قوى الأمة الحية، القومية منها، والدينية، والسارية، والليبرالية، وهي اتجاهات واعدة تبشر بمستقبل أفضل للأمة العربية.
#منذر_خدام (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العرب والعولمة( الفصل السادس)
-
العرب والعولمة( الفصل الخامس)
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
-
العرب والعولمة(الفصل الثاني)
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
-
العرب والعولمة( مدخل)
-
العرب والعولمة(مقدمة)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الحادي عشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الهاشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل التاسع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثامن)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل ااسابع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل السادس)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الخامس)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الرابع)
-
في المنهج= دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الرابع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثالث)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثاني)
-
في المنهج. دراسة نقدية في الفكر الماركسي ( الفصل الأول: منطق
...
المزيد.....
-
مسؤولون أمنيون إسرائيليون: قلق في إسرائيل من تصاعد تهديد حرك
...
-
ألمانيا قررت التخلي عن تاريخها وبدأت الاستعداد للحرب المقبل
...
-
أندرو تيت في مواجهة جديدة: دعوى بالاعتداء الجنسي والتهديد با
...
-
تواصل العمليات الإسرائيلية في غزة ونزوح من رفح إثر طلب إخلاء
...
-
سويسرا.. القضاء العسكري يحقق في مشاركة 14 مواطنا كمرتزقة في
...
-
ريابكوف: واشنطن لا تنوي الانسحاب من -الناتو-
-
مدفيديف: إدانة لوبان -مُختلقة- لإقصائها من سباق الانتخابات ا
...
-
برلماني إيطالي يطالب بتعليق عضوية هنغاريا في الاتحاد الأوروب
...
-
كيف سيكون رد إيران الحاسم على تهديدات ترامب؟
-
نتانياهو يشبّه توقيف مساعديه في قضية -قطر غيت- بـ-احتجاز رها
...
المزيد.....
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
/ منذر خدام
-
ازمة البحث العلمي بين الثقافة و البيئة
/ مضر خليل عمر
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
/ منذر خدام
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
قواعد اللغة الإنكليزية للأولمبياد مصمم للطلاب السوريين
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
أنغام الربيع Spring Melodies
/ محمد عبد الكريم يوسف
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة