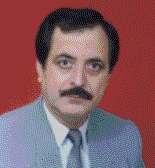|
|
العرب والعولمة(الفصل الثاني)
منذر خدام


الحوار المتمدن-العدد: 8260 - 2025 / 2 / 21 - 08:42
المحور:
قضايا ثقافية
الفصل الثاني
منظمة التجارة العالمية
والبلدان النامية
1-مدخل
إن ولادة منظمة التجارة العالمية سرع كثيرا من عملية تحرير الاقتصاد العالمي وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات ورؤؤس الأموال، فأخذت تبرز أكثر فأكثر السمات الكونية للاقتصاد العالمي، فتغيرت بالتالي مفاهيم عدية كانت حتى حين راسخة ومستقرة. بعض هذه المفاهيم يتعلق بالدولة الوطنية واستقلالها وسيادتها، وبعضها الآخر يتعلق بالتنمية وما يرتبط بها من مفاهيم مثل الثروة والموارد والتشغيل..الخ. أضف إلى ذلك فقد شكلت منظمة التجارة العالمية سابقة في التاريخ باعتبارها منتدا دوليا للحوار وتبادل الآراء في كل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي.
غير أن هذه المنظمة قد تعرضت ولا تزال تتعرض لانتقادات عديدة من جميع الأطراف المشاركة فيها، وإن كان أغلبها قد جاء من الدول النامية. بعض هذه الانتقادات له طابع اقتصادي اجتماعي، وبعضها الأخر له طابع إجرائي، وقسم ثالث له طابع صحي وبيئي الخ. أضف إلى ذلك فإن بعض الانتقادات له طابع تكتيكي يهدف إلى تحقيق مكاسب أو التقليل من أضرار محتملة في المدى القصير، لكن بعضها ذو طابع استراتيجي يتعلق بقضايا التنمية ومستقبل الصناعة الوطنية والبيئة ..الخ.
لقد وجهت الدول النامية، ومن بينها الدول العربية، انتقادات للمنظمة واتهمتها بأنها تغلب المصالح التجارية على قضايا التنمية المستدامة، وهي ترى أن تحرير التجارة قد يؤدي إلى زيادة النمو، لكن ذلك لا يعني حصول التنمية. البلدان النامية بحاجة ماسة إلى إحداث تغيرات هيكلية في اقتصادياتها تؤدي إلى تنمية طاقاتها الإنتاجية الصناعية والزراعية، وليس إلى تحرير التجارة بلا قيود أو ضوابط. أضف إلى ذلك قد يكون النمو الذي يحصل من جراء تحرير التجارة من طبيعة مؤقتة، ولا يعكس تغيرا هيكليا في الإنتاج أو في تنميته.
وفي الرد على هذا الانتقاد وكمحاولة لطمأنة الدول النامية، تؤكد منظمة التجارة العالمية أن تحرير التجارة، وفتح الأسواق سوف يهيئ ظروفا ملائمة للتنمية والنمو في آن واحد. لكن ذلك سوف يتوقف، إلى درجة كبيرة، على كيفية استفادة الدول النامية من هذه الظروف الجديدة. أضف إلى ذلك فإن العديد من اتفاقيات المنظمة تنص صراحة على مراعاة ظروف البلدان النامية سواء لجهة إعطاء فترات سماح أطول لهذه الدول للتكيف مع متطلباتها وتطبيقها، أو إعفاء الدول الأكثر تخلفا من بعض أحكامها.
من جهة أخرى رأت الدول النامية في تحرير التجارة ورفع الدعم خصوصا عن المنتجات الزراعية خطرا سوف يزيد في ثقل فاتورة البلدان المستوردة للغذاء، ويقلل من حصيلة الرسوم الجمركية مما سوف ينعكس سلبا على ميزانية الدولة فيحد من مواردها ويزيد في عجزها. بصورة عامة ترى البلدان النامية أنها في وضع غير متكافئ مع الدول المتقدمة، سواء من ناحية إنتاجية العمل، أو من ناحية مستوى تتطور قطاع الخدمات، أو من حيث المزايا التي يوفرها الحجم الكبير للشركات. ويزيد في مخاوف البلدان النامية كون البلدان المتقدمة لم تكن متحمسة لفتح أسواقها أمام تجارة المنسوجات التي تتمتع بمزايا نسبية فبها.
غير أن منظمة التجارة العالمية في ردها على هذه المخاوف، أشارت إلى أن اعتماد مبدأ حرية التجارة بالسلع، والخدمات، لا يعني إلزام الدول الأعضاء بتحرير جميع تجارتها بالسلع، أو بالخدمات، بل تركت لكل دولة حرية التفاوض، حول ما ترغب بتحريرة. بمعنى آخر، إذا كان تحرير التبادل التجاري بالسلع والخدمات، وتقليص الإجراءات الحمائية، هو من مبادئ منظمة التجارة العالمية، فإنه ترك لكل دولة أن تقرر من خلال المفاوضات درجة تحرير تجارتها، وحجم التقليص في الإجراءات الحمائية، والفترة الزمنية الضرورية لتحقيق ذلك. بعض الدول يمكن أن تلجأ إلى الانفتاح التدريجي، بحيث يستطيع المنتجون المحليون التأقلم مع الوضع الجديد، ويمكنها أيضا أن تحدد متى وكيف يتوجب عليها التدخل لحماية إنتاجها الوطني من مخاطر الإغراق، أو الدعم. وتشدد منظمة التجارة العالمية على أن اعتماد مبدأ عدم التمييز والشفافية في التجارة الدولية يمكن أن يقلل من مخاوف الدول النامية، خصوصا في مجال تجارة الخدمات. فقطاع الخدمات في الدول النامية لا يزال متخلفا، و من المشكوك به أن يستطيع هذا القطاع منافسة قطاع الخدمات في الدول المتقدمة، وإنه يحتاج لكي يتطور إلى تحفيز كبير، وهذا ما تؤمنه حرية التجارة بالخدمات حسب زعم منظمة التجارة العالمية. وتتخوف البلدان النامية أيضا من أن الفترة الممنوحة لها للتكيف والتأقلم مع متطلبات المنظمة غير كافية، ولا تستطيع التحكم بها، بل الدول المتقدمة. أضف إلى ذلك لم تضع المنظمة أية قيود على الشركات الدولية لمنعها من اقتسام الأسواق، وفرض أسعار احتكارية، أو التلاعب بالأسعار، وذلك من خلال الاستيراد من فروعها الخارجية. وتطالب الدول النامية بإعادة النظر في اتفاقية تحرير الاستثمار وإجراءاته بما يراعي مصالحها، ويحول دون الشروط القاسية التي تفرضها الشركات متعددة الجنسيات. فهي ترى أن عولمة الأسواق المالية، وتحرير الاستثمارات، قد تسببت في حصول أزمات مالية في المكسيك عام 1994، وفي دول جنوب شرق أسيا في عام1997، وفي روسيا والبرازيل، وبعض دول أسيا في عام1999. وبصورة أكثر تحديدا تتخوف البلدان النامية من:
-تعرضها لهجمات المضاربين.
-هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج.
-حصول تقلبات مفاجئة في رؤوس الأموال.
-غسل الأموال ودخول الأموال القذرة إليها.
-إضعاف دور الدولة الوطنية في مجال رسم السياسات النقدية والمالية.
ومما يزيد في مخاوف الدول النامية، كون البلدان الكبرى هي التي تسيطر على تدفق وحركة رأس المال الأجنبي. وقد حاولت منظمة التجارة العالمية طمأنة الدول النامية، والتخفيف من هواجسها ومخاوفها، وذلك من خلال تركيزها على أن تحرير الاستثمارات سوف يوفر للدول النامية مصادر إضافية لتمويل التنمية، والحصول على التكنولوجيا الحديثة وزيادة أرصدتها من العملة الصعبة، وتحسين مستوى إدارة الاستثمارات ورفع كفاءتها، وفي المحصلة زيادة مداخيل الدولة وإيراداتها. ورغم هذه التطمينات إلا أن الدول النامية لا يمكنها المغامرة بفتح أسواقها، واقتصادها، أمام الاستثمارات القصيرة الأجل الباحثة عن الربح السريع(رؤوس الأموال الجوالة)، لما يمكن أن تسببه من اضطرابات اقتصادية واجتماعية. كما أنه لا يجوز تحت عنوان حرية الاستثمار السماح بتهريب المدخرات الوطنية إلى الخارج، ولا بد من منع المضاربة سواء جاءت من المستثمرين المحليين، أو من الأجانب. ما يجب تشجيعه فعلا هو الاستثمار الطويل الأجل، وهو يحتاج بلا شك إلى خلق المناخات الملائمة لتشجيعه على التدفق والتوطن.
وجهت الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية انتقادات أخرى تفيد بأنها؛ أي منظمة التجارة العالمية غير ديمقراطية، وتتبنى سياسات الدول المتقدمة، ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الصغيرة والضعيفة، واشتكت هذه الدول بأنها أرغمت على الدخول في منظمة التجارة العالمية تحت الضغط والتهديد.
وبالفعل فقد تعرضت دول كثيرة من بلدان العالم الثالث إلى ضغوطات شديدة من قبل الولايات المتحدة، للدخول في منظمة التجارة العالمية. فعندما حدد الكونغرس الأمريكي تاريخ 5/2/1993 باعتباره نهاية فترة التفاوض لجولة الأورغواي، مثل ذلك بالنسبة لدول كثيرة نوعا من القوة القاهرة المسلطة فوق الجميع، خصوصا الدول النامية، التي كانت تبحث عن شروط أفضل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. بل كانت تواجه هذه الدول في حالات عديدة بيافطة تحملها المسؤولية عن التداعيات، التي يمكن أن تنجم عن عدم توقيعها على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي يمكن أن تتسبب بنشوب صراعات اقتصادية بين الدول المتقدمة، والدول النامية.
وإذ تعترف منظمة التجارة العالمية في تطميناتها للدول النامية بأن هذه الدول سوف تتعرض بلا شك لمشكلات ليست قليلة من جراء انضمامها إليها، إلا أنها في مقابل ذلك سوف تجني مكاسب عديدة، وأن الايجابيات سوف تتفوق في النهاية على السلبيات. فعلى سبيل المثال سوف تخضع التجارة الدولية إلى مبدأ الشفافية، وعدم التمييز، وان المزايا من تحرير التجارة سوف تشمل جميع الدول، وليس الدول الكبرى فقط.أضف إلى ذلك فإن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تجيز، بل تشجع قيام تكتلات بين الدول الصغيرة، أو الضعيفة اقتصاديا، أو بينها وبين الدول المتقدمة، التي تتقاطع مصالحا معها.
إن السؤال حول الخيارات المتاحة أمام الدول النامية للانخراط في العولمة، ومنها انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، هو سؤال خاطئ مبدئيا، فليس ثمة من خيارات أمام العولمة، بل تفاوض يمكن أن يحسن من شروط الانخراط في هذه العملية الكونية. وفي هذه الحالة فإن القضية برمتها تظل خاضعة لوضعية الدولة المفاوضة، من حيث قدراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. من هذه الناحية تشتكي الدول النامية، والصغيرة منها بصورة خاصة، بأن صوتها لا يسمع، وأن دورها ضعيف، وغير مؤثر في المفاوضات التي تجري في إطار منظمة التجارة العالمية.
غير أن منظمة التجارة العالمية ترى أن وضع هذه الدول يمكن أن يكون أسوأ فيما لو فاوضت من خارج المنظمة، لأنها في هذه الحالة سوف لن تستفيد من حماية القواعد التفاوضية التي وضعتها المنظمة، والتي تسري على جميع الدول المتقدمة منها والمتخلفة، الكبيرة منها والصغيرة. من الناحية النظرية يبدو ذلك منطقيا وصحيحا، غير أن الواقع يقول غير ذلك. فالدول المتقدمة تهيمن على منظمة التجارة العالمية وتحول دون تنفيذ الكثير من الاتفاقيات في حال تعارضها مع مصالحها، ولا يمكن التخفيف من تأثير هذه الهيمنة إلا بتحالف الدول النامية، التي تتشابه مصالحها، وتشكيل تكتلات إقليمية في إطار منظمة التجارة العالمية. ويمكن أن يساعدها في ذلك إصرارها على اعتماد الآليات الديمقراطية في إدارة المنظمة، وفي مجال اتخاذ القرارات فيها. إن الدول المتقدمة، التي ترفع عاليا رايات الديمقراطية في خطابها الأيديولوجي، تمارس أشد السلوكيات لا ديمقراطية في مجال اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية. ففي حين أصرت الدول النامية على اعتماد مبدأ التصويت، لحسم القضايا الخلافية خلال مباحثات جولة الأورغواي، تمسكت الدول المتقدمة بمبدأ توافق الآراء. وتحت ضغط الخوف من فشل الجولة، وافقت الدول المتقدمة أخيرا على حل وسط، يفيد باللجوء إلى التصويت في حال تعزر توافق الآراء(المادة التاسعة من اتفاقية إنشاء المنظمة). غير أن الدول المتقدمة لم تتقيد بالمبدأ الجديد، وظلت تصر على عدم تمرير أي قرار لا يخدم مصالحا، تحت ذريعة غياب توافق الآراء.
إن غياب الآليات الديمقراطية من منظمة التجارة العالمية سوف يخدم بالضرورة مصالح الدول الكبرى المهيمنة على الاقتصاد العالمي، وسوف يحرم الدول النامية من فرصة الدفاع عن مصالحا، وسوف يحد من فعالية منظمة التجارة العالمية ذاتها، وقد تجل ذلك بوضوح في مؤتمر سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية.
من الناحية الواقعية، تهيمن على الاقتصاد العالمي ثلاث قوى كبرى هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، واليابان. وإن المفاوضات التي تجري في إطار منظمة التجارة العالمية هي المفاوضات التي تجري بين هذه القوى، فإذا توافقت مصالحها سارت المفاوضات إلى نهاية ناجحة، وإذا تعارضت مصالحها توقفت المفاوضات، أو انتهت إلى فشل. ولقد اشتكت الدول النامية من هذه الوضعية التي حالت دون طرح قضاياها الخاصة، سواء في جدول أعمال المؤتمرات، التي تعقدها المنظمة، أو في سياق المفاوضات التمهيدية. ففي مؤتمر سياتل على سبيل المثال فإن قضايا معايير العمل والبيئة، وعلاقتها بالتجارة العالمية، وكذلك قضايا مكافحة الإغراق، وشفافية المشتريات الحكومية، شكلت محور الاهتمام الأمريكي. من جهتها ركزت دول الاتحاد الأوربي على ضرورة توسيع نطاق المفاوضات لتشمل قضايا أخرى، في مسعى منها لإحباط المسعى الأمريكي لفتح الأسواق الزراعية الأوربية أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، وصرف الانتباه عنه. أما اليابان فقد ركزت على ضرورة مراجعة القوانين الأمريكية التي تحمي صناعتها المحلية تحت ذريعة مكافحة الإغراق. ورغم احتجاجات الدول النامية، ضد هيمنة الأقطاب المشار إليها في الاقتصاد العالمي، ورغم محاولتها تدعيم مواقفها، من خلال الاستفادة من نشاط القوى المناهضة للعولمة، إلا أنها لم تنجح في تركيز الاهتمام على قضاياها الخاصة.
لقد ذكرنا أن الانتقادات التي وجهت إلى منظمة التجارة العالمية لم تقتصر على المجال الاقتصادي، بل تخطته لتشمل المجالات الاجتماعية والبيئية والصحية. ففي المجال الاجتماعي ترى القوى المناهضة للعولمة، وهي في غالبيتها منظمات وهيئات غير حكومية، أن الهوة تزداد اتساعا بين الأغنياء والفقراء سواء على الصعيد العالمي، أو في داخل الدول ذاتها. ففي بيان وقعته 1200 منظمة غير حكومية من 87 دولة، أُشير إلى أن قلة من الأغنياء في العالم يتحكمون بالثروة العالمية، في حين يزداد الفقر والتهميش والبطالة في العالم. أضف إلى ذلك وعلى عكس ما هو معلن من تحرير للتجارة الدولية وتعميم الشفافية في المبادلات التجارية الدولية، فإن المنظمة ركزت اهتمامها على فتح أسواق البلدان النامية أمام الاحتكارات العالمية، في الوقت الذي غضت النظر فيه عن الإجراءات الحمائية في البلدان المتقدمة، مما أدى إلى خسارة هذه البلدان نحو 700 مليار دولار. لقد ازدادت قيمة فاتورة الغذاء لدى الدول المستوردة للغذاء، وهي في غالبيتها من الدول النامية، بمقدار 290 مليار دولار، في حين تراجعت قيمة صادراتها بمقدار يزيد عن 250 مليار دولار. ولم تنجو البلدان المتقدمة ذاتها من تلك الآثار السلبية، فازدادت البطالة فيها، بحيث تحولت إلى بطالة عضوية، من جراء تطور وسائل الإنتاج، وزيادة إنتاجية العمل. فالرأسمالية المعاصرة لم تعد تهتم بالتشغيل في فلسفتها الاقتصادية، وهذا بالتأكد سوف يؤدي إلى تنامي المشكلات الاجتماعية، وإلى فقدان الاستقرار على الصعيد العالمي، وفي داخل كل دولة.
من جهة أخرى إن التركيز على الربح، وعلى تنمية التجارة الدولية، جعل التقيد بالمعايير الصحية ضعيفا، خصوصا ما يتعلق منها بالمنتجات الغذائية. من المعروف أن تطبيقات الهندسة الوراثية أخذت تنتشر في الزراعة، مما جعل الملف الزراعي من أعقد الملفات التي يتم التفاوض بشأنها في منظمة التجارة العالمية، وبالأخص بين دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت المنظمة قد أجازت للحكومات اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سكانها، والحيوانات، والمزروعات فيها، في ضوء المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، فإن القلق لا يزال يساور العديد من الحكومات والشعوب من جراء تدني معايير السلامة في المبادلات التجارية الزراعية. ويزيد في قلقهم هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، واستخدامها للوسائل السياسية، في إدارة علاقاتها الاقتصادية الدولية. وإذا كان لا يمكن الاستغناء عن منجزات الثورة العلمية، والتكنولوجية المعاصرة، في مجال الزراعة ، خصوصا، وإن مستقبل تأمين الغذاء في العالم يعتمد على تطبيقاتها، إلا أن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب معايير السلامة الصحية، مهما كان الدافع للربح قويا.
إن صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، لا تتوقف على سلامة الغذاء فقط، بل تتعداه إلى البيئة المحيطة، وفي هذا المجال توجه انتقادات حادة إلى منظمة التجارة العالمية، لجهة تجاهلها الأخطار الجسيمة التي تلحقها الشركات العابرة للقارات بالبيئة، في سياق سباقها المحموم من أجل الربح وتعظيمه، وفتح الأسواق والسيطرة على الموارد العالمية. ومع أن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية قد أشارت إلى ضرورة الحفاظ على البيئة، وعلى الموارد العالمية، واعتماد قواعد التنمية المستدامة، وإن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية فد نصت في مادتها العشرين على ضرورة حماية صحة الكائنات الحية، إلا أن المنظمة، في الغالب الأعم، لم تتابع ذلك، وأحالت الموضوع إلى المنظمات الدولية المختصة.
إذا كان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يكاد يكون حتميا في ظل العولمة المتسارعة، وأنه لا مفر من تحرير التجارة الدولية، وان منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة يمكن استيعابها بصورة تتجاوز البعد الفني التقني إلى البعد الحضاري، وهذا يتطلب ضرورة المواءمة والتوفيق بين ما هو عصري وحداثي، ومقتضيات الحرية والعدالة الاجتماعية.
وإذا كانت العولمة تعمق فعلا من الاستقطاب على الصعيد العالمي، وفي داخل كل دولة، بين الأغنياء والفقراء، وأن الهوة تزداد اتساعا بين المراكز الرأسمالية المتقدمة، وبقية دول العالم، وأن الدول النامية تتسارع حركتها باتجاه التهميش، بسبب رضوخها لمشيئة الدول المتقدمة، التي لم تف بوعودها التي قطعتها على نفسها في جولة الأورغواي.
فإن من الحقيقة أيضا أن منظمة التجارة العالمية تنخر بها الأزمات، وهي بحاجة ماسة للإصلاح، خصوصا لجهة الحد من تأثير الأقطاب الثلاثة الكبار على المنظمة، وتعميم المبادئ والآليات الديمقراطية في حياة المنظمة . وأن تحرير التجارة، وما يمكن أن ينجم عنه من تغيرات في الهياكل الاقتصادية لكل دولة، وعلى الصعيد العالمي، يحتاج إلى زمن ليس بالقصير. وهو يتطلب أيضاً التركيز المتوازن على تطوير وتنمية الفروع الإنتاجية، وخصوصا الصناعية منها، إلى جانب تطوير الفروع الخدمية من صحة، وتعليم، واتصالات، وغيرها. ومن البديهي أن تحقيق كل ذلك يتطلب مناخا ملائما، تحترم فيه حقوق الإنسان، وتسود فيه الحرية، والمسؤولية، والديمقراطية، في جميع مناحي الحياة.
2- >، والبحث عن مزيد من المصداقية.
في مؤتمر الدوحة الذي دشن مرحلة جديدة من المفاوضات المتعددة الأطراف، طالبت الدول النامية بأن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات >، عملا بمبدأ توازن المصالح، الذي هو من صلب النظام التجاري العالمي الجديد. وكان قد تم الاتفاق في مؤتمر جنيف الوزاري للمنظمة،أيار/1999، على ضرورة تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واحترام قواعد التعامل فيها، حرصا على مصداقية المنظمة من جهة، ومن أجل جذب الدول الأخرى إلى هذا النظام، من جهة ثانية. وقد جاء في النص << إن تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية والقرارات الوزارية، ضرورية للمحافظة على مصداقية نظام التجارة المتعدد الأطراف، ومن اجل الدفع اللازم لتوسيع أفاق التجارة الدولية>>. ومراعاة لهذه القاعدة، التي ترقى إلى مستوى المبدأ من مبادئ التجارة الدولية، أقر الوزراء ضرورة المراجعة والتقويم الدوري لما تم إنجازه في ضوء الأهداف المرجوة. وجرى الاتفاق على أن تشمل عملية المراجعة والتقويم، جميع جوانب النظام التجاري الدولي الجديد، بما فيه من إيجابيات وسلبيات، وكذلك المعوقات التي تعترض تنفيذه، بما فيها الجداول الزمنية للمفاوضات والمراجعات وغير ذلك من القضايا التي يتم الاتفاق عليها.
انطلاقا من ذلك، وعملاً بما جاء في الفقرتين 21 و22 من مسودة النص الوزاري تاريخ 19/تشرين الأول/1999، فقد اجتهدت الدول النامية خلال الفترة التحضيرية لمؤتمر سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، في تحديد المشكلات التي تواجهها، والتي لها الأولوية بالنسبة لها، في تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف. ومع أن مؤتمر سياتل الوزاري قد أخفق في التوصل إلى اتفاقات جديدة، إلا أن القضايا التي تهم البلدان النامية قد حازت على اهتمام الأعضاء الآخرين، وتم الاعتراف بها على نطاق واسع، بل تم التأكيد على ضرورة إيجاد الحلول لها، حتى لا تعيق التنمية في هذه البلدان، وكذلك لتشجيعها على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. لذلك تركز الاهتمام في الاجتماع العام للمنظمة الذي انعقد في 3/أيار/2000 على ضرورة اعتماد برنامج لمعالجة هذه المشكلات والقضايا، وخصوصا تلك التي برزت خلال التطبيق. بل كرست المنظمة جلسة خاصة للمجلس العام للمنظمة لمناقشة كيفية تنفيذ هذا البرنامج، ولا سيما ما يتعلق منه بالقضايا المستعجلة، التي وردت في الفقرتين 21 و22 من مسودة النص الوزاري المشار إليه[1] وهذا يعني من الناحية العملية مناقشة نحو 54 قضية من القضايا التي تتعلق بالتطبيق والتي شملها نحو13 اتفاقا تجارياً متعدد الأطراف، أو مجالا من مجالات التجارة الدولية. وفي الدورة الخاصة للمجلس العام للمنظمة التي انعقدت في 18/تشرين الأول/2000 تم إحراز تقدم بشأن آلية معالجة بعض القضايا التي وردت في الفقرة 21 من النص الوزاري، دون المضمون. وقد شملت هذه الآلية نحو 20 مسألة من أصل نحو 54 مسألة وردت في الفقرة 21 المشار إليها هي التالية: التدابير الصحية المتعلقة بالصحة وبصحة النباتات(sps )، (النقاط 1، 2، 3 ، 4)، الحوافز الفنية للتجارة(TBT)، (النقطتان1، 2)،
الزراعة، (النقاط 3، 4، 5، 6)، التقييم الجمركي، (النقاط 1، 2، 3، 4)، قواعد المنشأ، (النقطة1)، الدعم، (النقطة4)، الخدمات، (النقطتان 1، 2)، الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية(Trips)، (النقاط 2، 3، 4).
لقد أصبح واضحا أن موقف الدول النامية من منظمة التجارة العالمية قد تجاوز مرحلة الحذر منها، إلى الشك بمصداقيتها من حيث التطبيق، لذلك أخذ عدد متزايد من الدول النامية يربط بين مسألة الاشتراك في جولة جديدة من المفاوضات المتعددة الأطراف، وبين مسألة تطبيق الاتفاقات المبرمة، معتبرة هذه الأخيرة شرط للأولى. في ضوء ذلك لم يكن مستغرباً أن تحتل هذه القضية حيزا كبيراً من المناقشات التحضيرية استعداداً للمؤتمر الوزاري الرابع الذي انعقد في الدوحة.
غير أن الدول المتقدمة التي كانت قد مارست ضغوطا كبيرة لاستثناء القضايا المتعلقة بمكافحة الإغراق، والمنسوجات، والجوانب التجارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- وثيقة منظمة التجارة العالمية Job(999)5868/rev.1
للاستثمار، وأحكام ميزان المدفوعات، والمعاملة الخاصة والتفضيلية من المناقشات، اعتبرت موقف الدول النامية فيه الكثير من التشدد. وبناء على
ذلك فقد عمدت إلى الرد بالمطالبة بإدخال بعض التعديلات على الاقتراحات المتعلقة بالتطبيق، سواء ما ورد منها في نص الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، أو تلك المشمولة بالتشريعات الوطنية. بكلام آخر حاولت الدول المتقدمة توسيع دائرة المفاوضات لتشمل حزمة من القضايا أوسع بكثير مما طرحته الدول النامية. وقد انعكس هذا التشدد من كلا الطرفين، الدول النامية من جهة، والدول المتقدمة من جهة أخرى، على الدورة الخاصة للمجلس العام للمنظمة التي انعقدت بتاريخ 21/نيسان/2001، فحال بينها وبين تحقيق تقدم ملموس ونوعي في القضايا موضوع الخلاف. وكنوع من المساهمة في إيجاد مخرج من هذه الأزمة التي بدت مستعصية على الحل، تقدمت سبع دول بعضها من الدول المتقدمة وبعضها الآخر من الدول النامية هي( الأرجنتين والمغرب ونيوزلندا والنرويج وسويسرا وتايلاند والأورجواي)، إلى دورة حزيران 2001 للمجلس العام للمنظمة، بوثيقة تهدف إلى التوصل إلى حل وسط، يقوم على أساس الفصل بين المسائل الملحة التي تحتاج إلى اتفاق في أقرب وقت، والمسائل التي يمكن إحالتها إلى الهيئات المعنية لإعادة دراستها بصورة معمقة. وبالاستناد إلى وثيقة الدول السبع المشار إليها، فقد نجحت دورة 20 تموز2001 في التوصل إلى اتفاق حول القضايا التي ينبغي إحالتها إلى الهيئات المختصة لمتابعة دراستها، وقد شملت القضايا المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق، والتدابير الصحية وصحة النبات، والتقييم الجمركي، والدعم، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، على أن ترسل هذه الهيئات المختصة تقاريرها بشأنها إلى المجلس العام حتى30أيلول2001.
ورغم كل الجهود المكثفة التي بذلت خلال الفترة التحضيرية لمؤتمر الدوحة الوزاري فقد بقيت المواقف على حالها تجاه أغلب القضايا المطروحة على طاولة المناقشة والبحث. وفي الاجتماع غير الرسمي للمجلس العام للمنظمة في 31/تموز/2001، المكرس لمراجعة المسائل المتعلقة بالتطبيق، جرى التفاهم بين رئاسة المنظمة ممثلة بنائب المدير العام،وعدد من الوفود حول بعض المسائل التي يمكن إحالتها إلى الهيئات المختصة لتقول رأيها بها قبل 30/أيلول/2001،وقد شملت هذه المسائل:
-توضيح المقصود با <<المورد الأساسي>>، و <<المعلومات الخاصة بقيم الصادرات>>، و<< إجراءات التحقق لمباشرة التدابير التعويضية>>،و <<المعاملة الخاصة والتفضيلية>>..الخ. وفي الوقت ذاته وجد أن هناك بعض القضايا يمكن اتخاذ قرارات بشأنها، وبشكل خاص ما يتعلق منها بتفسير المادة 18 من اتفاقات الجات لعام 1994، بحيث تعتبر بمثابة الحكم الخاص الذي ينص على ضرورة المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وعلى إعادة تقويم ومراجعة تطبيق التدابير الصحية وحول صحة النباتات كل أربع سنوات، وعلى تمويل الملحق رقم 7 لكل بلد ينخفض فيه نصيب الفرد من الدخل الوطني عن 1000 دولار أمريكي.
3- بعد عشر سنوات من التطبيق لا تزال المشكلات قائمة.
مما لا شك فيه أن منظمة التجارة العالمية تجمع في داخلها بين قوى اقتصادية، وسياسية غير متكافئة، وبالتالي لا يمكن إلا أن ينعكس ذلك على وضع كل دولة في داخل المنظمة، وعلى دورها وفعاليتها. ومهما حاولت الدول الضعيفة النمو أن تحقق مكاسب من جراء انضمامها إلى المنظمة، فإنها سوف تظل محكومة بالشك، والخوف من خسرانها للكثير من جراء العلاقات غير المتكافئة بين الدول، والأطراف المنضوية في إطارها. وفي النهاية لا يمكن لقواعد، ومبادئ التجارة الدولية، التي تحاول المنظمة ترسيخها، باعتبارها قواعد عامة لاشتغال النظام الرأسمالي، إلا أن تعكس هذا الخلل البنيوي في موازين القوى الاقتصادية، والسياسية، والتقنية..الخ، بين مختلف الأطراف.
وبالفعل وبعد تجربة من عشر سنوات على إعلان قيام منظمة التجارة العالمية، تبين أن البلدان النامية تواجه مشكلات كثيرة بعضها يتعلق بتطبيق الاتفاقات ذاتها، وبعضها الآخر ناجم عن سوء تطبيقها. المشكلات من النوع الأول تشمل بصورة خاصة:
أولاً، التفاوت الشديد في اقتسام مكاسب حماية حقوق الملكية الفكرية، بين حاملي هذه الحقوق، وبين مستهلكيها. فمن وجهة نظر الدول النامية لا يجوز الاكتفاء بتشجيع الابتكار، والتقدم التكنولوجية، من جراء حماية حقوق الملكية الفكرية، وهو الشق الذي تحققه الاتفاقية في البلدان المتقدمة بالدرجة الأولى، بل لا بد من أن تساهم الاتفاقية بتحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية فيها، كدول مستهلكة للابتكارات، وبراءات الاختراع، وللتكنولوجيات، وخصوصا المتقدمة منها.
وهناك، ثانياً، قضية الدعم، حيث ترى البلدان النامية أن قواعد الدعم والتعويض، خصوصا تلك المتعلقة بدعم الحلقة الإنتاجية، وليس التصديرية، لا تراعي مصالحها، بل تشتغل ضدها، في حين هي منحازة بشكل كبير لصالح الدول المتقدمة. فلا يمكن مقارنة الدعم الذي تقدمه البلدان النامية لصناعتها وزراعتها من اجل تنميتها وتطويرها، مع الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة والذي يهدف أساسا إلى تحسين قدرتها التنافسية، خصوصا في مجال التصدير.
وثمة قضية ثالثة، تتعلق بالجوانب التجارية للاستثمار، حيث تراها الدول النامية منحازة ضدها، ولا تخدم سياساتها التنموية. فهي، مثلاً، تجد صعوبة كبيرة في تطبيق الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، التي تحول دون دعم وتشجيع المنتجات المحلية، على حساب المنتجات المستوردة، بهدف تشجيع الصناعة المحلية، علما أن الدول المتقدمة، والدول المصنعة حديثا،ً كانت قد استخدمت هذه الإجراءات على نطاق واسع. لذلك ترى هذه الدول أنه لا ينبغي الاكتفاء بتمديد الفترات الانتقالية، التي منحت لها لتكييف أوضاعها بما ينسجم مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف، بل لا بد من انتهاج سياسات تنموية عالمية، لتنمية البلدان النامية، تكون أكثر مرونة وأبعد مدى .
وهناك أيضا قضية التباين الشديد في البنى الهيكلية لكل من الدول النامية والدول المتقدمة، والتي تجعل جميع الاتفاقات تعمل لصالح هذه الأخيرة. فنظراً للفجوة الصناعية الكبيرة القائمة بين الدول النامية والدول المتقدمة، فإن هذه الأخيرة تستطيع جني فوائد أعظم من تطبيق اتفاقيات التجارة والاستثمار، والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وتدابير الدعم والتعويض، بما في ذلك آلية فض المنازعات، بالمقارنة مع الدول النامية، مما شكل على الدوام موضوع شكوى وتزمر لهذه الأخيرة. وأكثر من ذلك كانت الدول النامية، وبدافع رغبتها في تصنيع بلدانها، تتعرض لضغوطات كبيرة للوفاء بالتزامات تتخطى، في كثير من الأحيان، تلك الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقات ذاتها.
وأخيرا، ترى البلدان النامية أن المرحلة الانتقالية التي منحت لها، لإعادة تكييف اقتصادياتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية غير كافية. لذلك فهي تعاني من صعوبات كثيرة في استخدام نظام الدعم والتعويض، لحماية نفسها، مما تسبب بإلحاق أضرار كبيرة بصناعتها الوطنية وبتجارتها. بعبارة أخرى تفتقر الدول النامية إلى الامكانات اللازمة لمواجهة الممارسات غير العادلة للشركاء التجاريين.
غير أن الدول النامية تعاني من صعوبات أخرى ناجمة أساساً عن سوء تطبيق الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، من قبل الدول المتقدمة، خصوصا تلك التي تتعلق بالقطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لها. فالدول النامية على سبيل المثال كانت تشكو من بطء تحرير التجارة بالمنسوجات والملابس، التي تشكل بين 20 و60 بالمئة من صادراتها. فبعد مضي أكثر من ثمانية سنوات على بدء التنفيذ، جرت خلالها عملية تحرير التجارة بالمنسوجات والملابس ببطء شديد، علما أن الموعد النهائي لتحرير تجارة المنسوجات هو المحدد في مطلع عام 2005.
أضف إلى ذلك فإن قطاع الزراعة، وهو من القطاعات الأخرى الهامة في الدول النامية، لا يزال يتعرض لضغوطات شديدة من جراء المعاملة المتحيزة التي تمارسها الدول المتقدمة. فالدعم الكبير الذي تقدمه هذه الدول لقطاع الزراعة لديها، والذي يزيد عن مليار دولار يومياً، قد ألحق ضررا بالغا باقتصاديات الدول النامية، وزاد في أعبائها. لقد كان من المتوقع أن يتراجع هذا الدعم تقيدا بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقات المتعلقة بالزراعة، غير أن الواقع يقول عكس ذلك، إذ استمر دعم الصادرات الزراعية بالارتفاع حتى منتصف عام2004، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الاتحاد الأوربي. المثال البارز في هذا المجال، يتمثل في دعم البلدان المتقدمة لإنتاج القطن وفول الصويا، الذي أدى إلى انخفاض أسعارها العالمية، مما اضعف، بالتالي، القدرات التنافسية لصادرات الدول النامية منها، وتراجعت قدرتها على النفاذ إلى الأسواق، خصوصا إلى أسواق الدول المتقدمة.
من جهة أخرى، فإن إجراءات وقواعد مكافحة الإغراق، التي وجدت فيها البلدان النامية نوعا من الحماية، واجهت صعوبات جمة في مجال التطبيق، مما افقد أسواقها مزيدا من الثقة، بسبب تعرضها المستمر والمتكرر لموجات من عدم الاستقرار. على العكس من ذلك فإن الدول المتقدمة، وبسبب من عدم دقة وصرامة الضوابط المعتمدة، كانت تلجأ باستمرار وبصورة متكررة إلى تدابير مكافحة الإغراق، مما تسبب في تحميل البلدان النامية أعباء إضافية ناجمة عن التحقيقات في قضايا إغراق الأسواق. أضف إلى ذلك فإن تكرر الشكاوى من إغراق الأسواق كانت تدفع المستوردين إلى البحث عن مصادر أخرى بديلة.
من المعلوم أن أحدى المغريات التي كانت تقدم للبلدان النامية لتشجيعها على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية في مجال نقل التكنولوجيا، والتجارة بالخدامات، والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية؛ أي ما نصت عليه المادة الرابعة من الاتفاق العام للتجارة. غير أن النتائج على هذا الصعيد لم تكن مشجعة، نظرا لأن أحكام الاتفاقات الخاصة بذلك لم تكن ملزمة. فالدول النامية لم تحصل على الدعم الفني المتوقع من البلدان المتقدمة في مجال تطوير أنظمة الصحة، بما فيها أنظمة صحة الحيوانات والنباتات، أو في مجال تطوير أنظمة الجمارك والتجارة، وإن ما حصلت عليه لم يكن فعالا.
4-التحرك المطلوب لتحسين موقع البلدان النامية.
لقد لوحظ في سياق عمليات التفاوض في إطار منظمة التجارة العالمية، وحتى خلال جولة أورجواي، أن ثمة تباينا واضحا بين مواقف الدول النامية والدول المتقدمة، وهو تباين يعكس الوضع غير المتكافئ لكلا الكتلتين في الاقتصاد العالمي، وفي مجال التجارة الدولية. اللافت، في هذا المجال، أن المفاوضات بشأن الاتفاقات التي هي محط اهتمام الدول المتقدمة، مثل الاتفاقيات حول الخدمات المالية والاتصالات، كانت تعمل هذه الدول بتنسيق كبير فيما بينها، على تسريعها وإنجازها في أقصر وقت ممكن، أما الاتفاقات التي تهم البلدان النامية مثل اتفاقية قواعد المنشأ، وتدابير منع التحايل في مجال مكافحة الإغراق وغيرها، فكانت تعيقها وتبطئها بدون مبرر مستغلة موقعها المهيمن في التجارة الدولية. لذلك ومن اجل نظام تجاري دولي أكثر فعالية وعدالة وتكافؤ، لا بد من تسريع المفاوضات بشان القضايا التي تهم البلدان النامية، والتي انعكست في المادتين 21 و22 من النص الوزاري الصادر بتاريخ 19/تشرين الأول/1999. من هذه القضايا نذكر ما يلي:
أ-لقد كان من المتوقع، عقب انتهاء جولة أورجواي في عام1994، أن تزداد المكاسب من جراء تحرير التجارة الدولية، بحيث تتراوح بين 200 و500 مليار دولار. غير أنه تبين بعد حوالي عشر سنوات من التطبيق، أن ثمة خللا كبيرا قد حصل في غير صالح الدول النامية، حيث تراجعت حصتها من التجارة العالمية، بدلا من أن تزداد. السبب في ذلك يعزى إلى الصعوبات الفنية والتدابير الصحية وقواعد المنشأ..الخ. وكان من المفترض أن تقدم الدول المتقدمة مساعدة فنية متنوعة لتذليل هذه الصعوبات، لكنها لم تفعل. لذلك وخلال التحضير لمؤتمر سياتل الوزاري في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999، تقدمت الدول النامية بجملة من المقترحات، نذكر منها:
- ضرورة جعل الأحكام المتعلقة بالمساعدة الفنية إلزامية، وخصوصا تلك المتعلقة بالتدابير الصحية، وصحة النباتات، والحواجز الفنية أمام التجارة، وضمان تكافؤ الاتفاقات المتعلقة بذلك.
- إشراك الدول النامية في جميع مراحل وضع المعايير الفنية، على أن يتم التمييز بوضوح بين المعايير الإلزامية، وتلك ذات الطابع التوجيهي.
في مجل التجارة بالمنسوجات طالبت الدول النامية:
- زيادة حصة الموردين الصغار، واعتماد منهجية الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بمبدأ <<النمو الإضافي>> لصغار المصدرين، بحيث لا يقل عن 6%، على أن يتم إقراره قبل بدء المرحلة الثالثة من المفاوضات بشان اتفاق المنسوجات والملابس. علما أن من العقبات الكبيرة التي تعيق نفاذ منسوجات البلدان النامية على أسواق البلدان المتقدمة، يعود إلى الدعم الكبير الذي تقدمه البلدان المتقدمة لصادراتها. ومن أجل الحد من تأثير هذا الدعم للصادرات على التجارة وعلى الإنتاج المحلي فقد اقترحت البلدان النامية: ضرورة تامين مرونة كافية لتمكين البلدان النامية من التغلب على مخاوفها في مجال الأمن الغذائي، والعمالة الريفية، وعدم التمييز في إدارة المعدلات التعريفية، مما يتيح للمصدرين الجدد إمكانية النفاذ إلى أسواق البلدان المتقدمة.
أما ما يتعلق بالتجارة بالخدمات، وخصوصا التجارة بالخدمات المالية والاتصالات، فإن البلدان النامية ترى أن المكاسب التي حققتها الدول المتقدمة كبيرة جداً، بالمقارنة مع المكاسب التي جنتها الدول النامية من انتقال الأشخاص الطبيعيين( المادة الرابعة من اتفاقية الجات).
ب- لقد لوحظ أن من العقبات الرئيسة التي تحول دون نفاذ منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة، تعود إلى عدم وضوح القواعد المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق، وخصوصا تلك القواعد المتعلقة بالإغراق وإجراءات مكافحته. لذلك وجد ممثلو الدول النامية أن تحرير التجارة بالمنسوجات والملابس لن يكون فعالا إذا لم يتم توضيح هذه القواعد وتحسينها. فمن خلال التجربة تبين أن شرط المنشأ قد طبق بصورة عشوائية، مما زاد في تعقيد إجراءات مكافحة الإغراق، خصوصا تلك المتعلقة بتجارة المنسوجات والملابس التي كانت خاضعة من حيث الأساس إلى نظام الحصص. ومن اجل تلافي العشوائية في التطبيق، والتحيز، وكذلك من اجل تحسين القواعد المعتمدة اقترحت الدول النامية[2]:
2- انظر كزياوبنج تانج" ملاحظات على أهم القضايا التي تهم البلدان النامية"
E/ Escwa/cab/2001/3/add.1
-ضرورة الإخطار المسبق حول أية تغيرات تطرأ على قواعد المنشأ، حتى لا تعيق هذه التغيرات النفاذ إلى الأسواق، وخصوصا نفاذ المنسوجات والملابس.
- اعتماد قاعدة الرسوم الأقل إلزامية.
- الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات لمكافحة الإغراق لمدة سنتين من بدء إخضاع هذا القطاع بصورة كاملة لاتفاقات الجات.
- منع تكرار التحقيق في الإغراق للمنتج الواحد قبل مضي سنة كاملة على آخر تحقيق.
- جعل أحكام المادة 15 إلزامية.
- رفع الهامش الأدنى لإغراق الأسواق من 2% إلى 5% بالنسبة للبلدان النامية، وتطبيقه ليس فقط على الحالات المستجدة، بل أيضاً في حالات التسديد والمراجعة.
- زيادة كميات المبيعات بالسعر الأقل من سعر الإنتاج من 20% إلى 40% على الأقل.
- توضيح كيفية التعامل مع تقلبات معدلات الصرف الأجنبي، خلال عمليات الإغراق، وتضمينها المادة 1،4،2 من الوثيقة الملحقة.
- تحديد المقصود بالإعاقة المادية لإنشاء صناعة محلية، وتضمين ذلك في المادة 3 من الوثيقة الملحقة.
5- نحو اتفاقات أكثر توازناً
غير أن ما تتوجس البلدان النامية منه خيفة هو الغموض في كيفية تطبيق الأحكام الخاصة والتفضيلية الواردة في الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، وترى هذه البلدان، من أجل إزالة هذا الخوف، ضرورة تحويل جميع الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية، إلى تعهدات واضحة ملزمة، مما سوف يسهل عليها دخول أسواق البلدان المتقدمة.
لقد أصبح واضحا أن ثمة خللاً كبيراً في أحكام بعد الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، وبشكل خاص في اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والتجارة والاستثمار..الخ. لقد تبين من خلال التجربة أن الأعباء المباشرة لتطبيق هذه الاتفاقات كبيرة جداً، بحيث أثرت على أسعار التكنولوجيا، والمواد الصيدلانية، وغيرها من المنتجات، كثير. أضف إلى ذلك لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الطب التقليدي المنتشر كثيراً في البلدان النامية. في ضوء ذلك طالبت البلدان النامية بمزيد من الحماية للعلامات الجغرافية المتعلقة بإنتاج بعض المنتجات الخاصة، الواردة في أحكام المادتين 23 و 24 من اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وعدم منح براءات تتعارض مع أحكام المادة 15 من CBD، وتعديل الفقرة 2 من المادة 64، بحيث يتوضح أن الفقرتين ب ، ت من المادة 23 من الجات لعام 1994 لا تنطبقان على اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.كما طالبت بأن تكون مدة تطبيق أحكام المادة 3، 27 (ب) خمس سنوات ابتداء من تاريخ استكمال المراجعة، على أن يتم النظر في إمكانية تعديلها في ضوء أحكام معاهدة " التنوع البيولوجي". وينبغي تنفيذ المادتين 7 و 8 من اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وتسهيل نقل التكنولوجيا بما يخدم مصالح الطرفين.
في الواقع كان الهدف من الاتفاقية المتعلقة بتدابير الدعم والتعويض، وكذلك اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، الحد من عدم التكافؤ في التجارة الدولية، وإزالة تأثيراتها المشوهة عليها. لكنها مع ذلك لم تأخذ بعين الاعتبار حاجة البلدان النامية إلى تنمية صناعتها المحلية، وتنويع الإنتاج، وتشجيع الصادرات، علما أن الدول المتقدمة والدول حديثة التصنيع قد استخدمت العديد من إجراءات الحماية، بما فيها إجراءات الدعم، لتطوير صناعتها المحلية، حتى قبيل انتهاء جولة أورجواي. لذلك تسعى الدول النامية إلى ربط جميع الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بقضايا التنمية، ومن اجل ذلك تقدمت بجملة من المقترحات في عام 1999 تخدم هذا الاتجاه،نذكر منها:
- العمل على تمديد المرحلة الانتقالية المنصوص عنها في المادة 2، 5 من اتفاق التجارة والاستثمار، بحسب ما تقتضيه حاجة التنمية في هذه البلدان.
- تعديل المادة 3، 5 من اتفاق التجارة والاستثمار، بحيث تأخذ بعين الاعتبار مصالحها التنموية، وجعل أحكامها إلزامية.
- إعفاء البلدان النامية من شرط المضمون المحلي، عن تطبيق المادتين 2 و 4 من اتفاق التجارة والاستثمار.
-تعديل المادة 1: 8 من اتفاقية الدعم والتعويض بحيث، يتم توسيع نطاق الدعم غير الموجب لإقامة دعوى، لتشمل الدعم المنصوص عنه في المادة 3/1 من الاتفاق، وذلك عندما تقوم البلدان النامية بتقديم الدعم.
- إلغاء المفعول التصاعدي للتكاليف، في حالة التكليف الضريبي، في البلدان النامية.
- يجب توسيع مفهوم " المدخلات" في العملية الإنتاجية، بحيث يشمل المدخلات غير المادية، التي قد تشارك في تحديد السعر النهائي للمنتج المصدر.
- تعديل الملحق1 لاتفاق الدعم والتعويض(ASCM)، لمنح البلدان النامية مرونة اكبر في تمويل مصدريها، بما يتناسب مع أهداف التنمية لديها[3].
6- مكاسب وحقوق البلدان النامية، وجهة نظر معاكسة.
تقوم منظمة التجارة العالمية على ثلاثة مبادئ أساسية هي :
- مبدأ عدم التمييز بين الدول في مجال التجارة الدولية. وإذا حصل تمييز ينبغي أن يكون في صالح الدول النامية.
- تخفيف القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات في التجارة الدولية، و إزالتها تدريجيا.
- وضع قواعد، وضوابط للسلوك في العلاقات التجارية الدولية، وفرض جزاءات على من يخرج عن هذه القواعد.
يرى المدافعون عن انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، أن وضع هذه البلدان في التجارة الدولية، غير الخاضعة لأية قيود أو ضوابط، سوف يكون في غاية السوء، وسوف تكون الخاسر الأكبر. ومع أنهم يقرون بأن اتفاقات منظمة التجارة العالمية تحابي، في كثير من جوانبها، الدول المتقدمة، إلا أن ما تجنيه البلدان النامية منها كبير أيضاً. وأن التصور الذي راج لفترة طويلة في صفوف الاقتصاديين من البلدان النامية، حول أن منظمة التجارة العالمية ليست أكثر من أداة لفتح أسواق هذه البلدان أمام منافسة غير عادلة مع سلع البلدان المتقدة، ووضع خيراتها في تصرف الشركات العابرة للقومية، لا يقوم على أساس سليم. ويمكن تبيان ذلك فيما يلي[4]:
أ-التوازن بين الحقوق والواجبات.
عند إنشاء منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاق مراكش، أُلحقت بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- لمزيد من التفاصيل انظر المرجع السابق، ص15-16.
4- سعيد النجار، " الحقوق الأساسية للبلدان النامية في ظل الجات ومنظمة التجارة العالمية " E/Escwa/1999/1
جميع اتفاقات جولة أورجواي وعددها 22 اتفاقاً دولياً، وسبعة تفاهمات، وأصبحت جزء لا يتجزأ من اتفاق مراكش. يعني ذلك أن من يوافق على اتفاق مراكش،عليه أن يوافق حكما على ملاحقه وتفاهماته، دون اللجوء إلى
التوقيع عليها مفردة، وهذا ما يعرف باسم الصفقة الواحدة(Single undertaking). وبموجب هذا الإجراء فإن التوازن بين الحقوق والواجبات يتحقق من خلال وحدتها، وليس من خلال كل اتفاق على حدة، نظراً لتفاوت أهمية كل اتفاق من بلد إلى آخر. فاتفاق الزراعة، على سبيل المثال، له أهمية كبيرة بالنسبة للدول المصدرة للغذاء ( الأرجنتين وتشيلي والأورجواي)، وكذلك بالنسبة للدول المستوردة للغذاء مثل مصر. غير أنه قليل الأهمية لدولة مثل هونغ كونغ. من جهة أخرى، فإن اتفاق المنسوجات مهم جداً بالنسبة لسورية ومصر وتونس وتايلاند والصين، لكنه قليل الأهمية بالنسبة للكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة..الخ.
وإذا كانت الدول توازن بين ما تحققه من فوائد، مع ما يترتب عليها من التزامات، عند انضمامها للمنظمة، فإن الدول النامية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بكثير من الإعفاءات، والاستثناءات، وهذه لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة مسألة انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية.
ب- تحرير التجارة لا يعني حرية التجارة.
ثمة اعتقاد خاطئ، مفاده أن منظمة التجارة العالمية سوف تلغي جميع القيود، من أي نوع كانت، على حرية التجارة(قيود كمية، تعريفية..الخ)، مما يعني عملياً وضع البلدان النامية في مواجهة منافسة غير عادلة، وغير متكافئة، هي خاسرة فيها مسبقاً. ومن الواضح أن هذه الفكرة قائمة على تصور خاطئ، وعدم دراية كافية باتفاقات منظمة التجارة العالمية.
تفرق الجات ومنظمة التجارة العالمية بوضوح بين نوعين من القيود: قيود كمية، وهذه ممنوعة بموجب المادة 11 من الجات. أما القيود المتعلقة بالتعريفة الجمركية فلم تقيد. معنى ذلك أن أي بلد يستطيع فرض التعريفة التي يراها مناسبة على الواردات، سواء لحماية صناعته الوطنية، أو لخلق شروط عادلة للمنافسة، أو لتامين موارد للخزينة الحكومية..الخ. يستثنى من ذلك ما يسمى بالتعريفات الجمركية المربوطة(Bound Tariffs). بموجب هذا النوع من التعريفات فإن حرية أي بلد في زيادة التعريفة الجمركية تقيدها ما يسمى بحدود الربط. من القواعد المتعارف عليها في منظمة التجارة العالمية أن يقدم كل بلد جدولا خاصاً بالضرائب المربوطة، يسمى بالجدول الوطني للتنازلات(National Schedule of concessions)، تتعين بموجبه الحدود التي تفقد بعدها الدولة المعنية حريتها في زيادة الضريبة الجمركية، بل غيرها من الضرائب، والأعباء المالية الأخرى.(المادة 2، الفقرة 7 من الجات).
تقوم فكرة الربط على الأسس التالية:
- حرية كل دولة في ربط الضرائب الجمركية على ما تستورده في ضوء مصالحها.
- تحقيق المصلحة الوطنية، بربط الضريبة بمستوى التنازلات التي يقدمها الشركاء التجاريون، وهذا يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات. فعلى سبيل المثال،بلداً معينا يفرض ضريبة على سلعة يستوردها من بلد آخر(أو من مجموعة بلدان) تصل إلى 50% من قيمتها ، في حين يصدر في الوقت ذاته إلى البلد المعني سلعة أخرى يفرض عليها هذا الأخير ضريبة تصل إلى 30% من قيمتها. فإذا وجد البلد المعني أن له مصلحة في تخفيض الضريبة على سلعته التي يصدرها بحيث تربط عند حدود 15%، فإنه يدخل في مفاوضات مع شركائه التجاريين، فيعرض عليهم ربط ضريبته على وارداته منهم عند حد 25% على أن يخفضوا ضرائبهم على وارداتهم منه إلى حد10% مثلاً.فإذا حصل اتفاق على ذلك تصبح البلد المعنية مقيدة من ناحية فرض ضرائب على وارداتها من الشركاء التجاريين عند حد 25%، على أن يخفضوا هم من جهتهم ضرائبهم إلى حد 10%. هذه الحدود الضريبية المتفق عليها، تسجل في الجداول الوطنية لكلا الطرفين. ومتى تم الاتفاق على حدود الربط تستطيع جميع الدول في منظمة التجارة الدولية أن تستفيد من حدود الربط تلك، وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
في العادة، يقدم العرض والطلب لربط الضرائب الجمركية خلال الجولات التفاوضية متعددة الأطراف، التي تعقدها منظمة التجارة العالمية بين الحين والآخر. وإذا حصل، وجاء وقت، ارتأت الدولة المعنية فرض ضرائب تزيد عن حدود الربط، أو أن تلغي الربط ذاته، فإنها تدخل في مفاوضات جديدة مع الدول التي اتفقت معها على حدود الربط، وكذلك مع الدول التي لها مصالح جوهرية في السلع المربوطة. وفي حال تم الاتفاق على إلغاء الربط، أو تعديله، يتوجب عندئذ على الدولة المعنية أن تقدم تنازلات بديلة معادلة في القيمة لما تم إلغاؤه، وإلا سوف تضطر الدول الأخرى إلى إلغاء الربط من جهتها. وفي مجمل الأحوال لا بد من التقيد بجدول المواعيد المحدد بالمادة 28 من الجات.
ج- تحرير التجارة مسألة سيادية.
لقد أصبح واضحاً، أن تحري التجارة غير حرية التجارة، وان تحرير التجارة مسألة سيادية للدول. مع ذلك فقد نجحت الجولات التفاوضية متعددة الأطراف في إطار الجات، خصوصا جولة أورجواي التي استمرت من أيلول 1986 إلى نهاية عام 1993، أي ما يزيد عن سبع سنوات، وجرى التوقيع على اتفاقاتها في مراكش في نيسان عام 1994، ودخلت حيز التنفيذ في مطلع عام 1995، في تحري قسم هام من التجارة الدولية، ونجحت في تخفيض الضرائب الجمركية في الدول المتقدمة من نحو 40% بالمتوسط، إلى نحو 8%. ومع أن الدول النامية لم تكن العنصر الفاعل في المفاوضات إلا أنها استفادت من هذا الربط للتعريفات الجمركية عند حد 8% استنادا إلى مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.ولم تلزم نفسها بربط ضرائبها حتى جولة أورجواي، غير انه في هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات المتعددة الأطراف فقد ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية، على هذه الدول لكي تخفض معدلات ضرائبها، وتحرر تجارتها. لكن مع ذلك فهي لا تزال بعيدة جداً عن المستوى الذي وصلته البلدان المتقدمة. بمعنى آخر لم تعد الضريبة الجمركية عقبة أمام دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة، بسبب ربطها عند حدود منخفضة جداً.
في الواقع لم تكن المشكلة محصورة في التعريفة الجمركية، بل في القيود الكمية. ومع أن الجات في المادة 11 قد نص صراحة على تحريم القيود الكمية، إلا أنه أجازها في حالات محددة واستثنائية، كما في حالة حماية ميزان المدفوعات( المادة 12 من الجات). ورغم أن جميع الدول تستطيع الاستفادة من هذا الاستثناء، فإن الدول النامية هي المستفيد الأكبر منه ، نظراً لحدوث عجوزات متكررة في موازين مدفوعاتها. وقد جاءت المادة 18 من الجات( المساعدات الحكومية للتنمية الاقتصادية) لتوسع كثيراً من نطاق الاستثناءات الممنوحة بموجب المادة 12، مما سمح للبلدان النامية أن تفرض قيوداً كمية على الواردات ليس فقط من أجل تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات، بل من أجل حماية الصناعة الوطنية، طالما لا يوجد إجراء آخر، وهذا ما وضحته الفقرتان 2 و 3 من المادة 18 من الجات.
د- الحماية ضد المنافسة غير العادلة.
د-1 –الحماية من الإغراق.
الإغراق يعني بيع السلعة في البلد المستورد لها، بسعر يقل عن سعرها في بلد المنشأ، المصدر لها. تلجأ الدول إلى الإغراق في حال كان لديها فائض كبير من سلعة معينة، أو لإخراج المنتج المحلي من المنافسة، ومن ثم العودة إلى بيع السلعة بسعر أعلى بعد ذلك.
ولكي يتحقق الإغراق لا بد من توفر الشروط التالية:
- بيع المنتج بسعر يقل عن سعره في البلد المصدر.
- انهيار أو تراجع الصناعة الوطنية المنتجة لسلعة مشابهة.
- وجود علاقة سببية بين السلعة المستوردة، المسببة للإغراق، وحصول الضرر الملموس الذي لحق بالمنتج المحلي.
في هذه الحالة يحق للبلد المستورد للسلعة المسببة للإغراق أن يفرض ضريبة جمركية إضافية، تسمى بالضريبة المضادة للإغراق(Anti-dumping duties) معادلة لهامش الإغراق، أي للفرق بين سعر السلعة في البلد المصدر، وسعر مثيلتها في البلد المستورد.
هذا وتجيز نصوص اتفاقية مكافحة الإغراق إبقاء الضريبة المضادة، طالما لم يزل سبب فرضها، على أن تتم مراجعة دورية لهذه الأسباب. وفي مجمل الأحوال لا يجوز أن تستمر الضريبة لمدة تزيد عن الخمس سنوات، يتم خلالها إزالة الأسباب الموجبة لفرضها.
وقبل فرض الضريبة المضادة للإغراق ثمة إجراءات لا بد من القيام بها. مثلا لا بد أولاً، من إجراء تحقيق شامل للتحقق من توفر شروط حدوث الإغراق.
وثانيا، أن يجري التحقيق بناء على طلب المنتجين المحليين، سواء أكانوا من أنصار فرض الضريبة المضادة للإغراق، أو من معارضيها، علما أنه في حالات محددة يمكن للبلد المستورد، أن يباشر التحقيق بدون وجود طلب من المنتجين المحليين.
وثالثا، ينبغي أن لا تقل حصة المنتجين المحليين، الذين طالبوا بالتحقيق في قضية الإغراق، من مجمل الإنتاج المحلي للسلعة المعنية عن 50%.
ورابعا؛ ينبغي إشراك البلد المصدر في جميع مراحل التحقيق.
د-2- الحماية من الدعم غير المشروع.
الدعم غير المشروع للسلع المصدرة يكسبها قوة تنافسية، تسمح لها بتخفيض سعرها، إلى مستوى يقل عن سعرها الفعلي في غياب الدعم. هذا النوع من الدعم يتسبب في منافسة غير عادلة بين السلعة الوطنية، والسلعة المستوردة، ولذلك فقد سمح للبلدان المستوردة أن تفرض ضريبة إضافية على السلعة المستوردة، تسمى بالضريبة التعويضية(Countervailing duties).
تشبه هذه الضريبة، من حيث شروط فرضها، الضريبة المضادة للإغراق؛ أي لا بد من وجود الدعم، وحصول الضرر الملموس، وتوفر العلاقة السببية بين الدعم، وحصول الضرر الملموس. وبالنظر إلى التشابه الكبير بين كلا الضريبتين فقد جمعتهما اتفاقية الجات في مادة واحدة، هي المادة السادسة، غير أن جولة أورجواي فرقت بينهما.
الإغراق هو تعبير عن سياسة المشروعات الخاصة، التي تحاول الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة. أما الدعم فهو إجراء تقوم به الحكومات أو الجهات العامة، ولقد ميزت الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف بين ثلاثة أنواع من الدعم:
- الدعم المحظور إطلاقا(Prohibited subsidies)، وهو نوعان: دعم تمنحه الدولة لسلعها التصديرية، وهي بذلك يمكن أن تؤثر على سير التجارة الدولية. ودعم تقدمة الحكومة لسلعة محلية محلة للواردات، وهو يتوقف على نسبة المكون المحلي في السلعة المعنية.
يحق لكل دولة تأثرت من سياسات الدعم لدولة أخرى، أن تفرض رسوما إضافية مضادة، أو تقدم شكوى إلى هيئة الخبراء المشكلة لهذا الغرض. وإذا ثبت لهيئة الخبراء وجود الدعم المحظور، فإنها تطالب بإلغائه.في هذه الحالة لا تطالب الدولة المشتكية بإثبات حصول الضرر الملموس والعلاقة السببية بينه وبين هذا النوع من الدعم.
- الدعم المسموح إطلاقاً(Non-actionable subsidies).يشمل هذا النوع من الدعم، ما تقدمه الدولة للبنية التحتية، مثل شق الطرق، ومد الكهرباء، أو تمويل الأبحاث في القطاعات المنتجة للسلع، أو في مجال المحافظة على البيئة.
- الدعم المشروط(Actionable subsidies). هذا النوع من الدعم يمكن أن يكون محل شكوى في حال تسبب بأضرار ملموسة، أو حال دون الحصول على منافع. مثلاً، عندما يتسبب دعم معين بإلغاء المنفعة التي كان يمكن تحقيقها من جراء ربط الضريبة عن حد معين.
ومع أن إجراءات مكافحة المنافسة غير العادلة( الإغراق والدعم) معقدة جداً، وتشمل على تفاصيل إجرائية كثيرة، إلا أن الدول النامية تتمتع باستثناءات كثيرة. لهذا الغرض تم تصنيف البلدان النامية في ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى، وتشمل البلدان الأقل نموا حسب تصنيف الأمم المتحدة. والمجموعة الثانية، وتشمل البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي عن 1000 دولار أمريكي. هاتين المجموعتين من الدول يحق لهما فرض ضرائب على الواردات، أو دعم صادراتها، دون أن يحق للبلدان المستوردة فرض ضرائب مضادة.
في حين المجموعة الثالثة التي يزيد نصيب الفرد من مواطنيها من الدخل الوطني عن ألف دولار أمريكي هي وحدها التي تنطبق عليها إجراءات مكافحة المنافسة غير العادلة.
هـ- الحماية من المنافسة الضارة.
المنافسة قد تكون مشروعة، لكنها ضارة، لذلك حرمت الجات في المادة 19 منها، هذا النوع من المنافسة. مثال على ذلك، الزيادة المفاجئة من الواردات من سلعة معينة ،والتي قد تلحق أضراراً كبيرة بالصناعة الوطنية، أو تهدد بحدوثها. وقد تلجأ بعض الدول إلى تصدير كميات كبيرة من سلعة معينة إلى بلد آخر، بسبب زيادة الإنتاج منها، بما يفيض عن حاجة السوق المحلية، أو بسبب حصول كساد في البلد المعني، مما يجعل القوة الشرائية المحلية عاجزة عن امتصاص العرض الزائد منها.
ومع أن هذا النوع من التجارة مشروع، فهو لا يسبب الإغراق، ولا يحصل على دعم، فقد أجازت اتفاقات منظمة التجارة العالمية للمستورد اتخاذ إجراءات وقائية لمنع حصول الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تلحق بصناعته.
غير أن اللجوء إلى ما أصبح يعرف بالشرط الوقائي لحماية الصناعة المحلية، يتطلب توفر شروط معينة:
أولاً؛ لا بد أن يكون الضرر الذي لحق بالصناعة جسيماً،(Serious injurity)، إذ لا يكفي فقط حصول ضرر ملموس (Material injurity)، كما يحصل في حالة الإغراق والدعم.
ثانياً؛ يتوجب على الدولة التي تستخدم الإجراء الوقائي تعويض الدولة المصدرة، عن الأضرار، أو الآثار السلبية، التي قد تلحق بها، من جراء تقييد صادراتها دون جرم، أو مخالفة ارتكبتها.
من الناحية الإجرائية يمكن للدولة المستوردة تطبيق الشرط الوقائي عن طريق فرض رسوم جمركية تعوض الضرر، أو تمنع حصوله، أو أن تلجأ إلى القيود الكمية على الواردات من السلعة المعنية، موضوع الشكوى، على أن لا تقل الحصة المسموح بها عن متوسط كمية الواردات منها خلال السنوات الثلاث الماضية.
يمكن أن يستمر تطبيق الشرط الوقائي لمدة أربع سنوات، قابلة للتمديد لأربع سنوات أخرى في البلدان المتقدمة، ولمدة عشر سنوات في البلدان النامية. وفي مجمل الأحوال لا يطبق الشرط الوقائي على البلد النامي إذا كانت حصته من الواردات لا تزيد عن 3%، على أن لا تزيد حصة الدول النامية مجتمعة عن 9%.
و- المساواة في المعاملة.
لقد لا حظنا في المبحث السابق، وفي حال كون البلدان النامية مستوردة للسلع أن اتفاقات الجات قد أجازت لها اتخاذ إجراءات كثيرة لحماية صناعتها الوطنية، من التأثير الضار للواردات، مثل فرض رسوم جمركية، وحتى تقييد الكميات المستوردة، بحيث تكون المنافسة مع المنتج المحلي عادلة، وغير ضارة.
غير أن الدول النامية تتمتع بمزايا كثيرة أيضاً، في حال كونها مصدرة للسلع إلى البلدان المتقدمة. من أولى هذه المزايا عدم التمييز.
بموجب الحق بعدم التمييز(Non-discrimination) فإن الدولة النامية تستطيع تصدير سلعها إلى الأسواق على قدم المساواة مع بقية الدول الأخرى. يعرف هذا المبدأ في التجارة الدولية باسم مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية(Most favored nation clause) المنصوص عنه في المادة الأولى من الجات. بموجب هذا المبدأ تحقق البلدان النامية مساواة كاملة مع بقية البلدان، من حيث الإجراءات، والمزايا، والتسهيلات، والحصانة..الخ التي تمنح للسلعة. ولا يشترط لذلك أن تكون هذه المزايا مسجلة في السجل الوطني للتنازلات.فإذا أعطت دولة معينة لدولة أخرى مزية جمركية، أو أية ميزة أخرى، فإن هذه الميزة تستفيد منها تلقائيا جميع الدول الأخرى الشريكة لها تجارياً.
إن مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، هو من المبادئ الأساسية، والشاملة في الجات، وفي منظمة التجارة العالمية. مع ذلك فهو يواجه باستثناءين: الأول ويتعلق بنظام الأفضليات الجمركية الممنوح للبلدان النامية. والثاني، يتعلق بتمييز دولة معينة عضو في تكتل إقليمي.
فعندما تكون دولة معينة عضو في تكتل إقليمي، تتبادل من خلاله تنازلات معينة، مثلا إلغاء الجمارك، فإن هذه الدولة تستطيع تمييز الدول الأخرى الأعضاء معها في التكتل ذاته، دون أن ينسحب ذلك على الدول الأخرى غير الأعضاء في التكتل المعني. ومع أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية، إلا أن المادة 24 من الجات قد أجازته ضمن شروط معينة:
-التدرج في إلغاء التعريفة الجمركية وغير الجمركية على التجارة البينية خلال فترة زمنية معينة.
-أن لا يؤدي الاتحاد الجمركي، أو إنشاء المنطقة الحرة إلى زيادة الحواجز الجمركية، وغير الجمركية، بحيث تصبح أعلى مما كانت عليه قبل إنشاء الاتحاد الجمركي، أو المنطقة الحرة.
ومع أن المادة 24 من الجات قد أجازت للتكتلات الاقتصادية الخروج عن مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية، إلا انه من الناحية العملية تم استخدام هذه المادة في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، لا ترقى إلى مستوى التكتل الإقليمي، أو منطقة للتجارة الحرة، لذلك تفكر منظمة التجارة العالمية في إعادة النظر في هذه المادة بحيث تصبح أكثر وضوحا ودقة.
من جانب آخر فإن مبدأ عدم التمييز، وشرط الدولة الأَولى بالرعاية، لا تؤثر على مساواة المنتج الوطني مع المنتج الأجنبي، أي ما يعرف باسم مبدأ المعاملة الوطنية(National treatment) الذي نصت عليه المادة الثالثة من الجات.غير أن المساواة هنا اقتصرت على الضرائب والإجراءات الداخلية من قوانين ولوائح، ولم تشمل الإجراءات الحدودية، من حيث التعريفة الجمركية أو القيود غير التعريفية.لكن بمجرد أن تدخل السلعة الأجنبية إلى السوق الداخلية بعد استيفائها للضرائب الجمركية، والقيود الأخرى غير التعريفية، فإنها تعامل معاملة السلعة الوطنية، ولا يجوز عندئذ فرض أية ضريبة، أو قيد عليها دون السلعة الوطنية. يطبق هذا المبدأ على جميع السلع المستوردة سواء كانت خاضعة لضريبة جمركية مربوطة أو غير مربوطة.
ز- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية.
عندما وقعت اتفاقات الجات لأول مرة في عام 1947، فقد كانت أغلب الأطراف المتعاقدة دول متقدمة، لذلك ساوت الاتفاقية بينها في الحقوق والواجبات. لذلك لم تلحظ اتفاقية الجات آنئذ مصالح الدول النامية في التنمية، واقتصرت الإشارة في المادة 18 منها على منح الدول النامية مرونة اكبر في مجال استخدام الضرائب الجمركية، والقيود الكمية، وغيرها، من اجل حماية صناعتها الوطنية، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وحمايته. في ذلك الحين كانت أغلب الدول النامية مستعمرة، ولذلك لم يجري الاهتمام بمصالحها في مجال التنمية.
غير أن الوضع بدا يتغير منذ عام 1964 مع إنشاء منظمة التنمية الصناعية( الأونكتاد)، التي كان هدفها الأساسي هو الدفاع عن مصالح الدول النامية وعن احتياجاتها التنموية. لقد رفضت الأونكتاد مبدأ المساواة بين أطراف غير متكافئة. أضف إلى ذلك، فإن التغيرات الاقتصادية العالمية، قد فرضت ضرورة مراجعة الجات، وشكلت لهذا الغرض لجنة برئاسة الاقتصادي المعروف هابرلر (Haberler)، للنظر في التعديلات المطلوبة، كان من ثمار عملها إضافة الفصل الرابع للجات في منتصف الستينات.
يتكون هذا الفصل من المواد36 و37 و38، وهي تتعلق بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية. ومع أن هذه المواد لا تلزم البلدان المتقدمة بالتزامات محددة، تجاه توفير متطلبات التنمية في البلدان النامية، إلا أنها شكلت منطلقاً جديدا في مسيرة الجات، وموقفها من الدول النامية. لقد منحت البلدان النامية أفضليات جمركية، وهذا يتعارض مع مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية المنصوص عنه في المادة الأولى من الجات. ومن أجل مساعدة البلدان المتقدمة على تطبيق نظام الأفضليات الجمركية فقد تم إعفاؤها في عام 1971من التقيد بمبدأ الدولة الأَولى بالرعاية لمدة عشر سنوات، أي حتى عام 1981. وقبل نهاية هذه المدة توافقت الدول المشاركة في جولة طوكيو في عام 1979 على مبدأ المعاملة المختلفة والتفضيلية، الذي أصبح يعرف بالشرط التكميلي(Enabling clause).
في جولة أورجواي تم تطوير نظام الأفضليات الجمركية، بحيث أصبحت الدول النامية تتمتع بمعاملة خاصة، فقد تم إقرار مبدأ المساعدات الفنية، والمساعدة المالية، ومنحت فترات انتقالية أطول، ولم يجري التشدد كثيراً في تطبيق الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقات المتعلقة بتحرير التجارة. بل تم إعفاء الدول الأقل نمواً من معظم الالتزامات التي تضمنتها اتفاقات جولة أورجواي.
ح- فتح الأسواق أمام سلع البلدان النامية.
لقد أفضت الجولات التفاوضية الثمانية التي أشرفت عليها الجات، إلى تخفيض الضرائب الجمركية إلى ما دون 10% بالمتوسط، وزيادة الضرائب المربوطة إلى ما يزيد عن 90% من التعريفات الجمركية في البلدان المتقدمة. إن مجمل هذه التغيرات في الظروف الاقتصادية الدولية، سهلت عملية فتح الأسواق في البلدان المتقدمة أمام منتجات الدول النامية. وفي جولة أورجواي فقد تم اتخاذ إجراءات حاسمة في صالح البلدان النامية. من هذه الإجراءات ما يتعلق بالرسوم الجمركية المتصاعدة ( Tariff Escalation) التي كانت تشجع البلدان النامية على تصدير المواد الأولية، نظراً لانخفاض الجمارك عليها، بل انعدامها في كثير من الحالات. في حين كانت تتصاعد الجمارك مع زيادة درجة تصنيع المادة الأولية، لتصل ذروتها في السلعة المصنعة بالكامل.في جولة أورجواي تم قلب هذه المعادلة بحيث أصبحت الجمارك تنخفض مع زيادة المادة المصنعة.أضف إلى ذلك فقد أزيلت القيود الكمية على صادرات المنسوجات والمنتجات الزراعية، وهذان القطاعان من أهم القطاعات الاقتصادية في الدول النامية.
كما هو معروف، ومنذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، أن جميع الدول المتقدمة قد انتهجت سياسة زراعية تقوم أساسا على حماية ودعم المنتجات الزراعية المحلية، واستخدمت لهذا الغرض حتى القيود الكمية، مخالفة بذلك أحكام المادة 11 من الجات. ولقد فشلت جميع جولات المفاوضات السابقة على جولة أورجواي في حل هذه المشكلة، بسبب إصرار الدول المتقدمة، وخصوصا دول الاتحاد الأوربي، على منع الخوض في هذا الملف المعقد. لقد كانت السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوربي تقوم أساسا على تقديم مختلف أشكال الدعم والحماية للزراعة، منها ما أخذ صورة قيود تعريفية، ومنها ما أخذ صورة قيود كمية. بل وتوسع نطاق الدعم ليشمل الصادرات. كل ذلك ساهم في إكساب المنتجات الزراعية الأوربية مزايا نسبية لا تتمتع بها أصلا، وتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالدول النامية على وجه الخصوص.
غير أنه وتحت ضغط بعض الدول المتقدمة المصدرة للمنتجات الزراعية، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم فتح هذا الملف، ووضع أخيراً، على طاولة المفاوضات، التي أسفرت في النهاية، عن اتفاق قضى بتحويل جميع القيود الكمية، وغير التعريفية، إلى قيود تعريفية. بهذا الشكل تمت إعادة الزراعة إلى التقيد بقواعد السلوك التجاري التي نصت عليها الجات. وأكثر من ذلك فقن تم الاتفاق على تخفيض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية بنسبة 36%، على أن تنفذ ذلك الدول المتقدمة خلال ست سنوات، في حين منحت الدول النامية مهلة من عشر سنوات، وقد تم ربط جميع الضرائب على السلع الزراعية وسجلت في الجداول الوطنية.أضف إلى ذلك اتخذت إجراءات لتخفيض الدعم الممنوح للصادرات، بنسبة 20% في الدول المتقدمة،و 13% في الدول النامية، على أن يتم استثناء الدعم الذي يقدم للبحث والتطوير، ولمقاومة الآفات الزراعية، وللإرشاد الزراعي.
إن تحرير التجارة بالسلع الزراعية، وتخفيض الإجراءات التعريفية عليها، ومنع القيود غير التعريفية، جعل العديد من الدول المستوردة للمنتجات الزراعية، تتخوف من ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مما سوف يترتب عليه ارتفاع قيمة فاتورة الغذاء.
ومع أن هذا التخوف ليس بلا أساس، إلا أنه تخوف مبالغ فيه. وللتخفيف منه رغبت الدول النامية أن يصدر المجلس الوزاري قراراً يقضي بالمراجعة الدورية لمستوى المعونات الغذائية، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ذلك، والحرص على أن لا يتراجع مستوى المعونات المقدمة للدول النامية. بل وحصلت الدول النامية المستوردة للغذاء على موافقة الدول المتقدمة من اجل زيادة الدعم المالي والفني لتحسين مستوى الإنتاج الزراعي لديها.
من جهة أخرى فإن قطاع المنسوجات والملابس وهو من القطاعات الهامة جداً بالنسبة للبلدان النامية، نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا نسبية، فقد ظل لفترة طويلة خارج نطاق المفاوضات المتعددة الأطراف، تنظمه اتفاقات خاصة. ومع أن القيود الكمية على صادرات المنسوجات في عام 1962 كانت تشمل المنسوجات القطنية فقط، إلا أنها منذ عام 1974 توسعت لتشمل جميع أنواع المنسوجات والخيوط. ولم تفلح جميع جولات المفاوضات السابقة على جولة أورجواي أن تحرر هذا القطاع، وتخضعه لاتفاقات الجات، واستمر العمل فيه بنظام الحصص، بحيث لا تستطيع أية دولة أن تصدر أكثر من حصتها.
في جولة أورجواي نجحت الدول النامية في إلغاء نظام الحصص، وإخضاع التجارة بالمنسوجات إلى قواعد الجات، من خلال تقديم تنازلات معينة للدول المتقدمة التي طالبت في إخضاع قطاع الخدمات إلى اتفاقات الجات أيضاً، علما أن اتفاقات الجات من حيث الأساس لا تشمل سوى التجارة بالسلع. وهكذا ومن خلال التوافق والتوفيق بين مصالح الدول النامية والدول المتقدمة فقد تم إخضاع قطاع الخدمات لاتفاقات الجات ، في مقابل إلغاء نظام الحصص على التجارة بالمنسوجات والخيوط.
وبطبيعة الحال لم يكن بمقدور البلدان النامية أن تغامر بتحرير قطاع المنسوجات دفعة واحدة، نظراً لأن هذا القطاع يشغل أعداد كبيرة من اليد العاملة وهو لا يتمتع بمزايا تنافسية مثل مثيله في البلدان النامية، لذلك تم الاتفاق على خطة من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تبدأ من بداية عام 1996 وتنتهي في نهاية عام 1997، تحرر خلالها الدول الصناعية نحو 16% من قيمة ما تستورده من منسوجات وخيوط وملابس. وفي المرحلة الثانية التي تنتهي مع نهاية عام 2001، تحرر 17% أخرى من قيمة مستورداتها النسيجية. أما المرحلة الثالثة التي تنتهي مع نهاية عام 2004 فيتم فيها تحرير 18% أخرى إضافية، بحيث يبلغ إجمالي ما تم تحريره منذ بداية المرحلة الأولى نحو 51%، على أن يتم تحير الباقي والبالغ نحو 49% مع مطلع العام 2005.
لقد أصبح باستطاعة البلدان النامية، جراء هذا الاتفاق، الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة بشروط مريحة، مما سوف يترك آثارا إيجابية على اقتصادياتها. فمن المعروف أن صناعة المنسوجات في هذه الدول هي صناعة حديثة، ترتبط بها صناعات تكميلية أخرى عديدة .
من جهة أخرى فتح هذا الاتفاق الباب على مصراعيه بين الدول النامية للمنافسة على الحصول على اكبر حصة ممكنة من أسواق البلدان المتقدمة. ولما كانت البلدان النامية تتفاوت كثيراً من حيث قدرتها على تطوير صناعتها النسيجية، وتحسين نوعية منتجاتها، لذلك لا مفر من أن يلحق بعض الضرر بالبلدان ضعيفة القدرة التنافسية، التي كان يحمي حصتها نظام الحصص السابق.
7- تسوية المنازعات وحقوق الدول النامية.
إن من طبيعة العلاقات الدولية أنها متعارضة، بتعارض المصالح الدولية والرأسمالية الواقفة وراءها. غير أنها في الوقت ذاته تقبل التسوية من خلال البحث عن تقاطعات ممكنة بينها، أو من خلال الاتفاق على قواعد معينة تنظم حراكها وأداءها، وهي في وضعية الاختلاف. وبقدر ما تكون هذه القواعد محكمة الضبط، وتحوذ على الاجماع والقبول، بقدر ما يسهل فض المنازعات الدولية الناجمة عن التجارة بسبب اختلاف المصالح، بسرعة قصوى، فالزمن هنا له أهمية كبيرة، إنه عامل متغير مستقل له تأثيره الكبير على مجمل الأوضاع الدولية، ومنها العلاقات الاقتصادية والتجارية. في هذا الاتجاه جاء تاكيد مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات، على ضرورة التسوية السريعة للمنازعات، ليس لتأثير ذالك على العلاقات التجارية الدولية فقط، بل لتأثيره على وجود ومصداقية منظمة التجارة العالمية ذاتهما.
لم يكن سهلا التوصل إلى مذكرة تفاهم حول قواعد وطرق وآجال تسوية المنازعات التجارية، بل مر تاريخ طويل من المناقشات والمقترحات والاعتراضات في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف من أجل إنجاز ذلك ووضع هذه القضية في حالة مستقرة وفعالة. قد يكون من غير المعلوم لغير المختصين أن اتفاقيات التجارة الدولية المتعددة الأطراف في ظل الجات، لم تتضمن سوى مادتين تتعلقان بموضوع تسوية المنازعات، وبقي تنفيذ الأحكام متوقفا على موافقة الطرف المشتكى عليه. وفي عام 1979 جرت محاولات لتطوير إجراءات تسوية المنازعات التجارية بين الدول، وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ، أي في عام 1989 تم اعتماد جهاز مؤقت لفض المنازعات، ومع ذلك بقيت جميع هذه الاجراءات قاصرة، مليئة بالثغرات والنواقص، ولذلك استقر الرأي على ادراج جميع القضايا المتعلقة بجهاز تسوية المنازعات وقواعد عمله ضمن مفاوضات جولة أورجواي التي استمرت نحو ثمانية سنوات(1986-1994) من اجل تحسينه[5].
وهكذا وبعد مفاوضات طويلة ومضنية تم التوصل إلى مذكرة تفاهم جديدة تتعلق بإنشاء جهاز جديد لتسوية المنازعات التجارية، واعتماد قواعد وإجراءات محددة لعمله. وبموجب مذكرة التفاهم المشار إليها أصبح هناك جهاز واحد في إطار منظمة التجارة العالمية لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف، وهو الجهة الوحيدة المخولة " إنشاء هيئات التحكيم، والموافقة على تقاريرها، وتقارير هيئة الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القوانين والتوصيات، والموافقة على إجراءات إنتقامية في حال عدم تنفيذ التوصيات "[6].
يتميز الجهاز الجديد لتسوية المنازعات بالمقارنة مع الآليات التي كانت متبعة في إطار الجات بأنه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5-محسن أحمد هلال، "تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية"، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا(الإسكوا)، أوراق موجزة، الأمم المتحدة، نيويورك 2001، ص 1
6- المرجع السابق، ص 1
أ- أصبح الجهة الوحدية المخولة معالجة القضايا المرتبطة بالنزاعات التجارية، واختلافات تطبيق اتفاقيات التجارة، في حين كانت هذه القضايا موزعة بين المجلس العام واللجان التي انبثقت عن جولة طوكيو.
ب- اعتماد صيغة الاجماع لانشاء هيئات التحكيم، واعتماد تقاريرها
ت- لم يعد بموجب النظام الجديد بمقدور طرفي النزاع عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة لتسوية المنازعات.
ث- إنشاء هيئة استئناف.
ج- سمح النظام الجديد للمشتكي أن يتخذ إجراءات إنتقامية ضد المشتكى عليه في حار رفض هذا الأخير تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم، بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به.
7-1 حل مشكلة التعارضات بين الاتفاقات، بما يخدم الدول النامية.
لقد صدر عن جولة أورجواي نحو 27 اتفاقا وتفاهما، بالإضافة إلى اتفاقات الجات. ولقد تميزت هذه الاتفاقات بطابعها الشمولي، بمعنى أنها تخضع لقاعدة الالتزام بها كحزمة واحدة، وجميعها تحت سلطة جهاز فض المنازعات.غير أنه قد يحصل نوع من التعارض بين أحكام اتفاق وأخر، ولذلك فقد اعتمدت منظمة التجارة العالمية جملة من القواعد لتسويتها، وفق ما يلي:
-إذا حصل تعارض بين اتفاقات الجات، وأي اتفاق من اتفاقات منظمة
التجارة العالمية الخاصة بالتجارة بالسلع، فإن الأولوية تكون لاتفاق التجارة بالسلع[7].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7-هامش الملحق 1، الخاص بالتجارة بالسلع، الفقرة أ
- وإذا حصل تعارض بين اتفاق التجارة بالسلع الزراعية، وأي اتفاق أخر للتجارة بالسلع، أو بينه وبين اتفاقات الجات، فإن الأولوية تكون لاتفاق الزراعة[8].
- في حال تعارض اتفاق الزراعة مع الأحكام الخاصة بالصحة(Sanitary and phytosanitary agreement ) ، سواء صحة الإنسان أو الحيوان والنبات، والمعروفة اختصاراً(SPSA) ، فإن الأولوية تكون لاتفاق الصحة[9].
- إذا تعارض اتفاق الصحة مع اتفاق الحواجز الفنية للتجارة (Technical barriers of trade )ومختصرها(TBT) ، فإن الأولوية لاتفاق الصحة[10].
- إذا تعارضت " التفاهمات على القواعد والإجراءات لتسوية المنازعات " مع الأحكام الخاصة أو الإضافية لتسوية المنازعات في أي اتفاق " مشمول"، فإن الأولوية تكون للأحكام الخاصة أو الإضافية[11].
- لم يتم النص على الأولوية في حال حصل تعارض بين الجات 1994، وأحكام التجارة بالخدامات (الملحق 1، الفقرة ب)، أو أحكام الملكية الفكرية( الملحق 1، الفقرة ج). غير أنه تم التعارف على أن الأولوية تكون لكل اتفاق في نطاقه الخاص.
7-2-نحو نظام لتسوية المنازعات أكثر عدلاً.
بالرغم من التحسين الواضح في نظام تسوسة المنازعات التجارية الدولية، إلا أن ثمة إمكانيات كبيرة لتحسينة، وهناك الكثير من المقترحات التي تصب في هذا الاتجاه، سوف تاخذها المفوضات المتعددة الاطراف، في جولاتها القادمة، بعين الاعتبار.
8- الفقرة 1 من المادة21 من اتفاق الزراعة
9- المادة 14 من اتفاق الزراعة.
10-الفقرة 5 من المادة 1 من اتفاق الحواجز الفنية للتجارة.
11- الفقرة 2 من المادة 1 من التفاهم المذكور.
وتبقى قيمة أي اتفاق دولي بقدر التزام الأطراف به، والتقيد بأحكامه، والعمل على تنفيذه بروح إيجابية. ونظرا لاحتمال حدوث خروقات، فإن الاتفاقات ذاتها تلحظ، في العادة، آلية معينة لتسوية المنازعات التي تحصل بين الأطراف المتعاقدة. وفي المجال التجاري يبدو أن حصول منازعات أمر لا مفر منه، ولذلك فإن تسوية هذه المنازعات، هو الأخر، أمر لا غنى عنه.
من المعروف أن قدرات الدول تتفاوت تفاوتاً شديدا في مجال العلاقات التجارية، فالدول ذات الأسواق الكبيرة، تستطيع فرض إرادتها، على الدول ذات الأسواق الصغيرة، وترغمها، في كثير من الأحيان، على القبول بما هو أقل من حقها. ولم تستطع اتفاقات الجات إيجاد حل لهذه المشكلة، واستمرت في اعتماد المفاوضات الدبلوماسية كوسيلة لتسوية المنازعات بين
الفرقاء التجاريين. بكلام آخر كان مبدأ التراضي وليس التقاضي هو المبدأ المعمول به، وبرز ذلك في المادتين 22 و 23 من الجات.
لقد أجازت المادة 22 للطرف المتعاقد، في أن يطلب من الطرف الآخر الشروع في المشاورات لتنفيذ الاتفاقات التجارية، في حين أن المادة 23 أجازت له الحق في التوقف عن تقديم التنازلات، بل الخروج من الجات في حال فشل الطرفان المتنازعان في تسوية النزاع خلال مدة زمنية محددة. ينطبق ذلك، بصورة خاصة، على المخالفات الجسيمة. وإن الحق بالخروج من الجات ممنوح لجميع الأطراف المتعاقدة، ومن ضمنهم الطرف صاحب الشكوى، وذلك في حال عدم قبوله بوقف التنازلات التي طلبها من الطرف المشكو.
لقد استمرت طريقة المفاوضات الدبلوماسية، لتسوية النزاعات التجارية، لمدة ثلاث عقود، ولم تستطع جولة طوكيو للمفاوضات المتعددة الأطراف تجاوزها، مع أنها أقرت ضرورة الاستفادة من بعض جوانبها، وبشكل خاص ما يتعلق منها بالإخطارات والمشاورات والرقابة على التنفيذ. ورغم الطابع الاختياري لهذه الطريقة في تسوية المنازعات، لكن لم يكن لأي طرف مصلحة في انهيار نظام التجارة الدولي، لذلك فقد تم تسوية كثير من النزاعات التجارية(تجاوز عددها المئتين)، بهذه الطريقة، مع أن بعضها كان على درجة عالية من التعقيد.
غير أن الاعتماد على الإرادة السياسية للأطراف المتعاقدة، لا يكفي لوحده لقيام نظام تجاري دولي راسخ ومتين، بل لا بد من تشييده على منظومة من القواعد المعروفة، ينبغي احترامها والتقيد بها. لذلك اتفقت الدول المشاركة في جولة أورجواي على نظام جديد لتسوية النزاعات التجارية، يمكن أن يشكل خطوة كبيرة باتجاه الوصول إلى نظام التقاضي الكامل الذي لا غنى عنه مستقبلا إذا ما أريد للعلاقات التجارية الدولية الاستقرار. يعرف النظام المنبسق عن جولة اورجواي اختصارا بـ(DSU)[12]، وهو يتميز بما يلي:
- تم إلغاء الحق بالفيتو؛ أي ما يعرف بالصفة الاختيارية، أو مبدأ إجماع الأطراف المتعاقدة. لقد أصبح الطرف الذي صدر تقرير لجنة التحقيق ضده ملزما بقبوله، إلا إذا أجمع الأطراف على رفضه. بكلام آخر بدلا من ضرورة حصول الإجماع لقبول تقرير اللجنة، أصبح حصول الإجماع شرطا لرفضه. وبذلك انتقل حق الفيتو من المشكو إلى الشاكي.
- احترام الزمن المحدد لتسوية المنازعات.
- تم استحداث هيئة استئنافية من سبعة أعضاء، لتلقي الاعتراضات والنظر فيها خلال زمن محدد، وتنفيذ ما توصي به خلال زمن محدد أيضاً، إلا إذا تحقق إجماع جميع الأطراف على رفضه.
12-Understanding on rules and procedures covering the settlement of disputes
إن الانتقال من نظام التراضي والدبلوماسية، إلى نظام شبه قضائي يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الجات، استفادت منه بالدرجة الأولى الدول النامية.
مع ذلك لا بديل في المستقبل، عن الانتقال إلى النظام القضائي بصورة كاملة.
وفيما يخص البلدان النامية فقد اتخذت عدة إجراءات تراعي اوضاع هذه الدول وتخدم مصالحها. فبموجب مذكرة التفاهم لانشاء جهاز تسوية المنازعات فقد سمح للدولة النامية المشتكية باللجوء إلى المساعي الحميدة للمدير العام، او إجراء تحكيم سريع كبديل لاتفاق منظمة التجارة العالمية(تطبيق أحكام القرار الصادر في5/نيسان/1966،)[13]، وطالبت المذكرة أيضا بأخذ اوضاع البلدان النامية ومصالحها الخاصة بعين الاعتبار
والسماح لها في حال كانت طرفا في نزاع مع دولة متقدمة ان تطلب مشاركة عضو واحد على الأقل من الدول النامية في قوام هيئة التحكيم[14] وقد منحت الدول النامية امتيازات زمنية أفضل خلال المشاورات، او خلال اعداد وتقديم مذكرة الشكوى او مذكرة الدفاع، وتم النص صراحة على وجوب تضمين قرار هيئة التحكيم مدى الاهتمام والعناية الخاصة بما تثيره الدولة النامية من احكام خاصة وتفضيلية[15].
8- آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على البلدان النامية.
في نهاية هذا المبحث يمكن التمييز بين نوعين من الآثار التي تنجم عن تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية، على البلدان النامية بعضها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13- المواد (3-12) من مذكرة التفاهم الخاص بنظام تسوية المنازعات.
14- المواد (4-10) من مذكرة التفاهم.
15-المواد (10-12) من مذكرة التفاهم.
إيجابي، وبعضها الآخر سلبي، وأن والتمييز بينها مهم جداً [16] و[17]
أ-الآثار الإيجابية وتتلخص فيما يلي:
1-سوف تساعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على انتعاش اقتصاديات الدول المتقدمة مما يخلق طلبا متناميا على صادرات الدول النامية. فمن
المتوقع أن يزداد الناتج القومي العالمي من جراء تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بمقدار300 مليار دولار.
2- زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة ويساعد في تحقيق ذلك إلغاء الدعم الذي تقدمه حكومات الدول المتقدمة للمنتجات الزراعية وإلغاء نظام الحصص(الكوتا).
3 - سوف تساعد اتفاقيات المنظمة على انتعاش بعض القطاعات الإنتاجية في البلدان النامية وذلك عن طريق:
- تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج المحلي وتخفيض معدلات التضخم الناشئة عن الكلفة.
- تحرير تجارة الخدمات يزيد في الطلب على العمالة في البلدان النامية مما يساعد على رفع كفاءتها ومستوى تأهيلها.
4-إن تطبيق اتفاقيات الجات سوف يساعد على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وذلك لأن تحرير التجارة سوف يزيد في حدة المنافسة على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16- جامعة الدول العربية، دراسة تحليلية حول " الآثار السلبية للجات على الاقتصاديات العربية "،القاهرة 1994. أنظر أيضا صحيفة "الاقتصادية " العدد الصادر في 14/4/1994.
17- صندوق النقد الدولي"آفاق الاقتصاد العالمي " أيار/ مايو1994.انظر أيضا د.نبيل حشاد "الجات " 1995،ص86 وما بعدها.
الصعيد العالمي مما يرغم المنتجين على رفع مستوى كفاءة إنتاجهم ومنتجاتهم كي يبقوا في السوق في ظل المنافسة الشديدة.إن خوض المنافسة في ظل اتفاقيات تحرير التجارة يتطلب من الدول النامية أن تعمل على تكييف اقتصادياتها مع متطلبات السوق الحرة.
ب- الآثار السلبية.
1 -إن إلغاء الدعم عن المنتجات الزراعية سوف يرفع سعرها مما يحمل الدول المستوردة للغذاء أعباء إضافية سوف تنعكس على ميزان مدفوعاتها.
2-من المشكوك به أن تستطيع الدول النامية منافسة المنتجات المستوردة سواء من ناحية الكلفة أو الجودة مما سوف ينعكس سلبا على صناعتها المحلية وقد يتسبب في زيادة البطالة.
3-تقلص المعاملة التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية.
4- تفرض اتفاقيات الجات قيودا على بعض منتجات الدول النامية ذات القوة التنافسية العالية مثل المنسوجات والملابس.
5- إن تخفيض الرسوم الجمركية سوف يؤدي إلى عجز الموازنة العامة في الدول النامية مما يؤدي إلى فرض مزيد من الضرائب على المواطنين وعلى المنتجات مما يزيد في تكاليف الإنتاج.
6- صعوبة منافسة الدول المتقدمة في مجال الخدمات وخصوصا الخدمات المصرفية والتأمين والملاحة، مع أن الاتفاقية تتضمن بعض التدابير التي تقلل من أثر ذلك مثل إمكانية الحصول على تعويض لقاء إلغاء الدعم على المنتجات الزراعية أو الأخذ بنظام الحصص أو منح مهلة أطول للدول النامية لتكييف اقتصادياتها مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
من الواضح أن اتفاقات الجات ومنظمة التجارة العالمية، تفرض على الأعضاء التزامات، وتقر لها حقوقا. فيما يخص البلدان النامية، فإن التزاماتها لا تنكر عليها الحق في حماية صناعتها الوطنية، أو حماية ميزان مدفوعاتها، أو الاشتراك في التكتلات الاقتصادية الإقليمية. وأجازت لها حماية اقتصادها من المنافسة غير العادلة الناجمة عن الدعم أو الإغراق، أو من المنافسة الضارة حتى ولو كانت عادلة..الخ. وتمنحها أيضاً الحق في الأفضليات الجمركية، بما يعني ذلك إعفاء صادراتها المصنعة، وغير المصنعة من الرسوم الجمركية، في حال دخولها أسواق الدول المتقدمة. بل وألزمت الاتفاقات الدول المتقدمة بالمساواة في المعاملة سواء بموجب مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية أو بموجب مبدأ المعاملة الوطنية، ومنحت الدول النامية إمكانية الاستفادة من التخفيضات الجمركية، وأصبحت تتمتع بنظام فعال لتسوية المنازعات ..الخ.
باختصار إن وضع الدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية أفضل بكثير من وضعها خارج المنظمة، حيث يمكن أن تتعرض لطغيان القوى الكبرى دون وجود أية حماية.
#منذر_خدام (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
-
العرب والعولمة( مدخل)
-
العرب والعولمة(مقدمة)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الحادي عشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الهاشر)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل التاسع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثامن)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل ااسابع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل السادس)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الخامس)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الرابع)
-
في المنهج= دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الرابع)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثالث)
-
في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي( الفصل الثاني)
-
في المنهج. دراسة نقدية في الفكر الماركسي ( الفصل الأول: منطق
...
-
في المنهج. دراسة نقدية في الفكر الماركسي
-
لمجتمع المدني ودوره في الأزمة السورية
-
لمحة من تاريخ القضاء الدولي
-
طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية
-
هل تنسحب القوات الأمريكية من سورية؟
المزيد.....
-
-أمريكا ليست وجهتنا-..أوروبيون يقومون بإلغاء رحلاتهم إلى الو
...
-
شاهد حجم الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي
...
-
إيران: قد يتغير مكان المفاوضات النووية.. وعلى أمريكا حل -الت
...
-
تحذيرات من عاصفة شمسية قد تدمر العالم الرقمي وتعيدنا إلى الق
...
-
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات لفلسطين بـ1.6 مليار يورو
-
باريس تقول إن الجزائر طلبت من 12 موظفاً بالسفارة الفرنسية مغ
...
-
لماذا تحتاج واشنطن إلى أوروبا لإنجاح الجولة الثانية من المفا
...
-
بوادر أزمة جديدة.. الجزائر تطلب مغادرة 12 موظفا بسفارة فرنسا
...
-
آثار زلزال طاجيكستان (فيديوهات)
-
محمد رمضان يرتدي -بدلة رقص- مثيرة للجدل
المزيد.....
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
/ منذر خدام
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
/ منذر خدام
-
ازمة البحث العلمي بين الثقافة و البيئة
/ مضر خليل عمر
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
/ منذر خدام
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
قواعد اللغة الإنكليزية للأولمبياد مصمم للطلاب السوريين
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
أنغام الربيع Spring Melodies
/ محمد عبد الكريم يوسف
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة