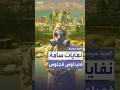|
|
دراسة عن فلسفة نشأة الدولة – مقارنة بين نظرية العقد الإجتماعي و النظرية الماركسية حول رؤيتهما لنشأة الدولة .
علاء عدنان عاشور
محامي وكاتب وباحث في السياسة والأدب والفلسفة والإقتصاد والقانون .
(Alaa Adnan Ashour)



الحوار المتمدن-العدد: 7793 - 2023 / 11 / 12 - 14:30
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
المقدمة
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين . ثم أما بعد :
إن موضوع هذا البحث ، وأهميته ، ودوافع إختياره تتمثل فيما يأتي :
1- موضوع البحث :
نشأة الدولة – دراسة مقارنة بين نظرية العقد الإجتماعي و النظرية الماركسية حول رؤيتهما لنشأة وبناء هذه المؤسسة السياسية والقانونية الكبيرة ( الدولة ).
2- أهمية البحث :
تدور أهمية هذا البحث حول دراسة أصل نشأة مؤسسة الدولة من منظور قانوني و سياسي وفلسفي وإجتماعي ، حيث يبين هذا البحث اتجاه نظرية العقد الإجتماعي والنظرية الماركسية في فلسفة كل منهما لنشأة وتكون الدولة .وسوف نركز هذا البحث على موقف نظرية العقد الإجتماعي والنظرية الماركسية في دراسة تتمحور حول تكون هذه المؤسسة ،حيث سنتمكن من فهم فحوى هذه النظريات حول بناء الدولة الحديثة ، و ربما الوصول إلى نتائج تمكننا إلى الوصول إلى تصور أفضل لشكل الدولة التي تمثل أعلى درجة بناء للمجتمع الإنساني .
3- دوافع إختياري لموضوع البحث :
قمت بإختيار هذا الموضوع المهم لكي أستطيع أن أستعرض موقف نظرية العقد الإجتماعي والنظرية الماركسية عن الدولة الحديثة لكي أوضح بشكل أفضل موقف هذه النظريات التي شكلت أهمية بالغة في نشوء الدولة الحديثة فإنني سوف أقوم بإجراء دراسة مقارنة لهذه النظريات التي ما زال صداها مؤثرا في كثير من النظم السياسية والقانونية والإجتماعية في العالم .
4-خطة البحث :
يتألف هذا المبحث من فصل واحد وخاتمة :
الفصل الأول : النظريات الوضعية في أصل نشأة الدولة .
المبحث الأول : نظرية العقد الإجتماعي .
المطلب الأول : ماهية العقد الإجتماعي .
المطلب الثاني : طبيعة العقد الإجتماعي .
المطلب الثالث : العقد الإجتماعي عند هوبز و لوك و روسو .
المطلب الرابع : تقدير نظرية العقد الإجتماعي .
المبحث الثاني: رؤية النظرية الماركسية للدولة .
المطلب الأول : أسس النظرية الماركسية .
المطلب الثاني : الدولة في النظرية الماركسية .
المطلب الثالث : تقدير النظرية الماركسية .
الخاتمة : النتائج التي خلصت إليها وتوصياتي المتواضعة في هذا الشأن .
المراجع :
تمهيد : إن مصطلح ( الدولة ) هو مصطلح حديث الظهور نسبيا ، حيث أن مصطلح الدولة وفكرة ظهورها ظهرا في القرن السادس عشر في أوروبا ، حيث بدأ قيام الدولة الوطنية سنة 1648 ، وأصبح مصطلح الدولة مدلولا متداولا في القرن التاسع عشر .
لقد أثار تعريف الدولة في أوساط الفقه خلافا شديدا ، يعود سببه إلى زاوية البحث التي تدخل في إهتمام كل فقيه ، فالعلامة ديجي جعل أساس قيام الدولة مرتبط بإنقسام أفراد الجماعة إلى حكام ومحكومين ، سواء أكان هذا الإنقسام في مجتمع بدائي أو في مجتمع متطور . من هنا كان ديجي يعتبر القبيلة أو العشيرة من قبيل الدول طالما يمكن التمييز بين فئة حاكمة وأخرى محكومة فيها .
غير أن هذه النظرة وجدت من الفقه من يخالفها ، فالدولة عند هوديو ليست مجرد إنقسام المجتمع إلى حكام ومحكومين ، وإنما وصول الجماعات البشرية إلى مرحلة متقدمة من التطور الحضاري ، قوامها الشعور بالصالح العام ، وعلى هذا الأساس يرفض هوديو إعتبار الجماعات القبلية و العشائر دولا لمجرد وجود سلطة الحكم فيها .
فلا يتحقق وجود الدولة إلا بوصول الجماعة السياسية إلى درجة معينة من التنظيم يسمح بإستقلالها عن شخص الحاكم أو أشخاص الحكام الذين يتولون السلطة فيها .
في العصور القديمة بإستثناء المدن اليونانية القديمة وطوال العصور الوسطى في أوروبا ،لم يكن هناك فصل للدولة عن شخص الحاكم أو أشخاص الحكام الذين يتولون السلطة فيها .
إلا أن جاء الإسلام ليبرز بوضوح تام إستقلال الدولة عن شخصية الحاكم وليبين بجلاء أن الخليفة أو رئيس الدولة يمارس السلطة في الدولة الإسلامية بإعتباره أمينا عليها ، فهو يتولاها بصورة مؤقتة نيابة عن الأمة التي تقوم بإختياره عن طريق البيعة الصحيحة القائمة على الرضا .
لذلك فالسبيل الوحيد الذي إنتهى إليه تطور المجتمعات خلال القرون العديدة هو الإلتجاء لفكرة الدولة والقانون تجسيدا للحق والعدالة وتحقيقا للمصالح المشتركة و الأهداف العامة .
لكن الكارثة الحقة في كثير من المجتمعات أن من يتمتع بمباشرة السلطة فيها وما تجلبه من منافع شخصية ، لا يمكنهم أن ينزلوا عنها دون صراع ، ومن ثم تتحول إلى سلطة شخصية وبالتالي ينشب صراع بين أفراد المجتمع العاديين ورجال السلطة حتى لو كانوا يعملون لصالح المجتمع ،
ولذلك تنبذ الدول الحديثة فكرة السلطة الشخصية ، وتستبدلها بخضوع هذا الحشد الهائل من الجماهير التي يتكون منها شعب الدولة لفكرة القانون .
فالدولة إذن منظمة تسعى إلى تحقيق خير الجماعة ومصلحة الشعب إلى أبعد مدى ممكن .
وقد عرف الفقيه بيردو الدولة : بأنها السلطة المنظمة أي النظام الذي تكمن فيه السلطة . لكن الفقهاء الألمان كانوا دائما يركزون على عصر السلطان .
فالفقيه جورج يلنك يرى تعريف الدولة بأنها تؤلف وحدة إجتماعية مشتركة تضم بشرا متحضرين وهي متصفة بأصولها بقوة السلطان .
وهذا يشبه الفكر الهتلري قي رؤيته للدولة القوية القائمة على قوة السلطان فهي أداة للحكم وممارسة السلطة .
ولكن إذا ذهبنا للتعريف الخلدوني للدولة فهي : جمع من الناس مستقرون ي إقليم معين الحدود ، مستقلون وفق نظام خاص .
وهذا التعريف الخلدوني للدولة يبين عناصر تكون أو وجود الدولة وهم :
1-الشعب .
2-الإقليم .
3-السلطة الحاكمة .
4-السيادة .
وبعد هذه التطرئة حول مفهوم الدولة فإن محور بحثي سيكون موضوع معين بذاته ،
ولذلك فسأقوم بإجراء دراسة مقارنة حول أصل نشأة الدولة حسب نظرية العقد الإجتماعي والنظرية الماركسية .
الفصل الأول
النظريات الوضعية في أصل نشأة الدولة
ان تناول النظريات الوضعية حول أصل نشأة الدولة يقتضي إستعراضها لكي يتم فهم ما تحويه من أفكار بهذا الصدد .
ولذلك فإن دقة البحث تقتضي مني أن أتناول هذا الفصل في مبحثين :
المبحث الأول : نظرية العقد الإجتماعي .
المبحث الثاني : رؤية النظرية الماركسية للدولة .
المبحث الأول
نظرية العقد الإجتماعي
سأقسم دراسة هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ترتيبهم على النحو الآتي :
المطلب الأول : ماهية العقد الإجتماعي .
المطلب الثاني : طبيعة العقد الإجتماعي .
المطلب الثالث : العقد الإجتماعي عند هوبز ولوك وروسو .
المطلب الرابع : تقدير نظرية العقد الإجتماعي .
المطلب الأول
ماهية العقد الإجتماعي
تذهب هذه النظرية إلى أن الدولة قامت نتيجة إتفاق مقصود و إختياري من ناحية الناس البدائيين الذين خرجوا من حالة الطبيعة . وهي تفترض أنه كان هنالك عهد في التاريخ البشري حين لم توجد دولة مطلقا ولم يوجد قانون سياسي .
وينظر بعض الكتاب إلى هذا العهد السابق للدولة على أنه سابق للمجتمع كذلك . وكان قانون الطبيعة هو القانون الوحيد الذي حكم العلاقات البشرية في حالة الطبيعة . ولم يتفق دعاة نظرية العقد الإجتماعي على ماهية قانون الطبيعة . فحالة الطبيعة كانت إما مثالية أو غير ملائمة ولا يمكن إحتمالها . ومن ثم فقد هجر الناس حالة البدائية إلى حالة الطبيعة وأقاموا مجتمعا سياسيا عن طريق التعاقد . ونتيجة للعقد فقد كل إنسان حريته جزئيا أو كليا ، وفي مكانها حصل على الأمن وحماية الدولة التي كفلها القانون السياسي .
.
ويرى بعض الفلاسفة أن نظرية العقد الإجتماعي هي النظرية الأم في تفسير نشأة الدولة وفي قيام السلطة السياسية فيها ، هذا من ناحية و من ناحية أخرى كان لهذه النظرية أثر بعيد في التنظيمات السياسية الحديثة والتي قامت إزاءها ثورات ووجدت دول ، مما دفع الكثيرين لتفضيلها على النظريات الأخرى لقيام الدولة وقوامها .
وتفسر نظرية العقد الإجتماعي ، نشأة الدولة ، على أساس أمرين : اتفاق ، ثم عقد . بمعنى وجود ( اتفاق ) وقع بين أعضاء الجماعة ، أو المجتمع ، تلاه ( عقد ) ، أبرمه أعضاء تلك الجماعة ، توجوا به اتفاقهم ، على إنشاء الدولة . وعلى هذا تعتبر الدولة قد أنشئت ، بمجرد إبرام ذلك العقد .
على أن إنشاء الدولة على هذا النحو يثير ثلاث قضايا :
الأولى : إن الإتفاق الذي توج بالعقد ، لا يتم إلا برضاء الأطراف ، أي بإرادتهم المشتركة . لذلك ، فإن أصل الدولة يرجع إلى الإرادة المشتركة ، لأفراد الجماعة . أي أن الأفراد اجتمعوا ، واتفقوا ، على إنشاء مجتمع سياسي ، يخضع لسلطة عليا . ويعني ذلك أنهم إتفقوا على إنشاء دولة . فالدولة ، وجدت نتيجة عقد أبرمته الجماعة .
الثانية : أنه سيترتب على إنعقاد هذا العقد ، هي تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم الطبيعية مقابل التمتع بميزات المجتمع السياسي .
الثالثة : أن نظرية العقد الإجتماعي . مثلها مثل مدينة أفلاطون الفاضلة . إنها قامت على أساس الإفتراض ، لا الحقيقة .
ومن هنا يتضح أن التركيز على العقد الإجتماعي ما هو إلا تحويل من حالة العشوائية والبدائية إلى حالة التحكم والسيطرة والخضوع لسلطان الدولة ، أي محاولة وضع الضوابط التي تحكم أفراد المجتمع عن طريق ذلك العقد ، الذي يفترض الالتزام بالحقوق والواجبات المقابلة لهذه الحقوق . وقد ذهب البعض إلى تعريف العقد السياسي أو الإجتماعي بأنه إنشاء الحكومة على أسس إتفاقية تبرر علاقة الخضوع بين الحاكم والمحكوم .
المطلب الثاني
طبيعة العقد الإجتماعي
العقد الإجتماعي بين الفرض والحقيقة :
لعل أهم تطبيقات الافتراض تتجلى في نظرية العقد الإجتماعي تلك النظرية التي تفترض وجود حياة فطرية تسبق قيام الجماعة ، وأن الإنتقال من حياة الفطرة و البداوة على حياة الجماعة المنظمة قد تم بناء على عقد إجتماعي بين الأفراد بغية إقامة السلطة الحاكمة .
ولقد كان هدف الفلاسفة من اللجوء إلى هذا الإفتراض القائم على التصور الذهني المخالف للواقع ’ هو إيجاد تبرير للعلاقة التي تربط بين الحكام وبين المحكومين ، مع رسم إطار ونطاق الحقوق والحريات العامة للأفراد .
وقد لجأ إلى هذه الطريقة الفقهاء المسلمين ، وكانوا يطلقون عليها ( الافتراض ) إصطلاح "الحيلة الشرعية " .
ولقد تعرضت هذه النظرية لإتقاد بأنها تقوم على إفتراض وهمي خاطئ ، ألا وهو أن الفرد كان يحيا حياة عزلة قبل قيام الجماعة . وهذا غير صحيح لأن الإنسان بطبعه كائن إجتماعي ، لا يطيق حياة العزلة .
المطلب الثالث
العقد الإجتماعي عند هوبز و لوك و روسو
أولا : العقد الإجتماعي عند هوبز :
يرى هوبز ، بأن حالة الطبيعة الأولى ، كانت حالة وحشية ، يسودها شرع الغاب ، وسلطان القوة ، والصراع الدائم ، بين الأفراد ، فالكل ضد الكل ، في حرب مستمرة ، وذلك لطبيعة الإنسان العدوانية كما أكد ذلك ابن خلدون أي : نتيجة لطبيعته الشريرة وأنانيته حيث " كان الفرد ذئبا على الفرد " . ولكن بدافع المحافظة على النفس – وبدافع المصلحة أيضا – اضطر الأفراد مكرهين ، للخضوع إلى القانون الطبيعي ، الذي أوجب عليهم إنهاء هذه الحالة . فاتفقوا على إبرام عقد ، تم بموجبه إنشاء الدولة .
فقد تأثر هوبز بما شاهده من أحداث قومية لا شك أنه كان لها الشأن الأول قي تقرير فلسفته .
إذ عاش فوق التسعين عاما عاصرت الحروب الأهلية في إنكلترا . ولم يكن هوبز يعيش معيشة المفكرين الذين يعتصمون بإعتزال النشاط العام ويقضون أيامهم بين الكتب فحسب ، بل شاء له القدر أن يعيش في وسط هذه الأحداث وأن يرتفع وينخفض ويتكلم ويصمت ويفر الى فرنسا ويعود الى انكلترا وفق ما كانت الظروف تملي عليه .
ولقد إستعان هوبز في وضع فلسفته السياسية بما ساد في القرن السابع عشر من علوم طبيعية . وهو في هذا القرن يعد من أوائل المفكرين المحدثين الذين خرجوا على منهج العصور الوسطى الديني في دراسة المجتمع وبنوه على أساس منطقي و علمي . اذ يفسر الكون و المجتمع تفسيرا ماديا ويقول أن الانسان قد وجد نفسه في عالم مؤلف من أجسام مادية طبيعتها الحركة . والانسان كجزء من هذا العالم لا يسعه الا أن يخضع لقانون الحركة . اذ تتحرك نفسه نحو الأشياء الخارجية التي نرضي رغباته ونزعاته ، كما ينفر من الأشياء التي لا تتفق ودوافعه النفسية . ومصدر اجتنابه ونفوره هو الأنانية التي تتمثل في حرص الإنسان على ما يصون ذاته واجتناب ما يضرها . وبناء على هذه الفكرة التي تجعل المادية عامة والأنانية الفردية القوة المقررة لتصرفات الانسان وأعماله يصف لنا هوبز حالة الإنسان في فجر الحضارة الإنسانية . فهو يقول أن حياة الإنسان الأولى لم تكن لتطاق . فتنافس الافراد على ما يصون ذاتهم تنافسا لا يرتدع برادع سوى المصلحة الخاصة قد جعل من الحياة الانسانية جحيما قانونه الحرب المستمرة وعنصره الشقاء والوحشية .
والعقد الإجتماعي عند هوبز هو عقد بين رعايا ورعايا ، وليس بين حاكم ورعايا ، لأن الحاكم ليس طرفا فيه ، وطبقا لذلك لا يستطيع الحاكم أن يرتكب أي خرق للعقد حيث أنه لم يشارك في إقامته ، ثم إن المواطن بمشاركته في خلق الحاكم يكون قد شارك فيما يقدم عليه الحاكم من أعمال ، ولذلك ليس له أن يظهر الشكوى من أي تصرف له ، لأنه إنما يشكو نفسه عندئذ .
من هنا فقد نادى هوبز بأن سيادة الحاكم مطلقة لا تحدوها حدود أو قيود ، إذ أن الأفراد قد تنازلوا بمقتضى العقد الإجتماعي عما كان لديهم حريات وحقوق في حالة الطبيعة ، وهو تنازل كامل وغير مشروط وإلا أتيح للفوضى الفطرية أن تعود من جديد . ومعنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يسترد ما أعطاه للحاكم ، كما أن الحاكم غير ملزم قبل الناس بشيء لأنه لم يكن طرفا في العقد ،اللهم إلا بتوفير الأمن لهم ، وبما أن الحاكم ليس طرفا في العقد فإنه من ثم لن يتنازل عن حقوقه الطبيعية ولا عن حريته بل أنه إحتفظ بهما ، ومن هنا فإن له أن يفعل ما يشاء .
إلتزامات العقد السياسي عند هوبز :
وتقسم إلى إلتزامات على عاتق المعقود له ( الحاكم ) ، و العاقد ( الحاكم ) .
أ- إلتزامات المعقود له ( الحاكم ) عند هوبز : يذهب هوبز في نظرية العقد السياسي ( الإجتماعي ) إلى أن الحاكم عليه واجبات نحو الأفراد ، وليس إلتزامات ، لأن الإلتزام لا ينشأ إلا عند العقد أو القانون ، والحاكم لم يكن طرفا في العقد السياسي ، كما أنه هو الذي يضع التشريعات و القوانين لأفراد المجتمع ، ولا يلتزم بها في حد ذاته .
ويرى هوبز : أن من واجبات الحاكم صاحب السيادة حفظ التوازن بين الأفراد حسب مستوياتهم الإجتماعية ، حتى لا تستأثر فئة بموارد الثروة في الدولة ، وتترك الآخرين دون مصدر للإرتزاق منه ، ويجب على الحاكم أيضا توفير الأمن والإستقرار والسلام ومد العون للأفراد حتى يتمكنوا من العمل المنتج .
ويرى طارق عبد الحميد الشهاوى : أن فكرة هوبز بإخراج الحاكم من العقد غير صحيحة ‘ إذ أن الحاكم عند هوبز إذا ضعف ، ولم يكن قويا ساهرا على رعاية وأمن أفراد الدولة ، فقد وجب عليهم عدم طاعته وعزله ، والإتفاق مع حاكم آخر ، وهذا معناه أن هوبز قد ألقى على الحاكم مسؤوليته ، وإلتزام ما تضمنه العقد الإجتماعي من أهداف هامة في نظر هوبز .
ويتضح من ذلك أن الحاكم يجب أن يكون طرف أصيلا في العقد ، مثله مثل باقي العقود الأخرى التي يتحدد أطرافها ، ويلتزم كل منهم بما يلقيه عليه العقد من إلتزامات .
ب - إلتزامات العاقد ( الشعب ) :
و أن الشعب بتخليه طواعية عن إرادته لصاحب السيادة ، فإن حريته تكون مقيدة بالقوانين التي وضعها صاحب السلطة والسيادة المطلقة .
وإذا لم يلتزم الشعب بنصوص العقد الإجتماعي ونصوص القانون ، ومارس حريته الطبيعية ، وآثر عدم إطاعة السيادة ، وإعترض على كل شيء ، إنقلب المجتمع حينئذ من حالة التمدن والتحضر إلى الى حالة الطبيعة الأولى بكل ما فيها من بؤس وصراعات وحروب وإنتهت العدالة وتلاشت حالة السلم والأمن بين المواطنين .
ولكن أرى هنا أن الخروج على الحاكم صاحب السيادة والسلطة المطلقة من قبل الشعب إذا كان هذا الملك أو الرئيس ظالما لن يؤدي بالضرورة إلى حدوث حرب أو بؤس وإنعدام للأمن ، لا فإن الشعب عندما يحكم بنفسه وبإرادته فهذه أكبر ضمانة لوجود الأمن والسلام في المجتمع .
ونشير هنا أنه لا تحد السلطة المطلقة التي أعطاها هوبز لصاحب السيادة الا بحدود عجزه عن مواصلة عمله الرئيسي في كفالة الأمن والحماية لرعاياه . فإذا وقع المواطن أسيرا في يد عدو ، واذا القى صاحب السيادة الحكم جانبا من نفسه وورثته ، أو إذا ما نفى مواطنا من المواطنين ، أو إذا هزم في الحرب وأصبح هو نفسه خاضعا للمنتصر ، فكل هذه الحالات تبيح للرعايا أن يتحرروا من الالتزامات السابقة نحوه .
ثانيا : العقد الإجتماعي عند جون لوك :
عارض جون لوك الأساليب الدينية والسياسية التي اتبعها الملوك الاستوارتيون ، وهاجم نظرية الملكية المقدسة التي نادى فيها فلمر وأنصار الكنيسة الإنجليزية ، وهاجم نظرية الملكية المطلقة التي قال بها هوبز مستندا على نظرية العقد الإجتماعي ، كما إنه كان قليل العطف على المبادئ التي نادى بها الأحرار .
كتب لوك رسالتين تناول في الأولى النظرية التي نشرها الكتاب عن السلطة التي يتمتع بها الملك على حسب مبدأ الملكية المقدسة ، وعارضها معارضة شديدة وبرهن على عدم صحتها وصلاحيتها ، إذ تناول كل نقطة وبحثها وناقشها وأثبت خطأها .
أما رسالته الثانية التي سماها الحكومة المدنية فقد بحث فيها بحثا مرتبا وتفصيليا عن أصل الحكومة وطبيعتها ووظيفتها ، وقد كتبها ردا على ما جاء في كتابات هوبز ، ولو أنه لم ينقض كلامه نقضا كاملا ، ولقد إعترف بأنه مدين لهوكر إذ إستمد منه أفكاره السياسية ، واتفق مع هوبز في مبادئه الخاصة بالأفراد وفي إعتماده على نظرية العقد الإجتماعي ، ولكنه رفض معظم الأسس الفلسفية التي نشرها هوبز .
نظرته للحالة الطبيعية :
يرى لوك بأن الإنسان قبل ان يكون المجتمع السياسي والدولة كان يعيش حياة يسودها السلام وتبادل الخدمات ، وأن الأفراد كانوا يعيشون في ظل هذه الحالة الطبيعية احرارا ومتساوين ، وان القانون الطبيعي هو الذي يحكم هذه العلاقات وينظمها ، وكان الإنسان يتمتع وفق هذا القانون بحقوقه الطبيعية مثل حق الحياة والحرية والتملك وغيرها . ولكن خروج الإنسان عن هذا القانون واضراره بمصالح الآخرين نتيجة لممارسة حقه في الحرية لا يعود لخطأ في القانون الطبيعي نفسه ، وإنما الى عجز وقصور العقل البشري عن الوصول الى حقيقة هذا القانون ، ولهذا فكر الانسان في الخروج من هذه الحالة الطبيعية التي يحكمها القانون الطبيعي من خلال وضع القوانين والأنظمة وانشاء المؤسسات السياسية ، لكي تساعده على تنفيذ القانون الطبيعي وحماية حقوقه الطبيعية وليس للتخلص من أحكام هذا القانون .
العقد : أرجع جون لوك نشأة الدولة إلى فكرة القبول أو العقد . وقد عرف لوك السلطة المدنية بأنها : حق سن القوانين المصحوبة بالعقوبات ، والتي ترمي الى تنظيم الملكيات الخاصة وحفظها ، واستخدام قوة المجتمع في تنفيذ هذه القوانين للمحافظة على الصالح العام . ثم قال أن هذه السلطة لا يمكن أن تنشأ الا عن طريق الموافقة أو القبول ، ويجب أن يكون القبول من كل فرد على حدة وذلك لأن السلطة المدنية لا يمكن ان تكون حقا الا اذا كانت مستمدة من حق كل فرد في حماية نفسه وممتلكاته ، وحق الهيئة التشريعية والتنفيذية في حماية الملكية هو الحق الطبيعي للفرد ، وقد تنازل عنه للحكومة ، ولا يمكن تبرير هذا التنازل الا بكونه تم لكي يكون وسيلة افضل لحماية الحقوق الطبيعية ، وهذا هو العقد الأول وهو الذي بواسطته كون الأفراد المجتمع ، فهو ليس الا مجرد اتفاق لتوحيد جميع الافراد في مجتمع سياسي واحد .
التمييز بين السلطات :
ولقد أراد لوك ان يؤيد برنامج حزب الهويج وهو حزب البرلمان ومناهض الأسرة المالكة ، فذهب بمنطقه الى القول بأنه كان الانسان في حالة الطبيعة نوعان من السلطة يتجرد عندهما عند انتقاله الى حالة المجتمع نوعان من السلطة يتجرد عندهما عند انتقاله الى حالة المجتمع لصالحه ( المجتمع ) فأصبح خلفا له فيها . فقد كان للمرء سلطة عمل كل ما يراه كفيلا بصيانة ذاته وصيانة غيره من الناس ، ثم تجرد منها لكي تنظم وتدار عن طريق قوانين المجتمع . وكان للإنسان الى جانب ذلك ، سلطة العقاب عن الجرائم التي ترتكب ضد القوانين الطبيعية ، أي سلطة استخدام قوته الطبيعية لتنفيذ هذه القوانين ، ثم انه نزل عن هذه السلطة ليقوي السلطة التنفيذية في ظل المجتمع السياسي ويدعمه . لقد خلف المجتمع السياسي الفرد في السلطتين وفي وظائفهما ، فنشأ في ظله سلطتان : واحدة تتولى عمل القوانين اللازمة لحفظ المجتمع وأعضائه ، وهي لذلك لها الصدارة على السلطة الثانية - السلطة التنفيذية -التي تسهر على تنفيذ القوانين ، ومن غير ان تكون تابعة للأولى ، فتأتي بالمرتبة الثانية . ولما تؤديه السلطة التشريعية من وظيفة خطيرة يتعلق بها بقاء الجماعة وأفرادها ، فإن اخطر ما يرتكب في ميدان السياسة أن تحاول السلطة التنفيذية الإعتداء على اختصاص السلطة التشريعية واغتصابها لصالحها .
وأرى ان لوك محق في مناداته الفصل بين السلطات ، حتى لا يكون هناك تعدي من قبل سلطة على اخرى وخاصة اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية والقضائية ، بحيث يوصف النظام في هذه الحالة بالنظام الشمولي الديكتاتوري والمنافي تماما للأنظمة الديمقراطية التي تحترم خيارات الشعب في اختيار من يمثله في الدولة لكي يسهر على حفظ حقوقه ، عبر سن قوانين تحترم حرية الانسان ومصالحه .
حق معارضة الحاكم المستبد :
تقوم الحكومة على أساس العمل على رفاهية المجتمع ، ورعاية مصالح المجتمع فاذا أهملت شيئا من ذلك وجب تغييرها ، وقد علل لوك هذا الرأي عن طريق المقارنة بين إستعمال القوة الغاشمة ، واستعمال الحق وقت الحروب فقد قال ان الفاتح المنتصر في حرب عادلة لا يمكنه اقامة حكومة في الدولة المنهزمة الا اذا احترمت هذه الحكومة الحقوق الطبيعية للأفراد ، وهي الملكية ، وحق الحرية ، اما اذا اهملت هذه الحقوق فلا يمكنه اقامة حكومة ، ويعني ذلك أنه يقصد ان القوة لا يمكن ان تكون اساس الحكومة ، فهو يميز القيم الأخلاقية والقوة الغاشمة كما فعل روسو بعده .
وتزول الحكومة اما بتغيير مركز السلطة التشريعية ، واما بعدم محافظتها على الأمانة التي وكل إليها الشعب صياغتها ، وقد دلل لوك على هذه النظرية بأمثلة من تاريخ إنجلترا . وبين ان الثورة قامت ضد الملك لأنه حاول ان يزيد من إمتيازاته ، وان يحكم دون برلمان ،وهنا حدث تغيير في مركز السلطة التشريعية ، فاقتضى ذلك حل الحكومة ، واذا حاول البرلمان ان يعتدي على حياة الشعب أو حرياته أو أملاكه ، فإن حله يصبح واجبا ، وتعود السلطة من جديد للشعب ليختار هيئة تشريعية جديدة يكون اليها مهمة الحكم .
ثالثا : العقد الإجتماعي عند جان جاك روسو :
كان جان جاك روسو الكاتب الذي وصف الأحوال في فرنسا في عصره وصف خبير ، وكان غرضه ، أن يرفع الظلم السياسي والاجتماعي الذي أَنَ الفرنسيون من جوره آنذاك ، وقد طبق نظرية العقد الإجتماعي في فرنسا في الوقت الذي كان هيوم يعمل على هدمها في انجلترا عن طريق المنطق ، ولقد كان قويا في آرائه ومحبوبا وبليغا ، أثر بكتاباته على الرغم من تناقضها وعدم دقتها تأثيرا كبيرا في العصر الذي جاء بعد ظهورها ، وكان عالما بالتاريخ وحوادثه ، متفقها في الفلسفة السياسية القديمة ، وكان معجبا بالجمهوريات الإغريقية والرومانية ، وبالدول الديمقراطية الصغيرة ، ولعله تأثر في ذلك بنظم جنيف حيث قضى أيام طفولته ، وقد إستمد كثيرا من آرائه ونظرياته من كتاب بفندورف ولوك ومنتسيكو ، وقد اتفقت نظريته في السيادة الشعبية مع نظرية الثسيوس فيها في كثير من النقط والوجوه .
لقد أشاد هوبز بنظرية السيادة في الدولة ورأى في اطلاقها وتركيزها في شخص واحد هو شخص الملك وسيلة فعالة لضبط عوامل الإضطراب والحروب الأهلية في بلاده ، ولكنه ما كان ليتخيل أن يجيء من بعده " روسو " فيستخدم نظريته لا لإعلاء شأن الحكم الملكي المطلق بل لتأييد حكم الشعب المطلق . فكلاهما بنا نظرية السيادة على فكرة العقد الإجتماعي ولكن اختلاف استعمالهما لنظرية العقد الإجتماعي أنتج إختلافا بينا في النتائج .
وعلى قدر دين روسو لفكرة السيادة المطلقة عند هوبز فهو يدين لجون لوك بتوجيه نظرية السيادة
المطلقة نحو تأييد سلطة الشعب .
الحالة الطبيعية :
استهل روسو فلسفته السياسية بالحديث عن الحالة الطبيعية مثل هوبز ولوك ، لكن إيمانه بحقيقة وجود هذه الحالة كان أصيلا أكثر من سابقيه ، وقد اعتقد أن الأفراد قبل أن يكونوا المجتمع السياسي أو الدولة كانوا يعيشون حياة فطرة سعيدة تسودها العدل والمساواة ، ولكن نتيجة لتقدم العلوم و المدنية وظهور الملكية الخاصة ونظام تقسيم العمل ، ظهرت الحاجة لوجود المجتمع والدولة التي إعتبرها شرا لا بد منه .
الإرادة العامة والسيادة :
اعتقد روسو ان كل فرد نزل عن حقوقه الطبيعية للجماعة السياسية بصفتها وحدة قائمة بنفسها ، فتأسست وحدة سياسية لها حياتها وارادتها متميزة عن افرادها وامتلك كل فرد جزء متساويا مع غيره في السلطة العامة واسترجع الحقوق التي نزل عنها تحت كنف الدولة وحمايتها ، ولذلك كان التعاقد الذي وصفه روسو اجتماعيا لا حكوميا ، وكان اتفاقا متبادلا بين الفرد والدولة ، ربط الفرد بغيره من الافراد بصفته شريكا في السيادة العامة ، وربطه بصاحب السلطان بصفته عضوا في الدولة ، وكان يعتقد أنه لا يوجد تعارض بين السلطة الممنوحة للأفرا د بصفتهم وحدة سياسية وبين حريتهم بصفتهم أفرادا وقد برهن حكم الارهاب في فرنسا على أن السلطة الشعبية ان لم تتقيد تصبح مستبدة مثل سلطة أي ملك مستبد آخر وعلى ذلك كانت نظرية روسو غير عملية ، ثم بحث في الارادة العامة ، وقال انها تتكون من ارادة الافراد الذين نزلوا بمحض ارادتهم ورغبتهم عن حقوقهم وسلطتهم للدولة ، وقال ان الارادة العامة هي ارادة الأكثرية في الدولة ، وتخطئ الأقلية إذا اعتقدت إن إرادتها هي الإرادة العامة ، وقال ان وجود حزبين قويين خطر على الدولة ، وطلب تعدد الأحزاب ان كان ولا بد من التحزب ، وفي رأيه كانت الإرادة العامة المظهر الوحيد للسلطة ، واتخذ آراء هوبز وبودان التي عضدت الملكية المطلقة معوانا له لمناصرة الرقابة الشعبية ، وتعبر الارادة العامة عن مصالح جميع أعضاء الدولة ، وهي القانون دون سواها ، وعلى ذلك يجب أن يكون القانون مطابقا للمصلحة العامة وصادرا من الشعب ، وتتكون الهيئة الحكومية لتنفذ الاوامر العالية للهيئة الشرعية الحقيقية ، ويتضح من هذا أن فكرة روسو في القانون تقرب الفكرة الحديثة عن القانون الأساسي أو الدستور التي تتمشى السلطات الحكومية على مقتضاه . أشار روسو ان الفرق بين الدولة والحكومة ، وقال إن الدولة هي جمهور الافراد مجتمعين في وحدة سياسية ، تظهر نفسها في الارادة العامة التي لها السلطة والسيادة العامة ، أما الحكومة فهي الأفراد الذين انتخبتهم الجماعة ليطبقوا الارادة العامة دون سواها .
يقول روسو : ان العقد الإجتماعي يعطي المجتمع السياسي سلطة مطلقة على كل أعضائه ، وهذه السلطة المطلقة – التي تتولاها إرادة عامة – تحمل إسم السيادة ، فالسيادة التي ليست سوى ممارسة الإرادة العامة – لا يمكن أبدا التصرف فيها ، وصاحب السيادة – الذي هو كائن جماعي – لا يمكن لأحد أن يمثله أو ينوب عنه سوى نفسه ، ويضيف روسو إلى ذلك أن السلطة العليا لا يكن تقييدها ، ذلك أن تقييد السلطة العليا معناه تحطيمه .
ويرى روسو أن الإلتزام الإجتماعي والخضوع للسلطة لا يمكن أن يكون أساسهما القوة ، ذلك أن تأسيس السلطة على القوة وحدها يعني انكار فكرة الحق كلية .
انقضاء العقد السياسي عند روسو :
رأى روسو أن الحاكم بصفة عامة ليس طرفا في العقد السياسي ، وانما هو وكيل يحكم وفق ارادتها لا وفق ارادته هو ، ولذلك كان للأمة ( الجماعة ) حق عزله متى ارادت ، لأن الحاكم ايا كان لقبه فهو خادم للشعب ووكيل عنه يعمل باسم الشعب وبإرادته . ومن ثم يكون لصاحب السلطة " الشعب " حق تعديل أعضاء الحكومة أو استبدالهم بآخرين ولا حرج عليه ‘ شريطة ان يكون هناك ما يدعو الى ذلك ، خاصة اذا ما اساءت الحكومة استخدام السلطات المخولة لها ، عاملة لمصلحتها الخاصة على سبيل المصلحة العامة ، فتصبح بذلك خائنة للأمانة ؛ مما يؤدي الى تفكك المجتمع االسياسي ، وبالتالي يكون من حق الشعب توقيع ما نص به العقد على الحكومة ؛ جزاء خيانتها الأمانة ، اضافة الى حق عزلها واستبدالها بغيرها .
نلاحظ أن روسو إعترف بأنه ليس من أثر تاريخي للعقد الإجتماعي . ولكنه يؤكد بأن المجتمع والدولة لا يمكنهما أن يؤسسا الا على القوة أو الإتفاقات . فاذا افترضنا ان الدول تتأسس عن طريق القوة ، فإننا نتخلى ، بذلك ،عن اعطائها اساسا قانونيا . وحدها فرضية العقد يمكن أن تقدم تفسيرا قانونيا صحيحا لنشأة تكوين الدولة .
رابعا : العقد الإجتماعي بين روسو ولوك وهوبز :
بين كل من روسو ، ولوك ، وهوبز إختلاف كبير في نظرية العقد الإجتماعي :
1-يصور هوبز الرجل البدائي على أنه أناني ، و أن الحالة الفطرية الأولى كانت حرب دائمة ، أما روسو فيتصوره رجلا صالحا ، والحالة الفطرية الأولى تمثل السعادة المثالية ، ويأخذ لوك طريقا وسطا بين الرأيين .
فقد رأى الدكتور ثروت بدوي أن حياة الفطرة عند روسو ليست – كما إعتقد البعض – هي أسعد حالة للحياة البشرية ، بل العكس لأن حياة الجماعة هي وحدها التي ترتقي بالإنسان ومعنوياته وترتفع بتفكيره ومشاعره ، وتحل العدالة والفضيلة مكان الغرائز والشهوات ، وتحكم العقل في التصرفات ، وتمنع من الإندفاع وراء الميول والنزوات .
واتفق مع الدكتور ثروت بدوي في ذلك لأن وجود الجماعة " الدولة " مهم لوجود من يمثل الأفراد ويسهر على مصالحهم وأمنهم ، بوضع قواعد قانونية يخضع لها جميع الشعب ، لترتقي به من قانون الغابة الى قانون الجماعة السياسية التي تحترم أفراد الأمة ككل .
2-يقول هوبز وروسو أن السيادة مطلقة ، أما لوك فيرى أنها مقيدة .
3-لم يميز هوبز بين الدولة والحكومة ، ويرى أن الحكومة الفعلية هي القانونية ، اما روسو ولوك فقد ميز كل منهما بين الدولة والحكومة ، وهناك من فرق بين الحكومات الفعلية ،والحكومات القانونية .
4-اذا كان لوك قد جعل العقد بين الأفراد والحاكم ، فإن روسو قد رأى أن الافراد إنما يبرمون العقد مع أنفسهم على أساس ان لهم وجهين أو صفتين : من حيث كونهم أفرادا طبيعيين كلا منهم في عزلة عن الآخر ، ومن حيث كونهم متحدين في الجماعة السياسية المزمع قيامها .
5-روسو اتفق مع هوبز أن الحاكم ليس طرف في العقد ، فهما يختلفان من حيث أن هوبز يضمن العقد الإجتماعي مجموعة عقود تقدر بعدد الأفراد المكونين للجماعة ويلتزم فيها كل منهم قبل الأفراد الآخرين ، بينما يحسب روسو أن طرفي العقد – وهما الأفراد الطبيعيون من ناحية ومجموع الأفراد أعضاء الجماعة السياسية من ناحية ثانية – وبعبارة أخرى يتخيل روسو الجماعة السياسية كما لو كانت قد تكونت بالفعل ويدخلها طرف في العقد ، والأفراد الطبيعيون طرف آخر .
6- اتفق روسو ولوك في وضع السيادة في الشعب ، وفي الحد من سلطة الحكومة ، ولكن لوك يرى أن الشعب يحتفظ بالسيادة لاستعمالها وقت الضرورة القصوى ، لأنه يعتقد أن جميع أعمال الحكومة تكون قانونية مالم تمس حقوق الأفراد الأساسية ، أما روسو فيرى أن الشعب يمارس سيادته دائما ، وأن جميع قوانين الدولة يجب أن تصدر عن الشعب بإعتباره صاحب السيادة .
المطلب الرابع
تقدير نظرية العقد الإجتماعي
أولا : اتفاق العلامة ابن خلدون مع العقد الإجنماعي :
تتفق نظرية العقد الإجتماعي مع آراء ابن خلدون ، في الأوجه التالية :
الوجه الأول : في مفهوم العقد . فإذا كانت نظرية العقد الاجتماعي ، ترى أن نشأة الدولة ، تتم بطريق التعاقد ، فإن ابن خلدون ، سبق له وأن تصور فكرة العقد . فهو يقول في هذه النصوص :
1-ثم ان هذا الإجتماع ان حصل للبشر ، كما قررناه ، وتم عمران العالم بهم ، فلا بد من وازع ، يدفع بعضهم عن بعض (...) ، فيكون ذلك الوازع ، واحدا منهم ، يكون له عليهم الغلبة والسلطان ، واليد القاهرة ، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان وهذا هو معنى الملك .
2-{ واحتاجوا من اجل ذلك ، الى الوازع ، وهو الحاكم عليهم ، وهو بقتضى الطبيعة البشرية ، الملك ( بكسر اللام ) القاهر المتحكم } .
3-فهو ( أي : الإنسان ) محتاج إلى المعاونة ، في جميع حاجاته أبدا بطبعه . وتلك المعاونة ، لا بد فيها من المفاوضة ، أولا ، ثم المشاركة ، وما بعدها } .
4-{ وهو لا يحاول في استبداده ، انتزاع الملك ظاهرا ، وانما يحاول إنتزاع ثمراته ، من الأمر والنهي ، والحل والعقد ، والإبرام والنقص ( ... ) ولم يقنع بما قنع به أبوه وأخوه من الاستبداد بالحل والعقد ، والمراسم المتتابعة } .
5-لأن الملك ، إنما يحصل بالتغلب ، والتغلب إنما يكون بالعصيبة واتفاق الأهواء على المطالبة } .
لا شك من أن معاني النصوص ، التي مرت ، دلالتها على أن تجمع الأفراد ، يفضي بالضرورة – في رأي ابن خلدون – إلى حالة سياسية ، ما لم يكن موجودا من قبل ، لدى الأفراد . يعني أن الأفراد ، دعتهم ( الحاجة ) إلى التجمع وإلى التعاون . وأن هذا التعاون ، أفضى بالضرورة أيضا ، إلى التفاوض والتشاور ، ثم الاتفاق على تعيين حاكم وازع ، يكون منهم ، ( له عليهم الغلبة ) . فينشأ بذلك ، الملك السياسي ، الذي هو الدولة . فهناك إذن – في تصور ابن خلدون – تدرج في كيفية نشأة المجتمع السياسي ، بحيث ينشأ ذلك المجتمع ، على مراحل ثلاث ، بالترتيب :
أ-تجمع الأفراد ، بدافع الخوف ، لإحتياج : { كل واحد منهم ايضا ، في الدفاع عن نفسه ، إلى الإستعانة بأبناء جنسه } . وإذا ما تم لهم ذلك ، فإنهم يكوِنون جماعات وعصائب . أو العصبيات . مما يعني خروجهم من حالة الطبيعة – بتعبير نظرية العقد الاجتماعي . أو من حالة التجمع الطبيعي – عند ابن خلدون .
ب-دخول الأفراد ، في حالة سياسية ، يتم التعاون فيما بينهم ، بطريق المشاورة و المفاوضة ، والمشاركة – إراديا – على تكوين الملك السياسي ( الدولة ) .
ج-اتفاق الأفراد : أي {اتفاق الأهواء على المطالبة } – كما جاء في النص الخامس – بمعنى اتفاق أفراد العصيبة القوية ، على الأقل على تعيين حاكم وازع : { يكون عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة ، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان . وفي هذا المعنى ، يقول ابن خلدون : { إن تمهيد الدولة ، وتأسيسها ، كما قلناه ، إنما يكون بالعصيبة ، وانه لا بد من عصيبة كبرى جامعة للعصائب ، مستتبعة لها ، وهي عصيبة صاحب الدولة الخاصة ، من عشيرة و وقبيلة } . فإن عملية جمع العصائب وإستتباعها للعصيبة الكبرى ، لا بد فيه – بأي شكل من الأشكال – من (المفاوضة ) ، ثم ( الاتفاق ) . وهو معنى تصور ابن خلدون ، لفكرة ( العقد ) ، في بناء الدولة.
الوجه الثاني : في مبدأ ( القوة ) التي تقوم الدولة ، على مقتضاه ، عند هوبز .
حيث : { تظل الكلمة العليا للقوة ، في عهد المجتمع المنظم ، كما لو كان ذلك في عهد الفطرة } . فقد أكد ابن خلدون قبل - هوبز – هذا المبدأ عندما اعتبر الملك السياسي ، يقوم على أساس { التغلب والحكم بالقهر} و{ الشوكة والعصيبة } . على أن القوة التي يقصدها هوبز هي القوة المادية بينما القوة التي يقصدها ابن خلدون هي القوة المعنوية .
الوجه الثالث : في مبدأ (عدوانية الانسان الطبيعية ) . فقد اعتبرت نظرية الوازع الخلدونية ، ان حياة الناس ، لا يمكن ان تستقيم ، إلا بالوازع ، الذي : { يدفع بعضهم عن بعض ، لما في طباعهم الحيوانية ، من العدوان والظلم } . { ولما في الطبيعة الحيوانية ، من الظلم والعدوان ، بعضهم على بعض } . فجاء هوبز ، وأكد هذا المبدأ – تقريا عندما اعتبر : { ان الانسلن اناني بطبعه } ، ولذلك كان في عهد الفطرة الأولى { وحيدا ، فقيرا ، متوحشا ، شريرا } ، وكانت الصراعات والحروب بين الافراد ، قبل وجود الدولة : { مبعثها الانانية ، والشرور المتأصلة في نفوس البشر ، وحب السيطرة ، والتسلط . لذلك أخضع نفسه لقوة تحميه هي قوة الدولة – فالدولة كما يؤكد أيضا هي : { إله الأرض ، الذي نعتبر مدينين له بالسلم والإستقرار ، في ظل الخضوع للإله الأعلى } .
الوجه الرابع : في مبدأ الارادة . فإن المؤكد ان نظرية العقد ، تستند الى الرضا ، والإختيار الحر ، أي الى ( الإرادة ) ، في اتفاق الافراد ، على ابرام العقد الاجتماعي ، ومن المؤكد ايضا ، ان ابن خلدون ، اثبت ذلك واكده ، بطريقته الخاصة ، قبل ظهو ر نظرية العقد ، في أوروبا . فقد استخدم ، للتعبير عن مفهوم ( الارادة ) ، مصطلح ( التعاون ) ، بمعنى تعاون الانسان ، مع بني جنسه ، بمحض ارادته . حيث يقول ابن خلدون : { فلا بد في ذلك كله ، من التعاون عليه بأبناء جنسه ، وما لم يكن هذا التعاون ، فلا يحصل له قوت ، ولا غذاء ، ولا تتم حياته } . وأيضا { لما في طباعهم من التعاون على المعاش } . لأن الإنسان { محتاج الى المعاونة ،في جميع حاجاته دائما بطبعه .
ثانيا : نقد نظرية العقد الإجتماعي :
إنتقادات وجهت لنظرية العقد الإجتماعي :
لا يستطيع أحد ان ينكر الدور الذي لعبته النظريات العقدية في تطور الفكر السياسي الحديث ، ولكنها مع ذلك ، تعرضت لعدة انتقادات أهمها :
1-غير صحيحة من الناحية القانونية : يعرف العقد بأنه توافق أو ارتباط بين إرادتين أو أكثر بقصد تحقيق آثار قانونية معينة . هذه الآثار يعبر عنها أحيانا بالمصالح والحقوق والتي لا يمكن ضمانها إلا بالوسائل القانونية التي تتبناها السلطة . لذا فإن القوة الإلزامية للعقد لا توجد إلا بوجود
السلطة التي تقوم على حمايتها وتطبق الإجراءات اللازمة لضمان إحترامها . وبناءا على ذلك لا يمكن أن يكون العقد الذي يحتاج إلى حماية السلطة العامة هو ذاته الذي أنشأ هذه السلطة وأقامها .
2-أن فكرة العقد الإجتماعي فكرة خيالية لا تجد أي سند من الواقع ، فالتاريخ لا يعطينا أي مثال لدواة نشأت عن طريق العقد .
3-نظرية العقد الاجتماعي تقوم على فكرة تقوم على سلب الحريات لربط الناس بالدولة . في حين أنها تقول أن الفرد حر بطبيعته . لذلك نجد أن بداية الفكرة لا تستقيم مع نهايتها .
4-أن المعلومات والشواهد التاريخية التي جمعها علماء الإجتماع والأنثروبولوجيا تؤكد أن العقد لم يكن بداية المجتمع ، كذلك لوحظ أن نظرية العقد الإجتماعي هي في حقيقة الأمر نظرية ميكانيكية ، فالدولة ليست نظاما صناعيا ينشأ ميكانيكيا عن طريق العقد ، فالنظم السياسية طبيعية تنمو وتتطور أساسا والدولة – كما يقول ارسطو – أحد هذه النظم الطبيعية .
5-إن هذه النظرية غير مقنعة ايضا كفرضية نظرية من جهة ان العقد لايربط الا الذين هم أطراف في العقد ، فلكي تتأسس الدولة بصورة صحيحة على عقد اجتماعي ، يتوجب ان يكون هذا العقد مقبولا من اجماع رعايا الدولة في المستقبل . ولكن التجربة تثبت أن الاجماع ، في مجوع ذي أهمية ، غير ممكن اطلاقا . والممكن هو الأكثرية . ولكن ما هو الوضع القانوني اذا بالنسبة الى العقد الاجتماعي ، لأولئك الذين لم ينضموا للاتفاق والذين ما يزالون ، رغم ذلك يشكلون جزءا من مجموع المواطنين .
6-قامت هذه النظرية على إفتراض وهمي خاطئ ، ألا وهو أن الفرد مان يعيش حياة عزلة قبل قيام الجماعة . وهذا غير صحيح ، لأن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي لا يطيق حياة العزلة .
7- يرى الكاتب السياسي الإنجليزي بلنتشلي ( 1733- 1804 ) بقوله : إن نظرية العقد تنطوي على آراء خطيرة على الدولة . إذ أن المؤمنين بهذه النظرية بأن للشعب حقا مطلقا في الثورة . وهذه الأفكار هدامة تؤدي إلى القضاء على الجميع بأسره . وأنا غير متفق مع بلنتشلي في هذا الإنتقاد ، لأن من مقومات وجود الدولة الأساسي هو وجود الشعب الذي يكون له الحكم والقرار فهو صاحب السيادة المطلقة ، ويستطيع القيام بثورات وثورات على كل ديكتاتور يريد أن يحتكر الدولة ، ويغتصب حق الشعب في الحكم وتوجيه الدولة إلى المسار الصحيح .
ولكن على الرغم من كثرة الإنتقادات التي وجهت لهذه النظرية ، فقد حققت في بدء ظهورها فوائد جمة للمجتمع الأوروبي ، لأنه وقفت في وجه نظام الحكم المطلق ، وأيدت حقوق الشعب ووضعت حد لطغيان الطبقة الحاكمة . وبفضل هذه النظرية إستقرت مبادئ وعقائد كالمساواة ووضحت الحريات والحقوق و الحريات العامة وتحققت نهائيا سيادة الشعوب وإعلاء كلمتها ، لذلك قيل إن نظرية العقد كانت أكبر أكذوبة سياسية ناجحة .
كما كان لهذه النظرية الفضل الكبير في نشر القيم والمبادئ الديمقراطية ، ولعبت دورا مهما في نشأة المذهب الفردي .
المبحث الثاني
رؤية الفكرالماركسي للدولة
سأتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب أساسية :
المطلب الأول
أسس النظرية الماركسية
أسس الفكر الماركسي : من وجهة نظر فلسفية يعتبر ماركس انجلز ماديين . ويجب ان نشير الى مايجب فهمه بالمادية . فالمادية ليست فلسفة مبنية على التساهل الأخلاقي أو على التمتع بالأموال المادية . لأن المادية هي مذهب مؤداه أن المادة هي الحقيقة الأساسية ، والفكر ، والروح ليسا سوى حصيلة مظاهر ظواهر مادية . فهمما متفرعين عنها . هذا الموقف الفلسفي يؤدي الى انكار الروح على انها شيء منفصل عن الجسد ، وتؤدي إلى انكار الإله .
وفيما يلي أهم الأسس والنظريلت التي تقوم عليه النظرية الماركسية :
1-المادية الجدلية ( الديالكتيك ) : تشكل هذه النظرية الأساس الفلسفي للنظرية الماركسية ، ويرجع الفضل في وضع أسس هذه النظرية وأصولها العالم الألماني هيجل الذي قال بأن العالم حقيقة متغيرة ، وان هذا التغير يتم عن طريق صراع الأضداد المتعارضة وتقول هذه النظرية بأن الفكر نتاج المادة وان الحياة عبارة عن صراع بين الأضداد وان هذا الصراع يؤدي الى التطور .
2-المادية التاريخية : هي تطبيق لتلك المادية الجدلية على التاريخ ، أي الى دراسة الحياة الإجتماعية عبر التاريخ .ان في الانتاج الاجتماعي لوسائل الوجود يعقد الأفراد فيما بينهم روابط معينة لا مناص منها مستقلة عن إرادتهم . وهي روابط تمر بمرحلة معينة من تطور قواهم الانتاجية . ومجموع روابط الانتاج هذه تكون الكيان الاقتصادي للمجتمع ، ذلك الكيان التي ترتكز اليه النظم القانونية والسياسية والأفكار الاجتماعية فهو الأساس الحقيقي لها . وهكذا فإن أسلوب الانتاج في الحياة المادية هو الذي يحدد بصفة عامة تطور الحياة الإجتماعي والإقتصادي والفكري .
3-العقيدة الإجتماعية : أي المجتمع ، أي العلاقات والروابط الموجودة بين بني البشر ، يتحدد بدرجة أولى بهذه الظروف المادية التي تحيط بالظواهر الفكرية وتؤثر فيها . ولكن العامل الحاسم هنا هو تقنية الإنتاج . فتقنية معينة تجر وراءها شكلا معينا للمجتمع . وكما يقول ماركس : المطحنة الهوائية تعطينا مجتمعا اقطاعيا والمطحنة البخارية تعطينا مجتمع الرأسمالية الصناعية . وينتج عن ذلك أنه في كل مجتمع يجب التمييز بين البنيات التحتية والبنيات الفوقية . فالبنية التحتية هي القوة الإقتصادية والتقنيات وعلاقات الإنتاج . والبنيات الفوقية هي الأشكال السياسية والأخلاق والحقوق والدين والفنون في ذات المجتمع . ويقول ماركس أن البنيات الفوقية للمجتمع تتشكل بناءا على الواقع الإقتصادي التي تمثل البنية التحتية للمجتمع . ومثال ذلك ان ثورة 1789 هي استبدال بنية تحتية خربة متوافقة مع نظام اقتصادي خاضع لسيطرة الأرستقراطية العقارية ، ببنية فوقية جديدة تتوافق مع تقدم البرجوازية إقتصاديا .
4-صراع الطبقات : ان هناك صراع دائم بن أفراد المجتمع دافعه اقتصادي لامتلاك وسائل الانتاج ، وان هذا الانقسام سيؤدي الى تقسيم المجتمع الى طبقتين متعارضتين احدهما تستغل الأخرى . وقد كان هذا الصراع بين طبقات عديدة على مر العصور ...الخ ، ومع تقدم قوى الانتاج وحلول المصانع الكبيرة والتجارة محل الزراعة ظهرت الطبقة البرجوازية محل الإقطاع ليبدأ الصراع بينها وبين طبقة العمال ( البروليتاريا ) .
5-ثورة البروليتاريا : فالتحول للإشتراكية يكون بإنفجار الصراع بين طبقة الرأسماليين وطبقة العمال . وفي النهاية ينتهي الأمر بتولي البروليتاريا مقاليد السلطة وتشكل ما يعرف بديكتاتورية البروليتاريا وتظل تحكم حتى تنتصر على جميع الطبقات الأخرى في المجتمع .
المطلب الثاني
الدولة في النظرية الماركسية
فالدولة في النظرية الماركسية ليست نظاما بديهيا أو حتميا ولازما لوجود الجماعة ، فإستقراءات " إنجلز " لتطور المجتمعات البشرية الأولى ، تقول : ان { الدولة لم توجد منذ الأزل ، فقد وجدت مجتمعات كانت في غنى عن الدولة ، ولم يكن لديها أي فكرة عن الدولة وسلطة الدولة ، وعندما بلغ التطور الإقتصادي درجة إقترنت بالضرورة بإنقسام المجتمع إلى طبقات غدت الدولة - بحكم هذا الإنقسام – أمرا ضروريا .
ان الدولة التي ولدت للحد من التعارضات بين الطبقات . ومن ثم قد أصبحت كقاعدة عامة دولة الطبقة الأقوى ، الطبقة المسيطرة إقتصاديا التي أصبحت بفضل هذه السيطرة الإقتصادية مسيطرة ايضا من الناحية السياسية ، فقد أصبح لها الكثير من الوسائل التي تعينها في استغلال الطبقة المقهورة .
وبما أن الدولة عبارة عن اداة قهر تستخدمه الطبقة الأقوى اقتصاديا لإخضاع الطبقات الأخرى داخل المجتمع ،فإنه بمجرد زوال هذه الطبقات كما هو الحال في مرحلة الشيوعية فإن مبرر وجود الدولة سيزول وبالتالي تصبح الدولة غير ضرورية . وبناءا على هذه الرؤية فان الفكر الماركسي يرى بأن وظيفة الدولة في المجتمع الماركسي محدد بفترة معينة وهي مرحلة الصراع ضد الطبقات الأخرى وبناء الاقتصاد الإشتراكي .
المطلب الثالث
تقدير النظرية الماركسية للدولة
1-أن الماركسيين يقولون من جهة بنظريتهم في المادية التاريخية ، حيث يفسرون جميع الظواهر تفسيرا ماديا إقتصاديا ، ثم يأتون في نظريتهم في الدولة ليقولوا بوجود عهد لم يكن لنظام الدولة فيه وجود ، بل كان هناك نظام القبيلة الذي يقوم فيه شيخ القبيلة بتسيير الأمور وفقا لسيادة العادات . فما الذي تعنيه العبارة التالية { ففي المجتمع البدائي لا نرى دلائل تنبئ بوجود الدولة ، وانما نرى سيادة العادات } . فهذا تفسير أدبي وأخلاقي لمركز شيخ القبيلة وسر نفوذه .
2-أن الدولة لم تنشأ مع الطبقات ، وانما نشأت كتطور إجتماعي لظاهرة السلطة ، هذه الظاهرة التي نشأت بدورها كضرورة حتمية تقتضيها الطبيعة البشرية . فالسلطة لم تنشأ من البداية ، والدولة لم تنشأ بعد ذلك ، لوجود تناقضات بين الطبقات ، وانما لوجود تعارض بين الحرية المطلقة للفرد و الحرية المطلقة لأخيه ، الأمر الذي حتم وضع حد لحدود كل منهما .
3-النظرية الماركسية نظرية عنيفة تصر على اللجوء الى العنف والصراع الدموي ضد الطبقات المسيطرة لهدم النظام القائم وترفض الحلول السلمية للمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتعتبرها مؤقتة .
واذا ما قارنا النظرية الماركسية مع نظرية العقد الإجتماعي فنرى أن :
النظرية الماركسية تقوم على العنف لوصول طبقة البروليتاريا للسلطة وذلك بسحق الطبقات الأخرى ، وبالتالي الاستبداد والعنصرية التي تؤدي الى انقسام المجتمع وتفككه، لأنه من غير الممكن أن تسحق طبقة من الشعب بكاملها دون أن يكون لذلك تبعات على الدولة .
بينما في العقد الإجتماعي يتنازل الأفراد بإرادة حرة سليمة من الإكراه للدولة ، ويخضعون لها لسلطانها على أساس عقد بين الأفراد والدولة ، ويكون ذلك بطريقة سلمية بعيدة عن إستخدام العنف ، فهدف العقد الإجتماعي إيجاد الدولة وضمان بقائها بإرادة الشعب الذي له الكلمة العليا .
النظرية الماركسية تحرم الملكية الفردية لوسائل الانتاج ، وهذا اعتداء على حرية الإنسان وحقه في التملك ، بل هي مخالفة للفطرة الطبيعية للإنسان .
بينما في العقد الإجتماعي فهو قائم على حرية الإنسان في التملك والمشاركة في حياة السياسية ،
فهو يعطي قيمة كبيرة للإنسان وروحه المعطاءة .
وعلى الرغم من هذه الإنتقادات للنظرية الماركسية الا انها قامت بترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع وتذويب الفوارق بين الطبقات الإجتماعية .
ويجب الإعتراف بدور هذه النظرية بالربط بين الظاهرة السياسية والاقتصادية .
وتركيز هذه النظرية على دور البيئة والجماعة في التاريخ أكثر من الأفراد .
الخاتمة
النتائج :
1-النظرية الماركسية في بناء الدولة ، سقطت إلى الأبد لمخالفتها للمنطق والطبيعة في إقامة المجتمعات المتماسكة والمتعاضدة ، فالتوجه الى اقامة المجتمع القائم على التفرقة الطبقية والعنصرية بين أفراده يؤدي الى انهياره لا محالة .
2-نظرية العقد الإجتماعي هي أفضل من النظرية الماركسية في بناء الدولة ، لأنها قائمة على بناء الدولة على أساس توجه إرادة الأفراد الى اقامة عقد بينهم وبين الدولة ، يرتب حقوق وإلتزامات بين الطرفين .
3-النظرية الماركسية قائمة على الحكم الشمولي الإقصائي والذي قد تستغله الطبقة الحاكمة لممارسة الإستبداد ضد معارضيهم من طبقة البروليتاريا نفسها ، وهذا ما حصل أثناء حكم ستالين للإتحاد السوفييتي حيث مارس الإبادة الجماعية للمعارضة .
4- العقد الإجتماعي يعطي للشعب ، حق عزل السلطة الحاكمة إذا تمادت في إستغلال سلطاتها وقوتها .
5-النظرية الماركسية خيالية في نظرتها لتشكل المجتمع واقامة الدولة ووصول طبقة البروليتاريا للحكم ومن ثم إضمحلال الدولة تدريجيا وصولا لمرحلة الشيوعية ، حيث أن هذه تطبيق هذه الفلسفة ، له كثير من الصعوبات والعقبات .
التوصيات :
1-نظرية العقد الإجتماعي وان كانت لها الفضل الكبير في الترويج للمبادئ الديمقراطية . وأنها أعطت الإنسان الحق في الملكية الخاصة ، فأتمنى على الدول التي تتبنى الفلسفة الديمقراطية بأن تسن قوانين تتبنى العدالة الإجتماعية بين أفراد الدولة ، وتذويب الفوارق بين الطبقات الإقتصادية في المجتمع .
2-الدول التي ما تزال تتبنى الأيديولوجية الشيوعية،وتمارس الحكم الإستبدادي الشمولي ،يجب أن تراجع سياساتها تجاه شعبها، حيث يجب أن يكون للحكم للشعب في إختيار حكامه عبر الانتخابات ، وليس الإستئثار بالسلطة بحجة الثورة ، ومن الضرورة أن تقوم هذه الدول بالإصلاح الديمقراطي في نظامها .
3-يمكن أن يتم اقامة نظام سياسي وقانوني ، يأخذ من قيم النظرية الماركسية :
مثل : العدالة الإجتماعية . وممارسة العمل السياسي وفق مقتضيات العمل الديمقراطي .
وأرجو أن يكون بحثي المتواضع ، قد أوفى الغرض منه ، فما يهمني هو رضا الله ورضا أمتي بي ، فالحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم .
قائمة المراجع والمصادر :
المراجع باللغة العربية :
1-غالي ، بطرس ، عيسى ، محمود . ( 1984 ) . المدخل في علم السياسة . ط 1 . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة ، مصر .
2-بدوي ، ثروت . ( 1999 ) . النظم السياسية . الطبعة بدون . دار النهضة العربية . القاهرة ، مصر .
3-خليفة ، حسن . ( 1929 ) . تاريخ النظريات السياسية وتطورها . ط 1 . المطبعة الحديثة بشارع خيرت . القاهرة ، مصر .
4-جمال الدين ، سامي . ( 2005 ) . النظم السياسية والقانون الدستوري . الطبعة بدون . منشأة المعارف . الإسكندرية ، مصر .
5-عصفور ، سعد . ( 1980 ) . المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية . الطبعة بدون . منشأة المعارف . الإسكندرية ، مصر .
6-حجى ، طارق . ( 1980 ) . أفكار ماركسية في الميزان . ط 3 . مطبعة الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية .
7-الشهاوى ، طارق . ( 2009 ) . نظرية العقد السياسي . ط 1 . دار الفكر الجامعي . الإسكندرية ، مصر .
8-بسيوني ، عبد الغني . ( 1984 ) . النظم السياسية والقانون الدستوري . الطبعة بدون . منشأة المعارف . الإسكندرية ، مصر .
9-الدبس ، عصام . ( 2014 ) . القانون الدستوري والنظم السياسية . ط 1 . دار الثقافة للنشر والتوزيع . عمان ، الأردن .
10-سعد الله ، علي . ( 2003 ) . نظرية الدولة في الفكر الخلدوني . ط 1 . دار مجدلاوي للنشر والتوزيع . عمان ، الأردن .
11-دويكات ، غازي . ( 2013 ) . القانون الدستوري .
12-فهمي ، مصطفى . ( 2000 ) . النظم السياسية والقانون الدستوري . ط 1 . دار المطبوعات الجديدة . الإسكندرية ، مصر .
13-نصر ، محمد . ( 1973 ) . النظريات والنظم السياسية . الطبعة بدون . دار النهضة العربية . بيروت ، لبنان .
14-بدوي ، محمد . ( 1966 ) . أصول علم السياسة . ط 1 . جامعة الإسكندرية . الإسكندرية ، مصر .
15-مهنا ، محمد . ( 2009 ) . علوم سياسية : الأصول والنظريات . ط 1 . مؤسسة شباب جامعة الإسكندرية . الإسكندرية ، القاهرة .
16-إسماعيل ، فضل الله . ( 2005 ) . تطور الفكر السياسي الغربي . الطبعة بدون . مكتبة بستان المعرفة . كفر الدوار ، مصر .
17-اسماعيل ، فضل الله ، عتمان ، سعيد . ( 2006 ) . نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي . الطبعة بدون . مكتبة بستان المعرفة . الإسكندرية ، مصر .
18-بركات ، نظام ، الرواف ، عثمان ، محمد ، الحلوة . ( 1999 ) . مبادئ علم السياسة . الطبعة بدون . مكتبة العبيكان . الرياض ، السعودية .
المراجع الأجنبية :
1-هوريو ، أندريه . ( 1977 ) . القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الجزء الثاني . ط 1 . الأهلية للنشر والتوزيع . بيروت ، لبنان .
#علاء_عدنان_عاشور (هاشتاغ)


 Alaa_Adnan_Ashour#
Alaa_Adnan_Ashour#



كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
غزة الخضراء .....
-
وهم التخلص من المقاومة المسلحة في غزة
-
نصوص نثرية عن غزة ...
-
المقاومة الفلسطينية المسلحة ومعضلة الشرعية الدولية
-
مآلات الحرب على غزة
المزيد.....
-
النسخة الإليكترونية من جريدة النهج الديمقراطي العدد 589
-
تحليل - فرنسا: عندما يستخدم رئيس الوزراء فرانسوا بيرو أطروحا
...
-
برقية تضامن ودعم إلى الرفاق في الحزب الشيوعي الكوبي.
-
إلى الرفيق العزيز نجم الدين الخريط ومن خلالك إلى كل مناضلات
...
-
المحافظون الألمان يسعون لكسب دعم اليمين المتطرف في البرلمان
...
-
استأنفت نيابة العبور على قرار إخلاء سبيل عمال شركة “تي أند س
...
-
استمرار إضراب عمال “سيراميك اينوفا” لليوم السابع
-
جنح مستأنف الخانكةترفض استئناف النيابة وتؤيد قرار إخلاء سبيل
...
-
إخلاء سبيل شباب وأطفال المطرية في قضية “حادث الاستثمار”
-
إضراب عمال “النساجون الشرقيون”
المزيد.....
-
الذكرى 106 لاغتيال روزا لوكسمبورغ روزا لوكسمبورغ: مناضلة ثور
...
/ فرانسوا فيركامن
-
التحولات التكتونية في العلاقات العالمية تثير انفجارات بركاني
...
/ خورخي مارتن
-
آلان وودز: الفن والمجتمع والثورة
/ آلان وودز
-
اللاعقلانية الجديدة - بقلم المفكر الماركسي: جون بلامي فوستر.
...
/ بندر نوري
-
نهاية الهيمنة الغربية؟ في الطريق نحو نظام عالمي جديد
/ حامد فضل الله
-
الاقتصاد السوفياتي: كيف عمل، ولماذا فشل
/ آدم بوث
-
الإسهام الرئيسي للمادية التاريخية في علم الاجتماع باعتبارها
...
/ غازي الصوراني
-
الرؤية الشيوعية الثورية لحل القضية الفلسطينية: أي طريق للحل؟
/ محمد حسام
-
طرد المرتدّ غوباد غاندي من الحزب الشيوعي الهندي ( الماوي ) و
...
/ شادي الشماوي
-
النمو الاقتصادي السوفيتي التاريخي وكيف استفاد الشعب من ذلك ا
...
/ حسام عامر
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة