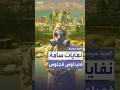ماثيو رينو


الحوار المتمدن-العدد: 7700 - 2023 / 8 / 11 - 14:59
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
نشر النص في موقع Contretemps باللغة الفرنسية بتاريخ ٢ شباط/فبراير ٢٠١٨
من كتاب:
Matthieu Renault, L’Empire de la révolution. Lénine et les musulmans de Russie, Paris, Syllepse, « Utopie critique », 2017.
—
في نهاية عام ١٩١٩، عندما وصلت الأزمة في باشكيريا إلى نقطة اللاعودة وخرجت النزاعات في تركستان إلى العلن، أتيحت للينين أول فرصة لعرض تصوره للسيرورة الثورية في الشرق. في الفترة الممتدة بين ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ٣ كانون الأول/ديسمبر، انعقد المؤتمر الروسي الثاني للمنظمات الشيوعية الإسلامية لشعوب الشرق، جامعاً أكثر من ٢٣ مندوباً جاؤوا بنسب مختلفة من تترستان وباشكيريا وتركستان وخيفا وبخارى وقيرغيزستان وأذربيجان وشمال القوقاز… عشية المؤتمر، انقعد اجتماع برئاسة لينين وبعض المشاركين ووفد من اللجنة المركزية للحزب. عند افتتاح المؤتمر في اليوم التالي، قدّم لينين تقريراً أمام الجمعية العامة. أكد فيه أن ما هو أساسي “في الوضع الراهن” هو “موقف شعوب الشرق إزاء الامبريالية والحركة الثورية بين هذه الشعوب”، وأصر منذ البداية على أن مثل هذه الحركة لا يمكنها “التطور بنجاح” إلا عن طريق ارتباط متين، “بعلاقة مباشرة بالنضال الثوري لجمهوريتنا السوفياتية ضد الامبريالية الدولية”؛ في الحالة المعاكسة، سيحكم عليها بالعجز. إن الوضع الجغرافي والاقتصادي والسياسي لروسيا كـ“بلد متخلف وواسع […] على تقاطع طرق بين أوروبا وآسيا، وبين الغرب والشرق” ما يجعل من هذا التحالف ليس ضرورياً فقط، إنما طبيعياً. (١)
ركز القسم الأول من عرض لينين على الوضع العسكري. فالانتصارات التي تحققت على جميع الجبهات ضد الجيوش البيضاء، عملاء الامبريالية، هي دليل على أن الجماهير العمالية والفلاحية الروسية قد تحررت فعلياً، لأنه كما كتب لينين الذي لم ينسَ ملاحظاته حول كلاوزفيتز(٢)، إن “طبيعة الحرب وكسبها يرتبطان قبل كل شيء بالنظام الداخلي للبلاد الذي يدخل في الحرب، والحرب هي انعكاس للسياسة الداخلية لهذا البلد التي اعتمدها قبل الأعمال العدائية”. إذا كانت الحرب الأهلية الروسية، “حرباً ثورية” بامتياز، سيكون مقدراً أن تتضمن “نطاقاً عالمياً مذهلاً لجميع شعوب الشرق” فذلك لأنها أثبتت أنها “على الرغم من ضعفها، وعلى الرغم من قوة ظلم الأوروبيين الذين يطبقون كل الفنون الحربية، إلا أن “الشعوب المضطهدة” قادرة على “تحقيق المعجزات”. من خلال تصور الحرب الأهلية الروسية كحرب شعبية وكحرب غير متكافئة، جعل منها لينين نموذجاً للحروب الثورية-القومية الآتية في العالم (شبه) الكولونيالي؛ وكانت إثباتاً على أن “تحرر شعوب الشرق هو اليوم بات قابلاً للتحقيق على نحو كامل”.(٣) وزاد الأمر سوءاً مع تفكك الجيوش الامبريالية من الداخل، منذ اللحظة التي يكتشف فيها الجنود “الدستور في روسيا السوفياتية، الذي بات مترجماً إلى كل اللغات”. ويضيف لينين: “اليوم كل شخص يفهم كلمة “السوفيات”، وهي عبارة تعمل كوسيط عالمي، ما يجعل من الممكن، لا بل من الحتمي في الحقيقة، نشر-ترجمة الثورة خارج الحدود الروسية، في الغرب كما في الشرق”.(٤)
إن البلاشفة هم الذين تولوا المهمة الهائلة بـ”فتح ثغرة في الامبريالية القديمة”، و”إشعال النيران في مسارات جديدة للثورة”. مع ذلك، قال لينين لمحاوريه: “تنتظركم مهمة أعظم وأحدث، أنتم الذين تمثلون الجماهير العمالية في الشرق”؛ لأن الثورة الاشتراكية “الوشيكة [الحصول] في كل أنحاء العالم”، لن تقتصر “على نضال البروليتاريا الثورية في كل بلد ضد برجوازيتها، إنما ستكون “نضالاً لا يتجزأ لكل الكولونيالات وكل الدول المضطهدة من جانب الامبريالية”. من خلال تكرار الأطروحات التي كتبها خلال الحرب، أكد لينين على أن “الثورة الاشتراكية العالمية” لا يمكن أن تفشل في الدمج بين “حرب العمال الأهلية” و”الحرب الوطنية ضد الامبريالية”. وأن تكون الأخيرة “مرتبطة” بالأولى لا يعني مطلقاً أن تكون تابعة لها: “نحن نعلم أن الجماهير في الشرق ستتدخل في هذه الحالة كمشاركة مستقلة، ومبدعة لحياة جديدة”، كـ”قوة ثورية مستقلة”، بكلمات أخرى مثل موضوعات سياسية كاملة، في حين “حتى الآن كانت هدف السياسة الدولية للرأسمالية، وسماداً للثقافة والحضارة الرأسماليتين”، ومجرد “مصدر إثراء”، ومحكومة بـ”لعب دور سلبي”، للبقاء “بالكامل خارج التقدم التاريخي”. (٥)
صحيح أن لينين لم يبتعد عن تطورية معينة، مصبوغة بالاستشراق، من خلال الاستمرار برؤية أن الشرق قد “استفاق من نومه”. تجربة عام ١٩١٧، أي ثورة “في بلد متخلف” تناقضت مع توقعات أرثوذكسية الأممية الثانية، مع ذلك فقد تحصن [لينين] بشكل نهائي ضد تشجيع ممثلي الدول غير الغربية، في حالتنا هذه الشيوعيين المسلمين في الشرق السوفياتي، على سلوك مسار بشكل أعمى قد جرى رسمه فعلياً، أو الخطوات التي اتخذت فعلياً، من جانب أوروبا الغربية، أو حتى من قبل روسيا السوفياتية:
“تبرز هنا مهمة لم تواجه بعد الشيوعيين في كل أنحاء العالم: على أساس النظرية العامة وممارسة الشيوعية، يجب أن تتكيف مع الظروف المحددة غير الموجودة في الدول الأوروبية، وتعلم تطبيق هذه النظرية وهذه الممارسة هنا حيث يشكل الفلاحون أغلبية الجماهير، وحيث يتطلب الأمر النضال ليس ضد رأس المال، إنما ضد رواسب العصور الوسطى. […] هذه هي المشاكل التي لن تجد حلاً لها في أي كتاب شيوعي، إنما فقط في النضال المشترك الذي أطلقته روسيا. يجب طرح هذه المشاكل وحلها بمساعدة تجربتك الخاصة”.(٦)
إن تطبيق-تكييف النظرية والممارسة الشيوعية التي لم تحققها بعد شعوب الشرق ليست بكل تأكيد مهمة ميكانيكية محددة سلفاً؛ هي عمل تطبيقي يجرى تنفيذه، وفق كل حالة لوحدها، ووفق الظروف والتجارب الفريدة للاضطهاد والنضال التي تخصها:
“إنها مسألة […] ترجمة العقيدة الشيوعية الحقيقية إلى لغة كل شعب، المخصصة لشيوعيي الدول الأكثر تقدماً”. (٧)
بعد عام ونصف، وفي رسالة وجهها إلى الشيوعيين في القوقاز- “من أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وداغستان وجمهورية شعوب شمال القوقاز”- كان لينين أكثر وضوحاً: “بهدف الحفاظ على سلطة السوفيات وتطويرها” باعتبار ذلك “انتقالاً إلى الاشتراكية”، “ومن المهم قبل كل شيء أن يعرف كل الشيوعيين في منطقة القوقاز خصوصيات وضعهم، […] المختلف عن وضع وظروف الجمهورية الاشتراكية الاتحادية السوفياتية؛ وهم يدركون الحاجة إلى عدم نسخ تكتيكاتنا، ولكن تعديلها بعد التفكير الناضج، بحسب الظروف الملموسة المختلفة”، سواء كانت الأخيرة مرتبطة بالوضع (الجيو)سياسي الآني أو المتجذر في البنى الاقتصادية والوطنية-الاجتماعية. في جمهوريات القوقاز، “من الممكن والضروري إقامة انتقال أبطأ وأكثر حرصاً ومنهجية نحو الاشتراكية”، ولينين يدعو الشيوعيين القوقازيين إلى “خلق جديد” بالسعي إلى “تطبيق غير حرفي، إنما بالمعنى والروح، لدروس تجربة ١٩١٧-١٩٢١”.(٨) تتكرر هذه الصيغة تقريباً حرفياً، من خلال تغييرها جغرافياً، للتعليمات التي أطلقها قبل عقدين في كتاب ما العمل؟ بهدف الترجمة في روسيا لتجربة الحركة الثورية الماركسية في أوروبا الغربية.
واتخذت خطوة حاسمة في صيف عام ١٩٢٠، عندما انعقد المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية في موسكو، وبلغت ذروتها في المناقشات حول “المسائل الوطنية والكولونيالية”، التي نظمها لينين. وقد حرص الأخير على تحضير الأرضية، حتى عبر تقرير مصير تركستان، وسلسلة من ١٢ أطروحة، تتعارض معها المطالبة بعدم حصر أنفسهم بـ”الاعتراف اللفظي بالأممية” و”تطبيق سياسة تهدف إلى تحقيق أقرب اتحاد لكل حركات التحرر الوطنية والكولونيالية مع روسيا السوفياتية”. هذه الأطروحات المسبوقة بـ ١٥ نقطة، وهي حالات يطلب من أعضاء الأممية الشيوعية تبنيها، وتعلق ثلث بنودها بمسألة الثورة في الشرق: “شعوب الشرق”، “النضال ضد القومية الإسلامية” و”جمهوريات البشكيريا والتتاري” و”قيرغستان” وأخيراً تركستان وتجربتها”. (٩)
قدم لينين كذلك مجموعة فرعية من الحجج الصالحة بشكل خاص لـ”الدول والأمم الأكثر تخلفاً” وحيث ما زال اختراق الرأسمالية ضعيفاً والطبقة العاملة غير موجودة تقريباً، وحيث، بالتالي، “تسيطر العلاقات الفلاحية الإقطاعية أو البطريركية أو البطريركية الفلاحية”؛ بكلمات أخرى، الحجج لم تكن محصورة بالشرق. وهو يحاجج أنه من الضروري مساعدة “حركة التحرر الديمقراطية البرجوازية في هذه الدول” في الوقت الذي نناضل “ضد الميل لصبغها بألوان شيوعية”. مثل هذا “التحالف” لا يمكن إلا أن يكون “مؤقتاً”، وأي “اندماج” مع الحركة البروليتارية، التي يجب أن تحافظ على “استقلالها”، مستبعد. من الضروري كذلك “دعم حركة الفلاحين في الدول المتخلفة على نحو خاص […] ضد كل أشكال الإقطاع أو ما بقي منه” من خلال العمل من أجل اتحادها الأمتن مع “البروليتاريا الشيوعية في أوروبا الغربية” وعن طريق العمل على “تكييف المبادئ الأساسية للنظام السوفياتي” مع سياق ما قبل رأسمالي بواسطة إقامة “سوفيتات عمالية”- بالكاد أوضح لينين هنا أطروحة رأس المال، إلا أنه سيعمقها خلال المؤتمر. (١٠)
ولهذا السبب، من الضروري شن نضال لا يرحم ضد المضطهدين في الداخل، “رجال الدين من العناصر الرجعية والعصور الوسطى الذين لهم نفوذ في الدول المتخلفة” وحلفاء المضطهدين الخارجيين، المتمثلين بالإمبريالية الروسية أو عملاء الإمبريالية الخارجية. كذلك، ينبغي النضال ضد “القومية الإسلامية وسواها من التيارات المماثلة، والتي تحاول الجمع بين حركة التحرير ضد الامبريالية الأوروبية والأميركية وتعزيز مواقع الخانات، وأصحاب الأراضي، والملالي…” بقيت هذه الحجج غامضة، بحيث ينظر إلى القومية الإسلامية على أنها شبح، يغطي ظله منطقة تمتد إلى ما وراء الحدود الروسية، أكثر من كونه عدواً محدد المعالم. أما بالنسبة لـ “التيارات المماثلة” التي تدور حوله، فهي غير محددة بدرجة أكبر، على الرغم من أنها في كل الحالات تشمل المتغيرات المختلفة المناهضة للبلشفية من القومية التركية. مع ذلك، لا يمكن الاستنتاج هنا ضرورة محاربة الإسلام بأي شكل من أشكاله. لينين، وسنتحدث لاحقاً عن الموضوع، يعلم تماماً أن هذا الدين هو جزء لا يتجزأ من “الشعور القومي للدول والشعوب المضطهدة لفترة طويلة من الزمن”، وهو يؤكد على ضرورة إظهار “الحذر والاهتمام البالغين” اللذين من شأنهما، لوحدهما، إزالة تدريجية لـ”عدم الثقة” و”الكراهية” التي تعيشها الدول المضطهدة ضد من يضطهدها. (١١)
بعد الانتهاء من كتابة أطروحاته، طلب لينين من “كل الرفاق، على وجه التحديد أولئك من لديهم معرفة ملموسة بواحدة من هذه المسائل المعقدة جداً” أن “ينقلوا إليه آراءهم أو تصحيحاتهم أو إضافاتهم وتعديلاتهم”. (١٢) جاء ذلك في وقت وصلت إليه تصريحات “وجهاء” النظام التي تدل على أن الجميع ما زالوا بعيدين عن تأييد قضيته. وحيال المخاوف التي عبر عنها جورجي تشيتشيرين بما خص دعم البرجوازية الوطنية في الدول (شبه) الكولونيالية، أوضح لينين أن التحالف مع فلاحي الدول المضطهدة هو الأولوية المطلقة. وإلى يفغيني بريوبراجينسكي الذي أكد أنه في يوم إنشاء أوروبا الاشتراكية، فإنه إذا كان من المستحيل إيجاد تدبيرات اقتصادية مع الكيانات الوطنية للمناطق المتخلفة، يجب قمعها بالقوة، إذا لزم الأمر، وإلحاقها بالاتحاد السوفياتي الأوروبي، رد لينين: “إنه خطأ كبير”؛ ولم يتردد في اعتبار وجهات نظره على أنها (نيو)امبريالية ماكرة. وفي السياق نفسه، بلغ الصراع ذروته بعد عامين حول القوقاز، بين لينين وستالين، حيث سعى الأخير إلى إنكار الاختلاف الذي أقامه الأول بين الجمهوريات المتمتعة بالحكم الذاتي داخل أراضي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية (باشكورتوستان مثلا)، والجمهوريات السوفياتية في الخارج (أوكرانيا)، وهو ما يصل إلى منح الحرية لإدامة سيطرة روسيا على “مناطقها” الحدودية. (١٣)
كما تلقى لينين في ١٢ حزيران رسالة حول “الوضع في قيرغستان وتركستان”، موقعة من قبل ريسكولوف ونظام الدين خوجاييف (تركستان)، فاليدوف (باشكيريا)، وأحمد باتورسينوف (قيرغزستان)، معلنين فيها إلى أن “الثورة الروسية القومية” التي حصلت في بلد ذات “ماضٍ امبريالي كريه” حيث الجرائم المرتكبة ضد الأقليات القومية تمر من دون عقاب، ما زالت تنتظر “التحول” إلى ثورة “أممية” حقيقية، ينتقد كتّاب الرسالة أطروحات لينين لتجريديتها، وعدم جدوى مناشدة عدم الإساءة للمشاعر القومية للمسلمين، والتي ستبقى حبراً على ورق في ظل غياب تدابير سياسية ملموسة، أو حتى الإشارة إلى القومية الإسلامية “التي لا أساس حقيقي لها”، التي ليست سوى اختراع للمرسلين الإمبرياليين. من دون شك، كما يشيرون، إذا استعمل هذا التوهم الإسلاموي كذريعة لشن صراع شرس ضد المسلمين، لتقسيم أراضيهم إلى جمهوريات تحكم بيد من حديد، عندها في الحقيقة، يمكن أن يكون الإسلام الحاجز الذي ستجتمع تحته “حركة عامة ضد روسيا” تربط نفسها بـ”الحركة المناهضة لبريطانيا” ومن المرجح أن تؤدي إلى “مذبحة بحق الأوروبيين؛ ولكن هذا لن يكون أكثر من مجرد نتيجة، وردة فعل. (١٤)
يكمل كتّاب الرسالة، إن أطروحات لينين، هي إحدى أعراض عدم القدرة على الاستماع لنداءات التحذير التي يطلقها الشيوعيون القوميون أنفسهم، والتي تجاهلها بحجة أنهم لن يدافعوا سوى عن برجوازية صغيرة راغبة بإقامة “جدار الصين بين الكولونيالات والمركز”. مع ذلك، “من المستحيل تحرير الفلاحين الأصليين الفقراء من نير الكولونياليين على أيدي الأخيرين أو من قبل سلطة تعتمد على الكولونيالية. إن القول بأن مثل هذا التحرير ممكن هو كقول إن تحرير العمال على يد الرأسماليين هو تحرير”. أما موضوعة “إرسال شيوعيين أوروبيين حقيقيين” من المركز لتحرير السكان الأصليين، فهذا يرقى إلى حجب الوجه، لأنه لا مفر من سقوطهم عاجلاً أم آجلاً تحت تأثير “الكولونياليين المحليين”. لذلك، يجب على السلطة السوفياتية، سنة بعد أخرى، أن تثق بشيوعيي الشرق وتعاملهم “بندية”؛ لأن “ما هو مطلوب هو المساعدة وليس الإكراه”. (١٥) لسوء الحظ، لا نعرف ما كانت ردة فعل لينين عند قراءة هذه الرسالة، التي كانت واضحة في اتهامها، لكنها مع ذلك فتحت الطريق أمام الأشكال الأصلية، التي يمكن وصفها بأنها دي-كولونيالية، وتشدد على ضرورة عقد تحالف بين السلطة السوفياتية وشيوعيي الشرق كـ“طرفين متساويين”.
عشية افتتاح النقاشات في اللجنة الوطنية والكولونيالية في المؤتمر، دوّن لينين ملاحظات بما خص تقرير “آفاق الثورة في الشرق”، الذي كتبه أفيديس سلطان زاده، شيوعي أرمني من أصل إيراني ومؤسس الحزب الشيوعي في إيران. واستنتج التالي: “١) رفض استغلال الطبقات المالكة”؛ ٢) يتألف الجزء الأكبر من الشعب من فلاحين خاضعين لاستغلال رجعي؛ ٣) صغار الحرفيين: في الصناعة؛ الخلاصة: تكييف المؤسسات السوفياتية والحزب الشيوعي (تكوينه وأهدافه الخاصة) مع مستوى الدول الفلاحية في الشرق الكولونيالي”. (١٦) إن حتمية ترجمة النظرية والممارسة الشيوعيتين في الشرق يعاد التأكيد عليها من جديد: إنها تشكل تطبيق سلسلة من التغييرات المنظمة على كل أشكال ومعايير التنظيم السوفياتي مثل تلك التي أقيمت في روسيا.
لكن المحاور الأساسي للينين، والمتناقض معه جزئياً، خلال المؤتمر الثاني للأممية الثانية كان الشيوعي الهندي م.ن. روي الذي وزعت “أطروحاته الإضافية” على المندوبين والذي، كما فعل سلطان غالييف في صفحات حياة القوميات،(١٧) دعا إلى قلب التنظيم “الأورثوذوكسي للأولويات الثورية، عبر اعتبار أن الثورة في الشرق كشرط لإمكانية الثورة في الغرب، وليس العكس. محاججاً أن الدول المكلينة ليس عليها بالضرورة المرور بمرحلة ديمقراطية برجوازية، طلب روي من شيوعيي الكومنترن تقديم دعمهم فقط للعناصر الثورية عبر الوقوف بقوة وحزم مع الجماهير العمالية في الشرق. (١٨) وجرى التوصل أخيراً إلى حل وسط مع أطروحات لينين الأولية. في التقرير الذي قدمه يوم ٢٦ تموز/يوليو، عاد الأخير إلى المسألة التي، كما يقول، “تسبب بعض الاختلافات”، أي “الحركة الديمقراطية البرجوازية”. هذه الصيغة، كما جرى الاعتراض عليها، كانت غامضة ولا تسمح بالتمييز، داخل القوميات البرجوازية، بين “الحركة الإصلاحية” و”الحركة الثورية”. ولكن هذا التمييز بات ضرورياً من ناحية “حصول تقارب معين بين البرجوازية في الدول المستغلة وبرجوازية الدول المكلينة”، المتحالفة الآن في صراع مشترك “ضد الحركات والطبقات الثورية”. ولهذا السبب قرر استبدال عبارة “ديمقراطية برجوازية” بعبارة “قومية-ثورية”، للدلالة بأن الدعم سيقتصر بكل وضوح على الحركات البرجوازية “التي ستكون ثورية فعلياً”، أو على الأقل لا تعارض أبداً “لما نشكله وننظمه في الروح الثورية الفلاحية وجماهير المستغلين الواسعة”. (١٩)
يضاف إلى هذه المسألة مسألة أخرى لا تقل أهمية: “كيف نطبق التكتيكات والسياسات الشيوعية في الظروف ما قبل الرأسمالية”، مع العلم أنه في دول الشرق “لا يمكن تشكُّل حركة بروليتارية بحتة”؟ أضاف لينين، المسألة التي أثارها “عمل الشيوعيين الروس في الكولونيالات التي كانت تحت سلطة روسيا، كما هو الحال في تركستان وسواها”. هذا العمل واجه “صعوبات بالغة”، إذا استعملنا عبارة مهذبة، أظهر كذلك أن “الفلاحين يجدون أنفسهم في علاقة تبعية شبه إقطاعية” يمكنهم “تماماً استيعاب فكرة المنظمة السوفياتية”، والتي لا تنطبق فقط “ضمن إطار العلاقات البروليتارية”، و”جعلها تتحقق”. مع الاعتراف بافتقار الشيوعيين “للخبرة” في هذا المجال، أعلن لينين أن المناقشات التي حصلت في اللجنة، التي شارك فيها “ممثلون عن الدول المكلينة”، “أثبتت على نحو قاطع” أنه كان من الضروري العمل على إنشاء سوفيتات فلاحية. الكلمة الأخيرة في ترجمة التنظيم السوفياتي هي أقلمة الشكل السوفياتي نفسه مع الظروف الخاصة للشرق. هذه الأطروحات لا يمكن أن تفشل في توجيه ضربة قاضية للمراحلية الأرثوذوكسية للأممية الثانية:
“جرى طرح السؤال على الشكل التالي: هل يمكننا اعتبار التأكيد على أن المرحلة الرأسمالية من تطور الاقتصاد أمر حتمي للشعوب المتخلفة […]؟ كان جوابنا سلبياً. […] في كل الدول المكلينة والمتخلفة، لا يجب علينا فقط […] متابعة البروباغندا لصالح تنظيم سوفيتات الفلاحين، والسعي إلى تكييفها مع الظروف ما قبل الرأسمالية التي هي ظروفهم، ولكن كذلك ينبغي على الأممية الشيوعية إقامة وتبرير المستوى النظري لهذا المبدأ بأنه بمساعدة بروليتاريا الدول المتقدمة، يمكن للدول المتخلفة الوصول إلى النظام السوفياتي والمرور عبر مراحل معينة من التطور، إلى الشيوعية، وتجنب المرحلة الرأسمالية”.(٢٠)
يدافع لينين هنا تحديداً عما كان يعارضه في بشدة في صراعه الافتتاحي مع الشعبويين في نهاية القرن السابق والذي ما زال يعتبره قابل للتصور في الكتابات عن الثورات الشرقية في مرحلة ما بعد [ثورة] ١٩٠٥، (٢١) أي إمكانية تحقيق القفزة نحو الشيوعية إلى ما بعد المرحلة الرأسمالية، حتى في ظل الظروف التي يحددها انتصار الاشتراكية (على الأقل) في دولة واحدة على أن “تميل البروليتاريا المنتصرة […] نحو” جماهير الدول المتخلفة. (٢٢) لم يذهب لينين مطلقاً أبعد من هذه الصيغة، أو على الأقل في مخططاته، لنظرية متعددة الخطوط للسيرورة التاريخية. مع ذلك، هو لا يرفض مطلقاً فكرة “التاريخ الأممي”: بالنسبة له، الطرق المفضية إلى الشيوعية متعددة ولا يمكن اختزالها خاصة لأنها متشابكة، ولأن هذه السيرورات غير المتجانسة لا تتوقف، بالضرورة، عن التقاطع. عمل لينين على تفكيك مركزية التاريخ العالمي، الذي جعلته ثورة أكتوبر أمراً لا مفر منه، وأعادت تعريف أماكن وأزمنة النضال من أجل الاشتراكية بشكل راديكالي. مع ذلك، إن هذه اللامركزية هي محصورة، ومحدودة ليس بسبب إخلاص مؤلفها لمفهوم غائيّ للتاريخ كما هو عليه، إنما من خلال خضوعه لمنطق ثنائي من التخلف والتقدم (بصفته كحضارة) الذي لا يعارضه أبداً، على الرغم من أنه ينزعه من كل قدرية. تشهد قطيعة لينين مع نظرية التطور، أفضل من أي تعليق، بحسبما كتبه في كانون الثاني/يناير ١٩٢٣، على حافة الموت، حول مذكرات (المنشفي) نيكولاي سوخانوف، حول الثورة:
“الأمر اللافت للنظر على نحو خاص، هو التفلسف الممارس من جانب الديمقراطيين البرجوازيين الصغار وكذلك كل أتباع الأممية الثانية. […]، إنه نهجهم الذليل للماضي. […] لاحظوا أن تطور الرأسمالية والديمقراطية قد تبع حتى الآن مساراً محدداً في أوروبا الغربية. لا يمكنهم تصور أن هذا المسار يمكن اعتباره نموذجاً فقط بعد إجراء التغييرات اللازمة، على شرط حصول تغييرات محددة (غير مهمة من وجهة نظر الحركة العامة للتاريخ العالمي). يتجاهلون تماماً أن انتظام التطور العام في التاريخ العالمي، بعيداً عن الاستبعاد، يعني على العكس من ذلك بشكل ضمني فترات محددة تقدم الفرادات سواء في شكل أو في مجال حصول هذا التطور. ولا يخطر ببالهم، مثلاً، أن روسيا، الموجودة بين الدول المتحضرة والدول التي أحضرتها هذه الحرب للمرة الأولى وعلى نحو نهائي إلى الحضارة، أي كل الشرق، والدول خارج أوروبا- حيث أن روسيا يمكن ويجب بالنتيجة أن تقدم نسقاً محدداً، مندرجاً في الإطار العام لتطور العلم، ولكن تميزه ثورتها الخاصة عن بقية الثورات السابقة في أوروبا الغربية، والحاملة لبعض الابتكارات الجزئية عندما تعلق الأمر بالدول الشرقية. […] إذا كان من الضروري من أجل خلق الاشتراكية الوصول إلى مستوى معين من الثقافة […]، لماذا لا نبدأ بداية الإستيلاء الثوري على الشروط المسبقة لهذا المستوى المحدد لكي ننضم، نحن الأقوياء في سلطتنا العمالية والفلاحية وفي النظام السوفياتي، إلى حركة الشعوب الأخرى”.(٢٣)
جرى التأكيد على الأطروحات حول المسائل القومية والكولونيالية، في غياب لينين، في شهر أيلول/سبتمبر، خلال المؤتمر الأول لشعوب الشرق في باكو، بأذربيجان. انعقد المؤتمر بعد المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية، حيث كانت غالبية المشاركين من الأوروبيين، وقد استقبل ما لا يقل عن ألفي مندوب (من بينهم ٥٠ امرأة)، من الشيوعيين وغير الشيوعيين، جاؤوا من الامبراطورية الروسية (السابقة)، ومن سواها (تركيا، إيران والصين…) يمثلون ٤٠ “قومية” ويتحدثون العديد من اللغات. بعد “جلسة رسمية” مساء ٣١ آب/أغسطس، كان ناريمانوف، مضيف المؤتمر، “سعيداً” بافتتاح المناقشات في اليوم الثاني. رغم ذلك، ما علينا سوى النظر بسرعة إلى برنامج المؤتمر لفهم أن القائد الحقيقي لم يكن سوى زينوفييف، برفقة مئة شيوعي روسي وبعض “المساعدين” من الأممية الشيوعية، وعلى رأسهم راديك، وجون ريد وبيلا كون. وكان على عاتق هذا الأخير مهمة عرض مواقف الكومنترن حول طرق الترجمة من “النوع السوفياتي” في الشرق:
“النظام السوفياتي قابل للتكيف مع الظروف الخاصة لأي شعب. […] بينما في الغرب، السلطة هي تجسيد لديكتاتورية البروليتاريا، في دول الشرق، حيث لا توجد طبقة عاملة صناعية، فستكون تعبيراً عن ديكتاتورية الفلاحين الفقراء. وجهة النظر التي تقول إن الشعوب، التي لم تحقق التطور الرأسمالي وبالتالي لم تمر عبر مرحلة الديمقراطية البرجوازية، يجب عليها الخضوع لكل هذا التطور قبل الانتقال إلى نظام السوفيتات، هدفها الوحيد التأكيد على أن فلاحي الشرق البائسين سيبقون تحت سلطة الأمراء والبيكوات والكولونياليين الأجانب”. (٢٤)
أما بالنسبة لزينوفييف، فقد أشار في خطابه الختامي إلى مشاكل بالترجمة، بالمعنى الحرفي-اللغوي، التي عانى منها المؤتمر، لكنه لم يكن أقل تكراراً، وبلهجة منتصرة، في ترداد الأطروحة اللينينية عن السوفيات باعتبارها محرك يعمل أممياً:
“أيها الرفاق، كان علينا ترجمة كل هذه الكلمات إلى كل اللغات، ولكن كلمة “سوفيات” ليست بحاجة إلى الترجمة، إنها معروفة في كل العالم، في كل الغرب، وكل الشرق! سيكون الشرق سوفياتياً”.(٢٥)
على الرغم من أن المؤتمر قد مثّل من دون شك “لحظة أمل كبيرة” (٢٦)، وتآخياً حقيقياً، إلا أنه لم ينجح في جعلنا ننسى النزاعات الشديدة، التي كانت قد اندلعت فعلياً بين السلطة لسوفياتية ومسلمي المناطق الشرقية الحدودية في الإمبراطورية (السابقة). إذا لم يحاول إخفاء الحقيقة، التي وصفها بأنها “مؤسفة”: “في تركستان كما في بقية الجمهوريات الشقيقة الأخرى في الشرق”، أعضاء في الحزب “يسيئون معاملة السكان الأصليين، ويصادرون ممتلكاتهم”، مع ذلك فإنه يعيد هذه الأفعال السيئة إلى الاختراق السيء لـ”صفوفنا”، من جانب “العناصر غير المرغوب فيها” المترسبة من “روسيا البرجوازية القديمة” والتي تطيل “من أمد التقاليد البرجوازية القديمة للإمبراطورية القيصرية”، من خلال اعتبار “السكان الأصليين” أنهم ينتمون إلى “عرق أدنى”. (٢٧) لقد أوضح لينين، من جهته، أن إرث العقلية والممارسات الكولونيالية لا تنحصر بالحدود الطبقية، المشكلة هي بالضبط أن جزءاً كبيراً من البروليتاريا الروسية في المناطق الحدودية قد تأثر بشوفينية القوة العظمى للعناصر البرجوازية. قبل ٣ أيام، كان تشابولات ناربوتابيكوف، مندوب تركستان، أكثر صراحة من زينوفييف، إذ قال:
“لذلك يجب بأسرع وقت، تنظيم الشرق بعقلانية وبحسب ظروفه الدينية والاجتماعية والاقتصادية. […] لا يعرف الرفيق زينوفييف ولا الرفيق لينين ولا الرفيق تروتسكي الوضع الحقيقي في تركستان؛ لا يعرفون ما الذي حصل هناك في السنوات الثلاثة الماضية. […] لمنع تكرار التاريخ في تركستان وفي أماكن أخرى من العالم الإسلامي، نقول لكم: تخلصوا من أعدائكم المعادين للثورة، وعناصركم الأجنبية الذين يزرعون الفتنة الوطنية؛ تخلصوا من الكولونيين الذين يعملون تحت ستار الشيوعية!” (٢٨)
في اليوم التالي، تكلم ريسكولوف بدوره، مستشهداً بأطروحات لينين حول الامبريالية، مذكراً بأن “نتيجة” سياسة الامبريالية الاحتكارية ليست سوى “اجتياح الكولونيات والأسواق، يليه استعباد عنفي للشعوب المكلينة المصحوب بالاستغلال المخزي”. في حين خاف “قادة الأممية الثانية من الشعوب في الشرق وقدموا عليها مصالح الثقافة الأوروبية”، استمروا باعتبار الكولونيات مسكونة من “عبيد لن يكونوا قادرين على الارتقاء إلى مستوى أوروبا”، كان شعار “الأممية الثالثة” هو اتحاد البروليتاريا الغربية بالتيار الشرقي الثوري”. مثل هذا التحالف ممكن فقط، مع ذلك، بشرط الاعتراف بأن هذه الحركة، على الرغم من “امتلاكها لطابع شيوعي”، لا يمكن أن تكون “شيوعية بحتة”: ستكون بداية حركة “قومية” ذات طبيعة “برجوازية صغيرة”، تسعى إلى توحيد الشرق برمته”، لتتحول لاحقاً إلى حركة “اشتراكية” ذات طبيعة زراعية”؛ (٢٩) تلك كانت طريقة خفية للقول إنه علينا عدم التسرع في الأمور، إنما ترك، مؤقتاً، مسألة قيادة الثورة في الشرق إلى البرجوازية (الصغيرة) القومية الراديكالية، أي إلى الشيوعيين القوميين المسلمين أنفسهم، وهو الموقف الذي عبر عنه سلطان غالييف والذي بات موقفاً مستبعداً بسبب إعطاء الأولوية لبناء السوفيتات الفلاحية.
لكن ريسكولوف لم يسعَ إلى الاشتباك في مداخلته. ولكن لم يمنعه ذلك إلى جانب ٢٠ مندوباً من تقديم قرار آخر يهدف إلى “تصحيح” تجاوزات السلطة السوفياتية في الشرق. متجاهلاً المبادئ التي وضعها الحزب الشيوعي عينه، يمكننا قراءة “ظنّ المفوضون واللجان المرسلة من المركز” نحو المناطق الحدودية أن مهمتهم هي “إلغاء “استقلالية” شعوب الشرق بأسرع وقت ممكن- على الرغم من أن هذه الاستقلالية لم يتح الوقت أمامها للتطور بعد”. هذه السياسة، التي تضاف إلى استمرار الاضطهاد الذي يمارسه الكولونياليون ضد السكان الأصليين، أدت بطبيعة الحال إلى تخيل الشيوعيين المحليين على صورة الحكام القيصريين السابقين. إضافة إلى ذلك، حصل ارتياب مستمر في المنظمات الشيوعية للسكان الأصليين، ما منعها من اتخاذ أي مبادرة، ومنعها ذلك من أي فاعلية. أما شعار حق الشعوب بتقرير مصيرها، فقد كاد يحصل التخلي عنه لصالح تكتيك يتيح للجيش الأحمر التحريض على ثورات وهمية. وألحق ذلك بسلسلة من الاقتراحات، من بينها إقامة أحزاب شيوعية (مستقلة) للسكان الأصليين، دعم كل الحركات الثورية، والقومية من ضمنها، ضد الامبريالية، وكذلك إقامة ثلاثة “مجالس عمل وبروباغندا” في باكو وطشقند وإركوستك، تهتم بجزء من الشرق، الروسي وغير الروسي. (٣٠)
من الواضح أنه، وعلى العكس من المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية الذي تغذى من عمل حقيقي للتنظير والتفكير الجماعي، وليس عبر استبعاد الخلافات، كان مؤتمر شعوب الشرق مظاهرة بروباغندية كبيرة، انعقد تحت لافتة الصداقة (الشيوعية) بين الشعوب، والتي لا تخلو من إيحاءات بطريركية؛ احتفظ ممثلو السلطة السوفياتي والزعماء (الأوروبيين) للأممية الثالثة بالسيطرة الصارمة على مسار النقاشات. من الواضح في هذا المجال، الأمر البليغ الذي أصدره زينوفييف حيال شن “حرب مقدسة” حقيقية ضد الامبرياليين الأوروبيين والأميركيين، والذي نسعد باقتباسها وكأنها تمثل ذروة ملحمية للتلاقي بين النظام السوفياتي والحركات القومية الثورية في الشرق، وحتى بين الإسلام والبلشفية، في حين كانت مجرد مسألة تعبئة لاواعية، أكثر من كونها “عملاً حقيقياً للتحول السياسي”: لقد كانت، إذا صح القول، الدرجة صفر من الترجمة الثورية التي تصورها لينين. يجب عدم التفاجؤ أن هذا الأخير بقي جامداً في مقابل الحماس الذي أثاره المؤتمر في الصحافة: لا يمكن أن تُحَد الشيوعية، ضمن هذه الشروط، بأن “تلون القومية باللون الأحمر”. (٣١)
م.ن. روي الذي كان وقتها عضواً في مكتب الكومنترن في آسيا الوسطى، لم يكن مخطئاً، هو الذي رفض المشاركة في هذه المغامرة، وسخر في سيرته الذاتية من “سيرك زينوفييف” ووصف المؤتمر بأنه “طواف على أبواب الشرق الغامض”. في حين كان زينوفييف غاضباً واستهزأ راديك من هذه الجرأة، “كان لينين يبتسم بتساهل أمام عنادي”. (٣٢) استراتيجية روي الخاصة به لنشر الثورة في الشرق، هي استراتيجية يمكن تسميتها ببلشفة القومية الإسلامية، والمتضمنة برنامجاً صارماً من التدريب النظري والعملي والأيديولوجي والعسكري، لم تلقَ نجاحاً. خطط لرعاية جيش من المهاجرين الهنود (المهاجرين المسلمين) في تركستان منحدرين من حركة الخلافة الإسلامية، الذين وصلوا بعد ذلك إلى الحدود الشمالية الغربية للهند عبر أفغانستان لتأسيس جمهورية سوفياتية، والتي بدورها ستجذب الجماهير الهندية كمثل لها وعبر البروباغندا بهدف تحرير البلاد بأكملها من الكولونيالية البريطانية، أرسل روي، بموافقة لينين، إلى طشقند فوصل في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٢٠ متسلحاً بترسانة [فكرية] كبيرة. لكن المشروع انهار بعد عدة أشهر، إحدى منجزاته الأساسية كانت تأسيسه للنسخة الأولى من الحزب الشيوعي الهندي في طشقند.
عام ١٩٢١، أغلقت المدرسة العسكرية في طشقند ومكتب آسيا الوسطى، ما أفسح في المجال أمام القسم الشرقي من اللجنة التنفيذية للكومنترن ومقرها موسكو [لتولي الأمور]. ثم تصور روي فكرة “مركز التدريب السياسي للثوار من دول آسيوية مختلفة”، وهو المشروع الذي “وافق عليه لينين بكل حماس” (٣٣). في أيلول/سبتمبر ١٩٢١، فتحت الجامعة الشيوعية لعمال الشرق أبوابها، حيث ضمت في هيئتها التعليمية أساتذة عرضيين مثل ريسكولوف أو سلطان غالييف، ناريمانوف، روي نفسه أو حتى سلطان زاده، ومن بين الطلاب، شخصيات لعبت دوراً حاسما في مصير الشيوعية على المستوى الدولي، مثل هو تشي منه (الهند الصينية) أو ليو شاوتسي (الصين) أو تان مالاكا (أندونيسيا). (٣٤) وعلى الرغم من النزاعات بين السلطة السوفياتية والشيوعيين القوميين المسلمين، كان المجال ما زال متاحاً للتعاون. سيستمر هذا الأمر حتى عام ١٩٢٤، وتحديداً اليوم الذي أعقب وفاة لينين، ستتعرض إدارة الجامعة لعملية تطهير كبيرة. لن يمنع هذا الأمر تروتسكي من إلقاء خطاب في مناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الجامعة في العام نفسه، من تلخيص مضمون السياسات اللينينية لترجمة [الثورة في الشرق] أفضل من أي شخص آخر:
“في لحظة الأحداث الحاسمة، سيقول طلاب الجامعة الشيوعية لشعوب الشرق: “نحن موجودون لقد تعلمنا أمراً محدداً. نحن لا نعرف فقط ترجمة أفكار الماركسية واللينينية إلى لغات الصين والهند وتركيا وكوريا؛ إنما تعلمنا كذلك كيفية ترجمة معاناة وعواطف واحتياجات وآمال جماهير العمال في الشرق إلى لغة الماركسية””. (٣٥)
في تقريره المقدم إلى المؤتمر الرابع للأممية الشيوعية عام ١٩٢٢- الذي ألهم تفكير غرامشي حول إمكانية ترجمة اللغات العلمية والفلسفية- انتقد لينين “قراراً حول البنية العضوية للأحزاب، وكذلك حيال أساليب ومضمون عملها”، والذي جرى تبنيه العام المنصرم، معتبراً القرار “مشبعاً بالروح الروسية”، و”شديد الروسية”، بالنسبة للأجانب، حتى يتمكنوا من تطبيقه في سياقات وظروف مختلفة. وأفاد إلى أنه لا يمكن أن يحصل تصديراً لأشكال التنظيم الشيوعي دون ترجمة متبادلة للخبرات الثورية في مختلف دول، وعلى كل تجربة “التعلم” من التجارب الأخرى، ومن دون ترجمة هذه التجارب نفسها إلى نظرية واستراتيجية والعكس صحيح. (٣٦) إذا كان يفكر هنا وقبل كل شيء في إعادة ترجمة الثورة السوفياتية في أوروبا الغربية، فلا شك في أن هذا المطلب كان صالحاً على نحو أكبر بحسب وجهة نظره بالنسبة للشرق. قريباً سيُنسى درس لينين، ولكن قبل أن يكون هذا هو الحال، كان عليه خوض “معركة أخيرة”، هذه المرة داخل السلطة السوفياتية، بما خص قضية تركستان.
الهوامش:
[1] Lénine, « Rapport présenté au 2e congrès de Russie des organisations communistes des peuples d’Orient, 22 novembre 1919 » [1919], Œuvres, t. 30, p. 149.
[2] Voir Lénine, « Cahier sur Clausewitz » (Leninskaïa Tetradka), dans Berthol C. Friedl (dir.), Les Fondements théoriques de la guerre et de la paix en URSS, Paris, Médicis, 1945, p. 69.
[3] Lénine, « Rapport présenté au 2e congrès de Russie des organisations communistes des peuples d’Orient, 22 novembre 1919 », Œuvres, op. cit., p. 150-152.
[4] Ibid., p. 153-156.
[5] Ibid., p. 157-159.
[6] Ibid., p. 159-160.
[7] Ibid., p. 161.
[8] Lénine, « Aux camarades communistes d’Azerbaïdjan, de Géorgie, d’Arménie, du Daghestan et de la République des peuples du Caucase du Nord » [1921], Œuvres, t. 32, p. 336-338.
[9] Lénine, « Première ébauche des thèses sur la question nationale et coloniale », Œuvres, op. cit., p. 145, 147, 149.
[10] Ibid., p. 150-151.
[11] Ibid., p. 150-152.
[12] Ibid., p. 145.
[13] Voir Lénine, Collected Works, Moscou, Progress Publishers, vol. 31, p. 170, p. 561, note 51.
[14] « Письмо Рыскулова, Ходжаева Ленину о ситуации в Киргизии, Туркестане от 1920-06-12-реакция Ленина » [Lettre de Ryskoulov, Khodjaïev à Lénine sur la situation en Kirghizie, au Turkestan du 12 juin 1920. Réaction de Lénine], RGASPI, f. 5, op. 3, d. 3, I. 23-27, http://islamperspectives.org/rpi/items/show/11195.
[15] Ibid.
[16] Lénine, « Matériaux pour le 2e congrès de l’Internationale communiste » [1920], Œuvres, t. 42, p. 201.
[17] Mirsaid Sultan Galiev, « La révolution sociale et l’Orient » [1919], reproduit dans Alexandre Bennigsen et Chantal Quelquejay, Les Mouvements nationaux chez les musulmans de Russie : Le « sultangaliévisme » au Tatarstan, Paris/La Haye, Mouton, 1960, p. 207-211.
[18] Voir Dinesh Kumar Singh et A. P. S. Chouhan, « M. N. Roy. Twentieth-Century Renaissance », dans Mahendra Prasad Singh et Himanshu Roy (dir.), Indian Political Thought : Themes and Thinkers, New Delhi, Dorling Kindersely, 2011, p. 177.
[19] Lénine, « Rapport de la commission nationale et coloniale, 26 juillet », Œuvres, t. 31, p. 248-249.
[20] Ibid., p. 250-252.
[21] Voir en particulier Lénine, « Démocratie et populisme en Chine » [1912], Œuvres, t. 18, p. 162-168.
[22] Lénine, « Rapport de la commission nationale et coloniale, 26 juillet », Œuvres, op. cit., p. 251.
[23] Lénine, « Sur notre révolution : À propos des mémoires de N. Soukhanov » [1923], Œuvres, t. 33, p. 489-492.
[24] Le 1er congrès des peuples de l’Orient, Bakou (1920), Paris, La Brèche/Radar, [1921], 2017, p. 153.
[25] Ibid., p. 192.
[26] Ian Birchall, « Un moment d’espoir : le congrès de Bakou de 1920 », Contretempsweb, 2012.
[27] Ibid.
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] « Corrections must be made and made quickly : Resolution submitted to Baku Congress by 21 delegates », dans John Riddell (dir.), To See the Dawn : Baku, 1920, First Congress of the Peoples of the East, New York, Pathfinder, 1993, p. 328-339.
[31] Lénine, cité dans M. N. Roy, M. N. Roy’s Memoirs, Bombay/New York, Allied Publishers, 1964, p. 395.
[32] Ibid., p. 392.
[33] Ibid., p. 526.
[34] Alexandre Bennigsen et Marie Broxup, The Islamic Threat to the Soviet State, Londres, Routledge, [1983], 2014, p. 94.
[35] Léon Trotsky, « Perspectives et tâches en Orient. Discours pour le troisième anniversaire de l’Université communiste des peuples d’Orient » [1924], http://www.matierevolution.fr/spip.php?article1425.
[36] Lénine, « Cinq ans de révolution russe et les perspectives de la révolution mondiale : Rapport présenté au 4e congrès de l’Internationale communiste, le 13 novembre 1922 » [1922], Œuvres, t. 33, p. 442-444.
#ماثيو_رينو (هاشتاغ)



كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة