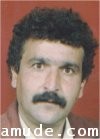إبراهيم اليوسف


الحوار المتمدن-العدد: 1700 - 2006 / 10 / 11 - 09:49
المحور:
مقابلات و حوارات
حاوره: فراس محمد، ودلبر أحمد
يعتبر الشاعر إبراهيم يوسف من أكثر الأدباء الكرد حضوراً يوميّاً من خلال مقالاته وتغطياته الخبرية المتواصلة، ومداخلاته التلفزيونية في أيّة لحظة محرجة يتعّرض فيها شعبه، لأية محنة، وما أكثر محن إنساننا..!، وقد أطلق عليه بعضهم صفة الأكثر جرأة، والأكثر موضوعية وعمق رؤى سياسية، لدرجة أن ّ كثيرين، نتيجة هيمنة الجانب السياسي الإعلامي على كتاباته، باتوا ينسون أنّه من عداد كتابنا الأكثر حضوراً أدبياً وإبداعياً، وأنّه من شعراء جيل الثمانينيات، بل وإنه إلى جانب عدد من شعرائنا المبدعين الغيارى، كانت ومازالت قصائدهم صوت الحلم الكردي في أقصى أمدائه، عاملاً بصمت بعيداً عن الإدّعاءات، وتوسّل النقد والحوار، ولعلّ معرفة أن أسئلة حوارنا هذا أعطيت له منذ عام، دون أن يجيب عنها (وهناك أسئلة لديه منذ سنوات ولم يجب عنها نتيجة كسل كبير غيرمتوقع) و ربّما ذلك لأنّ هناك في نظره قضايا عامّة، أهمّ ، لأنّ إنسانه كما يقول: (في مرمى الأضغان اليوميّة من كلّ حدب وصوب) وهذا في تصوّرنا أحد أهم المآخذ الجديّة على الشّاعر الذي نحبّ –ـمع غيرنا من محبي تجربته الإبداعية والحياتية كي يعود إلى عالم قصيدته، التي ضحّى بها، ليعنى بها، من جديد، وهو القادر بنظرنا على معاودة مواصلة تجربته الإبداعية، بعد انقطاع طويل عن الشعر لصالح النثر، لاسيّما أن آخر مجموعة شعرية أصدرها هي "الرّسيس" وتعود إلى عام، 2000، ولم يصدر له بعدها إلا مجموعة قصصية يتيمة هي "شجرة الكينا بخير-2003".
* كثيرة هي قصائدك التي تحمل في حناياها حضوراً أنثوياً صارخاً، ما سرّ العلاقة الكامنة بين ثالوث: إبراهيم يوسف - الشعر - المرآة؟.
ـ إن المرأة حاضرة على امتداد نصوصي باستمرار، إنّها جزء رئيس في الفضاء الشعريّ الحقيقيّ لديّ ، وأكاد أؤكّد أنّ أية لوحة في هذا العالم، ما لم تكن مضمّخة برائحة الأنثى، والحلم بها، فهي بلا شكّ - ناقصة ً- باهتةً - غير مرغوب فيها، إن لم أقل: قبيحة.
لو اتّفقنا أنّ هناك ثالوثاً أو ثلاثيّاً في "عالمي"، على هذا النّحو الموصوف، فإن علينا معرفة أنّ ذات الشاعر- أيّ شاعر- هي التي ستوجز روحه، ورائحة وطنه، وحلمه، منازعاً الشّعر، متساوقاً معه، في سائر مكوّناته، إلى حدّ التداخل، ممحين بذلك المسافة مع الأنثى التي تحدثتما عنها، على أنّها معلم رئيس في قصيدتي، هذه....!.
لقد تحدّثت كثيراً جدّاً عن سرّ علاقتي بهذا الكائن الذي ما كانت الحياة لتستحقّ العيش، البتّة، دونه، لدرجة أنّ أيّة حياة خارج حضن المرآة، أو رائحتها، أو رسمها، أو عالمها هوالإفلاس الأكبر، بل الموت الأدهى، و المحتّم..!
وحقيقةً، ثمّة صوى كثيرة - لها علاقة عميقة بالصّوى السائدة في تلك الفترة التي بدأنا نقترف فيها موبقة الشعر، حيث كان لابدّ من أدلجة - الرّغبة، وعقلنة الرؤى صوب هذا الكائن، حتّى ضمن ضفاف القصيدة، كامتداد للرؤى نحوها خارج هذه الضّفاف، رغم الفارق الشسيع بين هذين العالمين المتناقضين، وهما باختصار عالم الشعر، وعالم اللاشعر.!
أُنثاي، أسألتماني عنها؟، أجل، لقد كنت أسلس قيادة الروح خلفها، أهرول راكضاً صوبها، حالماً بالاستمتاع في حضرة - نرجسها الوفير- كصلاة أبهى، وانتشاء أرقى، غير خائف البتّة على أصابع رجليّ الحافيتين وأنا أهرول فوق مساحات الشّوك، ممنيّاً النفس ـ على الدّوام بعناق أنثى الخيال الزئبقيّة.!
ولعلّ شاعراً مثلي، لا يستطيع أن يدير ظهره لآلام الناس من حوله، أيّاً كانوا، سيروم دائماً، لكي يكون لسان حال من اضطرّوا أن يحبسوا أصواتهم في صدورهم، الكظيمة، مولعاً بقدح الصوان، في انتظار إيماضة، أو شرارة، تزيل كلكل الدّيجورالأحمق، كي يقول لأنثاه وبكلّ حرية: أحبك، غير خائف مقابل ذلك من سوط شرطيّ، أو صفعة وحش آدميٍّ، أخرق، عابر، يريان في أيّة آية للجمال مايستنفرّ دمهما، ويغطيهما، ويهدّد رتابة لحظاتهما.
- هل قلت ما كان ينبغي أن أقوله؟
- يقيناً لا، وهيهات، ولن. لأنّ عمر علاقتي بالأنثى، يختصر عمر العالم بأسره، وهو ما قد يمكن لأيّ حبر عابر تناوله، مادام أن الشّريط الذي يظهر اكتواء الرّوح في مختبر القصيدة، إزاء سورة الأنثى، عارماً، ينوء تحت حرائق كلّ هاتيك الأيّام، والحلم، والهرولات، في الدّورة التي لا تنتهي.
* يقول محمود درويش: إنّ الشّعر مشروع غير قابل للتّحقيق النهائيّ، إبراهيم يوسف كشاعر كيف ينظر إلى مشروع الشعر؟.
ـ لعلّه منذ الترنيمة الأولى لشاعر البشريّة الأول- الذي لم يصدّقه أحد، ولم يكتشفه أحد- وحتّى هذه اللحظة ، ثمّة خطّ بيانيّ للقصيدة، حيث نجد على الدوام إضافات،واضحة، على عالم القصيدة الإنسانية، كي يغدو كلّ شاعر ذو خصوصية، حقيقية، علامةً فارقة في هذا الخطّ البياني، وهنا، فإنّ مثل هذا الكلام - تحديداً - لينطبق على تجربة أيّ شاعر - على حده - عندما يكون جاداً مع أدواته، مخلصاً لقصيدته، راكباً أيّمة الشّعر، دون توقّف، مكتشفاً دررها، مرّة تلو أخرى، ليحقّّق إضافات ملموسة فى تجربته، في كلّ حين ويحسّ - أخيراً - أنّه إزاء - اللانهاية - في هذا المجال، إذ نكون - باستمرار ـ أمام "القصيدة التي لمّا تكتب بعد" هنا يكمن سرّ سرمديّة الشعر، وتجدّده.
* ثمّة مقولة هي: إن خاصية أيّ فن تنبع من ارتباطه بقضايا الواقع، وقضايا المجتمع، كيف تنظر إلى إشكالية العلاقة بين الخطاب الشعري وبين الآخر/ المتلقي؟.
- ليس خافياً على المتابع الحقيق لتجربتي، أنّني أحد هؤلاء الشّعراء المكتوين بهموم وأحلام الناس من حولهم، منطلقاً بذلك من نزعة إنسانية، راسخة كما يخيل إلي، مؤمناً أنّ للفن - عموماً - أكثر من وظيفة، بحيث أن قضايا الإنسان، تدخل في مقدّمها، غير مغامر البتّة بجمالية النصّ الشعريّ، ضمن فهم خاص في هذا المجال.
ولعلّ تضخّم اهتمامي بالآخر، قادني أكثر من مرّة إلى لحظة انغراق في محيطاته، متناسياً شكل أنيني المدوّي، كي يسجّل عليّ هذا النزوع، إلى درجة أن هناك من رآني، مرتمياً في فخّ الأيديولوجيا، حاكماً عليّ هنا، من خلال معرفة خصوصية رؤاي، وهو بدوره حكم من داخل "فخّ ما"، هو أيديولجيا موائمة، أو مضادّة، دون دراية بكنه ما هو عليه، كما في أمثلة، معروفة من قبل بعض مغامري الكتابة النقدية، ومجازفي الكلام، ممّن راحوا يعمّمون الجزئي، في عالم تجربتي متعامين عن سواه.!
أجل، إن التفكير بالمتلقّي، بالآخر، من حولي، شغلني طويلاً إلى درجة الأرق، وهو ما يصدم في بعض الأحيان قارئاً معيناً، لا سيّما عندما أدخل في مختبر قصيدتي، لأراني- وجهاً لوجه - إزاء معادلة معقّّّدة من بين أطرافها: رؤى الشّاعر، تكنيك النص، الخصوصية.. إلخ..، نازعاً عن قصيدتي صخب الإيقاع الخارجي، والبهرجات والزّراكش، والهالات الخادعة، متناولاً صورتي على النّحو الذي أريد، بعيداً عن التواطؤ مع بواعث شهوة التّصفيق الآنيّ، الخلّبي، بدوره، وهذا- تحديداً- ما قادني إلى أن أفكّر بعد طوال تجربة شخصية بإيجاد معادلتي الفنية الخاصة، ضمن نصي- كما أزعم - دون أن يكون ذلك على حساب المتلقي الذي يستطيع حمل مفاتيح النص، وولوج عالمه.
* كيف تنظر إلى الحداثة الكرديّة في الشّعر، وما هي أسباب غياب النقد الجاد في واقع الأدب الكردي، وعدم مواكبته للمدّ الحداثوي الرّاهن؟.
ـ لعلّكما هنا تسألانني عن الشّعر الكرديّ الجديد المكتوب بالكرديّة، حيث أنّ [لأيدي لاتزال في الصلصال] ونكاد لا نجد تبلور الرؤى في هذا المجال، باستثناء حالات قليلة، حيث وجود أسماء جادّة تعمل بإخلاص لأدواتها، غير مبالية بأي بريق باهر، آنيّ.
كما أنّ عدم وجود نقد كرديّ مواكب للأدب الكردي الجديد،عموماً، هو مرتبط تماماً، بالعملية الإبداعية، على اعتبار أن النقد لاحق للإبداع، لا سابق عليه، إذ لم نجد في هذا المجال نقداً حقيقياً، مرتبطاً بما هو موجود من الإبداع، بل كتابات في غالبها الحاليّ، موهومة بحمّى النقد، مكررةً لكليشات نقدية، سابقة عليها - ولا أقول مواكبة - وبلغة متخشبة، خاوية، بيد أنني أتفاءل في هذا المجال، كلما رأيت تجربة شعرية جادة تخرج إلى النّور، لأتيقّن بأنها سوف تفرز نقدها الموازي، لاريب.
* تعتمد في معظم قصائدك على الموسيقى الداخلية للنص الشعري، هل يمكن اعتبار العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة عضوية تفاعلية؟.
ـ لاخلاف على أنّ الموسيقى هي جزء رئيس من روح النص، إنّها نبض الصّورة، وأكثر من وشيجة هرمونية، ترفع قامة النص، وتزجّ به في لحظة الاصطدام.
شخصيّاً، رغم أنّني بدأت بكتابة قصيدة العمود، وقصيدة التفعيلة، لكنّني عمدت - وفي وقت مبكّر- من تاريخ تجربتي إلى "إخفات"، إن لم أقل "إلغاء"الموسيقى الخارجية، واعتماد الموسيقى الدّاخلية، الأبقى، والأكثر قابلية لرفع دعامات النّصّ الشعري، واشتعال ألهبته، وغواية المتلقي.
إنّ النّجاح في خلق الإيقاع الداخليّ للنص، كفيل باستنهاض روح النص، لتتواشج فيه كل الأدوات المعتمدة، والمدروسة كي نكون بالتالي أمام نص جدير بتوقيع صاحبه، ما دام أنّه فوق - كل هذا وذاك - خلاصة لحرائقه الخاصة.
* يقول بعضهم: إنك تعتمد في معظم قصائدك أسلوب المداوارة و(والنصّ المغلق)، كيف تنظر إلى مفهوم المداوارة في القصيدة, وهل يمكن ربط هذا المفهوم باللغة الدّاخلية, والبناء والتعبير للقصيدة, أم بالبناء الخارجي لها,أم أنّه كلّ ذلك؟.
ـ لم يعد - الآن- بعد كل هذه السنين، من الهرولة، واللّهاث،على دروب القصيدة ممكناً الحديث عن حضور "غير كامل" في عالم النص, أو أي ضرب من ضروب الاستغفال عن أدواتي الشعرية، بعيداً عن إمكان التحكّم بمجاديف النص، كما ينبغي, وهو حالي إزاء نصوصي في عموم تجربتي اللاحقة، والتي أستطيع تحديد نقطة بدئها في مجموعتي الثالثة (عويل رسول الممالك)1992، هذه المجموعة التي رآها بعض متابعي تجربتي ـ علامةً فارقةً ـ في عموم تجربتي الشعرية, في أقلّ تقدير أقوله هنا، والتي ستردف في ما بعد بتجربتيّ الأخريين هما (الإدّكارات 1995 ـ الرّسيس 2000) وهي كما يخيّل إلي قادرة ـ برمّتها- أن تمثّل التجربة التي أطمئن أن تكون بداية انطلاقة حقيقية لي شعرياً.
وإذا كان انتشار تجربة النصّ المفتوح، أو المغلق, أو كما هو الحال هنا - المفتوح المغلق - قد جاء في مرحلة انتاج نصوص هذه المجموعات، وإن كان يمكن الحديث عن امتدادات سابقة عليها في مجموعتي الأوليين, أيضاً، فإن ذلك في تصوّري، لم يأت اعتباطاً البتّة, بل نتيجة لحالة خارج نصيّة، تتعلق بتبلور رؤى فنية لي، كناصّ فيما يتعلق بنقطة تناول العلاقة الجدليّة بين الشكل والمضمون, والتنبيه على الشعور الخفيّ، والملحّ لديّ على ما هو معرفيّ، ولكن عبر أدوات مختلفة في فضاء النصّ.
ولعلّ أهمّ خصيصة في الإبداع - عموماً - هو أن البناء يتنامى في الدّاخل صوب الخارج، أي أنّ جملة أدوات تعتمل في مختبر الشعر، تؤول فيما بعد إلى إنشاء عمارة النص المختلفة.
كما أن التدوير الإيقاعي، بل التدوير البنائي للنص, من شأنهما أن يمنحا النصّ، طاقات أكبر، وإمكانات أكثر، عبر بناء النص، اعتماد اًعلى مجمل الأدوات الضرورية في مختبره الخاص, شريطة أن يتحكّم بـ (الدفق) المخلّ في تين الحالتين، إيقاعياً، أو شكلياً، كي نكون فيما بعد، إزاء نصّ صادم، بدهشته, قابض على عناصر الإيقاع، ضمن حدود الإبداع الفني ذي الرّسالة الخاصة، كما أزعم أيضاً.
بدهيّ، أن الحالة الشعريّة، عادةً، هي التي توفّر أسباب بناء النصّ, ودرجة حضورالنّاص في أعماق نصّه هي التي تخلق هرمونيّها، وعوامل تواصلها مع المتلقي، ضمن وشيجة نصيّة, أقول وشيجة، كي أعود في آخر ـ دائرة التنظير إلى ما يدعم مثل هذا الحكم على عالم محّدد من نصوصي....!
#إبراهيم_اليوسف (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة