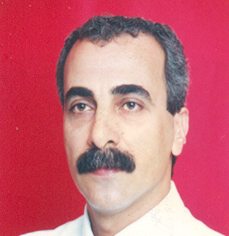سعيد موسى


الحوار المتمدن-العدد: 2134 - 2007 / 12 / 19 - 04:34
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
بداية لابد لنا من العودة خطوة مرحلة سياسية إلى الوراء لنقيم الحاضر, ونستخلص العبر لقياس معامل وعوامل النجاح والفشل, لإخفاقات البدايات , وما أفرزته من نتائج رسمت مشهد حاضرنا المأساوي, وأدت إلى تراجع كإرثي للقضية الفلسطينية على كافة الصعد, الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية, هذا إذا أردنا أن نتفادى كثيرا من المثالب التي تراكمت وتكلست لتشكل طامة وطنية كبرى , كان لها من التداعيات السلبية المأساوية على مجمل القضية الفلسطينية, كي نستخلص العبر من تلك المرحلة البائدة والتي مازالت ضلال نتائجها تضرب بمعاول تدميرها لواقعنا الحياتي, وتنذر بالخطر على مستقبل القضية الفلسطينية بشكل كامل,حينها نستطيع أن نقرر أي من الأدوات التي يجب البدء بها من جديد كي نصحح المسار الوطني الفلسطيني الداخلي, والذي يمكننا من إدارة معترك الصراع الفلسطيني_الصهيوني, لصالح قضيتنا وحقوقنا وثوابتنا الفلسطينية, أو ربما نستطيع من جديد أن نرتب أولويات أوراقنا الوطنية, على ضوء تجربة المرحلة المنصرمة منذ 1994 كبداية لتكوين السلطة الفلسطينية على ارض الواقع, ونحدد بأمانة وصدق وجرأة أين أصبنا وأين أخبنا, أين منعطفات النهوض وأين منعطفات الكبوات والإخفاقات؟؟ أي من الأدوات التي استخدمت في غير زمانها ومكانها؟ وكيف تم إدارة تلك الأدوات؟؟ وبيد من ولمصلحة من؟ هل كانت البدايات تتجه صوب روح المؤسسة ؟ أو اتجهت صوب مأسسة الانحدار؟؟ هل امسكنا بأطراف النجاحات لنبني عليها, أم استمرئنا منافع الكبوات التي كانت تصب في شخصنه المصالح على حساب ماسستها للصالح العام, من اجل بلوغ مؤسسة النظام والقانون؟؟ هل قننا النظام والنجاح, أم دفعنا باتجاه تقنين الفساد الأمني والاقتصادي والإداري؟ وماذا كانت النتائج؟ وهل جاءت تلك النتائج على غير المتوقع وفق معطيات لاينتج عنها ,إلى مزيدا من الانحدار صوب مستنقعا لانهيار والدمار؟
كم كان انجازا عظيما أن يكون لنا سلطة وطنية وعلم ومؤسسة فلسطينية, على الأرض والتراب الوطني الفلسطيني, لننطلق بتلك البداية صوب إقرار حقوقنا الوطنية الفلسطينية, وكان حريا بنا أن تكون انطلاقتنا الوطنية صادقة يتولاها رجال عشقوا فلسطين وذاقوا مرارة الغربة والشتات والمطاردة وعدم الاستقرار من الشقيق فبل العدو,فكبرنا وحمدنا الله على أولى خطوات التحرير وعاهدنا الله والأرض, اقسمنا بحق الزرع والضرع, أن نحفظ عهد الشهداء ونسير قدما صوب القدس, وصوب إقامة الدولة الفلسطينية, وانتزاع الثوابت التي لا تقبل المساومة.
فكانت البدايات إقامة المؤسسة الأمنية, من اجل خلق واقع وأرضية خصبة, لمؤسسة اقتصادية وسياسية آمنة,لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن, فقد طغت المؤسسة الأمنية على كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية, كل شيء أصبح تحت سيطرة المؤسسة الأمنية, وكل الإمكانيات التي هدرت بفعل هروشة التخطيط السيئ وأصبحت تقاس بمدى تأثير القرار الأمني, بل وتحولت المؤسسة المنية إلى ريادة العمل الاقتصادي والتحكم في سير كل المؤسسات الخدماتية الأخرى, وبالمجمل تحولت المؤسسة المؤمننة بالكامل, إلى وجهين نصفها امني والآخر اقتصادي, وحدث الخلط المدمر فلم تعد تفرق بين المؤسسة الاقتصادية أو حتى التعليمية والصحية , وبين المؤسسة الأمنية, فكان الطابع الغالب هو امننة المؤسسة, وحتى تلك المؤسسة الأمنية انقسمت على نفسها, فاستقلت بقراراتها ومصالحا تحت مسميات كثر لأجهزة ووحدات أمنية وعسكرية, فأصبحت المؤسسات الاقتصادية, والاجتماعية, والصحية, والتعليمية, والصناعية, والتجارية , وحتى الثقافية, تدار بمفرزين من المؤسسة الأمنية, أو موالين بالمطلق لها, مع عدم الاعتماد على التخصص والكفاءات, فزادت إرهاصات الانحدار للمستنقع, حتى تم ((اقصدة المؤمنن)) , مما تسبب في ذروة الفساد المالي والإداري وقد تم تقنين امننة تلك المؤسسات الوطنية الاقتصادية الوليدة, فكانت النتيجة قتل الوليد في مهده.
وما زاد الطين بلة, هو تعارض خطي السياسة والمقاومة, وكما أشبعت هذا الموضوع شرحا, وتحذيرا في مقالاتي المئوية, حيث أراد كل خط أن يشطب ويطمس الآخر, تحت شعارات ومبررات لاتصلح للبدايات والمنطلقات الوطنية, والتي يفترض أنها تبشر ببدايات تجذير المؤسسة والتحرر, وقد فشل خطي المقاومة والسياسية, في إيجاد أرضية مشتركة وتقاسم ادوار من شانها أن تشكل سفينة وطنية منسجمة مع متطلبات واقع الصراع, ومماطلات ومناكفات الصهاينة, كي نصل بمشروعنا الوطني إلى بر الأمان , الذي يكون بداية انطلاقة ثانية صوب هدف التحرير والدولة المستقلة, فحدث الصدام والمؤسسة الأمنية التي تتحكم بمقاليد السلطة منغمسة في مصالحا الاقتصادية, ومتنافسة في بسط نفوذها على باقي ألوان المؤسسة الفلسطينية, فأصبحنا لا نفرق بين معاول الأمن ومعاول الفوضى, لا نفرق بين شعار الفساد وشعار الإصلاح, كلها أصبحت أوجه لواقع واحد مصيره لمن قرأ مابين سطور الصراع الأمني والاقتصادي والنفوذ كان معروف مسبقا, وبالتالي تلاشت المؤسسة المدنية بكاملها في مستنقع الامننة المؤقصدة.
كل ذلك أسس لواقع فوضوي مقنن, أسس لان تترعرع خفافيش الظلام وسط واقع سوداوي مأساوي, فحتى المقاومة تحللت من مركزياتها, وذهبت في شطحات الكتاتيب المقسمة, ونتيجة الانفلات عن قطب المركز عانت تلك الوحدات المهلهلة, من ضعف الإمكانيات التي تمكنها من استمرار المقاومة, مما أدى بها إلى اللجوء إلى غير لونها, وقد كسب الجولة مستقبلا من كرس كل إمكانياته لاستقطاب المقاومة المشتتة لصالح أجندته السياسية والعسكرية, وهذا مفاده انه تم ((اقصدة المقاومة)) حيث تحكم فيها وفي توجهاتها لخدمة أهدافه من أجزل عليها الدعم والعطاء المالي, والإمكانات العسكرية, وفي وقت متأخر حاولت المؤسسة الأمنية استقطاب تلك الوحدات المقاتلة والمنفلشة عن مركزها الذي تاه في دهاليز تقمص المسميات السلطوية على حساب الاستمرارية التنظيمية, والفصل بين السلطة والتنظيم, وذلك بإغراء المركز والمال وتفريغ العناصر, لكن كلمة الفصل كانت لمن خطط واستثمر نتيجة تلك الفوضى العارمة الشاملة والانهيار, وقد كانت المعركة السياسية التشريعية, فكانت الإجابة بنعم لمن رفع شعار النهوض والاستنهاض, لمن وعد بالتغير والإصلاح, لمن كان شعاره لا للفساد ونعم للمقاومة, حتى تبين لاحقا أن لا تغيير قد تحقق ولا إصلاح قد تترجم, وأصبحت المقاومة((عرين النصر وحصن الأمان)) يتم المساومة عليها, وصولا إلى عنق الزجاجة وشرك الانقلاب وسقوط حرمة الدم الفلسطيني, وإحداث مزيدا من التهتك على النسيج الوطني الفلسطيني, وما لتلك النهاية المأساوية, من تداعيات على مجمل القضية الفلسطينية, داخليا وخارجيا.
تتلك المرحلة والتي أسيء فيها توظيف المؤسسة الأمنية وانحرافها عن المسار الصحيح, وشخصنة المؤسسات, وصراع النفوذ, وهدر المال العام,وصولا إلى طوفان الفوضى الشاملة والفساد وانعدام الأمن والأمان, وصولا إلى مرحلة استبشر بها قصار النظر خيرا, فأضافت تدميرا للمدمر, وفسادا للمفسد, وخرابا للمخرب, فلا إصلاح ولا تغيير, وقد طغت حزينة الأجندات من جديد بعد شخصنتها, فأحدثت مزيدا من الهدر للإمكانيات وبلغ الاستخفاف بأمن وحرمة الدم الفلسطيني ذروته , فكان المشهد ينبئ بتراجع على منجزات الثورات والانتفاضات المعمدة بدماء عشرات آلاف الشهداء, لنعود عشرات السنين إلى الوراء على خارطة التحرر والموقع السياسي العربي والإقليمي والدولي.
وقد تحدثنا سابقا عن انطلاقة سياسية جديدة بدأت من أسابيع, انطلاقا من المؤتمر الدولي(انا بوليس)) وكيف نشاهد العالم بأسره حتى المجتمع العربي يهلل ويلوح لضرورة استثمار تلك الفرصة التاريخية لعملية السلام, فتحامل الطرف الفلسطيني على الجراح, وانطلق من واقع مأساوي حيث الانقلاب العسكري في غزة , وما رافقه من دموية وانفصال بين شطري الوطن, ومراهنات عقيمة على المقاومة وتوظيفها لخدمة الأجندات السياسية, وصولا إلى بيت قصيد مقالتي حيت المؤتمر الاقتصادي الدولي المنعقد حاليا في العاصمة الفرنسية(باريس).
سابقا ومنذ سنوات تحدثت عن مسار التسوية السياسي, إن لم يوازيه قوة اقتصادية بادرة سليمة على الأرض فسيفشل المسار السياسي فشلا ذريعا, وستهدر إمكانيات ضخمة في غير مكانها وهذا ماحدث فعلا, كانت الإمكانيات تناسب البدايات, لكن الآليات كانت موبوءة, فضاعت كل تلك الإمكانيات سدى فيما لا يخدم المسار السياسي الموازي.
واليوم نشهد بعض المتغيرات التي طرأت على أولوية الأدوات, على اعتبار أن التجربة السابقة كانت بداياتها خاطئة, وإدارتها غير سوية وغير مناسبة, لذلك نشهد أن الأدوات الاقتصادية بدء بالمخططات ومرورا بالشخوص قد ألقت بظلالها على كامل المؤسسة الفلسطينية, وأصبحت القوة الاقتصادية, ورجالات الاقتصاد لهم الكلمة المؤثرة والفاعلة على سلم الهيكل الهرمي القيادي, وهنا نستطيع القول أن بدايات المرحلة السابقة(سطوة حكم الأجهزة الأمنية)) قد تراجعت لصالح سطوة المراكز الاقتصادية, ووصول رجالات الاقتصاد إلى أعلى قمة الهرم السياسي والأمني الفلسطيني, دون الاعتبارات لتبدل حكم الحزب الواحد من فتح إلى حماس, وهذا ما درج تسميته (الحكم أو الإدارة التكنوقراط)) فنجد أن المسار السياسي قد تباطيء بخطى السلحفاء بعد انا بوليس, كي يلحق به خط الدعم الاقتصادي على مستوى دولي, حيث إن الخطة التي قدمتها السلطة الفلسطينية, كخطة تنمية اقتصادية ثلاثية, تتطلب مبلغا ضخما يقدر بحوالي((6 مليارات دولار)) على اعتبار أن النظرية تقول((اقتصاد قوي يؤدي لقوة سياسية وقوة أمنية إذا ماتم إدارته بشفافية وتخصص ونزاهة)) وهذا بحد ذاته جزء جيد من المشهد الشامل, رغم أن الوضع السياسي المتأزم والأحوال الاقتصادية المتردية, اكبر أسبابها الحصار ومعيقات الاحتلال والتبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال, وهذا سينجح إلى حد ما, لكن المغالاة والمبالغة بالعامل الاقتصادي بشكل منفرد انه المخرج من الأزمة, سوف يؤدي بالحالة الفلسطينية إلى الارتداد والانحدار من جديد كما تلك البدايات البائدة, لان الأصل في القضية هو الاحتلال, ولو بلغ الدعم بعشرات أضعاف تلك المليارات, دون إحداث اختراق في كسر تعنت المحتل, كي يتجه صوب تسوية سلمية, تعيد الحقوق إلى أصحابها, فان سنوات وإمكانيات ستهدر عبثا, فالنظرية السابقة(اقتصاد قوي_امن قوي) تصلح في حال الاستقلال, وليس تحت نير الاحتلال.
لذلك اعتقد أن المغالاة في إطفاء صبغة الحل السحري على العامل الاقتصادي, أي اقصدة المؤسسة الأمنية والسياسية, فان ذلك مصيره الفشل, لسبب واضح واستراتيجي وبسيط, بداية هو أن شريك السلام الصهيوني, لايسلك سلوكا يوحي برغبته ونيته للسلام, الاستمرار في الحفريات(باب المغاربة) , وبناء المستوطنات(300 وحدة جديدة في القدس الشرقية) , والاستمرار في بناء الصور العنصري(الذي يسقط مرجعية حدود التسوية 67), والتوغلات في الضفة الغربية وقطاع غزة والاغتيالات على حد سواء, فماذا تفيد إذن تلك المليارات, هل تستطيع كل تلك المليارات ومئات أضعافها, أن تشتري صوت المقاومة في حال ذلك العدوان الشامل؟؟ هل تستطيع تلك المليارات أن تبهرنا كي يتم إسقاط حق العودة, حيث أن التعداد الفلسطيني التقريبي في العالم زاد عن العشرة ملايين فلسطيني, والمتواجد منهم في فلسطين اقل من النصف بكثير, فكم من مئات المليارات تكون كافية, لإعادة توطينهم في حال وافق من وافق على التعويض وعدم العودة!!! , وهل تساعد تلك المليارات بعوائد تستطيع الهاء الشعب الفلسطيني عن عودة القدس الشرقية كالملة وغير منقوصة التراب والسيادة؟؟؟!!!
وهنا أقول أن الأداة الاقتصادية يجب أن تأخذ موقعها الاقتصادي الداعم للامني والسياسي, فاقتصاد قوي بذاته في ظل تلك المعطيات السياسية لن تخلق أمنا ولن تؤسس لمؤسسة, ولن تكون حاضنة لمجتمع مدني سليم طالما بقي الاحتلال جاثما على صدور الشعب والأرض الفلسطينية, وان إهدار مزيدا من السنوات تحت حكم الاداوات الاقتصادية سيكون عبثا, إن لم يرافقه سلوكا دوليا ضاغطا وبجدية ومصداقية, على دولة الكيان الإسرائيلي, كي تتخلى عن أيدلوجيتها الاستعمارية وتحرير الثوابت الفلسطينية التي لن تشترى ولإتباع ببلايين الدولارات, وفي مقدمتها حق العودة دون إطفاء ادلجة الحالات الإنسانية عليه, فقرار 194 ليس حالة إنسانية بل حقا ثابتا يسقط خديعة الدولة اليهودية أو تسقطه!!! وكذلك القدس الشرقية المشمولة بقراري الأمم المتحدة((242)) و((338)), والحدود والمياه والسيادة والأسرى,المقاومة, كل تلك الثوابت الإستراتيجية, لا تفيدها مليارات ادعم الدولي دون عودتها كحقوق ثابتة وانتهاء مسببات الصراع والمقاومة, واختم فقرتي بالتنويه لان أسوء حكم خارجي هو حكم البنك الدولي, والمعونات المشروطة سياسيا, بعيدا عن ثوابت الحق والباطل!!!
لذلك فإننا سنلمس عما قريب , بان ذلك الدعم السخي الدولي, والذي نرحب به من الأشقاء العرب والأصدقاء, وكل من يهمهم إحلال سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط, انطلاقا من مصالحهم, وادعائهم بترسيخ السلم والأمن الدوليين, فلنا أن نراقب حركة تلك المليارات وكم سيكون هدفها التنمية الحقيقية, بعيدا عن الضغط على المسار السياسي أو التأثر عليه واقصد الطرف الفلسطيني, كآلية مشجعة للصرف, ففي الوقت الذي يصرح به رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي(أيهود اولمرت)) بان الدعم الاقتصادي للفلسطينيين سيساعد في صنع السلام, وكأن لقمة العيش هي أسمى آيات غاياتنا, ولم يقل أن الانسحاب ووقف الاستيطان والاغتيالات هي الركيزة الداعمة للسلام, فمازال يكيل المديح من على طرف لسانه للدعم الاقتصادي الدولي الذي سيكون أسير للقرار الصهيوني, إلا انه وبنفس الوقت وبفم مليء يعطي تعليماته للتصعيد العسكري, ولبناء مزيد من المستوطنات, وتعليمات بمزيد من التوغلات والاعتقالات حتى في الضفة الغربية ودون التفرقة بين فصيل مقاوم وأخر, فكيف يتحقق السلام ومازالت الدول المانحة والتي تفتقر إلى سياسة خارجية موحدة وباهتة للتأثر السياسي على دفة الصراع, انطلاقا من المرجعيات والقوانين الدولية, فما زال هؤلاء الداعمين المشكورين يتحدثون عن محاولات لتعزيز الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي , وأنسنة المعاناة, فأي ثقة تحت نير الاحتلال,؟؟ وأي تنمية وسيف الاحتلال مسلط على كل شاردة وواردة لحركة الاقتصاد الفلسطيني الهش, الذي من السهل أن يعيق تلك التنمية تحت المبررات الشرعية من وجهة النظر الأمريكية والأوروبية((مبررات وضرورات أمنية)) فتعود الأحوال إلى أصولها, اقتصاد قوي بزوال الاحتلال, واقتصاد متذبذب تحت واقع الاحتلال, اقتصاد محكوم بأرصدة مجمدة يتم الإفراج عن جزء تنموي منها طالما تساهل الطرف الفلسطيني في عملية المفاوضات, في حين أن أسرع الطرق إلى سلام نافع وحقيقي, والى تنمية ذات جدوى هو زوال الاحتلال وتفعيل أدوات الاقتصاد, وفي المحصلة فإنني انوه وأنبه بان أي مغالاة وطغيان للأدوات الاقتصادية على الثوابت السياسية, والعمل الوطني, فلن يفرز عنه لا امن ولا أمان طالما تم تغييب التمثيل السياسي الحقيقي للشعب الفلسطيني لصالح التمثيل الاقتصادي, وجعل الأداة الاقتصادية هي صاحبة النفوذ والسطوة لتشكل السياسة والأمن بفعل امتلاك تلك القوة الاقتصادية وتجاوز كل مؤسسات العمل الوطني التاريخي.
وفي النهاية لا نملك إلا أن نشجع وندعم هذه التجربة التنموية الجديدة, ولكن ليكون الفريق المشرف عليها, ليس هو صاحب القرار الوحيد لصياغة المعادلة السياسية, كي لا تتكرر تجربة الفشل رغم تغيير الأولويات والأدوات, فاستفراد أداة اقتصادية لاتصنع أمنا وسياسة دون التخلص من ابتزاز الاحتلال فسيشكل ذلك كبوة بل انحدارا وانهيارا جديدا, وفق الله قيادتنا الفلسطينية, ودعوة إلى كل الأحزاب والفصائل الفلسطينية كذلك إلى ترك الانشطار العبثي, كي لاتغرق ثوابتنا في محيط أدوات الحكم الاقتصادي الدولي, ويقسم الشعب على نفسه بين مؤيد بشكل سطحي وحذر بشكل أكثر حرصا ومعارضا بشكل شعاري عبثي, وبكلمة أخيرة اعتقد أن من يتوقع أن يكون الدعم الاقتصادي السخي هو مؤامرة دولية جديدة تحسن الاقتصاد وتعزز الاحتلال, فانه يراهن عند انكشاف المؤامرة الاقتصادية على انتفاضة ثالثة, ستكون تحت مسمى ((انتفاضة العودة)) كما سبقها ((انتفاضة الأقصى)) ليصبح لدينا من جديد كتحصيل حاصل للرد على المؤامرة , كتائب شهداء العودة ليستمر الصراع,فهل يشهد عام 2008 ميلاد دولة فلسطينية حسب رؤية بوش, وإعلان الدول المانحة, أم نشهد اخفاقة تؤدي إلى انغلاق سياسي جديد بعد سبع سنوات من الانغلاق, وميلاد انتفاضة جديدة جراء التملص والمماطلة للكيان الإسرائيلي مما قد يحبط كل الجهود الإقليمية والدولية؟؟
وفي نهاية مقالتي اعتذر من القارئ عن الإطالة, ونشد على يد رأس الشرعية الفلسطينية الأخ الرئيس- أبو مازن في معترك تحدي السلام الذي يخوضه وحكومة السيد- سلام فياض , أن يقبضوا على جمر الثوابت الفلسطينية, ويقيسوا السلام وأولوياته بمدى استعداد الكيان الإسرائيلي عمليا, إلى إنهاء الاحتلال, وهذا سيتبين جليا في المفاوضات القادمة, وما الاقتصاد والدعم الاقتصادي إلا عاملا مساعدا في حال اندحار الاحتلال عن كل جزء من أرضنا الفلسطينية, داعين لهم بالتوفيق.
الأمننة : هو حكم المؤسسة الامنية وتفردها.
الأقصدة: هو المغالاة في طغيان الأدوات الاقتصادية على السياسية والأمن.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)



كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة