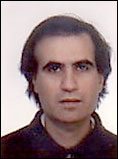|
|
المهاجر الكردية الأولى
دلور ميقري


الحوار المتمدن-العدد: 1415 - 2005 / 12 / 30 - 09:11
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
1 _ التاريخ والأسطورة :
ثمة أسطورة طريفة في أصل الأكراد ، تقول أن الملك سليمان الحكيم بعث عفاريت من الجن إلى أوروبة كي يجلبوا له خمسمائة فتاة من حسانها ، فلما أنجز هؤلاء مهمتهم وآبوا إلى مليكهم ، وجدوه قد إرتحل إلى سماء ذاخرة بالحسان المخلدات ، فاحتفظوا بنسوته الأرضيات لأنفسهم ، ومن نسلهم المختلط كان الأكراد (1) . كان من شيوع هذه الحكاية الخرافية ، لدى جيراننا ، أنّها قبلت كحقيقة راسخة ؛ حتى أن " مينورسكي " ، المؤرخ المعروف ، ينوّه بها : " وليس من العبث عندما نرى الفرس والأتراك وهم يعيدون المثل العربي " أنّ الأكراد طائفة من الجن " . (2)
ولكن لهذه القصة مغزاها ، أيضاً ؛ لجهة التأكيد على عامليْن مهميْن ، وهما الهجرة والتفاعل ، أسهما في تشكيل العنصر الكرديّ . مع التشديد بأن الأمر غير مقتصر على " أولاد الجن " حسب ، بل يشمل ، إلى هذا الحد أو ذاك ، كافة الشعوب المعروفة . ولا أدل على ذلك من الإنتشار العربي _ السامي ، قبل الإسلام ، والمعتمد على أسطورة لا تقل طرافة ، عن الكاهنة " طريفة " ، التي تنبأت بأن فأراً سيسبب سيل العرم وتشتت العرب وإنسياح بعضهم إلى بلاد الشام والرافدين . وفي رواية للمسعودي ، المؤرخ المولّع بالخرافات ، أن الخليفة العباسي ، السفاح ، سأل خالد بن صفوان عن رأيه بالقحطانيين ، فأجابه : " غرقتهم فأرة ، وملكتهم إمرأة ، ودلّ عليهم هدهد " (3) . الفأرة عرفناها ؛ والمرأة هي بلقيس ملكة سبأ ؛ أما الهدهد طائر الملك الحكيم سليمان ، فيلفتنا إلى ورود ذكر مليكه في إسطورتيْن تخصان العرب والكرد ، لدرجة أن المدونين المسلمين إتفقوا على " حقيقة " المنبت الواحد لهذين القوميْن . وفي ذلك ، يقول الشاعر العربي :
لعمرك ما الأكراد أبناء فارس ، ولكنهم أبناء كرد بن عامر
لنرجع الأسطورتيْن إلى ذمة صاحبهما ( المسعودي ) ، ونرَ ما إذا أجمع مؤرخو زمننا على أصل الأكراد وجغرافيّة موطنهم . الحقّ ، أن البحث العلمي ما عاد ليقبل أن تبقى أمة يفوق تعدادها الأربعين مليوناً " مجهولة الهوية " ، ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين ؛ أمة من أقدم أمم العالم ، ممن إستوطن أسلافها بإستمرار المنطقة الجبلية ، المعقدة التضاريس ، والمشكلة حدود " الهلال الخصيب " ، الشمالية . إستناداً إلى الأبحاث الإركيولوجية والإنتربولوجية ، فعلماء التاريخ تم لهم الإستنتاج الإفتراضي ، بأن العنصر الكردي إنبثق ، بدرجة أساسية ، من مجموعة الشعوب الجبلية القديمة التي توطنت في البقعة الشاسعة ، الشرق أوسطية ؛ أين تسمى الآن كياناتها الحديثة بدول تركية وإيران والعراق وأرمينية ؛ هذا العنصر المسهم بحضاراتها المتنوعة ، ومنذ فجر التاريخ ؛ التاريخ الذي هو من الغنى ، أن دراستنا هذه لا تستطيع الإحاطة به ، مع أنها لن تهمل شأنه .
لم يختلف العلماء ، في واقع الحال ، بإنتماء الأكراد " عرقياً " لأولئك المهاجرين الشماليين ( النورديين ) ، المنساحين إلى منطقتنا الشرق أوسطية ، منذ الألف الثانية قبل الميلاد ؛ أيْ الهندو اوربيين ، المظللة شجرة لغاتهم ، الوارفة ، البقعة الجغرافية المحصورة بين براري الهند شرقاً وشواطيء الميط الأطلسي غربا . أما معضلة الموطن الأول ، الأصلي ، لتلك الشعوب ، فليس بذي أهمية ، طالما الأمر ما فتيء إحتمالات شتى . المهم في هذه الإرتجاعة ما قبل الميلادية ، أن الفرع الكردي من هذه السلالة العتيدة ، قد مدّ جذوراً راسخة ، عنيدة ، في تربة المنطقة . وما دمنا نتكلم عن الشجرة ، فلنقل أن " تطعيماً " عرقياً _ لغوياً ، تمّ بين السلالات الجبلية المسماة بالغوتية والكاشية والهورية ، وبين جيرانهم أهل السهول كالسومريين والآراميين . لقد كان من ثمار هذا التفاعل قيام دولتيْن كبيرتيْن في أراضي الكرد ، التاريخية ، هما إمبراطورية ميتاني ( منتصف القرن 15 ق م ) ، وإمبراطورية ميديا ( القرن السادس ق م ) . وإستمرت المدونات القديمة تسم الكرد بالميديين ، حتى القرون الأولى للميلاد ، حينما إنتشر إسمهم المستعار من لدن المؤرخ الإغريقي كسينوفون ؛ الذي خبّر في تذكرته التاريخية عن قوم جبليّ ، بإسم " كاردوخ " ، إتصف بالمراس والجسارة وكبّد ابناء قومه ، الغزاة ، خسائر فادحة ، في حملتهم عبر ميديا القديمة . على أن إكتشاف ألواح جديدة ، في عصرنا الحاضر ، بيّن أن كلاً من الأرمن والآشوريين ، كانوا يعرفون جيرانهم اللدودين بإسم " كاردوئي " ؛ إيْ قبل زمن كسينوفون بعدة قرون (4). غوتي ، هوري ، ميدي ، كاردو ؛ هي تشكيلة الأسماء المفترض ، بعرْف علماءنا ، أنها إشتقاقات إسم " كرد " . هذا ، دون إغفال أن البعض من عرب المسعودي ، ما زال يتبنى هذا الإسم المهول " كرد بن مرد بن عامر بن صعصعة " ؛ فيما الأتراك ، لخفة في دمهم ، يردون ذاك النسب بتأكيدهم ، أن إسم " كرد " ، اليتيم ، قد تنوّع من إسم " ترك " ..
2 _ الأكراد في البلاد الشامية :
مع الفتح الإسلامي لكردستان ( أو إقليم الجبل ) ، دخل قومنا الكاردوخ مرحلة جديدة ، مختلفة ، أثرت جذرياً ، وإن تدريجياً ، في كيانهم وعقائدهم . الأرجح أن الأكراد وهم " اولي البأس الشديد " _ بحسب تفسير البعض لآية قرآنية يتيمة (5) . خضعوا شكلياً للحكم الجديد ، وربما بشكل مغاير للشعوب الاخرى المجاورة. بيد أنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم وقد إنساقوا خلف الصراع المتمخض عن التنافس التقليدي ، القبلي ، بين آل هاشم وبني أمية ؛ صراعٌ دمويّ ، خاضوه ضد هؤلاء الأخيرين ، بإنتساب الكثير منهم إلى فرق العلويين والخوارج ، وخاصة فترة حكم الحجاج للعراق (6) . ثم هدأوا نوعاً مع العهد العباسيّ ، في طوره الثاني خصوصاً ، متسنياً لهم أيضاً إنشاء حكومات مستقلة ؛ كالدولة المروانية ( الدوستكية ) ، التي قامت على الحدود الشمالية لبلاد الشام ، في الفترة السابقة لظهور نجمهم الأشهر ، صلاح الدين .
نأتي الآن إلى المرحلة التاريخية ، الفاصلة ، المنطلق منها مبحثنا . ذلك أن القرن الحادي عشر للميلاد ، الصاخب ، شكّل " العتلة " الثانية لهجرة أحفاد الكاردوخ ؛ والمنطلقة من كردستان ، هذه المرة . فبعد ما يقارب الثلاثة آلاف عام على الهجرة الاولى ، الآرية ، للعنصر الكرديّ ، إلى أعالي الهلال الخصيب ، هاهو في إنطلاقته الكاسحة ، جنوباً ، في توسع طاريء وبعد " سبات " ، مديد ، إستغرقه منذ إنقراض دولة ميديا . وفي هذا الصدد ، يكتب الباحث سبانو : " سكنت المناطق الجبلية الواقعة في أعالي الجزيرة ، شمال وشمال شرقي الموصل ، أعداد كبيرة من القبائل الكردية ، التي كانت مجموعات منها تهاجر لتقطن بلدان الجزيرة وتستوطن بها مندمجة مع سكانها . وقد إستطاع أحد قادة جماعة الأكراد ، وهو " باذ " ، تأسيس دولة في ميافارقين وديار بكر ، في الجزيرة ، عرفت بإسم الدولة المروانية ( 983 _ 1085 ) . وفي القرن الحادي عشر ، هاجرت قبائل التركمان من منطقة ما وراء جيحون ، إلى خراسان والعراق والجزيرة وآسيا الصغرى والشام ، مما دفع أمامهم كميات من الأكراد نحو تلك الدويلات ، منخرطين في جيوشها ، وبالتالي سمح بتغلغلهم فيها ممهداً السبيل أمامهم لوراثة التركمان والحلول محلهم ". (7)
وإذا ضربنا صفحاً عما تضمنته رواية باحثنا من مغالطات ، بخصوص ما يسميه " الهجرة والإندماج " ؛ فالواقع أن حركة الإنسياح الكردية في بلاد الشام الداخلية والساحلية ، وخاصة المدن والقلاع المهمة ، لا علاقة لها بالوجود القومي ، الحضاري ، لهذا الشعب العريق في منطقة الجزيرة ، والعائد لفجر تاريخها . وعلى أي حال ، فإن القرن الحادي عشر الميلاديّ ، شهد طبقة عسكرية كردية ، ارستقراطية ، كانت على رأس السلطة في بعض المدن السورية ، لعل أشهرها تلك الحاكمة في حماة ؛ مؤسسها علي بن وفا الكردي ، الأمير الإقطاعي التابع لسلطة أتابكة السلجوقيين ، الدمشقية (8) . قبل ذلك ، وجدت حامية عسكرية كردية في القلعة الحاملة إسمها ، تاريخياً " حصن الأكراد " ؛ القلعة الإستراتيجية ، المشرفة على الطريق بين سورية الداخلية والساحلية . ويخبرنا الكاتب وصفي زكريا ، شيئاً عنها : " ومجيء الأكراد إلى بلاد الشام قديم ، وربما كان أول من أتى بهم عامل حمص ، شبل الدولة نصر بن مرداس سنة 424 للهجرة ، وأسكنهم في حصن الصفح ليحفظوه ويصونوا الطريق بين حمص وطرابلس ، فسمي منذ ذلك الحين " حصن الأكراد " . وقد بقوا فيه نحو قرن ونيّف إلى أن جاء تانكرد ، أمير أنطاكية ، وإستخلصه منهم سنة 530 هجرية ، فتشتتوا " . (9)
لدينا ، أيضاً ، دليلٌ آخر على وجود إقطاعيلت كردية في بلاد الشام ؛ إحداها يعود بنا إلى السنوات الأولى من القرن الحادي عشر . فإن إبن تالشليل ، الأمير الكرديّ للساحل السوري ، إضطهد دناصري الحاكم بأمر الله ، من دروز وادي التيم ، اللبنانيّ ، في حملة قتل ونهب وسبي ، عاتية (10) . بعد حوالي القرن ، جاء الأمير معن مع جماعته ، ليسكن البقاع بأمر من صاحب دمشق ، طغتكين ، بهدف مضايقة الصليبيين (11) . ويرجع المعنيون نسب سلالتهم إلى بني أيوب ، ويعتبرهم بعض الباحثين أول جماعة كردية مهاجرة إلى لبنان (12) . في أيام الأيوبيين الكرد ، المتخذين لدمشق عاصمة لبلاطهم ، إنتشر بني قومهم في معظم المدن الإسلامية الشامية ، وبدرجة أقل ، في الساحل السوري ؛ الذي بقيت أهم مدنه وقلاعه بيد الإفرنجة حتى قيام الدولة المملوكية . إن أول إشارة تاريخية لدينا ، عن التواحد الكردي في ساحل بلاد الشام ، تتحدث عن إنتفاضة في كسروان ضد المماليك ، في القرن الرابع عشر ، حيث أنجد الأكراد عسكر السلطنة ضد المنتفضين . وما لبث أن توافدت أعداد من بني قومهم إلى مختلف مناطق الساحل ، مستولين على إقطاعات كبيرة فيها ، وخصوصاً في طرابلس وعكار والضنية (13) . ما من شك في أن إنتشار الكرد في مناطق الساحل السوري ( محافظة اللاذقية ، الحالية ) ، حاصلٌ لإستيلاء صلاح الدين على الحصن المهيب ، المعروف الآن بإسمه ( قلعة صلاح الدين ، في الحفة ) . وقد تعزز الإستيطان الكرديّ هناك ، في زمن المماليك والعثمانيين ، حتى أن أحفاد أولئك الكرد ، المحاربين ، ما إنفكوا إلى وقتنا الحاضر محتفظين بأنسابهم وعاداتهم ، في قرى ونواحي جبل صهيون وجسر الشغور . وفي هذا الشأن ، يقول الباحث كمال الصليبي : " ومهما قيل في أصل هؤلاء المستوطنين العرقية ، فقد كانوا جميعاً على المذهب السني ، مما أدى إلى تعزيزه في البلاد (14) . ولكن إستيطان الكرد في الساحل السوري ، لم يقتصر على السنة وحدهم ؛ فواحدة من أهم العشائر العلوية ( الرشاونة ) ، تتصل فرعاً بأصلها الكبير ؛ عشيرة ( رشوانا ) ، الكردية ، الكبيرة . (15)
أما حلب ، كبرى مدن الشمال السوري ، الإسلامية ، فإن قربها من جبل الأكراد ، الواقع إلى الشمال الغربي منها ( كورداغ ) ، سهّل منذ القدم إتصال الكرد بها ، وهجرتهم إليها . لا ريب أن الوجود الكردي ، تاريخياً ، في هذه الحاضرة العريقة ، إتخذ حجماً أهم مع سيطرة صلاح الدين عليها ، وتعيينه لإبنه الملك الظاهر ، نائباً عليها . وقد حكمت سلالة بني أيوب حلبَ ، مخلفة فيها ، شأن المدن الشآمية الاخرى ، آثاراً راقية من مدارس وخانقاهات وحمامات وغيرها . جدير بالذكر ، أن فرعاً من العائلة الأيوبية ، الحلبية ، إستمر محتفظاً بنفوذه في زمن المماليك والعثمانيين . عُرف هذا الفرع بإسم " جان بولاد " ؛ إبن الأمير قاسم الكردي ، الشهير ب " إبن عربو ". كان السلطان العثماني ، سليم الأول ، قد ثبت جان بولاد هذا ، على سناجق حلب والمعرة وكلس وإعزاز وتوابعها ، مانحاً إياه لقب " أمير الأكراد" . توفي أميرنا عام 1576 ، بيد أن داره العظيمة ، التي إبتناها لنفسه داخل منطقة باب النصر ، مشهورة ما تزال ، وقبلة للسياح في حلب القديمة (16) . المصادر التاريخية تخبرنا ، أيضاً ، أن أحد أحفاد الأمير جان بولاد ، هرب من بطش الباب العالي في أوائل القرن الثامن عشر ، ملتجئاً إلى جبل لبنان ، واضعاً في تربته بذرة العائلة الدرزية العريقة ؛ الجنبلاطية (17)
قلنا أن أول إمارة إقطاعية ، كردية ، في بلاد الشام ، قد وصلنا أخبارها ، كانت تحكم في مدينة حماة ، في بداية القرن الثاني عشر . وفي أواخر ذلك القرن ، أضحت المدينة مملكة مزدهرة ، ذائعة الصيت ، بفضل سلالة من بني أيوب ؛ مؤسسها الملك منصور الأول محمد بن تقي الدين عمر ، إستمرت في الحكم حتى أواسط القرن الرابع عشر . كان من ملوك هذه السلالة ، العالم والمؤرخ الأشهر ، أبو الفداء ؛ من أعطى لقبه لحماة ، ومقامه فيها من المزارات المشهودة . فضلاً عن أن عمائر الأيوبيين ، الراقية ، تذخر بها مدينة أبي الفداء ؛ وخاصة في الحيّ الذي أسسوه وسكنوا فيه ، والمعروف ب " حارة الكيلانية " (18) . كذلك حكم أولاد عمومة صلاح الدين في مدينة حمص ، قلب بلاد الشام ، وفي مدينة الرقة ، التي تعد من أقدم حواضر منطقة الجزيرة .
تعود بدايات الإستيطان الكردي ، العسكري أساساً ، في جنوب بلاد الشام ، إلى فترة الحروب الصليبية . وما يهمنا هنا ، هو فلسطين وشرقي الأردن . كان تحرير البلاد المقدسة ، هو الهدف الثاني لصلاح الدين بعد تمكنه من إزالة الخلافة الفاطمية ؛ واضعاً القدس الشريف ، المحتلة من لدن الفرنجة ، نصب عينيه . ورغم حقيقة التخريب المتعمد لكل حصن صليبيّ ، كيلا يستخدم من قبلهم في حملة مجددة ؛ إلا أن سلطاننا الأيوبيّ أبقى على الكثير من القلاع الهامة ، في صفد والكرك ، كمثال ، مضيفاً إليها بصماته العمرانية المميزة ؛ وهو ما بقي تقليداً عند من خلفوه فيما بعد . وبما أن العادة جرت ، وقتئذ ، على إحلال حاميات كردية ، بشكل خاص ، في تلك القلاع المنتزعة من العدو ؛ فما أسرع أن تحولت هذه إلى مجتمعات جديدة ، ألحق بها إقطاعات مناسبة . علاوة على ذلك ، عمّر الأيوبيون قلاعاً اخرى في فلسطين وشرقي الأردن ، ما فتيء معظمها قائماً في السلط والشوبك وحصن فرعون وغيرها ؛ فضلاً عما خلفوه من مدارس ، في القدس المحررة بوجه خاص ؛ كالصلاحية والأفضلية والكاملية والمعظمية والبدرية .. حتى أن الباحث مصطفى الدباغ يؤكد ، أن فلسطين لم تعرف المدارس إلا في عهد الأيوبيين ، وأما قبل ذلك فكانت المساجد تقوم بمهمة البحث والدراسة الفقهية (19) . وفي هذا المقام ، لا بد لنا أن نكر بأنّ وزير صلاح الدين ، القاضي الفاضل ، كان عربياً فلسطينياً من عسقلان ؛ رجل البيان وأحد أعلام النثر العربي ، الذي كان من أهميته في البلاط الأيوبي ، أنّ مليكه قال عنه مخاطباً أقاربه الأمراء الأكراد : " لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم ، بل بقلم الفاضل " (20) . لا بد ، أيضاً ، من التنويه ، بأنه عُرف العديد من الأعلام الفلسطينيين ، من ذوي الأصل الكردي ، نظير الشاعر أحمد الشهرزوري ( توفي 1067 ميلادية ) ، والمحدث إبراهيم الهكاري ( توفي 1312 ) ، وأحمد بن علي الكردي ( توفي 1369 ) ، وكان والياً على صفد وأنشأ جامعاً فيها يحمل إسمه . ونذكر أخيراً ، الشاعر أبو اللطف الحصكفي ، المدرّس في المدرسة الصلاحية ، المقدسية ، ومن تولى الإفتاء في المدينة الشريفة ، قبل إنتقاله للآستانة ووفاته فيها عام 1660 . (21)
3 _ جيرون وجيرانها :
دمشق ، أو جيرون ، أو جلق ؛ بحسب أسمائها العابرة للتاريخ . إنها أكبر مدن سورية الطبيعية ، حتى أنها معروفة ب " الشام " ؛ وكأنما إسمها يختصر تلك البقعة الجغرافية ، بأسرها . إن موقعها الفريد ، قد أضفى عليها سحره الخاص ؛ سهلٌ غاية في الخصوبة ، يتخلله المياه الغزيرة ، المتدفقة من الغرب عبْر غوطة نضرة ؛ سهلٌ خِلٌ لجبل ، تحدق منه على منظر الحاضرة الأقدم ، فيخيل إليك أنك تطلّ عل فردوس الله . وفي ذلك تقول شاعرة الشام ، عائشة الباعونية :
هي في الأرض جنة فتأمل ، كيف تجري من تحتها الأنهارُ
كانت الشام قبلة القاصدين وبغية الطامعين ، فالأحرى أن تكون هدفاً لجيرانها الشماليين ، الكردوخيين ، من باب أولى . طريقها القديم ، الموصل حلب شرقاً بالعراق ، وشمالاً بالأناضول ؛ طريقٌ لا بد أن يمر عبر جبال وعرة ، تتوعدُ القوافل بكمائن " أولاد الجنّ " وغاراتهم . تاريخياً ، ربما يعود إتصال أقدم عواصم العالم بجيرانها الشماليين ، النهابين ، إلى أيام دولة ميتاني . إذ دخلت هذه الدولة في نزاع مع منافستها الجنوبية ، مصر ، إنتهى إلى الإتفاق فالمصاهرة الملكية ، على عادة تلك الأزمان . ومن ثم تقاسم سورية كبائنة للعروس ؛ الجزء الشمالي حتى حماة القديمة حصة للميتانيين ، وما تبقى يكون في عهدة الفراعنة (22) . هؤلاء الأخيرون إستمروا في لعبتهم مع أجدادنا . هاهم في القرن الثامن قبل الميلاد ، يحرضون أمراء الميديين على الدخول في محالفة مع أندادهم من آراميي سورية ، لمواجهة الآلة العسكرية ، الجهنمية ، للآشوريين . بيْد أن تحلفهم تشتت ، ودفعت دمشق ثمن الحلف الذي جمع لمرة ، أسلاف الكرد والسريان ! من الطرافة ، أيضاً ، أن نذكر ، بأن " دياكو " ، أول ملوك ميديا ، المعروفين ، قد نفي في شبابه إلى حماة ، بأمر من الملك الآشوري سركون ؛ كما تسجل سجلات هذا الأخير (23) . على أن نهاية آشور ، حلّت أخيراً ، بتدمير الميديين وحلفائهم الجدد ، الكلدانيين ، مدينة نينوى عام 612 ق م ؛ والذي أضحى منذئذ فاتحة التقويم الكردي . أما ما كان آنذاك من أمر مدينتنا ، فهذا ما يخبرنا عنه مؤرخها ، القساطلي أفندي : " ولما سقطت بابل بسيف كورش ، ملك مادي ، صارت دمشق تابعة له حتى سنة 331 ق م ، عندما إستولى اسكندر المقدوني على سورية ، فإنتقلت دمشق لليونانيين وبعد موته تبعت السلوقيين " . (24)
في القرن السابع الميلادي ، ومع ضم بلاد الشام إلى غنائم الدولة العربية الإسلامية ، فكان لا بد من تحوّل جذريّ ، طاريء على مناحي الحياة كافة ؛ دينية وإجتماعية وسياسية وحضارية . حلّ بداة الصحراء في قصور أهل المدنية ، من البيزنطينيين ؛ الذين إنقرضت سلالتهم ، ليلحقها ، بدرجة أقلّ ، العنصر السوري الشعبيّ ، الآراميّ . وإذ تمكن الكثير من النصارى من الإفلات من البوتقة الإسلامية ، بما نالوه من إعتراف الفاتحين ك " أهل ذمة " ؛ فإنهم فقدوا ، في واقع الحال ، موقعهم الإجتماعي وصاروا مع اليهود ، مواطنين من الدرجة الثانية . من جهة اخرى ، فالكثير أيضاً من البداة العرب ، وبعد إستحواذهم للغنائم الموعودة ، أقفلوا عائدين إلى مواطنهم ، عدا قلة منهم طاب لها العيش في الصحراء السورية . أما أهل الحضر من آل أمية _ وهم أصحاب رحلة الشتاء والصيف ، بحسب القرآن _ فما أسرع توالفهم مع الحياة الشامية ، بإستلائهم على دور وقصور البيزنطيين ، الباذخة . وما هي إلا أعوام اخر ، حتى سيطر الأمويون على مقاليد الخلافة ، مبعدين آل البيت ، نهائياً ، عن السلطة . وبالرغم من أنّ أحد أهم مقامات الشيعة ، السيدة زينب ، قد إحتبتها دمشق ؛ فإنها بقيت " مدينة مارقة " ، بنظر هؤلاء ، لما لعبته من دور مذهبيّ _ سياسيّ ، زمن الخلاف مع الأمويين .
بالمقابل ، أضفى أهل السنة المسلمين ، هالة من القداسة على الشام ، متبنين الكثير من الأساطير التي كانت سائدة لدى من سبقهم من أتباع الديانات الاخرى . كان جبل قاسيون ، وتحديداً منحدره المحتضن اليوم حينا الكرديّ ، موئلاً لتلك الأساطير : هاهنا مثوى آدم وحواء ، إثر نفيهما من جنة الفردوس ؛ وما فتيء دم إبنهما ، هابيل ، مرتسماً على حجارة الكهف المسمى " مغارة الدم " . يهبط الملاك من عليائه ، للتعزية بأول قتيل في الأرض ؛ فيسمَ غاراً آخر بإسمه " كهف جبريل " . وحكاية أهل الكهف ، الشهيرة ، جغرافيتها في جبلنا نفسه ، " مغارة الجوع " . كما أن مولد إبراهيم الخليل ، سيضلّ موضعه في " الرها " ، بكردستان ، ليشار إليه هناك ، في منحدر الجبل المطل على قرية " برزة " ، المجاورة . فضلاً عن إلتجاء المسيح وأمه إلى " ربوة ذات قرار معين " _ بحسب القرآن _ وتم تفسيرها على أنها تلك الضاحية الدمشقية الجميلة ، " الربوة " ، المنحدرة من قاسيون . وكان لا بد أن تكتمل أسطورة دمشق ، بقصة وطىء الرسول العربي لأرضها . فالنبيّ يستنكف دخول المدينة " لأنه لا يريد رؤية الجنة مرتيْن ! ؛ ليبقى أثر قدمه ، الشريفة ، في تلك البقعة المعروفة ب " القدم " ؛ ضاحية دمشق الجنوبية. هذه الأساطير ، المختلقة لهدف سياسيّ بيّن ، بغية تثبيت سلطة الأمويين خارج الحجاز ؛ شغف بها مختلف العناصر القومية ، المشكلة نسيج الخلافة الإسلامية . وإذ أجبر الوضع السياسي السلالة العباسية على نقل العاصمة إلى بغداد ، بفعل حرج موقعهم في الشام ، إلا أن تركمان السلاجقة والأتابكة ، المسيطرين على شؤون الدولة ، إهتموا مجدداً بدمشق ، التي إستخلصوها من يد الفاطميين ؛ لدرجة أن بلاط آل زنكي إنتقل إلى قلعتها . الواقع أنّ الأكراد ، ورثة التركمان في البلاد الشامية ، كانوا قبل ذلك على رأس إمارات مستقلة في موطنهم ، الكردستاني . ومن المفيد التنويه هنا ، بأن عدداً من المغامرين الكرد ، إقتحموا في تلك الآونة ، الحرجة ، الحياة السياسية لهذا البلاط الإسلامي وذاك . لعل أبرز هؤلاء ، كان الملك العادل سيف الدين إبن السالار ، وزير الظافر بالله ، الخليفة الفاطمي في مصر . إنتمى الملك العادل هذا لبطن من عشيرة كبيرة من الكرد ، هي الزرزارية . في شبابه ، وجد نفسه ضابطاً بخدمة ولاة الشام ، ثم إنتقل لمصر الفاطميين ، ليتسلم بعد مكائد ودسائس ، منصب الوزير الأول عام 1147 م ، متنعماً بلقب " أمير الجيوش ". غير أن المنصب كان وبالاً على حياته ، التي أخترمت إغتيالاً بعد تاريخ توزره بأربع سنوات (25) . وبعد مقتله بعقدين من الزمن ، شاء قدر الخلافة الفاطمية ، العلوية ، أن تنتهي على يد وزير آخر ؛ هو الملك الناصر صلاح الدين إلن أيوب .
هوامش ومصادر :
1 _ شرفنامة ، للأمير شرفخان بدليسي / ترجمة محمد علي عوني _ القاهرة 1958 ، ص 67 ج 1
2 _ مينورسكي ، الأكراد / ترجمة معروف خزندار _ بغداد 1968 ، ص 67
3 _ المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر / المصحح شارل بلا _ بيروت 1979 ، و 1257 ج 7
4 _ طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة _ بغداد 1956 ، ص 386 ج 2
5 _ كذلك كان تفسير العلامة محمود الآلوسي ، لتلك الآية القرآنية : أنظر ، محمد أمين زكي ، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان / ترجمة محمد علي عوني _ القاهرة 1939 ، ص 288 ج 1
6 _ المصدر نفسه ، ص 134 ج 1
7 _ أحمد غسان سبانو ، مملكة حماة الأيوبية _ دمشق 1984 ، ص 33
8 _ مجموعة باحثين ، الأكراد وكردستان / ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية _ بيروت 1982 ، ص 310
9 _ أحمد وصفي زكريا ، جولة أثرية في بعض الأنحاء الشامية _ دمشق 1934 ، ص 331
10 _ الأكراد وكردستان ، مصدر مذكور ، ص 311 : نقلاً عن كتاب ، سورية الجنوبية لكلود كاهن _ دمشق 1940
11 _ محمد علي مكي ، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني _ بيروت 1979 ، ص 94
12 _ أحمد محمد أحمد ، أكراد لبنان وتنظيمهم الإجتماعي والسياسي _ بيروت 1995 ، ص 42
13 _ كمال الصليبي ، تاريخ لبنان الحديث _ بيروت 1984 ، ص 18
14 _ المصدر نفسه ، ص 18
15 _ ملاحظة المحقق يوسف جميل نعيسة ، في كتاب : تاريخ حسن آغا العبد _ دمشق 1986 ، ص 145
16 _ إبن الحنبلي ، در الحبب في تاريخ أعيان حلب _ طبعة محققة في دمشق 1972 ، ص 445
17 _ لمزيد من المعلومات عن تاريخ هذه الأسرة ، راجع : محمد أمين زكي ، تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي / ترجمة محمد علي عوني _ القاهرة 1939 ، ص 380
18 _ مملكة حماة الأيوبية ، مصدر مذكور ، ص 160
19 _ مصطفى الصباغ ، موجز تاريخ الدول الإسلامية وعهودها في فلسطين _ بيروت 1981 ، ص 23
20 _ المصدر نفسه ، ص 29
21 _ محمد عمر حمادة ، أعلام فلسطين _ دمشق 1985 ، ص 28 ص 252 ج 1
22 _ مجموعة باحثين ، الموسوعة المصرية _ القاهرة بلا تاريخ ، ص 384 ج 1
23 _ ارنولد توينبي ، تاريخ البشرية / ترجمة نقولا زيادة _ بيروت 1985 ، ص 78 ج 1
24 _ نعمان قساطلي ، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء _ بيروت 1878 ، ص 11
25 _ إبن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان _ طبعة محققة في بيروت ، بلا تاريخ ، ص 418 ج 3
الفصل الأول من دراسة بعنوان : ملامح اللوحة الكردية الدمشقية ))
#دلور_ميقري (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كي لا ينام الدم
-
سنوات النهضة الكردية: مدرسة الشام
-
المصادر الاسطورية لملحمة ياشار کمال ..جبل آ?ري
المزيد.....
-
حلبجة: ماذا نعرف عن المحافظة العراقية رقم 19؟
-
كلمة الرفيق حسن أومريبط، في مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية
...
-
ترامب لإيران.. صفقة سياسية أو ضربة عسكرية
-
كيف نفهم ماكرون الحائر؟
-
إسرائيل تعلن إحباط محاولة -تهريب- أسلحة من مصر
-
مبعوث ترامب يضع -خيارا واحدا- أمام إيران.. ما هو؟
-
أول رد فعل -ميداني- على احتجاجات جنود إسرائيليين لوقف الحرب
...
-
مقاتلة إسرائيلية تسقط قنبلة قرب -كيبوتس- على حدود غزة.. والج
...
-
باريس تُعلن طرد 12 موظفًا من الطاقم الدبلوماسي والقنصلي الجز
...
-
عامان من الحرب في السودان... تقلبات كثيرة والثابت الوحيد هو
...
المزيد.....
-
الرغبة القومية ومطلب الأوليكارشية
/ نجم الدين فارس
-
ايزيدية شنكال-سنجار
/ ممتاز حسين سليمان خلو
-
في المسألة القومية: قراءة جديدة ورؤى نقدية
/ عبد الحسين شعبان
-
موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية
/ سعيد العليمى
-
كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق
/ كاظم حبيب
-
التطبيع يسري في دمك
/ د. عادل سمارة
-
كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟
/ تاج السر عثمان
-
كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان
/ تاج السر عثمان
-
تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و
...
/ المنصور جعفر
-
محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي
...
/ كاظم حبيب
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة