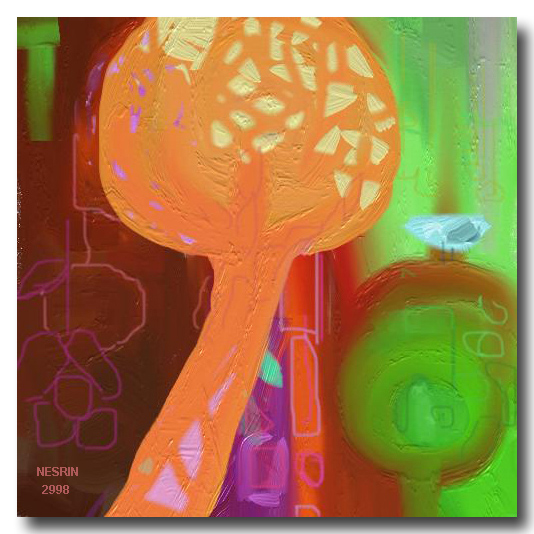|
|
القرشيّة امتدادا للعصبيّة القبليّة .. قراءة في الفكر السياسي الإسلامي
شايب خليل


الحوار المتمدن-العدد: 5249 - 2016 / 8 / 9 - 16:46
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الملخّص :
إن الباحث في تاريخ قيام الدول و الإمبراطوريات يُلاحظ من غير كبير جهد و لا كثير عناء أن هذا القيام مُرتهن أساسا بعامل معيّن يُثبّت الحكم و يُشَرْعِنُهُ ، و يجعل من الرّعيّة تلتّف حوله و لا تحاول الخروج عنه أو ترفض طاعته ؛ و يختلف هذا العامل من منطقة لأخرى .
فما هو يا تُرى العامل الرّئيس الـمُتحّكم في قيام الكيانات السياسيّة العربيّة ؟ أو ما هي أهم صبغة مميّزة لنظام الحكم عند العرب ؟ كيف كان تأثيرها في الإسلام كدين سماوي خاتم ؟ ثم هل أسهمت في الحفاظ على الهوية العربية في عصور لاحقة أم هل عادت بالسلب على الدولة العربية الإسلامية النّاشئة بعد ظهور الإسلام ؟
سنُحاول في هذا البحث استعراض العصبيّة القبليّة كصبغة تاريخية مميّزة للنّظام السياسي العربي قبل الإسلام ، يليه تحديد البعد المفاهيمي للفظة ، ثم تعامل الدين الإسلامي معها و هو الذي برز في جغرافيا أبرز سماتها العصبيّة ، و بعدها نتطرّق للعصبيّة في العهد الراشدي باعتباره الإطار العام الذي تُحاكم إليه أي تجربة سياسيّة بعد العصر النبوي كما قرّر ذلك فقهاء السّياسة الشرعيّة ، لنمرّ إلى تجلّياتها في العصرين الأموي و الراشدي ، و نختم ذلك بقراءة في آراء المفكرين السياسيين المسلمين حول القرشيّة كشرط من شروط تولي أمور المسلمين، نذيّلها بمناقشة الآراء الواردة في هذه المشكلة لنخرج بنتائج معيّنة في الأخير . أمّا محاور البحث فستكون كالآتي :
1- مفهوم العصبيّة القبليّة .
2- العصبيّة في العهد النبوي و الرّاشدي .
3- العصبيّة في العصرين الأموي و العبّاسي .
4- القرشيّة كمظهر من مظاهر العصبية و موقف فقهاء السياسة الشرعية منها .
الكلمات المفتاحية : 1- العصبيّة : نزعة انتمائيّة مصلحيّة تدفع لنصرة العصبة ظالمة أو مظلومة .
2- القبليّة : نزعة انتمائيّة مصلحيّة و فيها تتجلّى صورة من صور العصبيّة .
3- القرشيّة : نزعة عرقية تهدف إلى إقصاء غير العرب من تولّي أمور المسلمين.
4- الانتمائيّة الضيّقة : الوجه الآخر للعصبيّة القبليّة ، أو الوصف الدقيق لها .
5- المساواة : مبدأ جاء الإسلام ليُرسيه كأساس للتعامل بين النّاس .
لقد بزغ فجر الدين الجديد في جغرافيا تحكمها نظم سياسية و طرائق حكمية مختلفة و متباينة - إلى حد ما - ، ففي بلاد فارس كان نظام الحكم ملكيا إلهيا - ثيوقراطيا - للإمبراطور فيه السلطة المطلقة ، تكفي كلمة واحدة صادرة منه لإعدام من يشاء و وقت ما يشاء دون بيان للأسباب . و كانت قراراته وأحكامه بمنزله الوحي الإلهي ، و كل خروج عنها يعتبر خروجا عن إرادة الإله – أهورا مازدا – . و للجيش في هذا النظام مكانة خاصة ، إذ هو المؤسسة الأهمّ بالنسبة للدولة ، و الداعم الحقيقي لسلطة الملك ، كما أن الإمبراطورية لن تحافظ عل بقائها و استمراريتها إلا إذا كان الجيش قويا و محافظا على قدرته على التّقتيل ، لذا كان الإمبراطور هو قائده الأعلى . و المتفحص في تنظيمات هذه الإمبراطورية الكسروية يمكنه استنتاج أنه لا قانون يعلو فوق إرادة الملك و القوة القمعية للجيش .
و لم يختلف الحال في القيصرية الرومانية ، فقد حاز الملك قداسة رفعته فوق مستوى البشر، حتى أصبحت مظاهر مثل حرق البخور أما تمثاله و الطواف حوله دليلا على الولاء للإمبراطور في مظهر أشبه ما يكون بيمين الولاء في أيّامنا هذه ، و مما عزز هذه المكانة مجموعة من المراسيم التي تصدرها الدولة تأكيدا على مكانة القيصر و رفعته عن مستوى البشر*.
و رغم صراعها الطويل مع هذا الوضع لم تستطع المسيحية أن تقاوم بل سارت وفق التيار ، إذ عملت هي الأخرى على إضفاء القداسة على الملوك و القياصرة من خلال تبنّيها لنظرية الحق الإلهي من جهة ، و القران المعقود بين السلطة السياسية و السلطة الدينية من جهة أخرى، وهذا ما جعل حق تفسير النصوص المقدسة في يد القياصرة وهكذا و بدل أن تتمسح روما، تروّمت المسيحية .
لقد كان القاسم المشترك بين الإمبراطوريّتين الحكم الثيوقراطي أو الصبغة اللاهوتية فما هي يا تُرى أهم صبغة مميّزة لنظام الحكم عند العرب ؟ كيف كان تأثيرها في الإسلام كدين سماوي خاتم ؟ ثم هل أسهمت في الحفاظ على الهوية العربية في عصور لاحقة أم هل عادت بالسلب على الدولة العربية الإسلامية النّاشئة بعد ظهور الإسلام ؟
عرفت شبه الجزيرة العربية نظما سياسية مختلفة ، فقديما حكمت أجزاء منها دويلات متباينة الجغرافيا تشترك في تبنيها للنظام الملكي مثل : دولة معين ، سبأ ، و حمير باليمن، تدمر بالشمال ، بالإضافة إلى دولة الغساسنة في الشمال الغربي و التي كانت موالية للقيصرية الرومانية ، و دولة المناذرة في الشمال الشرقي الموالية للكسروية الفارسية . وقد حظيت هاتان المملكتان بنوع من الاستقلال المحدود و استعانت بهما الإمبراطوريتان في الوقوف في وجه بعض القبائل الأخرى التي كانت تهدد أمنيهما .
كما ساد النظام القبلي أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة ، كان أساس كيانه السياسي : الوحدة العصبية التي تجمع أفراد القبيلة ، بالإضافة إلى المنافع المتبادلة من حماية الأرض و دفع العدوان ، فقد كان أفرادها متضامنين إلى حد أنهم ينصرون الواحد منهم ظالما أو مظلوما ، و إذا غنم الفرد أو غرم فكل ذلك للقبيلة أو عليها .
و الجدير بالذكر أن رئيس القبيلة -الشيخ- له درجة رفيعة تساوي و يمكن أن تفوق مكانة الملك في رعيته ، إذ القبيلة خاضعة لرأي شيخها في السلم و الحرب و يكفي للتدليل على ذلك القول أن آلاف السيوف تغضب بل وحتى تموت لغضبه و هذا ما يجعله يشبه أي دكتاتور شديد السطوة في أيامنا هذه .
إذا لقد ظهر جليا أن شمس الإسلام انبلجت في جغرافيا تُعتبر العصبيّة و التمييز أو التفرقة القبلية و الطبقية بين أفراد المجتمع بل و أبناء الجنس الواحد هي أساس النظام الاجتماعي و حتى السياسي ، و أصلا من أصول الحياة الاقتصادية و بّما الدينيّة .
- فماذا نقصد بالعصبية ؟
العصبيّة لفظة مشتقة من العَصْبِ وهو: الطَّيُّ والشَّدُّ . وعَصَبَ الشيءَ يَعْصِبُهُ عَصْبًا: طَوَاه ولَوَاه، وقيل: شدَّه. والتَّعَصُّب: المحاماة والمدافعة ؛ و العَصَبَة : الأقاربُ من جهة الأب ، وعَصَبَةُ الرَّجُلِ: أولياؤه الذكورُ من وَرَثَتِه ، سُمُّوا عَصَبَةً لأنهم عَصَبُوا بنسبه ، أي أحاطوا به، فالأب طَرَفٌ والابن طرف، والعم جانب والأخ جانب، والجمع: العَصَبَات، والعرب تُسمِّي قرابات الرجل: أطرافَهُ ، ولـمّــَــا أحاطتْ به هذه القراباتُ وعَصَبَتْ بنسبه، سُمُّوا: عَصَبَةً، وكلُّ شيءٍ استدار بشيء فقد عَصَبَ به. و يقال : عَصَبَ القوم بفلان أي استكفوا حوله
والعُصْبَة والعِصَابة: الجماعة؛ ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﭼ ، ومنه حديث: " اللَّهُمَّ إنْ تُهْلِكْ هَذِه الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ " .
و العصبيّ هو الذي يغضب لعَصَبَتِه ، أو من يُعين قومه على الظلم أو من يُحامي عن عن عصبته ويغضب لهم ، و رجل عصبي : سريع الانفعال ، و في الحديث: " العصبيّ من يُعين قومه على الظلم "، و في حديث آخر : "ليس منّا من دعا إلى عصبيّة أو قاتل َعصَبِيَّةً " . وعَصِيب: شديد ، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ
و الظاهر مما سبق أن العصبيّة تدور معانيها حول النّصرة و الحميّة و الانتصار للمُنتسب إليه سواء عائلة أو قبيلة ، و في مختلف الحالات ظالما أو مظلوما .
أما اصطلاحا فعرّفها الأزهري بقوله : " و العصبيّة أن يدعوَ الرجل إلى نصرة عَصَبتِه و التّألَب مهم على من يُناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين " .
و عرّفها ابن خلدون بقوله :" هي النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم ، أو تُصيبهم هَلَكَةٌ " و هي في نظره صفة جبليّة فُطِر عليها البشر مذ وُجدوا .
و يذهب المفكر محمد عابد الجابري إلى أنّها : " رابطة اجتماعية سيكولوجية شعوريّة و لا شعوريّة تربط أفراد جماعة ما ، قائمة على القرابة ، ربطا مستمرّا يبرز و يشتدّ عندما يكون هناك خطر يهدّد أولئك الأفراد ، كأفراد أو كجماعة " .
و عُرّفت بأنّها : " التلاحم بالعصب ، و الالتصاق بالدّم ، و التكاثر بالنّسل ، و وفرة العدد ، و التّفاخر بالغلبة و القوّة و التّطاول " .
و الظاهر مما سبق من التعريفات أنها رابطة مصلحيّة نفعية قائمة على شيئين رئيسين هما :
- القرابة : سواء قرابة دم كما هو الحال في العائلة الواحدة ، أو قرابة انتماء كما هو الحال بالنسبة للقبيلة أو حتى الدّولة .
- النّصرة : و هي الدافع المصلحي البارز للعصبيّة ، بحيث يُسخّر الفرد نفسه لنصرة عَصَبَتِهِ و ربما حتّى يجود بنفسه و ماله في سبيلها ، سواء كانت هذه العصَبَةُ ظالمة أو مظلومة .
لقد جاء صلوات ربي و سلامه عليه ليبدّد سحب العصبية و الاعتداد بالجنس أو القبيلة أو العرق و يعلي شمس الانتماء الديني العقدي مكانها ، فرفع من شأن المساواة و ارتقى بها إلى أعلى المستويات ، و في المقابل ذم العصبيات و حطّ من رفعة العنصريات خارج الانتماء العقدي الديني ، لذا وجدناه صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر و قد عيّر غلامه بأمه السوداء : " يا أبا ذرّ إِنّك امرؤٌ فيك جاهليّة " ، ترسيخا منه و تربية لصاحبته الكرام على أنهم سواسية . إذا فالمساواة في الإنسانية التي نادى بها الإسلام و
سعى في كل الظروف لتطبيقها قد أسقطت كل افتخار و اعتزاز بالأجناس و الأعراق و الألوان مبتغيا وراء
ذلك إزالة مظاهر التمييز بين أفراد المجتمع و ذلك حفاظا منه على تماسك كيانه الاجتماعي و السياسي .
إن هذا الارتقاء من الاعتداد بوشائج الأرض و الطين ، و من وشائج اللحم و الدم ، إلى الاعتداد بأخوة الإسلام أنتج لنا أرقى صورة للأخوة و المساواة بين مختلف الجنسيات العرقية و القبليّة ، يكون فيها أبو بكر العربي و بلال الحبشي و صهيب الرومي و سلمان الفارسي إخوة في الدين ؛ وبذلك أمكن الخروج من ضيق الانتمائية إلى سعة الأخوة الدينيّة .
و يذهب الدكتور طه حسين إلى أن الإسلام جاء بقضيتين مهمتين تنطوي تحتهما باقي القضايا قضية توحيد الله عزّ و جلّ و محاربة كل وجه من أوجه العبودية المنصرفة لغيره تعالى ، و قضية المساواة بين جميع البشر ، و لعل هذه القضية الأخيرة - كما يرى - كانت أغيظ ما غاظ سادة قريش من محمد صلى الله عليه و سلم ، إذ ساوى بين السيد و المسود ، و هذا كان بمثابة الثورة على المبادئ السائدة آنذاك .
و تأكيدا منه على مبدأ المساواة بين البشر و مقت الانتمائيّة العصبية الضيّقة نجد القرآن الكريم يذكر بوحدة المنشأ، قال تعالى : ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ . إذ كل الناس متساوون في أصل الخلقة كلهم من آدم و آدم خلق من تراب ، و الإسلام بهذا التوجيه أراد الارتقاء بالإنسان من الاعتداء بوشائج الدم و الطين إلى الاعتداء بوشيجة الدين و العقيدة ، و أساس التفضيل في هذا السياق هو التقوى والعمل الصالح ، قال تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ . و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " إنّ الله لا ينظر إلى صوركم و أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم " .
و رغم كلّ هذا وذاك ، أُثيرت مشكلة العصبية في المدينة من جديد ، حيث نجد رسول الله في ميثاق المدينة يجعل المهاجرين بمثابة القبيلة حين قال : "المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ..." ؛ و نسب الأنصار إلى قبائلهم ، كما نسب اليهود و من بقي على دينه من أهل يثرب إلى قبائلهم فقال : "إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين" ، رغم أنه ما فتئ يُحاربها و يُجفّف منابعها . ربّما كان هذا محاولة لاحتوائها أو ربّما لتوظيفها في أحد أمرين :
1- الاستفادة منها في مجال التكافل الاجتماعي مثل : دفع الديات ، فكاك الأسرى ، إعانة المحتاج من أفراد القبيلة الواحدة ، كما ستوظف لاحقا في المعارك و الغزوات ... فبتحمّل الوحدات الصغيرة المكونة- القبائل- "للدولة الإسلامية" مهام التكافل الاجتماعي ترتفع أعباء كبيرة عن عاتق الكيان الوليد لتُوظّف الجهود و تُستفرغ الطاقات في مجالات أهم كالدّعوة إلى الله و حماية المنتسبين لهذا الدّين .
2- إن نسبة المتهوّدين من اليثربيين إلى قبائلهم ، و إقرار حلفهم مع المسلمين هدفه لــمّ شمل الدولة والحفاظ على وحدتها الاجتماعية و السياسية ،كما أنه يؤكد أيضا أن المقصود من الحديث عن العصبيات كان الإفادة في تحقيق التكافل الاجتماعي لا غير ، و هما هدفان يمكن فهمهما من خلال الحفاظ على حلفهم مع المسلمين و عدم نقضه و إيقاع العقاب على كل مثير للشغب خارق للقوانين مهما كان انتمائه
الطائفي ، منبها في ذلك إلى المسؤولية الفردية الواقعة على عاتق كل شخص .
توفي رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و لم يعهد بأمر الخلافة إلى أحد من بعده ، كما أنه لم يترك لصحابته الكرام رضوان الله عليهم خاصة و المسلمين عامة أنموذجا محددا واجب الاتباع سواء في طريقة اختيار الإمام ، أو غيرها من المباحث التفصيلية التي تطرح في هذا الباب ، بل اكتفى بوضع قواعد عامة موضحة في القرآن الكريم و السنة المطهرة ، تحدد معالم النظام السياسي في الإسلام ، و ترك لأهل العلم في كل زمان و مكان البحث و الاجتهاد في استنباط أمور تفصيلية تتماشى و الظروف السائدة في عصر اجتهادهم ، و ذلك لعدم تقييد الأمة بأنموذج جامد يصلح لعصر و قد لا يصلح لباقي العصور ، لكن هذه المرونة الموجودة في النظام السياسي في الإسلام قد خلقت العديد من المشكلات بعد وفاته مباشرة .
ثُمّ إنّ أعظم خلاف حدث بين المسلمين - بل بين الصحابة المقربين - كان حول الأحقية في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول الشهرستاني : " و أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سُل على الإمامة في كل زمان " ، ولعل الروايات التي يوردها ابن سعد عن الحادثة التي دارت بين على كرم الله وجهه و بين عمه العباس تُظهر نوعا من التخوف من هذه المشكلة ، و تُضمر في طيّاتها محاولة من العمّ - العباس - لحسم مادة الخلاف في المسألة ، إذ يقول لعلي: "(...) فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه ، و إن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس" ، فكانت إجابة عليّ هي الأخرى تطرح الكثير من التساؤلات : " إني والله لا أفعل ، والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده" ؛ أهو شعور بالأحقّيــــــــة في الخلافــــــــة منه عليه السّلام خاصّـة إذا علمنا ماله من قرابة و نسب ؟ لعل رواية أخرى عند ابن هشام تجيبنا بكل وضوح "بلى" : فحين طلب منه العباس أن يبسط يده ليبايعه - و ليته فعل - فيُقال : عمّ رسول الله بايع ابن عــــــــمّ
رسول الله ، أجاب : و من يطلب هذا الأمر غيرنا !!!
و يتحقق التخوف الذي بدر من العباس ، فبمجرد وفاته صلى الله عليه و سلم ، و قبل إتمام تسجية جسده الطاهر ، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة للتباحث و التشاور في أمر خلافة رسول الله في إدارة شؤون المسلمين ، فلما سمع أبو بكر و عمر بذلك انطلقا إلى السقيفة و معهما أبو عبيدة بن الجراح،
و هناك دار حوار بين المهاجرين و الأنصار ، يمكن أن نستشفّ من مجرياته وجهتي نظر مختلفتين :
1- الأنصاريّة :
يرأس وفدهم زعيم الخزرج سعد بن عبادة ، و الذي رفع سقف طموحاته إلى جعل إمرة المسلمين في الأنصار دون المهاجرين مستدلا بما قدمه الأنصار من نصرة للدين و خدمة للرسول الكريم ، طامحا في أن يكون أول خليفة للمسلمين بعد رسول صلى الله عليه و سلم ، لكن بعد حوار و نقاش مع أبي بكر أخذ السقف ينخفض شيئا فشيئا ببروز رأي الحباب بن المنذر - من الأوس- و الذي رأى أن للجميع مهاجرين و أنصارا الحق في خلافة رسول الله في إمرة المسلمين قائلا : لا تسمعوا لمقالة هذا- يقصد عمر بن الخطاب - و أصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر" .
و هو في حقيقة الأمر رأي يعبر عن تعمق روح العصبية للإسلام و تجذرها في نفسه رضي الله عنه دون سواها من العصبيات ، فللجميع الحق في الترشّح و رئاسة المسلمين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو
القبلية بل المرتكز الأوّل الانتماء لهذا الدّين .
2- المهاجريّة :
كان يمثل المهاجرين في هذا الاجتماع كل من أبي بكر و عمر و أبو عبيدة بن الجراح ، فبعد اعترافهم للأنصار بفضلهم بينوا أنهم الأحق في خلافة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ، إذ هم قومه و العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لذلك الحي من العرب . و هذه الفكرة -القرشيّـــــة- ستكون حجر الزاوية في الفكر السياسي للأمة ، و من الشروط الأساسية الواجب توفرها في خليفة المسلمين كامتداد تاريخي و مباشر لظاهرة العصبية القبلية .
و باعتبار الخلافة الراشدة الإطار العام للتفكير السياسي الإسلامي ، أو الدولة المثالية التي تحكمها قوانين الله ، و المرجع الأساس الذي تقاس عليه كل تجربة سياسية خاضها المسلمون - و هو ما نراه قد حجّر واسعا ، خاصة إذا تذكرنا أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يفرض أنموذجا محددا لنظام الحكم بل ترك
ذلك لاجتهادات المسلمين في كل العصور و اكتفى بإبراز البنود العريضة لهذا المشروع الإسلامي- ، أدرجت القرشيّة سليلة العصبية القبيلة في مباحث الفكر السياسي الإسلامي إدراجا كما سيأتي .
و بعد أخذ و ردّ بويع لأبي بكر بالخلافة ، وكان أول المبايعين قيس بن سعد حسدا منه لابن عمه سعد بن عبادة ، ثم بايع بعدهم الأوس خوفا من استيلاء الخزرج على السلطة ، و رفض سعد بن عبادة سيّد الأنصار أن يبايع ، بل و اعتزل الناس حتى إنه كان لا يصلي بصلاتهم و لا يجتمع بجمعهم ، و لا يفيض بإفاضتهم .
أما المهاجرون فقد انقسموا كل حسب انتمائه القبلي ، فاجتمعت بنو أمية إلى عثمان ، وبنو زهرة إلى سعد بن وقاص و عبد الرحمن بن عوف ، و بنو هاشم إلى عليّ بن أبي طالب ، فلما أقبل الوفد الثلاثي قال عمر : "مالي أراكم مجتمعين ، قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته و بايعه الأنصار فقام عثمان و من معه من بني أمية فبايعوا و ما كان لهم - بنو أمية- مواجهة أبي بكر وعمر إذ ليس لهم من نصيب مع هذه الأحجام الكبيرة كما يقول الأستاذ صالح عوض ، و بايع بنو زهرة أيضا .
أما عليّ و من معه من بني هاشم فانصرفوا و لم يبايعوا اعتراضا على أحقيتهم في الملك لقرابتهم ، و ظلّ كرّم الله وجهه و رهط من قبيلته على هذه الحالة إلى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام ، فبايعوا لأبي بكر جمعا لكلمة الأمة و حفاظا على وحدتها ، خاصة و أن طبول الحرب قد دقت بين المسلمين و المرتدين . ولو حلّلنا موقفه بمنطق و تحيّز لكان هو الأحقّ بالخلافة من غير فهو إضافة إلى قرشيّته ابن عمّ رسول الله و زوج ابنته .
و بذلك كانت بيعة أبي بكر أول حدث سياسي مهم في التاريخ الإسلامي ، و أول بيعة سياسية تحدث
عد وفاة الرسول الكريم ؛ و رغم كل هذا الصراع استطاع الخليفة الأول رضي الله عنـــه و بحنكة بالغة إدارة شؤون الدولة و توطيد أركانها و الحفاظ على وحدتها السياسية و الدينية و بقيت حال العصبيّة بين بروز وخمود طيلة العصر الراشدي إضافة إلى المشكلات التي تلت مقتل عمر و بعده عثمان ثم علي ، و ما انجرّ عنها من حروب وصراعات .
و نتيجة لكل هذه التراكمات السياسية و الاجتماعية بدأ الظهور الفعلي للفرق الإسلامية سواء ذات المنشأ السياسي أو المنشأ العقدي ، و بدأ التنظير المؤدلج لمبحث الإمامة -كل فرقة تكتب وفق الإيديولوجية التي تنتمي إليها أو حتى التي تخدم مصالحها و حسب - مثل ما هو الحال مع بني أمية و الإرجاء و مع المحكّمة و الخروج على الحاكم الظالم ... الخ . و هكذا أصبح الصــــــراع ذو اتجاهين : مع السلطة من جهة ، و مع الفريق الخصم من جهة أخرى .
و بمجرّد استتباب الأمر لبني أمية عملوا جاهدين على تكريس القرشية كمبدأ من مبادئ الحكم الإسلامي و تحويله من الشورى إلى الأسريّة ، فقد كان الصراع الهاشمي الأموي قديما يمتد إلى العصر الجاهلي حيث تنافسوا حول المناصب الكبرى في مكّة خاصة سدانة الكعبة ، لكن ظهور النبي هاشميا كان قاسمة الظهر بالنسبة للأمويين و ربما كان سببا في تأخر إسلام كبرائهم ، حتى إذا اعتنقوا الإسلام حاولوا أن يكون لهم من المكانة ما يساوون به بني هاشم ، و بمجرد إدراج عمر لعثمان ضمن أصحاب الشورى الستة ظهرت بارقة أمل لتحقيق هذا الحلم ؛ ومع تولي ذي النورين رضي الله عنه خلافة المسلمين اقتربوا أكثر فأكثر من تحقيق حلمهم ، ولعل امتناعهم عن مبايعة علي كرّم الله وجهة مجرّد تمسك بالسبق الذي حقّقوه على حساب الهاشميين ؛ و رغم تفرّق المسلمين بين مؤيّد و معارض لحكمهم إلا أنهم استطاعوا في الأخير توطيد حكمهم بالقوة و الترهيب من جهة ، و بالسلاح الديني من جهة أخرى إذ كانوا أول من أظهر و أذاع عقيد الجبر بين المسلمين ؛ و لم يتوقّف الحال عند هذا الحدّ بل لقد أسهم التمييز الممهنج في التعامل مع القبائل العربية الأخرى وأقصد هنا بين القبائل اليمنيّة و المضريّة ، حيث أقام معاوية عرشه و ثبّت مُلكه على سيوف اليمنيّين و قرّبهم بل و تزوّج منهم وهذا ما أثار القيسيّين و دفعهم للانضمام لعبد الله ابن الزبير و ساهم أكثر في إثارة النعرات و العصبيات القبلية الدّفينة و تأجيجها ، إلى جانب الثورات المستمرة على الحكام خاصة من طرف الشيعة و الخوارج ، إضافة إلى الاضطهاد و التهميش الذي عاشه كل من الموالي و آل بيت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم الكرام ، إضافة إلى التعصب للعرق العربي و النظر إلى ما سواه -و خاصة للموالي- نظرة سيّد و مَسُود و اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية -بتعبير العصر- لدرجة أنهم مُنعوا من الزواج من العربيات و الإمامة في الصلاة و القضاء حتى أصبح الحق و الباطل يختلفان باختلاف جنس من صدر عنه الفعل ، بل وصل الحدّ بالأمويين لأخذ الجزية عن الداخلين الجدد للإسلام ،و استأثروا بمناصب الدولة و احتكروها للعرب دون غيرهم ، ناهيك عن الصراع الداخلي الدائر حول تولي مقاليد الحكم بين أفراد الأسرة الملكية ، في التعجيل بإسقاط الدولة الأموية و ظهور كيان سياسي جديد بنى أركانه على أنقاض سابقه .
و كردّة فعل رافضة لهذا الوضع التّهميشي الإقصائي ظهر الحكم العباسي بدعم قوي من الموالي طمعا منهم في استرداد حقهم في المساواة و ربما حتى طمعا في السلطة و استرداد الهيبة الهاشمية الضائعة منذ مقتل عليّ كرّم الله وجهه، و بذلك أخذ نفوذهم السياسي يزداد يوما بعد يوم مقابل تراجع النفوذ العربي إذ أصبح معظم الوزراء و قوّاد الجيش و الولاة من الفرس .
و ظل شأنهم بين صعود و نزول إلى أيام حكم الخليفة المعتصم الذي رفع الأتراك مكان الفرس و العرب جميعا ، و بهذا بدأت العصبية للجنس العربي تزول بالتدريج شيئا فشيئا ليولد من هذا الضعف قوة للعنصر الأجنبي الذي أخليت له الساحة للتفرد بالإدارة و الملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتزول هذه العصبية بظهور دول داخل الكيان السياسي للدولة تقوم على عصبيات جديدة عقدية أو فكرية أو جنسية بل و حتى سياسية لتبدأ بذلك بوادر زوال الحكم العباسي تظهر بجلاء بعد فقدان العصبية القومية .
و بعد أن استعرضنا دول العصبية القبيلة في الفعل السياسي الإسلامي من قبل مبعثه صلوات ربي و سلامه عليه إلى سقوط الدولة العبّاسية و تلاشي هذه النزعة الفئوية ، سنأتي الآن على ذكر مواقف فقهاء السياسة الشرعية حول العصبية القرشية كشرط من الشروط الواجب توفّرها في خليفة المسلمين :
و قبل أن نخوض في موقف العلماء من هذا الشرط لابّد من معرفة الإجابة عن السؤال : من هم قريش ؟
ينسبون القرشيّون إلى أبيهم الأول قريش ، و قد اختلف النسّابون في تحديده إلى أربعة أقوال نوردها باختصار :
أ - هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، و يرى ابن هشام أن من كان من ولد
مضر فهو قرشي ، و العكس بالعكس . و هذا رأي الأكثرية كما يذكر البغدادي و قد اختاره الشافعي و أصحابه و كثير من العلماء .
ب - هو فهر بن مالك ، و هو ما اختاره محمد الأمين الشنقيطي و غيره ، حيث يقول : و من كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" .
جـ - هم ولد إلياس بن مضر ، وهذا اختيار التميمية .
د - هو مضر بن نزار وهو قول القيسية .
و يعتبر شرط القرشية موضع خلاف و نزاع كبير بين الفرق الإسلامية و العلماء سواء منهم القدامى أو المحدثون ، و قد أَوْلَوْهُ أهــميّة لم يولوها لغيره من الشروط ، و سنحاول هنا إيراد كل رأي على حده للخروج باستنتاج محدد في الأخير :
أوّلا : المـــــــــــــــــــــــوجبون :
و هذا رأي جمهور أهل السنة و الشيعة ، و جمهور المرجئة ، و بعض المعتزلة ، و قد أوردوا على ذلك عدّة أدلة نذكر منها :
1- قوله صلى الله عليه و سلّم -في حديث كان المستند الأوّل و الأقوى للقائلين بوجوب توفر شرط القرشية في الإمام- : " إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه ، ما
أقاموا الدين " .
2- و قوله : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان " .
3- و قوله أيضا : "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مســـــــلمهم تبع لمسلمهم ، و كافرهم تبع لكافرهم " .
4- استدلال أبي بكر رضي الله عنه بالقرشية على أحقيّة المهاجرين في الخلافة و إذعان الأنصار له في ذلك ، فقد جاء عند أحمد : "... و لقد علمت يا سعد - أبو بكر هو المتكلم - أن رسول الله قال و أنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمر ، فبرُّ الناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم ، فقال له سعد : صدقت ..." .
و قال ابن حزم أثناء حديثه عن هذا الشرط و الأحاديث الواردة فيه أي : " الأئمة من قريش " جاءت مجيء التواتر رواها أنس بن مالك و عبد الله بن عمر و معاوية ، و روى جابر بن عبد الله و جابر
ابن سمرة و عبادة بن الصامت معناها .
بل إن الحافظ بن حجر العسقلاني قد قام بجمع طرق هذا الحديث عن نحو أربعين صحابيا . و هذا ما لا يدع مجالا للطعن في هذه الأحاديث أو تضعيفها .
5- الإجماع :
فقد أجمع الصحابة و التابعون و من جاء بعدهم من فقهاء و متكلمين و محدثين على كون الأئمّة من قريش ، قال النووي : " هذه الأحاديث و أشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا
يجوز عقدها لأحد غيرهم ، و على هذا انعقد الإجماع زمن الصحابة و التابعين فمن بعدهم
بالأحاديث الصحيحة " .
6- من العقل :
ذهب الدهلوي إلى أن السبب الباعث وراء اشتراط النسب القرشي هو أن الله عزّ و جلّ أنزل القرآن و هو معجزة رسوله صلى الله عليه و سلم بلسان قريش ، و أن جُلّ ما تعيّن من مقادير و موازين و حدود كان مما هو سائدا عندهم ، كما أنهم قبل ذلك قومه و حزبه ، بل لا شرف لهم و لا فخر إلا ّ بعلوّ دينه ، قال تعالى : ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﭼ . و بنزول الوحي الكريم جمع الله فيهم حميّـــةً دينيّـــــةً ربطتهم أشد من أي حميّـــــــة ، إلى جانب حمية النسب ، و بذلك كانوا مَظِنّة القيام بالشرائع و التمسك بها دون غيرهم ، أضف إلى كل ذلك أن الخليفة يجب أن يكون جليل النسب عالي الحسب لأن من لا نسب له حقير ذليل في أعين الناس ، كما أنه يجب أن يكون من قوم عرفت منهم الرياسة و الشرف و جمع الرجال و القتال و القوة و المنعة و النصرة ، و هذا كلّه مجتمع في قريش .
و لعل أبا بكر كان مدركًا لكل هذا حين قال في اجتماع السقيفة : " "و لن يُعرف هذا الأمر إلا بقريش " .
و يرى الدهلوي أن الحكمة من وراء ذكره صلى الله عليه و سلم قريشا بالعموم دون تخصيص- كأن يقول بني هاشم مثلا- حتى لا يقع في خواطر الناس أنه أراد تمليك أهل بيته كما هو ديدن الملوك و القياصرة في ذلك الزمان ، فيكون ذلك سببا في افتتان الناس و ارتدادهم عن دين جاء لإعلاء شأن قوم أو قبيلة أو جنس دون آخر ، أو ربما رفعا للضيق و الحرج على الناس إذ من المحتمل ألا يوجد شخص تتوفر فيه جميع شروط الإمامة في القبيلة المحددة ، و وجودِه في غيرها و هذا ما يوقع الحرج و التعسير على الناس .
ثانيا : عدم المشترطيـــــــــــــــــن :
و أول من قال بعدم الاعتداد بالقرشية الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي كرم الله وجهه و ذهبوا إلى أن كل مرشح امتاز بالعدل و اجتناب الجور و الظلم كان إماما .
و ذهبت الضرارية إلى أن الإمامة تصلح في غير قريش ، بل أنه لو اجتمع قرشي و نبطي قدمنا
النبطي لسهولة خلعه إذا جار أو خالف الشرع ، و ذهب الكعبي إلى أن القرشي أولى بها من غيره إلا إذا خشيت الفتنة فأن الإمامة تنتقل إلى غيره .
و قد استدل هؤلاء و من وافقهم من المعتزلة و بعض أهل السنة بأدلة منها :
1- عن أبي ذرّ قال : " إن خليلي أوصاني أن أسمع و أطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف " .
2- و قوله صلوات ربي و سلامه عليه : " لو استعمل عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا و أطيعوا " .
3- و قوله : " اسمعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " .
و هذه النصوص و غيرها تنفي القرشية بلا شكّ ، و ظاهرها يتعارض مع اشتراط كون الإمام من قريش بل إن ظاهرها يتعارض أيضا مع التوجيهات التي وجّه الفريق السابق لهذه الأحاديث .
4- الإطلاق الموجود في النصوص القرآنية ، كقوله تعالى : ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﭼ .
5- الإجماع :
إذ لم ينكر أحد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال : " لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا لم يخالفني فيه شك " ، أي لم يراودني شك في استخلافه مع أنه مولى و ليس بعربي فضلا عن أن يكون من قريش ، و لو كان ذلك ممنوعا شرعا لخلّد لنا التاريخ معارضة الصحابة له في هذه المسألة . و منه
فسكوتهم هذا يعتبر بمثابة إجماع على الجواز .
6- قول الأنصار في السقيفة : " منا أمير ومنكم أمير " فلو كان شرط القرشية واجبا حقا ، و منصوصا عليه صراحة لما استطاعوا مخالفة النص ، و احتمال جهلهم بهذه النصوص ضعيف إن لم نقل ممتنع .
منـــــــــــــــاقشة الأدلّـــــــــــــة :
لو رجعنا و بحثنا في الأصول و المبادئ العامة التي جاء الدين الحنيف لإرسائها و تثبيتها في النفوس و العقول من حرية و عدل و مساواة ... و التي قررتها نصوص القرآن الكريم سنجدها تجعل أساس المفاضلة بين الناس التقوى و العمل الصالح ، قال تعالى : ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ ، و جاء عن الرسول الكريم صلوات ربي و سلامه عليه : " من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه " ، و الأحاديث المروية في تقديم قريش تتعارض مع هذه المبادئ رغم صحة سندها ، و لذلك ربما يكون سبب ورودها مما أملته الظروف السياسية و التاريخية للدولة الجديدة آنذاك ، خاصة و قد كانت دولته صلى الله عليه و سلّم أول دولة عرف العرب فيها وحدة ثقافية فكرية في كيان سياسي واحد ، لكن بمجرّد انتقال الرئيس الرسول عليه الصّلاة و السّلام إلى جوار ربّه لزم ظهور مثل هذه العصبيات للحفاظ على وحدة الأمة و الحيلولة دون التشرذم و الانقسام الذي بدأت أولى بوادره تظهر مع الاختلاف الذي حدث في سقيفة بني ساعدة و الذي لم ينتهي بمبايعة أبي بكر بل استمر و إن في شكل معارضة فردية كما هو الحال مع سعد بن عبادة و علي بن أبي طالب كرّم الله وجــــــهه ، ثمّ ليزداد حدة مع حروب الردّة التي كانت
تجسيدا فعليا لهذا الاتجاه التشرذمي القبلي .
و يذهب ابن خلدون إلى أن اختصاص الخلافة بقريش دون غيرها راجع لأن قريش كانت ذاتَ عصبية و كان لها من الزعامة ما يعترف به و يذعن له كل الناس فكان تفرّدها بالرياسة أدعى لجمع الكلمة ولمّ الشمل ، بل إنها لو جعلت في غيرها لاحتمل افتراق الكلمة ، و مع أنه هنا يريد أن يعمم الأنموذج القرشي في كل عصبية سائدة في أي عصر من العصور ؛ إلا أنه لقائل أن يستفهم : إن الأحكام تدور مع عللها وجودًا و عدمًا و بالتالي فبمجرد انتفاء العصبيات أو زوال اعتبارها يسقط الشرط . أضف إلى ذلك أن الإسلام ما جاء ليُضفي الشرعنة على العصبيات بل جاء ليحاربها ، و من جهة أخرى فالمجتمعات اليوم أصبحت لا تولي لرابط العصبية أي اهتمام بل حلّت محلها روابط اجتماعية ، سياسية ، ثقافية ... و من هنا فلا معنًى و لا اعتبار شرعي لهذا الشرط .
كما أن الأحاديث المؤكدة على اختصاص قريش بالخلافة دون غيرهم قد جاءت في عمومها مقيّدة بشرطين :
1- بقاء قريش : و هذا واضح من قوله : " ما بقي منهم اثنان " ، و هو ما يرى فيه الدكتور المراكبي إشارة إلى أن قريش أسرع الناس فناءً ، أو ربما يقصد بقاء عصبيتها فإذا ذهبت العصبيّـــــــة ذهب الاعتداد بهذا الشرط في تعيين الإمام .
2- إقامة حق الله عليهم في هذا المنصب : و قد أشارت إليه عدة أحاديث مثل : " إذا استرحموا فرحموا و حكموا فعدلوا ، و عاهدوا فوفّوا " و قوله : " ما أقاموا الدين " فإذا انتفا هذان الشرطان جازت في غيرهم ، و يرى ابن حجر من خلال اشتراط رسول الله صلى الله عليه و سلم إقامـــــة الدّيـــن : أنهم - بمفهوم المخالفة- إذا لم يقيموه فلا سمع و لا طاعة لهم ، أو أنه لا يقام عليهم هذا القرشي إمامًا ، حتى و إن كان لا يجوز بقاؤهم من غير إمام .
و هنا لسائل أن يقول : هل يمكن خلوُّ قريش ممن يصلح للإمامة ؟.
لقد ذهب البعض إلى عدم الجواز لأن ذلك يجعل من الأحاديث السالفة الذكر لغوًا . و قال آخرون بجوار ذلك و لهم في ذلك عدة أدلة :
أهمها قوله صلى الله عليه و سلم : " هلكةُ أمتي علي يدي غِلمة من قريش " و في رواية : " يُهلك
الناسَ هذا الحي من قريش " .
فالحديث يؤكد أنّ قريشا كغيرها من النّاس في مسألة الخير و الشرّ ، بل إنّ هلاك الأمة كما يقرر الحديث يكون على يد سُفهاء من قريش . و ما يذهب إليه الدهلوي أنّ هؤلاء الغلمة هم بنو أمية .
أضف إلى كل ذلك أنه يمكن حمل هذه الأحاديث على الإخبار لا على الإلزام و الإجبار و هذا ما يتماشى مع قول عمر في حق سالم مولى أبي حذيفة ، و قبل ذلك اجتماع الأنصار في السقيفة مع أن احتمال علمهم بهذه الأحاديث كبير و هو ما يمكننا أيضا من الجمع بين الأحاديث التي استدل بها الفريقان . و الذي يذهب إليه الدكتور محمد ضياء الدين الريّس و هو ما نرى أنّه مقنع إلى حدٍ كبير من وجهة نظرنا احتمال تخصيص قريش بالمهاجرين دون غيرهم و هذا وارد جدًا ، فقد جاءت عدة أحاديث تؤيد ذلك ، و هو ما يُفهم من قول أبي بكر للمجتمعين يوم السقــــــيفة : " نحن الأمراء و أنتم الوزراء " فالضمير "نحن" يخص المهاجرين وحدهم دون غيرهم من قريش كما أن "أنتم" تشير إلى الأنصار دون غيرهم . و هذا ما يوافقه عليه طه حسين إذ حسب رأيه أن قول أبي بكر: " إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا النادي من قريش " لا يمكن أن يُفهم منه إلاّ المعنى الذي يتّصل بالمهاجرين و بأصحاب الفضل و السبق منهم خاصة .
و ممّا سبق يُمكن القول أن القرشية مجرّد امتداد للعصبية القبلية التي فرضتها ظروف جغرافية و تاريخية و سياسية معيّنة ، ثم وجدت طريقها للفكر السياسي الإسلامي عن طريق :
1- مجموعة من الأحاديث الّتي و إن صحّ سندها فإن متنها يُخالف و بوضوح مبادئ الإسلام العامة الّتي جاء ليرسيها و من أبرزها رفض الاعتزاز و الاعتداد بالنسب و الشرف و العرق و القبيلة و ... و جَعْلُ الإسلامِ أهم أساس للانتماء و الاعتزاز دون غيره من وشائج التراب و الدّم ؛ لدرجة أن هذه الأحاديث تعارض نصوصا قرآنية و أحاديثَ نبويّة صريحةَ الدلالة على التساوي بين البشر ، قال تعالى: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ .
و قال: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ و هي آيات واضحة و صريحة تدعوا إلى الابتعاد عن أي انتمائيّة ضيّقة أو تعصّب مقيت أو اعتداد بالنّسب أو العرق ؛ و جعل الولاء و الانتماء للدّين الإسلامي . ونجد أحاديث مختلفة في هذا المجال منها : قوله صلوات ربّي و سلامه عليه : " من خرج من الطاعة، و فارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية، و من قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، و من خرج على أمتي يضرب برها و فاجرها، و لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني" ، و قال: " ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية "
2- استعداد العقليّة العربيّة لقبول مثل هذه الأفكار ، ذلك أن العصبيّة " قِيمة " معجونة مع الطّينة التي خُلق منها العربي ، و مبثوثة في عقله الجمعي ، فرضتها أبعاد نفعيّة مصلحيّة بالدرجة الأولى ، بالإضافة إلى تأثرات الجغرافيا و الأوضاع السائدة آنذاك و قبل كلّ هذا و ذاك توق العربي للتحرّر من مختلف القيود ؛ وكل ما سبق لأسهم بشكل أو بآخر في تسلّلها إلى الفكر السياسي الإسلامي في صورة معدّلة محسّنة -القرشيّة- أُضفيت عليها الصبغة الدينيّة من خلال مجموعة من الأحاديث و الآثار .
3- محاولة فقهاء السّياسة الشرعية إضفاء الصبغة الدينية على الواقع الذي لم يستطيعوا مواكبة التغيّرات الحاصلة فيه ، و بذلك حصلت قطيعة شبه تامة -إن لم نقل التامة- بين ما ينظّر من جهة ، و ما يجسّد على أرض الواقع من جهة أخرى ، أو بين الواجب و الممكن التطبيق ، و بذلك أصبحت الكتابات في هذا المجال مجرد صورة من صور التعبير عن مكبوتات سياسية تخرج إمّا في صورة مثالية إلى أقصى درجة مثل ما هو الحال مع الفارابي و مدينته الفاضلة ، أو في مشروع سياسي محكوم عليه بالإقامة الجبرية إما في مخيال الكاتب أو بين دفتي كتاباته و لا أمل له في إبصار النور . و هذا كله لا يعني بحال من الأحوال طعنـًا في تلك المجهودات المشكورة التي ضمّت الكثير من الفرادة و التميز و القابلية للتطبيق و التي أنتجتها عقول كبار المفكرين في هذا المجال أمثال : المارودي ، ابن تيمية ، و ابن خلدون... ممن أنجبت الجغرافيا العربية .
قائمة المراجع :
-القرآن الكريم : رواية حفص عن عاصم .
- ويل ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجيب محمود، م1، ج2، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1، 1992.
2-أحمد أمين، يوم الإسلام، دار الأصالة، الجزائر، ط1، 2010 .
3- حسن حنفي، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، ج2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، لبنان، ط1، 1986 .
4- محمد سعيد العشماوي، الخلافة الإسلامية، ج1، سينا للنشر، القاهرة، مصر، ط2، 1992،.
5- أحمد أمين، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط10، 1969.
6-ابن منظور الإفريقي ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، دط ، دت .
7-مجمع اللّغة العربية ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدوليّة ، مصر، ط4 ، 2004 .
8-ابن خلدون ، المقدّمة ، أحمد جاد ، دار قصر البخاري ، الجزائر ، ط1 ، 2012 .
9- محمد عابد الجابري ، العصبيّة و الدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،بيروت لبنان ، ط6 ،1994ص .
10- خالد بن عبد الرحمن الجريسي ، العصبيّة القبليّة من المنظور الإسلامي ، مؤسسة الجريسي ، السعودية ،دط ، دت .
11- سعيد حوى، الإسلام، دار الشهاب، باب الوادي ، الجزائر، ط2، 1988.
12- طه حسين، طه حسين، الفتنة الكبرى، ج1، دار المعارف، مصر، د ط، د ت، ص 10-14.
13- ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق عادل بن سعد، ج2، دار الاعتصام، القاهرة، مصر، ط1، 2008.
14- عبد الله بن ناصر سلطاني السحيباني ،السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد النبوة ، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية ،1979.
15 - الشهرستاني، الملل و النحل، تحقيق أمير علي مهنا،علي حسن فاعور،دار المعرفة، بيروت ، لبنان ، ط2 ، 1993.
16- محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، تحقيق على محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط1، 2001.
17- محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو فضل إبراهيم، ج3، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط2، 1967.
18- عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،الإمامة والسياسة ، تحقيق محمد محمود الرافعي، ج1، مطبعة النيل، شارع محمد علي ، مصر، ط1، 1904.
19- صالح عوض النظام السياسي في الفكر العربي الإسلامي، دار الشروق، القبة، الجزائر، ط1، 2010 .
20- نعمان عبد الرزاق السامرائي، النظام السياسي في الإسلام،مكتبة الملك فهد، الرياض، السعودية، ط2، 2000.
21- علي حسني الخربوطلي ، الإسلام و الخلافة ، دار بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1969 .
22- شايب خليل ، نظام الخلافة عند الشاه ولي الله الدهلوي دراسة تحليلية نقدية ، مذكرة ماجستير ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة الجزائر ، 2014 .
23- السيوطي، جلال الدين السيوطي،تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت ، لبنان، ط1، 2003 .
24- البغدادي، أصول الدين، دار الفنون التركية،إسطنبول،تركيا،ط1 ، 1928 .
25- محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن، إشراف بكر أبو زيد، ج1، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، العربية السعودية، ط1، 1426.
26- ابن حزم، ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق محمد إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط2، 1996.
27- ابن حجر العسقلاني،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز وآخرون، ج7، دار المعرفة، بيروت، لبنان ، دط، دت .
28- النووي، المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ، ج12،دار المصرية للطباعة و النشر،القاهرة،مصر،دط، دت .
30- الدهلوي، حجة الله البالغة، تحقيق السيد سابق، ج1، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1، 2005.
31- إحسان عبد المنعم عبد الهادي سمارة، النظام السياسي في الإسلام، دار يافا العلمية للنشر، عمان، الأردن، ط1، 2000 .
32- جمال الدين السيد جاد المراكبي، الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، مطابع ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط1، 1414هـ .
33- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز وآخرون، ج13، دار المعرفة ، بيروت، لبنان، دط، دت .
34- محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، دار التراث، القاهرة، ط7، د ت .
#شايب_خليل (هاشتاغ)



الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

|
حفظ
 |
بحث |
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
| إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الصراع السياسي على السلطة ... قراءة في العهد الراشدي .
المزيد.....
-
آخر تطورات ما يجري بالضفة الغربية والمسجد الأقصى المبارك
-
اليوم الـ84 من العدوان المستمر واقتحام المسجد الأقصى ودهس مج
...
-
الشرطة الألمانية تعتقل شبانا حاولوا التسلق إلى كاتدرائية كول
...
-
مستعمرون يقتلعون أشجاراً ويجرفون أراضٍ بالخليل وسلفيت
-
مصادر فلسطينية: مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية بالمسجد الأقصى
...
-
مظاهرات حاشدة في مدن عربية وإسلامية دعما لغزة
-
الخارجية الأمريكية تطالب الموظفين بالإبلاغ عن حالات التحيز ض
...
-
أحد الشعانين: مسيحيو غزة يحتفلون في -ثالث أقدم كنيسة في العا
...
-
أنور قرقاش يهاجم -الإخوان المسلمين- ويثير جدلا على منصة -إكس
...
-
عاجل | أبو عبيدة: فلسطين وشعبها لن ينسوا الوقفة المشرفة من ا
...
المزيد.....
-
السلطة والاستغلال السياسى للدين
/ سعيد العليمى
-
نشأة الديانات الابراهيمية -قراءة عقلانية
/ د. لبيب سلطان
-
شهداء الحرف والكلمة في الإسلام
/ المستنير الحازمي
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
المزيد.....
|
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة