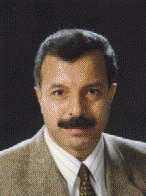في العقد الأخير من القرن العشرين بدأت معظم الاقتصادات العربية مرحلة جديدة تسمى مرحلة الإصلاح الاقتصادي. وقطعت شوطاُ كبيراً في الاتجاه نحو إقامة اقتصادات تستند إلى " اقتصاد السوق ". وقد رافق هذا التحول تضحيات كبيرة وعدم استقرار في الإنتاج والعلاقات الاقتصادية الخارجية. وقد حاولت معظم الدول العربية الاستفادة من نصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تطبيق برامج التثبيت الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، الذي كان هدفه الحد من النتائج السلبية، لذلك ظلت التحديات كبيرة جداً كما توضحها المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها معظم الدول العربية.
يعد موضوع الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق من مواضيع الساعة في الوطن العربي، حيث يوضح لنا هذا الأمر علاقة التنمية الاقتصادية بالتصحيحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتحول إلى اقتصاد السوق، وكيف يؤدي هذا التحول إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الجودة في إنتاج السلع والخدمات، وهل يؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة ؟ وبالتالي خفض العبء الضريبي على المواطن، والتخلص من الآثار السلبية للتضخم؟ وهل يؤدي إلى زيادة الادخار وبالتالي زيادة الاستثمار ؟ وهل تؤدي عملية إشاعة ملكية الأسهم بين صغار المدخرين والمستثمرين إلى تحقيق عدالة أكبر واستغلال اقتصادي أفضل ؟
أولاً - اقتصاد السوق المصطلح والمفهوم:
لم يعد مصطلح السوق يعني المكان الذي تباع فيه السلع وتشترى كما هو الحال في سوق اللحوم، ولا يعني المراحل التي تمر بها السلع بين المنتج والمستهلك أقنية التسويق، بل يعني الطريقة المجردة التي تتم بموجبها عمليات بيع السلع وشرائها وتحديد أسعارها. وباستخدام المصطلح بهذا المعنى فإنه ينطبق على القرارات التي لا حصر لها والتي يتخذها منتجو السلعة الذين يخلقون العرض، ومستهلكو السلعة الذين يخلقون الطلب، والتي تسهم في تحديد مستوى سعر السلعة. ينطبق مصطلح السوق على قرارات الإنتاج والاستهلاك التي تتخذها الأسر والأفراد والتي تسفر مؤثراتها المشتركة عن تعيين سعر السوق للسلعة.
يدل التعريف على أن مصطلح السوق مفصول عن أية تغطية جغرافية معينة. إذ أن المجال الجغرافي للمصطلح يعتمد على السياق الذي يستخدم فيه، فربما ينطبق على الوضع المحلي في جزء ما من الاقتصاد الريفي أو ربما ينطبق على الدولة كلها، أو على المنطقة، أو حتى على الاقتصاد العالمي. وهكذا فإن عبارة السوق العالمية تنطبق على عملية تشكل السعر على الصعيد العالمي للسلع التي خضعت للعمليات التجارية بين دول العالم.
تعمل الأسواق بطرق عدة بحسب عدد المساهمين على كل جانب من جوانب السوق وحجم هذه المساهمة، وبحسب كفاءة انسياب المعلومات بين المشترين والبائعين، وبحسب البنية التحتية الطبيعية كالطرق والسكك الحديدية، التي تنقل بوساطتها السلع، ويستخدم الاقتصاديون مصطلح السوق التنافسي لوصف الحالة التي يوجد فيها بائعون ومشترون كثر، كل منهم صغير بمفرده بحيث لا يؤثر مباشرة على سعر السوق.
أما مصطلح السوق الناقصة أو مصطلح فشل السوق فهو يعني أن بعض مكونات الوضع التنافسي في السوق غائب، فعلى سبيل المثال، يمكن لمشتر أو بائع واحد كبير جداً، أن يؤثر مباشرة على سعر السوق بقرارات بيع أو شراء يتخذها، وهذه حالة تعرف بـ الاحتكار. كما أن المعلومات حول الأسعار واتجاهاتها يمكن أن توزع بشكل غير متساو، الأمر الذي يصب في صالح بعض المشتركين في السوق دون سواهم. وكذلك يمكن للأسواق أن تتجزأ بسبب سوء وسائل النقل والاتصالات، أو يمكن أن تختفي بسبب ارتفاع تكاليف المعاملات التجارية وفشل تبادل المعلومات وأسباب أخرى. " [1]
ثانياً - آليات السوق وإمكانية تطبيقها في الدول العربية:
تقوم فلسفة السوق كما هو معروف في الاقتصاد السياسي على عدد من الفرضيات أهمها:
1. وجود اقتصاد يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والتخصص وتقسيم العمل، والتبادل النقدي السلعي على نطاق واسع.
2. يتيح هذا الاقتصاد حرية التملك والعمل والإنتاج والتحول والتنقل والتبادل، من خلال مؤسساته القائمة وتنظيماته والتشريعات والقوانين النافذة.
3. كما يتيح حرية اتخاذ القرارات بما يهيئه من إمكانية وحرية للاختيار. (2)
4. وحتى تكتمل هذه الفرضيات فإن مفهوم السوق يستند إلى مبدأ كمال السوق، وهذا المبدأ يعني سيادة الحالة الطبيعية للسوق، وهي ظروف المنافسة الكاملة كشرط أساسي لعمل آلياته بكفاءة.
(هذه الفرضيات النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية. والتي تأسيساً عليها قدمت بناءها حول عمل آليات السوق والذي يتمثل في مجموعة من القوانين المفسرة لسلوك المنتج الفرد والمستهلك الفرد، وفي تفاعل قوى العرض والطلب من أجل بلوغ الأسعار التوازنية على مستوى السلعة والسوق. كما قدمت تصوراً للرفاهية الاجتماعية مبنياً على هذه القوانين الجزئية. كما قدمت مفهوماً معمماً للكفاءة في توظيف واستخدام الموارد وعوامل الإنتاج وفي توزيع عائد العملية الإنتاجية). (3)
ووجدت النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية أن في سعي المنتجين لتحقيق أعلى ربح ممكن، وسعي المستهلكين لتحقيق أقصى إشباع ممكن في حدود الإمكانات المتاحة، يمكن تحقيق أفضل استخدام للموارد وأفضل توزيع لعائد العملية الإنتاجية بين من اشترك بهذه العملية. وهذا ما يسمى بعمل اليد الخفية في اقتصاد السوق. فهل هذا صحيح ؟
إن تقييم النموذج التاريخي للنمو الرأسمالي، وفقاً لآليات السوق يبرز لنا ظاهرتين أساسيتين هما : (4) الأولى – إهدار الموارد المتاحة. الثانية – تدمير البيئة نتيجة الاستخدام الجائر. وهذان الأثران نتيجة طبيعية للعمل وفقاً لمعيار السعي لتحقيق أقصى ربح ممكن، وهو المعيار الرئيسي في ظل اقتصاد السوق. بل أكثر من ذلك فإن السعي لتحقيق أعلى ربح ممكن قد لعب ويلعب باستمرار دوراً بارزاً في تشكيل فنون الإنتاج بما يتلاءم مع هذا القانون، وليس بما يتلاءم مع حماية البيئة أو مع احتياجات المجتمعات والتنمية المستدامة فيها.
لو قبلنا بالصحة النظرية لمفهوم السوق النيوكلاسيكي وآليات عمله في دول المركز والدول الرأسمالية المتقدمة (وهي أحياناً أمور تحتاج إلى إقامة الدليل عليها والبرهان)، فإلى أي مدى يمكن قبول وتطبيق نفس المفهوم ونفس الآليات بالنسبة للدول العربية ؟ إن تطبيق وتقبل آليات السوق في الدول العربية يرتبط بعدد من العوامل أهمها:
1 ـ مدى واقعية شروط السوق.
2 ـ الإطار الاجتماعي والاقتصادي لهذا السوق.
3 ـ تقسيم العمل الدولي وتنظيم الأسواق العالمية.
4 ـ أسلوب إدارة الاقتصاد الوطني.
5 ـ البنية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية لكل دولة عربية، وللدول العربية مجتمعة.
والسؤال المطروح هل يمكن تطبيق مفهوم السوق النيوكلاسيكي في كل دولة عربية على حدة ؟ هل يمكن أن يطبق هذا المفهوم على صعيد الوطن العربي بكامله ؟ سؤال مازال يثير الاهتمام. الجدير بالذكر أن كفاءة عمل آليات السوق رهن بطبيعة هذا السوق وخصائصه ودرجة اتساعه ونماء مؤسساته.
إن اقتصاد السوق لا يعني ترك إدارة النشاط الاقتصادي أو غالبيته للقطاع الخاص، وإنما هو نظام متكامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويفترض توفر المعلومات وسرعة وحرية تداولها. كما يفترض أن تكون الأسواق حرة، والوصول إليها متاحاً لجميع الناس. كما أن وجود نظام السوق يجب أن يتيح المنافسة. إلا أن هذا غير موجود في الدول النامية بشكل عام أو في الدول العربية.
ثالثاً - الاختلالات الهيكلية التي تحول دون قيام السوق في البلدان العربية:
عملية التنمية عملية تاريخية ودينامية، تفرض التغيير على كل عناصر المجتمع، وتقييم عملية تقدم التنمية في أي دولة، مهمة معقدة في جميع المجالات، وبخاصة في مجال التنمية الاقتصادية. لكن زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وزيادة الإنتاجية يعد موضوعاً مفيداً موحداً للتقييم. ذلك لأن صناع السياسة الاقتصادية يلقون أهمية كبيرة على نمو الإنتاج والناتج وتأثيره المباشر على رفاهية الجميع.
ما هي العوامل التي تشجع أو تثبط زيادة الإنتاج وتوسعه ؟
وكيف يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة والسليمة ؟
يرى بعض الاقتصاديين أن تحقيق تنمية اقتصادية سليمة ومتواصلة يتطلب عدداً من الشروط منها:
ـ تحرير الأنشطة الاقتصادية والأسعار والتحول إلى اقتصاد السوق.
ـ زيادة فعالية تخصيص الموارد الاقتصادية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
ـ تحقيق الاستقرار الاقتصادي. واستخدام أدوات غير مباشرة في التوجه نحو اقتصاد السوق.
ـ توفير إدارة اقتصادية فعالة للمشروعات، تحقق الكفاءة الاقتصادية. ( يرى البعض أن هذه الإدارة تتحقق عن طريق الخصخصة).
ـ فرض قيود متشددة على الميزانية، الأمر الذي يؤدي إلى توفير شروط الحوافز لتحسين الكفاءة الاقتصادية.
ـ إرساء إطار مؤسسي وقانوني لضمان حقوق الملكية.
ـ سيادة القانون ومنع التجاوزات.
ـ الشفافية وبخاصة في القواعد التنظيمية للتحول إلى اقتصاد السوق.
لا يوجد نمط واحد يميز التجارب التنموية في الاقتصادات العربية. بل هناك تباين واختلافات كبيرة بين البلدان أو مجموعات البلدان العربية. ويمكننا تقسيم البلدان العربية من حيث سرعة واستمرار النمو الاقتصادي في ثلاث مجموعات رئيسة هي:
ـ الدول التي لديها معدل نمو مستمر وعالي.
ـ الدول التي لديها معدل نمو سالب.
ـ الدول التي لديها معدل نمو قليل جداً أو لا تحقق معدل نمو على الإطلاق.
يلاحظ وجود العديد من الاختلالات الهيكلية التي قد تحول دون قيام سوق بالمعنى الاقتصادي المطروح في دولة عربية ما أو على صعيد الوطن العربي وفي مقدمة هذه الاختلالات :
1 ـ عدم كفاية الإنتاج المحلي للوفاء باحتياجات المجتمع، وبخاصة إذا لاحظنا المعدل المرتفع للنمو السكاني في الوطن العربي. إضافة إلى تشويه نمط الاستهلاك تحت تأثير التقليد الأعمى للغرب.
2 ـ الطابع الغالب للسوق في البلدان العربية هو الاحتكار الذي يأخذ مظاهر متعددة أبرزها:
· احتكار القطاع العام لقسم هام من الانتاج والتجارة.
· احتكار بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة لوكالة الواردات الأجنبية وبخاصة في مجال السلع الغذائية.
· تقاسم كل من القطاعين العام والخاص احتكار السلع الوسيطة الأساسية وبخاصة مصادر الطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
· ارتباط حركة التجارة الخارجية للدول العربية بالأسواق الاحتكارية على الصعيد العالمي (الحبوب، النفط، القطن).
3 ـ تعاني مؤسسات السوق نفسها من عدم نضج أو تشوهات، كالضعف النسبي في سوق الأوراق المالية، وعدم استيعاب النظام النقدي لكفاءة عمليات التدفقات النقدية. غموض القوانين الناظمة لعمل السوق وتضاربها أحياناً، وبخاصة قوانين التجارة والضرائب وتنظيم البنوك والأسعار وحتى أحياناً شكل ملكية وسائل الإنتاج. إضافة إلى هيمنة الاقتصاد الموازي والسري على بعض مقومات السوق، وتعاظم وزن الأنشطة الطفيلية على حساب الأنشطة الحقيقية، توظيف الفائض خارج حدود الدول العربية (تهريب رؤوس الأموال).
4 ـ تلازم إجراءات إطلاق آليات السوق مع انتشار مظاهر الفساد التي تنجم عن حدة الاختلالات الاقتصادية والمالية. قصور وضعف مؤسسات السوق بسبب ضعف الرقابة وتراجع دور الدولة في ظل عمل اقتصاد السوق.
5 ـ تتعرض الأسعار في معظم الاقتصادات العربية للتشوهات من خلال الفرق بين الأسعار الفعلية والأسعار الحقيقية التي كان من الممكن أن تسود في ظل ظروف السوق الطبيعية. ومن أمثلة هذه التشوهات اختلاف أسعار المنتجات الصناعية وكذلك مدخلاتها الفعلية عن الأسعار الحقيقية بسبب الحماية، والمبالغة في تقدير أسعار المنتجات الغذائية وبعض المنتجات الصناعية والطاقة في السوق المحلية بأقل من قيمتها نتيجة للدعم واحتكار الدولة للتجارة الداخلية، وكذلك تشوهات أسعار الصرف نتيجة التحديد الإداري (السعر الرسمي). وكذلك تشوهات الأسعار الناتجة عن التحديد المركزي من قبل الدولة لهيكل الأجور والفائدة. ويظل المصدر الرئيسي لتشوهات الأسعار هو تدخل الدولة في تحديد الأسعار سواء من خلال الملكية العامة لوسائل الإنتاج والهيمنة المباشرة عليها، أو من خلال مفاتيح السيطرة والهيمنة ممثلة في احتكار أنشطة كالتسويق والتوزيع، والتوريد الإجباري، وتشغيل العمالة، أو ملكية البنوك، أو من خلال توظيف أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية. (5)
يشير الأستاذ جلال أمين إلى وجود مدرستين فكريتين في مصر لتفسير الاختلالات التي حدثت فيها خلال عقد الثمانينات وطرق معالجتها:
الأولى - تؤمن بالفكر الليبرالي وتأييده للاعتماد على قوى السوق في عملية التصحيح والتنمية.
الثانية - تميل إلى التدخل الحكومي واتباع سياسة تنموية تؤمن بالاعتماد على الذات والتوجهات الداخلية. ويرى أن تفسير المدرستين للاختلالات واقتراحهما للحلول ينبع من موقف أيديولوجي. ولا يوافق على الانضواء تحت لواء أي من المدرستين.
ويؤكد أن السياسة الاقتصادية السليمة لابد من أن يتوفر فيها شرطان رئيسيان:
الأول - (أن تكون منسجمة مع الظروف الداخلية والدولية. فتحرير التجارة الخارجية مثلاً يشكل سياسة سليمة إذا حدث في وقت كان الاقتصاد العالمي فيه مزدهراً وكانت هناك تدفقات كبيرة للاستثمارات الأجنبية. مع استقرار المناخ السياسي الداخلي. من ناحية أخرى قد يكون الالتجاء إلى درجة عالية من الحماية هو السياسة السليمة إذا كان البلد يواجه كساداً في الاقتصاد العالمي وتقلصاً في الاستثمارات الأجنبية واضطراباً في المناخ السياسي الداخلي.
الثاني - أن يكون هناك حد أدنى من التوافق بين العناصر الأساسية للسياسات الاقتصادية. ويقول : إن أسوأ السياسات هي تلك التي تحاول تحقيق أهداف متعارضة في نفس الوقت.) (6)
رابعاً - إعادة الهيكلة والتصحيح الاقتصادي في البلدان العربية:
في سياق إعادة الهيكلة والتصحيح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق، نستطيع أن نميز بين ثلاث مجموعات من الدول العربية: (7)
المجموعة الأولى - وتضم الدول العربية المصدرة للنفط مثل الكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وعلى دول هذه المجموعة أن تواجه الآثار المترتبة على تقلبات أسعار النفط، لذلك فإن التصحيح فيها ضروري في اتجاهين :
أ ـ المحافظة على سياسة تنويع القاعدة الإنتاجية التي بدأ تطبيقها في منتصف السبعينات بما يقلل من اعتمادها الكبير على النفط.
ب ـ القيام بالترتيبات اللازمة لمواجهة الانتقال من وضع كان فيه دخلها من عوائد النفط يبلغ مائتي مليار من الدولارات إلى وضع انخفضت فيه العوائد إلى أقل من ستين مليار دولار.
ونتيجة لذلك تواجه دول هذه المجموعة عجزاً محسوساً في الموازنة الحكومية وفي ميزان المعاملات الجارية. لذلك عليها أن تعمل على تخفيض العجز في الموازنة الحكومية وفي ميزان المعاملات الجارية إلى المستوى الذي يمكن احتماله.
المجموعة الثانية - وتضم الدول العربية متوسطة الدخل مثل الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس. ودول هذه المجموعة ليست متجانسة تماماً. حيث نلاحظ فوارق كبيرة بين بلدانها من حيث حجم السكان أو عوائد النفط أو مستوى دخل الفرد. ويتراوح حجم السكان بين أقل من 4 ملايين نسمة وأكثر من 50 مليون نسمة. كذلك يتراوح متوسط دخل الفرد بين أقل من 800 دولار سنوياً في بعضها وأكثر من 1500 دولار سنوياً في البعض الآخر. إلا أن دول هذه المجموعة تشترك بعدد من الخصائص تبرر اعتبارها مجموعة واحدة. فهي تتمتع بقاعدة إنتاجية متنوعة نسبياً كما أنها تمتلك مؤسسات مالية واقتصادية متطورة إلى حد ما.
تواجه دول هذه المجموعة ظروفاً اقتصادية على درجة كبيرة من الصعوبة. وبخاصة الآثار السلبية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتراجع تحويلات العاملين في دول النفط. وكذلك الصعوبات الناشئة عن الظروف غير المواتية والتي تسود الاقتصاد العالمي، وبخاصة كساد أسواق المواد الأولية وتدهور شروط التبادل التجاري. الأمر الذي أدى إلى تزايد حجم المديونية الخارجية وتزايد عبء خدمتها. كما رافق ذلك عجز في الموازنات الحكومية. فلجأت الحكومات إلى تمويل العجز عن طريق الاقتراض من المصارف، وأدى ذلك إلى تزايد كمية النقد المتداول مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم والمبالغة في أسعار الصرف، بالإضافة إلى ذلك تعاني دول هذه المجموعة من اختلالات هيكلية تتمثل في تشوهات الأسعار وانخفاض إنتاجية العمل ورأس المال وضعف الكفاءة في القطاع العام الذي يسطر على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي.
المجموعة الثالثة - وتضم الدول العربية منخفضة الدخل مثل موريتانيا والصومال والسودان واليمن. وتعتبر مسألة إعادة الهيكلة والتصحيح في دول هذه المجموعة أكثر تعقيداً منها في المجموعتين السابقتين. فهي تعتمد اعتماداً كبيراً على سلعة واحدة أو عدد محدود جداً من السلع ومن ثم فهي أكثر تعرضاً للصدمات الخارجية. وهي تعاني من مديونيات خارجية ثقيلة وحجم من عبء خدمة الديون الخارجية لا يتناسب مع قدراتها الاقتصادية. يضاف إلى ذلك العجز المزمن في الموازنة الحكومية والميزان التجاري وميزان المدفوعات ومعدلات تضخم مرتفعة جداً. كما أن دول هذه المجموعة تعاني من ضعف البنية التحتية والمؤسسات المالية والاقتصادية وانخفاض متوسط دخل الفرد فيها.
لقد ارتفع عدد الدول العربية التي أصبح لديها القناعة بأهمية سياسات التصحيح وإعادة الهيكلة وضرورة الاستمرار فيها. (وفي هذا الصدد انضمت الجزائر إلى الدول العربية التي تطبق برامج تصحيح شاملة، حيث تبنت برنامج تصحيح بمساعدة المؤسسات الدولية والعربية، وعمدت في إطار ذلك ولأول مرة، إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية.) (8)
كما يقوم السودان بتطبيق برنامج تصحيح اقتصادي يهدف لإزالة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني. واستمرت دول أخرى في جهود إعادة الهيكلة والتصحيح في كل من مصر المغرب تونس والأردن، وأعلنت عن قابلية تحويل عملاتها لأغراض معاملات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. كما استمرت دول مجلس التعاون في الخليج العربي في تطبيق السياسات التي انتهجتها منذ عدة سنوات للتكيف مع عوائد تصدير النفط المنخفضة وإمكانية تنويع مصادر دخلها.
يمكننا تحديد أهم عناصر سياسات التكيف وإعادة الهيكلة في الدول العربية وفقاً لما يلي:
ـ إحداث تعديلات في هيكل ملكية وسائل الإنتاج حيث طرحت بعض المؤسسات العامة والشركات الحكومية في بعض الدول العربية للبيع، وبيع بعضها بالفعل في مصر والأردن وتونس والجزائر. كما صدرت قوانين بإحداث الشركات القابضة والشركات التابعة لها وقوانين أخرى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لبعض المؤسسات.
ـ إصدار قوانين تنظم عمل السوق المالية وتداول رأس المال بهدف زيادة فعالية آلية السوق وتعزيز اتجاه تحديث هيكل الملكية. مع إمكانية تداول أسهم وسندات المشروعات الخاصة والمشروعات العامة.
ـ إحداث تعديلات جوهرية في أسلوب إدارة المشروعات العامة وبخاصة ما يتعلق منها بتحديد أسعار المنتجات (تحريرها)، وكذلك تحرير أسعار الصرف وتوحيدها، اعتماد مبدأ التمويل الذاتي، إنشاء صناديق وبنوك الاستثمار الوطنية وتفعيل نشاطها، إعادة تنظيم مجالس الإدارة ومنح الإدارة مرونة وبخاصة في موضوع تحويل الملكية والدمج والتصفية.
ـ (تحجيم وظيفة الموازنة العامة كأداة للتوازن الاجتماعي، من خلال برنامج انكماشي للإنفاق الاجتماعي وتقليص الدعم، لإطلاق العوامل الاقتصادية وحدها في بلوغ التوازن من ناحية ولمكافحة التضخم من ناحية أخرى).(9)
ـ رفع القيود الجمركية عن الواردات والسماح باستيراد السلع المحظورة كلياً أو جزئياً. وذلك بإتاحة عمل الآليات بشكل مطلق وإلغاء الحماية تدريجياً. بالرغم من معارضة بعض المنتجين وبخاصة في القطاع الخاص لمثل هذه الإجراءات لأنها تؤثر على صناعاتهم الوليدة علماً بأن الحماية تدفع المنافسة خارجاً. لذا لابد من إشاعة المنافسة بشكل عام.
أوردنا بعض عناصر سياسات التكيف وإعادة الهيكلة في الوطن العربي على سبيل المثال لا الحصر، وهي تسعى لضمان سلاسة واتساق عمل آلية السوق في الدول العربية، وقد أخذت هذه التعديلات شكل الحزمة دفعة واحدة مع الاهتمام بالجوانب النقدية والمالية في السوق بصفة أساسية. ولكن هل هذه العناصر والإجراءات وحدها كفيلة بتفعيل آلية السوق في البلدان العربية ؟.
خامساً – أهداف برامج التصحيحات الهيكلية في البلدان العربيــة:
تهدف برامج التصحيحات الهيكلية على المدى القصير إلى إعادة التوازن لميزان المدفوعات وذلك من خلال الضغط على الطلب الداخلي، وتتخذ عادة بعض الحكومات إجراءات عاجلة خاصة تتمثل في تخفيض قيمة العملة المحلية، وخفض الإنفاق العام عن طريق تجميد الأجور والحد من الواردات والاستثمارات.
وتتحدد الأهداف على المدى الطويل لتطوير العرض الداخلي للسلع والخدمات، وتحسين مستوى أداء جهاز الإنتاج، والحد من هدر الموارد المتاحة، ودعم القدرة التنافسية للإنتاج، ولتحقيق هذه الأهداف لابد من أن يشمل الإصلاح : النظام المالي والنقدي، التجارة الخارجية سياسة الأسعار والأجور، النظام الضريبي، سياسات الاستثمار وغير ذلك. ولابد من مراجعة طرق تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
يوضح لنا التطور التاريخي لسياسات التكيف والتصحيح الهيكلي والتحول إلى اقتصاد السوق، في معظم الدول العربية أنها قد مرت بمرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى - يتم خلالها تهيئة أرضية التحول لآليات السوق بتحييد القيود الإدارية في السياسات المالية والنقدية. وقد اهتمت سياسات التصحيح الهيكلي في هذه المرحلة بإلغاء الدعم تعويم أسعار صرف العملات الوطنية تجاه العملات الأجنبية، تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة، مع الإبقاء على الهيكل الجامد للأجور. وتمتد هذه المرحلة من منتصف السبعينات في بعض الدول العربية وحتى بداية التسعينات.
المرحلة الثانية - تم في هذه المرحلة السعي وبمعدلات عالية (أقرب إلى نظام الصدمة) إلى إحداث تغييرات جوهرية في هيكل ملكية وسائل الإنتاج وأسلوب إدارة الاقتصاد الوطني، (التخصيص) والعمل على توفير شروط آلية السوق، وفق الإطار النيوكلاسيكي. وتمتد هذه المرحلة منذ بدء التسعينات وهي مستمرة إلى يومنا هذا. ويرى بعض الاقتصاديين أنها لازالت في بدايتها رغم تسارعها.
أما من ناحية معالجة الاختلالات الهيكلية فإن أغلب البلدان العربية تطبق سياسات سعرية تتسم بالجمود ولا تعكس التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات مما يؤدي إلى حدوث تشوهات في الأسعار وانحراف الأسعار الحقيقية عن الأسعار الفعلية. ففي حالات كثيرة نجد أن مستوى الأسعار الداخلية يختلف كثيراً عن مستواها في السوق العالمية. ويمكن أن نضرب مثالاً بأسعار القمح في سورية حيث تقوم الدولة بشراء القمح من الفلاحين بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، في حين يتم بيعه للأفران لصناعة الخبز بأسعار أقل من التكلفة بكثير بسبب دعم سعر الخبز فيها.(10) [2] ومثال آخر أسعار الطاقة في مصر ظلت إلى نهاية الثمانينات تمثل 20% من أسعارها العالمية. هذا وتوجد أنواع أخرى من التشوهات في الأسعار. ففي بعض الحالات نجد أن للسلعة الواحدة أسعاراً متعددة بحسب المجموعات المختلفة من المستهلكين. ولاشك أن هذه التشوهات تنطوي على قدر كبير من الهدر والضياع الاقتصادي. ويلاحظ أن تشوهات الأسعار بأنواعها ليست مقصورة على مصر وسورية بل نجدها في بلاد عربية أخرى مثل تونس والجزائر وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الاقتصاديين يرى أن تخفيض سعر الصرف عديم الفاعلية في سياسات التصحيح وإعادة الهيكلة وعالي التكلفة أيضاً. وانتقد هذا الفريق الدور الذي تقوم به أسعار الفائدة في أغلب البرامج التصحيحية وإعادة الهيكلة ورأيهم أن الاقتصادات في الدول النامية لا تستجيب للتغيرات التي تحدث في أسعار الفائدة. كما أن هناك بعض الاعتبارات الحضارية والدينية تقيد من استخدام أسعار الفائدة في عملية التصحيح وإعادة الهيكلة.
تتمحور الأهداف الرئيسية لعمليات التصحيحات الهيكلية وعناصرها حول النقاط التالية:
ـ إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص وانسحاب الدولة تدريجياً من بعض النشاطات الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.
ـ التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشآت الاقتصادية الخاسرة، وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية.
ـ تطوير السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركية على رأس مال الشركات بقصد تطويرها وتنمية قدرتها الإنتاجية.
ـ خلق مناخ الاستثمار المناسب، تشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية.
(ومن بين الأهداف الهامة للتصحيح الهيكلي تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المحدودة، وبخاصة النقد الأجنبي ومصادر الطاقة ورأس المال. وترتبط مسألة الكفاءة بالتسعير الملائم لعناصر الإنتاج ولكنها أشمل من ذلك.(فعلى سبيل المثال إن الكفاءة في استخدام الاستثمارات العامة والجهود الحكومية لتشجيع تنمية الموارد البشرية والتغيرات التكنولوجية يمكن أن تشكل عناصر هامة في تحسين استجابة الاقتصاد لعملية النمو، وذلك بصرف النظر عن وجود تشوهات حادة في الأسعار ). (11)
وهكذا فإن سياسات التصحيح الهيكلي تتعلق بالعوامل التي تؤثر في القرارات الخاصة بالإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك. مع العلم أن بعض الاقتصاديين يرى أن سياسات التثبيت وسياسات التصحيح الهيكلي تتداخل وتكمل كل منها الأخرى.
سادساً ـ وصفة صندوق النقد الدولي في برامج إعادة الهيكلة والبرنامج البديل:
لقد أصبح التدويل الاقتصادي (عولمة الاقتصاد) واقعاً ملموساً، وإن مؤسسات التمويل الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هي التي أطلقت الدعوة لما سمته بالسياسات التصحيحية والتحول إلى اقتصاد السوق، وتعظيم دور القطاع الخاص وتحجيم القطاع العام ودور الدولة في النشاط الاقتصادي. مع (التركيز على الجانب المالي ـ النقدي باعتباره جوهر المشكلة، وهو في الواقع، كما نرى أحد مظاهر الأزمة المركبة للتنمية في البلدان النامية). (12)
ومن هنا يتبين بأن هذا التوجه المندفع نحو الخصخصة من الخارج لا يعبر بالضرورة عن حاجة موضوعية، أي أنه لم يكن كنتيجة لتقييم جاد لأداء القطاع العام وبيان قصوره، مما يستدعي نقل ملكيته للقطاع الخاص، بافتراض أنه الأقدر على تحقيق التنمية. فالموضوع بحاجة إلى دراسة معمقة لمعرفة مدى الحاجة للخصخصة في الواقع القطري، (13) في مختلف البلدان العربية.
الاختلالات التي يلحظها صندوق النقد الدولي في اقتصاديات الدول العربية هي حصيلة تراكمات لسياسات اقتصادية واجتماعية خاطئة أصلاً. ويكمن خطأ تلك السياسات في أنها قيدت المبادرات الخاصة وضيقت المجالات المفتوحة أمام القطاع الخاص، وحالت بين الاستثمار الأجنبي والاقتصاد الوطني، وأطلقت العنان للقطاع العام فدخل مجالات لا تتفق مع طبيعته، وعزلت الاقتصاد الوطني عن الاقتصاد الرأسمالي العالمي من خلال التدخل في تحديد مستويات الأسعار والأجور، وإقامة أسوار حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية، ونشرت مظلة الحماية الاجتماعية فوق قطاع عريض من الشعب بالدعم والتأمينات الاجتماعية والمشاركة بالأرباح مما أفقده الحافزية للعمل والإنتاج. (14)
لذلك جاء العلاج الذي يقترحه الصندوق من خلال برامج التصحيح وإعادة الهيكلة التي قدمها وتستهدف تحرير الاقتصاد، أي جعله يسير على مذهب الاقتصاد الرأسمالي الحر (اقتصاد السوق) مع إدماجه دمجاً عضوياً في النظام الرأسمالي العالمي. وأضحت المهمة المطلوبة هي تعديل مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني وخفضه بما يتناسب مع مستوى العرض الكلي. والهدف الأكثر مباشرة لبرامج التصحيح التي يقترحها الصندوق هو تحسين وضع ميزان المدفوعات. والعلاج هو الوصفة (الروشيتة) التي وضعها الصندوق والتي تتضمن تحرير الاقتصاد، تخفيض سعر الصرف، تخفيض الإنفاق العام، بيع القطاع العام للقطاع الخاص، إلغاء الدعم.
التوصيات:
ـ ضرورة استقرار الاقتصاد الكلي المتواصل في البلدان العربية أي التحكم في معدلات التضخم ومنع تزايدها.
ـ عدم تأجيل الإصلاحات الاقتصادية لأن تأجيلها يمكن بالفعل أن يؤجل المعاناة، ولكنه يؤجل الانتعاش المتواصل والتقدم أيضاً، ويزيد من مخاطر انتكاس النمو.
ـ لا يوجد طريق ملكي للإصلاح يمكن تطبيقه في كل الاقتصادات ولا يستطيع أي مكون من مكونات الإصلاح بمفرده أن يحدد الطريق . لكل مكونات برنامج الإصلاح تأثير وعلاقة إيجابية بالنمو ولكن ليس لأي منها تأثير طاغ يحدد الطريق . ومن الضروري تنفيذ كل مكونات الإصلاح، لان النمو يأتي نتيجة جهود كبيرة جداً يبذلها عدد كبير من الناس يقومون بالأعمال الصحيحة على مدى زمني طويل.
ـ ضرورة التطوير المؤسسي لإنشاء إطار قانوني يلعب دوراً مهماً في عملية الإصلاح، وهذا يعني سيادة القانون، الانضباط، ضمان حقوق الملكية، والتي بدونها لن تسفر الإصلاحات الأخرى عن فوائد كبيرة. [3]
ـ ضرورة توفر الإرادة السياسية في تنفيذ برنامج الإصلاح لأنها العامل الحاسم في تنفيذه.
بالإضافة إلى ذلك هناك قضايا اقتصادية ملحة في الوطن العربي أهمها:
1 ـ تسريع وتائر التنمية الشاملة وتوسيع دائرة انتشارها.
2 ـ معالجة موضوع عدم المساواة في توزيع الدخل.
3 ـ توفير المناخ المناسب لتدفقات رؤوس الأموال.
4 ـ الحد من التضخم.
5 ـ الإصلاح الإداري والتنظيم وسياسات الأجور.
6 ـ إصلاح القطاع المصرفي، والسياسات المالية والنقدية.
7 ـ إصلاح المشروعات العامة وتطويرها.
8 ـ تطوير الميزانية وقيودها وإجراء الإصلاح الضريبي.
9 ـ الاهتمام بموضوع الاقتصاد الموازي والاقتصاد السري.
10 ـ دور الحكومة المتغير.
11 ـ الاهتمام بالتنمية البشرية.
12 ـ تحديات العقد القادم من الألفية الثالثة.
- الخاتمة:
إن مفهوم التكيف والتصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق، يضع مسألة التحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة أحد محاور (الإصلاح الاقتصادي) وإطلاق آلية السوق. وأكثر من ذلك ترى أن بعض الاقتصاديين ينادي بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتحجيمه في الدور التقليدي للدولة فقط، ولكن الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة وبخاصة القابلة للنضوب والحيلولة دون تبديدها، وحماية البيئة من التلوث والتدمير، والمواءمة بين المصالح الاقتصادية والمصالح الاجتماعية، والموائمة بين المصالح الوطنية والمصالح الأجنبية يتطلب عدم تحجيم دور الدولة لذلك فإن دور الدولة سوف يتحول ولا ينتفي. بل ربما يزيد هذا الدور عن ما كان عليه سابقاً.
إن تحقيق الاستقرار في السياسات المختلفة، والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والسياسات التجارية والاستثمارية. تكاد تكون من معطيات السوق ذاته. وهذا لا يستطيع أحد أن يقوم به سوى الدولة. مما يعطيها مبرراً لتنامي دورها في النشاط الاقتصادي حتى في ظل اقتصاد السوق.
التعددية الاقتصادية هي المناخ المناسب والوعاء المؤسسي الأمثل للتنمية الشاملة في الوطن العربي، ليسهم كل قطاع بدوره في عملية التنمية في إطار تقسيم للعمل يحدد دور كل قطاع بوضوح، ويوفر المناخ الضروري للتنافس الإيجابي فيما بين مؤسساتها، ويحقق التكامل والانسجام فيما بين مصالح كل منها مع الصالح العام، إنني لا أرفض فكرة الخصخصة، وإنما أرفض فكرة تحجيم القطاع العام ودور الدولة الإنمائي في الدول العربية وبخاصة في هذه المرحلة من تطورها، ومع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كشريك للقطاع العام وليس على حساب تحجيمه أو تصفيته، لأن التنمية الشاملة وأهدافها الطموحة تحتاج إلى تضافر جهود جميع قطاعات الملكية (العام، الخاص، المشترك والتعاوني). (15)
وتبدأ عملية معالجة الاختلالات الكلية في الاقتصادات العربية بتصحيح الاختلالات الحاصلة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة، وإزالة العجز في الموازنة الحكومية، ففي أغلب البلدان العربية نجد أن أسعار الصرف تنطوي على نسبة كبيرة من المغالاة، كما أنها لا تتغير تبعاً للتغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني. وتعتبر المغالاة في أسعار الصرف المسؤول إلى حد كبير عن ضياع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. وهي في نفس الوقت تشجع على الاستيراد وتعرقل القدرة على التصدير. كما أن أسعار الفائدة في الدول العربية تتحدد عند مستويات منخفضة ولا تعكس الندرة النسبية لرأس المال ولا معدلات التضخم. ومن ثم فإن أسعار الفائدة الاسمية تنطوي في الواقع على أسعار فائدة حقيقية سلبية، الأمر الذي يؤدي إلى الإسراف في الاستثمارات ذات الكثافة الرأسمالية العالية كما يضعف الحافز على الادخار. ولاشك أن اجتماع أسعار الفائدة الحقيقية السالبة مع المغالاة في أسعار الصرف هما المسؤول الحقيقي عن هروب رؤوس الأموال للخارج مما يزيد من الاختلال في ميزان المدفوعات ويحرم البلدان المعنية من هذه الموارد النادرة. كما أن العجز في الموازنات الحكومية في البلدان العربية مسؤول عن الضغوط التضخمية المزمنة مما يشوه آلية الأسعار ويضعف القدرة التنافسية ويفرض عبأً ثقيلاً على أصحاب الدخول المنخفضة.
أدركت الاقتصادات العربية أهمية الانفتاح على الخارج، والاندماج مع الاقتصاد العالمي، من خلال السياسات التجارية المتبعة في معظم الدول العربية، وسعى عدد متزايد منها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي انبثقت عن اتفاقيات الغات بعد انتهاء جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في عام 1994. (16) وتشهد الاقتصادات العربية جهودا مكثفة لتحرير التجارة الخارجية ونظم الصرف، وجعل الأنظمة المتعلقة بها أكثر شفافية. واستطاعت بعض الدول العربية من خلال برامج التصحيح التي تطبقها أن تخطو خطوات كبيرة على هذا الطريق، حيث تم إلغاء الكثير من القيود على التجارة الخارجية، كما تم إدخال التوازن في المعاملة بين القطاعين الخاص والعام، وتحرير سعر الصرف وصولاً به، في بعض الدول، إلى تحقيق قابلية عملاتها للتحويل. (17 )
ويحتل إصلاح القطاع العام مكانة هامة في برنامج إعادة الهيكلة والتصحيح والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية. لأن الحاجة ماسة لتحسين مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية في مؤسسات القطاع العام وإعادة النظر في أولويات النفقات والاستثمارات الحكومية. ولابد من خلق مناخ مناسب للاستثمار العام والخاص المحلي والأجنبي.
من السهل لأي بلد يقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أن يجد نفسه في حلقة مفزعة بعد القيام بالخطوات الأولى للإصلاح الاقتصادي والتي تخلق فرصاً للبحث عن الربح بالطرق غير المشروعة وللفساد أيضاً. وبسرعة فائقة يرسخ أصحاب المصالح المكتسبة الذين استفادوا من هذه الفرص أنفسهم ويقاومون اتخاذ المزيد من خطوات الإصلاح، وبخاصة الدخول الحر للسوق، تعزيز المنافسة، العمل من اجل التحرير الكامل، إرساء سيادة القانون، فيظهر الاقتصاد السري الذي يقود إلى تقدم اقتصادي بطيء وانتكاس النمو وانهيار الاستقرار المالي.
الاستثمار وحدة لا يضمن النمو والانتعاش السريع لأي دولة، ولا يمكن إحداث النمو الاقتصادي السريع قسراً بزيادة الاستثمارات . فالاستثمارات اليوم تستغرق وقتاً حتى تنتج، ومن الطبيعي أن يتبع الزيادة في الاستثمارات زيادة في النمو ولكن بعد سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل. ويمكن للنمو المبكر والسريع أن يحدث نتيجة مكاسب الكفاءة الناتجة من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المناسبة، التي تولد حوافز لدى أصحاب المشروعات لكي يزيدوا من إنتاجيتهم. طبعاً هذا لا يعني أن الاستثمار ليس مهماً، بل إن الاستثمار الجديد ضروري جداً في بعض القطاعات أو على مستوى الشركات، وبدون ذلك لا يتحقق النمو، وعندما يحدث الانتعاش يصبح من المهم توفير مستوى أعلى من الاستثمار حتى يتواصل النمو، فالاستثمار وحده لن يوفر النمو المتواصل ولكنه ضروري لتحقيق ذلك.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
[1] - فرانك إيليس، السياسات الزراعية في البلدان النامية، ترجمة الدكتور إبراهيم الأطرش، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1997، ص 8 و9.
(2) - انظر كتاب سامويلسون. أ.، أسس التحليل الاقتصادي 1947 وكتاب كوانت ر.يMicroeconomic Theory (1985).
(3) - د. سعد حافظ، سياسات التكيف وآليات السوق، مصدر سابق ص6.
(4) - د. سعد حافظ، المصدر السابق ص17-18.
(5) - المصدر ص7.
(6) - ندوة التصحيح والتنمية في البلدان العربية، مصدر سابق، ص33.
(7) - ندوة التصحيح والتنمية في البلدان العربية، تحرير سعيد النجار، صندوق النقد العربي، أبو ظبي1987، ص 20-22.
(8) التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1995، المصدر السابق.
10 - أتبعت سورية هذه السياسة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح ونجحت هذه السياسة وتحولت سورية من دولة مستوردة للقمح إلى دولة مصدرة.
(11) برفيز حسن، المصدر السابق ص71.
(12) د. مجيد مسعود، الخصخصة من منظور تنموي في الواقع القطري، بحث مقدم إلى ندوة توجهات وآفاق الخصخصة في دولة قطر، 6 - 7 نيسان 1996، ص4.
(13) مجلة النهج، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي العدد 44 صيف / خريف 1996، دمشق ص 274.
(14) انظر، د. إبراهيم العيسوي، المسار الاقتصادي المصري وسياسات تصحيحه، بحث مقدم إلى ندوة (السياسات التصحيحة والتنمية في الوطن العربي)، المعهد العربي للتخطيط الكويت من 20 - 22 شباط 1982، ص226.
[3] - مجلة التمويل والتنمية، العدد الصادر في حزيران 1999 ص 15 .
(15) من المفيد هنا الاستفادة من تجربة سورية في موضوع التعددية الاقتصادية في سورية التي تسير بخطوات متوازنة منذ عام 1970 وبخاصة بعد عام 1985 وصدور قوانين تشجيع الاستثمار فيها.
(16) اقتصرت عضوية الدول العربية في الغات على خمس دول هي : تونس والكويت ومصر والمغرب وموريتانية وانضمت كل من الإمارات والبحرين وقطر إلى عضوية المنظمة العالمية للتجارة وتتفاوض حالياً كل من الأردن والجزائر والسعودية والسودان للانضمام إلى المنظمة.
(17) التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ص71.
المراجع:
1 - فرانك إيليس، السياسات الزراعية في البلدان النامية، ترجمة الدكتور إبراهيم الأطرش، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1997.
2 - سامويلسون أ.، أسس التحليل الاقتصادي 1947 وكتاب كوانت ر.يMicroeconomic Theory (1985).
3 - د. سعد حافظ، سياسات التكيف وآليات السوق، دراسة حالة الاقتصاد المصري، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي القاهرة، العدد الأول، المجلد الثاني حزيران 1994.
4 - ندوة التصحيح والتنمية في البلدان العربية، تحرير سعيد النجار، صندوق النقد العربي، أبو ظبي1987.
5 - التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1995.
6 - د. مجيد مسعود، الخصخصة من منظور تنموي في الواقع القطري، بحث مقدم إلى ندوة توجهات وآفاق الخصخصة في دولة قطر، 6 - 7 نيسان 1996.
7 - مجلة النهج، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي العدد 44 صيف/ خريف1996، دمشق.
8 - د. إبراهيم العيسوي، المسار الاقتصادي المصري وسياسات تصحيحه، بحث مقدم إلى ندوة (السياسات التصحيحية والتنمية في الوطن العربي)، المعهد العربي للتخطيط الكويت من 20 - 22 شباط 1982.
9 - FRANK ELLIS, Agricultural Policies in Developing Countries, CAMBRDGE UNIVERSITY PRESS,New York Port Chester Melbourne Sydney.
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة