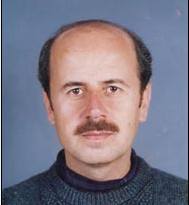بعد استيقاظ بلا يقظة انقشع مزاجي السيئ وأنا أقرأ مقالات في صحيفة “النهار” لمثقفين سوريين ولبنانيين حول العلاقة بين بلدينا. فدفعني حنين الذكريات إلى لبنان, حيث امتزج شقاء اللحظات المعاشة بأحلام طفولية حامت في فضاء روحي, مازلت أكنُّ إليها, واستبشر صلاح الحال بيننا. وسأترك الحوار يتفاعل بين مثقفينا لأكتب أشياء أخرى, غير قريبة ولا بعيدة, ولكنها جاثمة على امتداد السنين.
قصتي مع لبنان واللبنانيين بدأت قبل أن يظهر برنامج "سوا ربينا" وإذاعة "سوا" على السواء!. كنت عندها في سني المراهقة, مما أدى إلى تثبت العديد من المنعكسات الشرطية المتعلقة بجوانب حياتية مختلفة. وكانت بالنسبة لي نقلة هائلة من الريف السوري الشديد التخلف تنمويا في النصف الأول من السبعينات, إلى بعض الريف اللبناني الذي بدا كحلم, لولا واقع الشقاء الذي دفع بي للعمل هناك, مثل الكثيرين من أبناء الريف السوري, بغية اكتساب القليل من الليرات اللبنانية في أوج عزها, للاستعانة بها في متابعة الدراسة, أو شراء بذلة جديدة مضمخة بالعطور والحبق, أو تأمين لقمة العيش إلى حين.
ففي بلدة “عجلتون” من قضاء كسروان كنت أحط رحالي...أنام في الأقبية الرطبة مستأنسا ببعوضها طوال الليل, لأستفيق على نداء العمل الذي لم يكن يتناسب مع قدراتي الجسدية المحدودة. وطوال الوقت كان الحلم الجميل يهدهدني. فما أن ينتهي وقت العمل حتى أقتعد الرصيف, قريبا من سوبر ماركت أسعد الأسعد, أرقب مرور السيارات الفارهة وأتعرف على ماركاتها بفضول صبياني لا يقاوم.
لم يكن يشعر أحد بوجودي سوى للحظات عابرة, ترمقني فيها أعين المارة, ثم تتابع هيامها في الضوء. وكنت حرا, أتفحص وجوه العابرين وحركاتهم, وأخمن ما يفتكرونه, وأستمع إلى أبواق سياراتهم في زحمة المساء, ودعاباتهم التي لا تخلو من الشتائم المستهلكة بين الفينة والأخرى.
والوحيد الذي يهتم لوجودي هو العم أسعد الأسعد...فيحادثني حين يغيب الزبائن, ويبدي استغرابه عندما أشتري صحيفة “النهار” وأتصفحها, فيحاول أن يمتحنني ليتأكد من معرفتي القراءة!. ويباغتني أحيانا بشتيمة لم أعد أعرها انتباها, بعد أن عرفت أنها من التقاليد اللبنانية الأصيلة, كالمازا والتبولة!.
كثيرة هي الطرف والأحداث التي انطبعت في مخيلتي الغضة. فعندما حاولت التنويع في مصادر الأخبار وشراء صحيفة “الشرق”, رد السيد أسعد قائلا: "أننا نتعامل مع الغرب وليس مع الشرق يا...!". فالحرب الباردة كانت هنا أيضا, كما في كل مكان, وكان السيد أسعد مستقطبا فيها, ولم يخفِ ذلك الإنسانَ في قلبه.
وفي الأيام التي لا أجد فيها من يطلب خدماتي في أي عمل, كنت أنتشي بسرور غامض يصعب تفسيره, ربما هو التفرغ للحلم بعيدا عن كآبة الواقع. فكنت أهرع إلى خيمة بلاستيكية تشبه القبعة على سطح أحد البيوت المقابلة لكازينو “عجلتون”, أستمع فيها لأغنية جوزيف صقر "أنا اللي عليك مشتاق" التي تصدح بها مكبرات الصوت في الكازينو مرة تلو المرة. كانت أغنية جديدة وقتئذ. ولشدة ما أدهشتني غرابة كلماتها ولحنها, بقيت حتى الآن أرددها في وحدتي, وأغنيها لمن أحب.
وعندما رأيت إعلانا على باب الكازينو يدعو لسهرة تحييها المطربة سميرة توفيق, لم أصدق أن سميرة توفيق نفسها, التي لم تفارق صورتها جدار بيتنا منذ وعيت على الحياة, بغمازة خدها وشامتها الشهيرة وفمها البسام, هي شخصيا ستغني على بعد أمتار مني!. لقد كنت في منتهى السعادة. وتذكرت قصة رواها لي والدي حول أن أحد العمال السوريين في لبنان قبَّل المطربة الكبيرة عندما كانت تحيي إحدى حفلاتها من وراء الزجاج, ورمى باتجاهها 300 ليرة لبنانية كانت كل ما بحوزته, وقد عمل من أجلها عدة أشهر, واضطر بعدها للاستدانة من أجل عودته إلى سوريا!. وكنت دائما أشك في هذه القصة, ليس لأنها بعيدة عن الواقع, إنما لاعتقادي بأن من فعل ذلك هو والدي نفسه!, نظرا لهيامه بـ "البدوية" سميرة توفيق, وترديده لأغانيها خارج أوقات صلواته الخاشعة!.
وفي صباح ضبابي ندي, أمرتني امرأة أربعينية أن أركب سيارتها لأساعدها في ترتيب الأثاث. كان البيت في الجزء الغربي المنحدر من البلدة, ويشرف على منظر طبيعي ساحر. بعد ساعة من العمل أشفقت علي المرأة, أو أنها لم تعد تطيق الصرير المنبعث من زحزحة قطع الأثاث على الأرضية العارية, والتي لم أكن أستطيع حملها بالطبع, فطلبت مني الاستراحة قليلا لتناول الطعام. كان في الطبق شيء ما يشبه الطعام, وقد مضى عليه في الثلاجة أياما أو أسابيع... ولم أستطع المقاومة!.
وما أن حل مساء ذلك اليوم حتى وصلت إلى حالة سيئة استدعت نقلي إلى عيادة أحد أطباء البلدة, والذي عالج التسمم الغذائي بـ "إكراعي" ثلاث قناني "سفن أب" دفعة واحدة, جعلتني أتقيأ كل شيء, وأستعيد عافيتي!. ومازلت حتى الآن معجبا بنجاعة تلك المعالجة مع أنني لم أطبقها على أي من مرضاي فيما بعد!.
وفي بلدة “عينطورة”, وقريبا من مدرستها الشهيرة, عملت في تشييد بناية الخواجا "نجا". مقابل البناء كانت أسرة لبنانية مغتربة تقضي الصيف في لبنان. ولن أنسى ربة المنزل التي كانت تنتظر الساعة الرابعة, ساعة انتهاء العمل, لتناديني وتقدم لي سندويشة كبيرة ولذيذة, مرفقة بحنان أمومي غائم يعكِّر صفوَ عينيها. في البداية, طلبت مني القيام ببعض الأعمال البسيطة مقابل ذلك, ولكنها كفَّت لاحقا عن هذه المقايضة!.
في “عينطورة" بدأ انعكاس الأحداث الدامية يتصاعد. وصارت الأمور تسوء مع استعار الحرب الأهلية اللبنانية, ومن ثم دخول قوات الردع العربية. ولم أكن أفهم طبيعة هذه الحرب ودوافعها ولا ألعابها السياسية. وكنت أسمع الشتائم بحق سوريا أحيانا, مع أن قوات الردع كانت تؤازر "القوات اللبنانية" في تل الزعتر, حسبما أخبرني الخواجا "نجا".
كان الخواجا يعتبر نفسه مسؤولا عني, ويحذرني باستمرار بأن لا أقترب من الطريق العام حيث كنت أتسلى بعد الظهر بمراقبة السيارات العسكرية التي تعبره, وقد اخترقت بعضها أنواع الأعيرة النارية. وعندما أوقفتني إحداها, وترجل منها مسلح ليتعرف على هويتي ثم يطلقني, أيقنت أن ثمة خطرا فعليا. وكان رد الخواجا "نجا" عند سماعه ذلك ثورة من الغضب الشديد, وقال:" هؤلاء كانوا (الكتائب), ولو كانوا (حراس الأرز) لكنتَ الآن في جهنم!". وفي الورشة لم يبخل علي البعض بالنصائح, فكانوا يوصونني عندما أذهب لشراء بعض الحاجيات من السوبر ماركت أن أقول, مثلا, "بنَدورة" بدل "بنْدورة" حتى لا يحسبونني فلسطينيا!.
كثيرة هي الذكريات بحلوها ومرها. ومهما يكن, كنت أتقاضى أجري دون تأخير, ولم يحدث أن استغلني أحد, باستثناء آلية الاستغلال الرأسمالي نفسها. وكنت أتذكر ذلك دوما عندما عملت مع أحد المتعهدين في بلدي, والذي ادعى الإفلاس, ولم أتقاضى حقي منه, وكثيرون غيري, حتى الآن. لقد كان مدعوما, أو أوحى لنا بذلك, وكان هذا كافيا لنتفرَّق من أمام مخفر الشرطة بعد تخويفنا.
حدث ذلك أثناء الدراسة الجامعية. وكان قد تشكَّل لدي وعي طبقي, فتخلدنت وتمركست وتفرودت... وتأدلجت!؛ وتعافيت تدريجيا بعد أن برَّأت ماركس وأضرابه من منظري الثورات وحارقي المراحل وديماغوجيي و"مناضلي التقدم والاشتراكية". وقد أدركت لاحقا أنه لاحق ولا عدالة مع الاستبداد.
أجيال ثلاثة من أبناء الريف السوري هاموا في لبنان وغيره طلبا لأي عمل, ولم تستطع الحكومات المتعاقبة تأمين سبل العيش الكريمة لهم في وطنهم. فامتلأت بهم ضواحي المدن الكبيرة, ورحلوا في كل اتجاه. واقتصر "الاهتمام" بالمواطن على الجانب الأمني, وذلك طردا مع حجم ملفه!. ووصلنا إلى ما نحن عليه, ننتظر الضربة القاضية.
وأنا, بهذه المناسبة, أحيي أصواتا سمعتها مؤخرا في لبنان, تقترح تنمية الريف السوري حتى لا يستمر بضخ أبنائه إلى ضواحي المدن, وإلى لبنان. وكم أشعر بالأسى أننا لم نستطع, لحد الآن, بناء علاقات سوية متعاونة بين شعبينا وبلدينا بعيدا عن الاستعلاء والهيمنة من أي جهة كانت. ولبنان الذي كان واحة الحرية, صارت تتعالى فيه أصوات مستنسخي الشعارات و"المبادئ" التي أَتحفْنا بها الداخل والخارج. صار لبنان يشبهنا, ولم نعد نشبه أحدا.
 |
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
 |
حفظ - ورد
|
حفظ - ورد

 |
بحث
|
بحث
 |
|
 إضافة إلى المفضلة
|
إضافة إلى المفضلة
|
 للاتصال بالكاتب-ة
للاتصال بالكاتب-ة